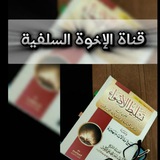🛑 جوامع الدعاء من صحيح السنة النبوية التي تجمع خير الدنيا والاخرة .. اكثروا من الدعاء لعلها ساعة إستجابة
1.🌱 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
[ متفق عليه ]
2.🌱 اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك
[ الصحيحة (٨٤٤) ]
3.🌱 اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني
[ رواه مسلم ]
4.🌱 اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
[ رواه مسلم ]
5.🌱 اللهم إني أسألك الهُدى والتُقى والعفاف والغنى
[ رواه مسلم ]
6.🌱 اللهم إني أعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاء وسُوء ِالقضاء وشماتة الأعداء
[ متفق عليه ]
7ّ.🌱 يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
[ حسنه الترمذي ]
8.🌱 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
[ حسنه الترمذي ]
9.🌱 اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبُخل وضَلَعِ الدَّينِ وقَهْرِ الرجال
[ حسنه الترمذي ]
10.🌱 اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد
[ رواه مسلم ]
11.🌱 اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
[ رواه مسلم ]
12.🌱 اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
[ متفق عليه ]
13.🌱 اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
[ رواه مسلم ]
14.🌱 اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً
[ صححه الألباني ]
15.🌱 اللهم احفظني بالإسلام قائماً واحفظني بالإسلام قاعداً واحفظني بالإسلام راقداً ولا تشمت بي عدواً حاسداً اللهم إني
أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك
[ الصحيحة (١٥٤٠) ]
16.🌱 اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
[ صححه الألباني ]
17.🌱 رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
[ متفق عليه ]
18ّ.🌱 اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نُرَدَّ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر
[ رواه البخاري ]
19.🌱 اللهم اهدني وسددني
[ رواه البخاري ]
20.🌱 اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني
[ قال الترمذي حسن صحيح ]
21.🌱 اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة
[ الصحيحة (١١٣٨) ]
22.🌱 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبخل والهَرَم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يُستجاب لها
[ رواه البخاري ]
23.🌱 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي
[ رواه الترمذي وصححه الالباني ]
24.🌱 رب أعني ولا تُعن علي وانصُرني ولا تنصُر علي وامكُر لي ولا تمكُر علي واهدني ويسِّر الهدى لي وانصُرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكَّاراً لك ذكَّاراً لك رهَّاباً لك مِطواعاً لك مُخبِتاً إليك أوَّاهاً مُنِيباً رب تقبَّل توبتي واغسل حَوبَتِي وأجب دعوتي وثبِّت حُجَّتي وسدِّد لساني واهد قلبي واسلُل سخيمة صدري
[ قال الترمذي حسن صحيح ]
25.🌱 اللهم إني أعوذ بك من القِلَّة والفقر والذِّلة وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم
[ الصحيحة (١٤٤٥) ]
26.🌱 اللهم حاسبني حساباً يسيراً
[ صحححه الألباني في المشكاة (٥٥٦٢) ]
1.🌱 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
[ متفق عليه ]
2.🌱 اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك
[ الصحيحة (٨٤٤) ]
3.🌱 اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني
[ رواه مسلم ]
4.🌱 اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
[ رواه مسلم ]
5.🌱 اللهم إني أسألك الهُدى والتُقى والعفاف والغنى
[ رواه مسلم ]
6.🌱 اللهم إني أعوذ بك من جَهْدِ البلاء ودَرَكِ الشقاء وسُوء ِالقضاء وشماتة الأعداء
[ متفق عليه ]
7ّ.🌱 يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
[ حسنه الترمذي ]
8.🌱 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
[ حسنه الترمذي ]
9.🌱 اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبُخل وضَلَعِ الدَّينِ وقَهْرِ الرجال
[ حسنه الترمذي ]
10.🌱 اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد
[ رواه مسلم ]
11.🌱 اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
[ رواه مسلم ]
12.🌱 اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
[ متفق عليه ]
13.🌱 اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
[ رواه مسلم ]
14.🌱 اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً
[ صححه الألباني ]
15.🌱 اللهم احفظني بالإسلام قائماً واحفظني بالإسلام قاعداً واحفظني بالإسلام راقداً ولا تشمت بي عدواً حاسداً اللهم إني
أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك
[ الصحيحة (١٥٤٠) ]
16.🌱 اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
[ صححه الألباني ]
17.🌱 رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
[ متفق عليه ]
18ّ.🌱 اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نُرَدَّ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر
[ رواه البخاري ]
19.🌱 اللهم اهدني وسددني
[ رواه البخاري ]
20.🌱 اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني
[ قال الترمذي حسن صحيح ]
21.🌱 اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة
[ الصحيحة (١١٣٨) ]
22.🌱 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبخل والهَرَم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يُستجاب لها
[ رواه البخاري ]
23.🌱 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي
[ رواه الترمذي وصححه الالباني ]
24.🌱 رب أعني ولا تُعن علي وانصُرني ولا تنصُر علي وامكُر لي ولا تمكُر علي واهدني ويسِّر الهدى لي وانصُرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكَّاراً لك ذكَّاراً لك رهَّاباً لك مِطواعاً لك مُخبِتاً إليك أوَّاهاً مُنِيباً رب تقبَّل توبتي واغسل حَوبَتِي وأجب دعوتي وثبِّت حُجَّتي وسدِّد لساني واهد قلبي واسلُل سخيمة صدري
[ قال الترمذي حسن صحيح ]
25.🌱 اللهم إني أعوذ بك من القِلَّة والفقر والذِّلة وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم
[ الصحيحة (١٤٤٥) ]
26.🌱 اللهم حاسبني حساباً يسيراً
[ صحححه الألباني في المشكاة (٥٥٦٢) ]
27.🌱 اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون
[ صحيح الترغيب (١/٩٧) ]
28.🌱 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك
[ حسنه الترمذي ]
29.🌱 اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت
[ الصحيحة (١٥٤٣) ]
30ّ.🌱 اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب
[ الصحيحة (٣٢٢٨) ]
[ صحيح الترغيب (١/٩٧) ]
28.🌱 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك
[ حسنه الترمذي ]
29.🌱 اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت
[ الصحيحة (١٥٤٣) ]
30ّ.🌱 اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب
[ الصحيحة (٣٢٢٨) ]
👍1
هذا آخر يوم جمعة من شهر رمضان ،حين يجتمع شرف أفضل يوم في الأسبوع وما يتميز به من فضائل مع شرف أفضل شهر في العام وما له من فضائل
فلنغتنم هذا اليوم أفضل اغتنام ولنتزود فيه من العبادات من اغتسال وتطيب وتبكير إلى المسجد لننال أجر الخطوات،مع قراءة وتلاوة القرآن ومنها قراءة الكهف،وكذا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحري ساعة الإجابة وخاصة إذا اجتمعت مع الصوم
وفقنا الله وإياكم لمرضاته وعبادته ولحسن ختام الشهر ...
فلنغتنم هذا اليوم أفضل اغتنام ولنتزود فيه من العبادات من اغتسال وتطيب وتبكير إلى المسجد لننال أجر الخطوات،مع قراءة وتلاوة القرآن ومنها قراءة الكهف،وكذا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحري ساعة الإجابة وخاصة إذا اجتمعت مع الصوم
وفقنا الله وإياكم لمرضاته وعبادته ولحسن ختام الشهر ...
👍3
🖊[أحكام مختصرة في زكاة الفطر]
ما حكم زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد .
الفتاوى (14/ 197)
بماذا تكون زكاة الفطر ؟
✅قال ابن باز:
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.
متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة .
الفتاوى (14/32-33)
سبب إخراج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. الفتاوى (١٨-٢٥٧).
من تصرف له زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء. الفتاوى الفتاوى (18/259)
حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. الفتاوى (18/262)
هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر ؟
✅قال العثيمين:
ج : يجوز ذلك . الفتاوى (18/268)
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
✅لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها. اللجنة الدائمة (9/387)
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم
الفتاوى (14/ 32)
✅قال ابن عثيمين:
إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام. الفتاوى (18/265)
هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟
✅قال ابن باز:
ج :ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
الفتاوى (14/ 197)
كم مقدار زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
الفتاوى (14/ 203)
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي ؟
✅قال ابن باز:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. الفتاوى (14/ 213)
أين تُخرج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
✅قال العثيمين:
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
✅قال العثيمين:
ج : لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
الفتاوى (١٨-٢٨٥).
هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
✅يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. اللجنة الدائمة (9/377)
ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟
✅إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
اللجنة الدائمة (9/380)
تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟
✅قال العثيمين:
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
الفتاوى (١٨-٢٦٦).
ما حكم زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد .
الفتاوى (14/ 197)
بماذا تكون زكاة الفطر ؟
✅قال ابن باز:
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.
متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة .
الفتاوى (14/32-33)
سبب إخراج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. الفتاوى (١٨-٢٥٧).
من تصرف له زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء. الفتاوى الفتاوى (18/259)
حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. الفتاوى (18/262)
هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر ؟
✅قال العثيمين:
ج : يجوز ذلك . الفتاوى (18/268)
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
✅لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها. اللجنة الدائمة (9/387)
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم
الفتاوى (14/ 32)
✅قال ابن عثيمين:
إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام. الفتاوى (18/265)
هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟
✅قال ابن باز:
ج :ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
الفتاوى (14/ 197)
كم مقدار زكاة الفطر؟
✅قال ابن باز:
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
الفتاوى (14/ 203)
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي ؟
✅قال ابن باز:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. الفتاوى (14/ 213)
أين تُخرج زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
✅قال العثيمين:
أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
✅قال العثيمين:
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
✅قال العثيمين:
ج : لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
الفتاوى (١٨-٢٨٥).
هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
✅يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. اللجنة الدائمة (9/377)
ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟
✅إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
اللجنة الدائمة (9/380)
تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟
✅قال العثيمين:
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
الفتاوى (١٨-٢٦٦).
👍2
✍️ اليكـم ثمانيـة اقـوال للعلمـاء منهـم الائمـة الثلاثة حول وجـوب اخراج زكـاة الفطـر طعاماً وعدم اجزاء اخراجها نقـداً ❌
❶- الإمام مالك -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❷ - الإمام الشافعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❸- الإمام أحمد -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❹- الإمام النووي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❺- ابن حزم -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❻- البغوي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❼- ابن قدامة -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❽- عمر بن الحسين الخرقي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
══════❁✿❁═════
❶- قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:
{ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام}.
❒ المدونه الكبرى ❪٣٨٥/٢❫. ══════❁✿❁═════
❷ - قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]).
❒ المجموع ❪١١٠/٦❫
وانظر ❒ الأم ❪٧٢/٢❫. ══════❁✿❁═════
❸- قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!).
❒ المغني ❪٣٥٢/٢❫.
══════❁✿❁═════
❹- قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
❒ شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.
══════❁✿❁═════
❺- قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه).
❒ المحلى ❪١٣٧/٦❫. ══════❁✿❁═════
❻- قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة.
❒ شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫. ══════❁✿❁═════
❼- قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد.
❒ المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.
══════❁✿❁═════
❽- قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
❒ المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫ .
❶- الإمام مالك -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❷ - الإمام الشافعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❸- الإمام أحمد -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❹- الإمام النووي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❺- ابن حزم -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❻- البغوي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❼- ابن قدامة -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
❽- عمر بن الحسين الخرقي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
══════❁✿❁═════
❶- قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:
{ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام}.
❒ المدونه الكبرى ❪٣٨٥/٢❫. ══════❁✿❁═════
❷ - قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]).
❒ المجموع ❪١١٠/٦❫
وانظر ❒ الأم ❪٧٢/٢❫. ══════❁✿❁═════
❸- قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!).
❒ المغني ❪٣٥٢/٢❫.
══════❁✿❁═════
❹- قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
❒ شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.
══════❁✿❁═════
❺- قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه).
❒ المحلى ❪١٣٧/٦❫. ══════❁✿❁═════
❻- قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة.
❒ شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫. ══════❁✿❁═════
❼- قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد.
❒ المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.
══════❁✿❁═════
❽- قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
❒ المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫ .
كثير من الفلكيين بل ومن الفقهاء لا يعلم أن العبرة بظاهر الرؤية لا بحقيقة حال الهلال.
يعني إذا شهد الشهود برؤية الهلال عُمل بها، بغض النظر أصاب الشهود أم أخطؤوا، ما لم نعلم بخطئهم.
الشيخ علي الرملي حفظه الله
يعني إذا شهد الشهود برؤية الهلال عُمل بها، بغض النظر أصاب الشهود أم أخطؤوا، ما لم نعلم بخطئهم.
الشيخ علي الرملي حفظه الله
# جديد فتاوى العلامة محمد علي فركوس حفظه الله #
في معنى المُحالات الثَّلاثة:
«كسبِ الأشعريِّ، وطفرةِ النَّظَّام، وأحوالِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ»
السؤال:
حذَّر العلماءُ مِنْ مُحالاتِ علم الكلام الثَّلاثة: «كسبِ الأشعريِّ، وطفرةِ النَّظَّام، وأحوالِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ» فما معنَى هذه المُحالات، وما وجهُ التَّحذيرِ منها؟ أنيرونا ـ وفَّقكم اللهُ ـ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرادُ بالمُحالات عمومًا هي عبارةٌ عن أمورٍ أو أحوالٍ لا وجودَ لها في الواقع لأنَّها مُمتنِعةٌ عقلًا، وإنَّما قد تُوجَدُ تقديرًا في الأذهان كما يُقدَّرُ المُمتنِعُ موجودًا ممكنًا أو واجِبَ الوجود، فهي مِنَ الأشياء الَّتي يدخلها المُحالُ والامتناع.
والمُحالاتُ المسؤولُ عنها هي:
أوَّلًا: الكسبُ ـ لغةً ـ هو طلبُ الرِّزقِ والسَّعيُ، وهو العمل أو الدَّخل، وأصلُه: الجمعُ، وهو يدلُّ على ابتغاءٍ وطلبٍ وإصابةٍ، والكسبُ يُطلَقُ على مَنْ عاد فِعلُه عليه بالنَّفع أو الضرِّ، يقال: كسَبَ إثمًا: فعَلَه أو تَحمَّله(١)، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا﴾ [النِّساء: ١١٢](٢).
أمَّا مسألةُ «الكسب» عند الأشعريِّ(٣) فقد رام التَّوسُّطَ بين الجبريَّةِ والقَدَريَّةِ في مسألةِ الأفعال الاختياريَّةِ للعبد، فأَحدثَ «نظريَّةَ الكسب» الَّتي لم يُعرَفِ القولُ بها إلَّا في زمنِه، تلك النَّظريَّةُ الَّتي حيَّرَتِ الأفهامَ في تصوُّرِها، واضطربت الأقوالُ في التَّعبيرِ عنها؛ ومَفادُها: أنَّ الكسبَ هو الاقترانُ العاديُّ بين قدرةِ العبد الحادثةِ وفِعلِه الواقعِ بقدرة الله وَحْدَها؛ وتوضيحُ ذلك: أنَّ الأشاعرة يُثبِتون أنَّ أفعالَ العبدِ مخلوقةٌ لله تعالى، وهي ـ مع كونها خَلْقَ اللهِ ـ فهي مِنْ كسبِ العبد، غير أنَّ أفعالَ العبدِ واقعةٌ ـ عندهم ـ بقدرةِ الله وَحْدَها، وللعبد قدرةٌ لا تأثيرَ لها فيها، أي: أنَّ العبد كاسبٌ وليس بفاعلٍ حقيقةً، والفعلُ يُوجَدُ عند القدرةِ لا بها، وإنَّما فاعلُ فعلِ العبدِ هو اللهُ تعالى، وعملُ العبدِ ليس فعلًا للعبد، بل هو كسبٌ له، وإنَّما هو مِنْ فعل الله فقط، والخالقُ قَرَنَ القدرةَ بالمقدور بمُجرَّدِ الاقتران العاديِّ لا لسببٍ ولا لحكمةٍ أصلًا.
وقد استنكر العلماءُ وكذا أعلامُ المذهبِ الأشعريِّ كالباقلَّانيِّ والجُوينيِّ وغيرِهما الكسبَ الَّذي قال به الأشاعرةُ، لأنَّه قولٌ حادثٌ لم يُعرَفْ إلَّا في زمنِ الأشعريِّ بعد انقضاءِ القرون الثَّلاثةِ المفضَّلةِ، وعَدُّوه قولًا مُتناقِضًا لا حقيقةَ له ولا حاصِلَ تحته وغيرَ معقولٍ، إذ لا يُوجَدُ فرقٌ معقولٌ بين الفعل الَّذي نَفَوْه والكسبِ الَّذي أَثبَتُوه له، وقولُهُم في الكسب ـ عند التَّحقيق ـ لا يخرج عن مَقالةِ الجهميَّةِ والجبريَّةِ(٤)؛ حيث يصرِّحون بأنَّ الخَلْقَ مجبورٌ باطنًا، مختارٌ ظاهرًا، ومِنْ أسوإِ ما نتَجَ عن هذا المُعتقَدِ: تفريقُهم بين الحقيقةِ والشَّريعة، حيث يقولون: إنَّك إذا نظَرْتَ إلى العاصي فإنَّك تَعذِرُه حقيقةً لأنَّه أُجبِرَ على المعصِيَةِ باطنًا، ولكنَّك تمقتُه شريعةً لأنَّه مُختارٌ لها ظاهرًا، وهذا تعارضٌ لا يَرتضِيه عقلٌ ولا يشهد له نصٌّ.
ثانيًا: الطَّفرةُ ـ لغةً ـ هي اسْمُ مرَّةٍ مِنْ طفَرَ يَطفِرُ طَفْرًا وطفورًا، وهو وُثُوبٌ أو قَفْزةٌ في ارتفاعٍ(٥).
وأمَّا طفرةُ النَّظَّام(٦) فقد زعَمَ أنَّه قد يجوز أَنْ يكون الجسمُ الواحدُ في مكانٍ، ثمَّ يصيرَ إلى المكانِ الثَّالثِ دون أَنْ يَمُرَّ بالثَّاني الَّذي بينهما على جهة الطَّفرة(٧)، فهذه الطَّفرةُ بحيث يكون الجسمُ في المكان الأوَّل، ثمَّ يصيرُ منه إلى المكان العاشر مِنْ غير المرور بالأمكنةِ المتوسِّطةِ بينه وبين العاشر، ومِنْ غير أَنْ يصيرَ معدومًا في الأوَّلِ ومُعادًا في العاشر(٨)، وهذا أخَذَه عن شيخه هشام بنِ الحكم الرَّافضيِّ ومَلاحدةِ الفلاسفةِ الَّذين صَحِبَهم، ثمَّ بنى على ذلك قولَه بالطَّفرةِ الَّتي لم يُسبَقْ إليها، بل هي دعوَى مُجرَّدةٌ لا يشهد لها شاهدُ عقلٍ ولا اعتبارٍ؛ قال محمَّد أمان الجاميُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا طفرة النَّظَّام: فهي (انزلاقةٌ) انفرد بها النَّظَّامُ المعتزليُّ دون سائر المعتزلة، وهي القولُ بأنَّ الله خلَقَ هذه الموجوداتِ دُفعةً واحدةً على ما هي عليه الآنَ، مِنْ نباتٍ وحيوانٍ وجبالٍ وبحارٍ، ولم يتقدَّمْ خَلْقُ آدَمَ على ذُرِّيَّتِه، غير أنَّ الله (أَكمنَ)(٩) بعضَها في بعضٍ، فالتَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ إنَّما يقع في ظهورِ هذه الموجوداتِ في أماكنها دون حُدوثها ووجودِها.
[وقد زعَمَ النَّظَّام ما زعَمَ](١٠) متأثِّرًا بأصحاب الكمون والظُّهورِ مِنَ(١١) الفلاسفةِ، وهي طفرةٌ لم يسبقه إليها أحدٌ قبله»(١٢).
في معنى المُحالات الثَّلاثة:
«كسبِ الأشعريِّ، وطفرةِ النَّظَّام، وأحوالِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ»
السؤال:
حذَّر العلماءُ مِنْ مُحالاتِ علم الكلام الثَّلاثة: «كسبِ الأشعريِّ، وطفرةِ النَّظَّام، وأحوالِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ» فما معنَى هذه المُحالات، وما وجهُ التَّحذيرِ منها؟ أنيرونا ـ وفَّقكم اللهُ ـ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرادُ بالمُحالات عمومًا هي عبارةٌ عن أمورٍ أو أحوالٍ لا وجودَ لها في الواقع لأنَّها مُمتنِعةٌ عقلًا، وإنَّما قد تُوجَدُ تقديرًا في الأذهان كما يُقدَّرُ المُمتنِعُ موجودًا ممكنًا أو واجِبَ الوجود، فهي مِنَ الأشياء الَّتي يدخلها المُحالُ والامتناع.
والمُحالاتُ المسؤولُ عنها هي:
أوَّلًا: الكسبُ ـ لغةً ـ هو طلبُ الرِّزقِ والسَّعيُ، وهو العمل أو الدَّخل، وأصلُه: الجمعُ، وهو يدلُّ على ابتغاءٍ وطلبٍ وإصابةٍ، والكسبُ يُطلَقُ على مَنْ عاد فِعلُه عليه بالنَّفع أو الضرِّ، يقال: كسَبَ إثمًا: فعَلَه أو تَحمَّله(١)، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا﴾ [النِّساء: ١١٢](٢).
أمَّا مسألةُ «الكسب» عند الأشعريِّ(٣) فقد رام التَّوسُّطَ بين الجبريَّةِ والقَدَريَّةِ في مسألةِ الأفعال الاختياريَّةِ للعبد، فأَحدثَ «نظريَّةَ الكسب» الَّتي لم يُعرَفِ القولُ بها إلَّا في زمنِه، تلك النَّظريَّةُ الَّتي حيَّرَتِ الأفهامَ في تصوُّرِها، واضطربت الأقوالُ في التَّعبيرِ عنها؛ ومَفادُها: أنَّ الكسبَ هو الاقترانُ العاديُّ بين قدرةِ العبد الحادثةِ وفِعلِه الواقعِ بقدرة الله وَحْدَها؛ وتوضيحُ ذلك: أنَّ الأشاعرة يُثبِتون أنَّ أفعالَ العبدِ مخلوقةٌ لله تعالى، وهي ـ مع كونها خَلْقَ اللهِ ـ فهي مِنْ كسبِ العبد، غير أنَّ أفعالَ العبدِ واقعةٌ ـ عندهم ـ بقدرةِ الله وَحْدَها، وللعبد قدرةٌ لا تأثيرَ لها فيها، أي: أنَّ العبد كاسبٌ وليس بفاعلٍ حقيقةً، والفعلُ يُوجَدُ عند القدرةِ لا بها، وإنَّما فاعلُ فعلِ العبدِ هو اللهُ تعالى، وعملُ العبدِ ليس فعلًا للعبد، بل هو كسبٌ له، وإنَّما هو مِنْ فعل الله فقط، والخالقُ قَرَنَ القدرةَ بالمقدور بمُجرَّدِ الاقتران العاديِّ لا لسببٍ ولا لحكمةٍ أصلًا.
وقد استنكر العلماءُ وكذا أعلامُ المذهبِ الأشعريِّ كالباقلَّانيِّ والجُوينيِّ وغيرِهما الكسبَ الَّذي قال به الأشاعرةُ، لأنَّه قولٌ حادثٌ لم يُعرَفْ إلَّا في زمنِ الأشعريِّ بعد انقضاءِ القرون الثَّلاثةِ المفضَّلةِ، وعَدُّوه قولًا مُتناقِضًا لا حقيقةَ له ولا حاصِلَ تحته وغيرَ معقولٍ، إذ لا يُوجَدُ فرقٌ معقولٌ بين الفعل الَّذي نَفَوْه والكسبِ الَّذي أَثبَتُوه له، وقولُهُم في الكسب ـ عند التَّحقيق ـ لا يخرج عن مَقالةِ الجهميَّةِ والجبريَّةِ(٤)؛ حيث يصرِّحون بأنَّ الخَلْقَ مجبورٌ باطنًا، مختارٌ ظاهرًا، ومِنْ أسوإِ ما نتَجَ عن هذا المُعتقَدِ: تفريقُهم بين الحقيقةِ والشَّريعة، حيث يقولون: إنَّك إذا نظَرْتَ إلى العاصي فإنَّك تَعذِرُه حقيقةً لأنَّه أُجبِرَ على المعصِيَةِ باطنًا، ولكنَّك تمقتُه شريعةً لأنَّه مُختارٌ لها ظاهرًا، وهذا تعارضٌ لا يَرتضِيه عقلٌ ولا يشهد له نصٌّ.
ثانيًا: الطَّفرةُ ـ لغةً ـ هي اسْمُ مرَّةٍ مِنْ طفَرَ يَطفِرُ طَفْرًا وطفورًا، وهو وُثُوبٌ أو قَفْزةٌ في ارتفاعٍ(٥).
وأمَّا طفرةُ النَّظَّام(٦) فقد زعَمَ أنَّه قد يجوز أَنْ يكون الجسمُ الواحدُ في مكانٍ، ثمَّ يصيرَ إلى المكانِ الثَّالثِ دون أَنْ يَمُرَّ بالثَّاني الَّذي بينهما على جهة الطَّفرة(٧)، فهذه الطَّفرةُ بحيث يكون الجسمُ في المكان الأوَّل، ثمَّ يصيرُ منه إلى المكان العاشر مِنْ غير المرور بالأمكنةِ المتوسِّطةِ بينه وبين العاشر، ومِنْ غير أَنْ يصيرَ معدومًا في الأوَّلِ ومُعادًا في العاشر(٨)، وهذا أخَذَه عن شيخه هشام بنِ الحكم الرَّافضيِّ ومَلاحدةِ الفلاسفةِ الَّذين صَحِبَهم، ثمَّ بنى على ذلك قولَه بالطَّفرةِ الَّتي لم يُسبَقْ إليها، بل هي دعوَى مُجرَّدةٌ لا يشهد لها شاهدُ عقلٍ ولا اعتبارٍ؛ قال محمَّد أمان الجاميُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا طفرة النَّظَّام: فهي (انزلاقةٌ) انفرد بها النَّظَّامُ المعتزليُّ دون سائر المعتزلة، وهي القولُ بأنَّ الله خلَقَ هذه الموجوداتِ دُفعةً واحدةً على ما هي عليه الآنَ، مِنْ نباتٍ وحيوانٍ وجبالٍ وبحارٍ، ولم يتقدَّمْ خَلْقُ آدَمَ على ذُرِّيَّتِه، غير أنَّ الله (أَكمنَ)(٩) بعضَها في بعضٍ، فالتَّقدُّمُ والتَّأخُّرُ إنَّما يقع في ظهورِ هذه الموجوداتِ في أماكنها دون حُدوثها ووجودِها.
[وقد زعَمَ النَّظَّام ما زعَمَ](١٠) متأثِّرًا بأصحاب الكمون والظُّهورِ مِنَ(١١) الفلاسفةِ، وهي طفرةٌ لم يسبقه إليها أحدٌ قبله»(١٢).
👍1
ثالثًا: أحوالُ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ(١٣):
المراد بالأحوال هي الصِّفاتُ المعنويَّةُ الَّتي انفرد أبو هاشمٍ بإثباتها دون سائر المعتزلةِ مع نفيه لِصِفات المعاني، وهو أوَّلُ مَنْ قال: إنَّ الصِّفاتِ أحوالٌ، فأَثبتَ أحوالًا هي صفاتٌ لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا معلومةٌ ولا مجهولةٌ، أي: هي على حِيالِهَا لا تُعرَف كذلك بل مع الذَّات، أي: أنَّه ينفي العِلمَ والقدرةَ والإرادةَ إلى آخِرِ الصِّفاتِ ثمَّ يُثبِتُ كونَه عالمًا وقادرًا ومريدًا، وهذه (الكوكنةُ) هي الأحوال، وهي ـ بهذا المفهوم ـ مُحالةٌ لا تَثبُت إلَّا في الذِّهن فقط، وقد أَشكلَتْ على العلماءِ أحوالُ أبي هاشمٍ هذه وجهَّلوه بها وشنَّعوا عليه؛ قال عبدُ القاهرِ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «ثمَّ إنَّه لَا يَقُول في الأحوال: إنَّها موجودةٌ ولا إنَّها معدومةٌ، ولا إنَّها قديمةٌ ولا مُحدَثةٌ، ولا معلومةٌ ولا مجهولةٌ، ولا تقول: إنَّها مذكورةٌ، مع ذِكرِه لها بقوله: إنَّها غيرُ مذكورةٍ، وهذا مُتناقِضٌ؛ وزَعَمَ ـ أيضًا ـ أنَّ العالِمَ له في كُلِّ معلومٍ حالٌ لا يُقالُ فيها: إنَّها حالةٌ [لعلَّها: حالُهُ] مع المعلومِ الآخَرِ، ولأجلِ هذا زعَمَ أنَّ أحوالَ الباري عزَّ وجلَّ في معلوماته لا نهايةَ لها، وكذلك أحوالُه في مقدوراتِه لا نهايةَ لها، كما أنَّ مقدوراتِه لا نهايةَ لها؛ وقال له أصحابُنا: ما أَنكَرْتَ أَنْ يكون لمعلومٍ واحدٍ أحوالٌ بلا نهايةٍ لصِحَّةِ تَعلُّقِ المعلومِ بكُلِّ عَالمٍ يُوجَدُ لا إلى نهايةٍ؛ وقالوا له: هل أحوالُ الباري مِنْ عملِ غيرِه أم هي هو؟ فأجاب بأنَّها لا هي هو ولا غيرُه؛ فقالوا له: فلِمَ أَنكَرْتَ على الصِّفاتيَّةِ قولَهُم في صِفَات الله عزَّ وجلَّ في الأزل: إنَّها لا هي ولا غيرُه؟»(١٤) ؛ وردَّ أبو محمَّدِ بنُ حزمٍ ـ رحمه الله ـ هذه الأحوالَ، واعتبرها مِنَ السَّفسطةِ والهذيان؛ فقال ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا الأحوالُ الَّتي ادَّعَتْها الأشعريَّةُ فإنَّهم قالُوا: إنَّ ها هُنَا أحوالًا لَيست حقًّا ولا باطلًا، ولا هي مخلوقةٌ ولا غيرُ مخلوقةٍ، ولا هي موجودةٌ ولا معدومةٌ، ولا هي معلومةٌ ولا هي مجهولةٌ، ولا هي أشياءُ ولا هي لا أشياءُ؛ وقالوا: مِنْ هذا عِلمُ العالمِ بأنَّ له علمًا.. ثمَّ نقولُ لهم: أَخبِرونا إِذا قُلْتُمْ هذه أحوالٌ: أهي مَعَانٍ ومُسمَّيَاتٌ مضبوطةٌ محدودةٌ مُتميِّزٌ بعضُها مِنْ بعضٍ، أم ليست مَعانِيَ أصلًا ولا لها مُسمَّيَاتٌ، ولا هي مضبوطةٌ ولا محدودةٌ متميِّزٌ بعضُها مِنْ بعضٍ؟ فإِنْ قالوا: ليست مَعانِيَ ولا محدودةً ولا مضبوطةً ولا متميِّزًا بعضُها مِنْ بعضٍ ولا لِتلك الأسماءِ مُسمَّيَاتٌ أصلًا؛ قِيلَ لَهُم: فهذا هو معنَى العَدَمِ حَقًّا؛ فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّها ليست معدومةً، ثمَّ لِمَ سمَّيْتُموها أحوالًا وهي معدومةٌ، ولا تكون التَّسمِيَةُ إلَّا شَرْعِيَّةً أَو لُغَويَّةً، وتَسمِيَتُكم هذه المَعانِيَ: أحوالًا ليست تسمِيَةً شرعيَّةً ولا لُغَويَّةً ولا مُصطلَحًا عليها لِبَيانِ ما يقع عليه، فهي باطلٌ محضٌ بِيَقينٍ؛ فإِنْ قالوا: هي مَعانٍ مضبوطةٌ ولها مُسمَّيَاتٌ محدودةٌ متميِّزةٌ بعضُها مِنْ بعضٍ، قِيلَ لَهُم: هذه صفةُ الموجودِ ولا بُدَّ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّهَا لَيست موجودةً... ويُقَالُ لَهُم أيضًا: هذه الأحوالُ الَّتي تقولون: أمعقولةٌ هي أم غيرُ معقولةٍ؟ فإِنْ قالوا: هي معقولةٌ كانوا قد أَثبتُوا لها مَعانِيَ وحقائقَ مِنْ أجلِها عُقِلَتْ، فهي موجودةٌ ولا بُدَّ، والعدمُ ليس معقولًا، لكنَّه لا معنَى لهذه اللَّفظةِ أصلًا»(١٥) [بتصرُّف].
علمًا أنَّه قد وافق أبا هاشمٍ على إثباتِ الأحوالِ خلائقُ مِنْ غيرِ المعتزلةِ كالقاضي أبي بكرٍ الباقِلَّانيِّ الأشعريِّ والقاضي أبي يعلى الحنبليِّ، وهو القولُ الأوَّلُ لأبي المَعالي الجُوينيِّ ثمَّ رجَعَ عنه(١٦).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في:١٣ رمضان ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ مـارس ٢٠٢٥ م
(١) انظر: «العين» للخليل (٥/ ٣١٥)، «مُعجَم ديوان الأدب» لأبي إبراهيمَ إسحاقَ الفارابيِّ (٢/ ١٤٦)، «كتاب الأفعال» لابن القوطيَّة (ص ٢٢٧)، «تهذيب اللُّغة» للأزهري (١٠/ ٤٨)، «المحيط في اللُّغة» للصاحب بنِ عبَّاد (٦/ ١٩٠)، «الصِّحاح» للجوهري (١/ ٢١٢)، «مُجمَل اللُّغة» (٧٨٥) و«مقاييس اللُّغة» (٥/ ١٧٩) كلاهما لابن فارس، «أساس البلاغة» للزَّمخشري (٢/ ١٣٤)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٣٤٧)، «النِّهاية» لابن الأثير (٤/ ١٧١)، «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد (٣/ ١٩٢٨).
المراد بالأحوال هي الصِّفاتُ المعنويَّةُ الَّتي انفرد أبو هاشمٍ بإثباتها دون سائر المعتزلةِ مع نفيه لِصِفات المعاني، وهو أوَّلُ مَنْ قال: إنَّ الصِّفاتِ أحوالٌ، فأَثبتَ أحوالًا هي صفاتٌ لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا معلومةٌ ولا مجهولةٌ، أي: هي على حِيالِهَا لا تُعرَف كذلك بل مع الذَّات، أي: أنَّه ينفي العِلمَ والقدرةَ والإرادةَ إلى آخِرِ الصِّفاتِ ثمَّ يُثبِتُ كونَه عالمًا وقادرًا ومريدًا، وهذه (الكوكنةُ) هي الأحوال، وهي ـ بهذا المفهوم ـ مُحالةٌ لا تَثبُت إلَّا في الذِّهن فقط، وقد أَشكلَتْ على العلماءِ أحوالُ أبي هاشمٍ هذه وجهَّلوه بها وشنَّعوا عليه؛ قال عبدُ القاهرِ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «ثمَّ إنَّه لَا يَقُول في الأحوال: إنَّها موجودةٌ ولا إنَّها معدومةٌ، ولا إنَّها قديمةٌ ولا مُحدَثةٌ، ولا معلومةٌ ولا مجهولةٌ، ولا تقول: إنَّها مذكورةٌ، مع ذِكرِه لها بقوله: إنَّها غيرُ مذكورةٍ، وهذا مُتناقِضٌ؛ وزَعَمَ ـ أيضًا ـ أنَّ العالِمَ له في كُلِّ معلومٍ حالٌ لا يُقالُ فيها: إنَّها حالةٌ [لعلَّها: حالُهُ] مع المعلومِ الآخَرِ، ولأجلِ هذا زعَمَ أنَّ أحوالَ الباري عزَّ وجلَّ في معلوماته لا نهايةَ لها، وكذلك أحوالُه في مقدوراتِه لا نهايةَ لها، كما أنَّ مقدوراتِه لا نهايةَ لها؛ وقال له أصحابُنا: ما أَنكَرْتَ أَنْ يكون لمعلومٍ واحدٍ أحوالٌ بلا نهايةٍ لصِحَّةِ تَعلُّقِ المعلومِ بكُلِّ عَالمٍ يُوجَدُ لا إلى نهايةٍ؛ وقالوا له: هل أحوالُ الباري مِنْ عملِ غيرِه أم هي هو؟ فأجاب بأنَّها لا هي هو ولا غيرُه؛ فقالوا له: فلِمَ أَنكَرْتَ على الصِّفاتيَّةِ قولَهُم في صِفَات الله عزَّ وجلَّ في الأزل: إنَّها لا هي ولا غيرُه؟»(١٤) ؛ وردَّ أبو محمَّدِ بنُ حزمٍ ـ رحمه الله ـ هذه الأحوالَ، واعتبرها مِنَ السَّفسطةِ والهذيان؛ فقال ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا الأحوالُ الَّتي ادَّعَتْها الأشعريَّةُ فإنَّهم قالُوا: إنَّ ها هُنَا أحوالًا لَيست حقًّا ولا باطلًا، ولا هي مخلوقةٌ ولا غيرُ مخلوقةٍ، ولا هي موجودةٌ ولا معدومةٌ، ولا هي معلومةٌ ولا هي مجهولةٌ، ولا هي أشياءُ ولا هي لا أشياءُ؛ وقالوا: مِنْ هذا عِلمُ العالمِ بأنَّ له علمًا.. ثمَّ نقولُ لهم: أَخبِرونا إِذا قُلْتُمْ هذه أحوالٌ: أهي مَعَانٍ ومُسمَّيَاتٌ مضبوطةٌ محدودةٌ مُتميِّزٌ بعضُها مِنْ بعضٍ، أم ليست مَعانِيَ أصلًا ولا لها مُسمَّيَاتٌ، ولا هي مضبوطةٌ ولا محدودةٌ متميِّزٌ بعضُها مِنْ بعضٍ؟ فإِنْ قالوا: ليست مَعانِيَ ولا محدودةً ولا مضبوطةً ولا متميِّزًا بعضُها مِنْ بعضٍ ولا لِتلك الأسماءِ مُسمَّيَاتٌ أصلًا؛ قِيلَ لَهُم: فهذا هو معنَى العَدَمِ حَقًّا؛ فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّها ليست معدومةً، ثمَّ لِمَ سمَّيْتُموها أحوالًا وهي معدومةٌ، ولا تكون التَّسمِيَةُ إلَّا شَرْعِيَّةً أَو لُغَويَّةً، وتَسمِيَتُكم هذه المَعانِيَ: أحوالًا ليست تسمِيَةً شرعيَّةً ولا لُغَويَّةً ولا مُصطلَحًا عليها لِبَيانِ ما يقع عليه، فهي باطلٌ محضٌ بِيَقينٍ؛ فإِنْ قالوا: هي مَعانٍ مضبوطةٌ ولها مُسمَّيَاتٌ محدودةٌ متميِّزةٌ بعضُها مِنْ بعضٍ، قِيلَ لَهُم: هذه صفةُ الموجودِ ولا بُدَّ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إنَّهَا لَيست موجودةً... ويُقَالُ لَهُم أيضًا: هذه الأحوالُ الَّتي تقولون: أمعقولةٌ هي أم غيرُ معقولةٍ؟ فإِنْ قالوا: هي معقولةٌ كانوا قد أَثبتُوا لها مَعانِيَ وحقائقَ مِنْ أجلِها عُقِلَتْ، فهي موجودةٌ ولا بُدَّ، والعدمُ ليس معقولًا، لكنَّه لا معنَى لهذه اللَّفظةِ أصلًا»(١٥) [بتصرُّف].
علمًا أنَّه قد وافق أبا هاشمٍ على إثباتِ الأحوالِ خلائقُ مِنْ غيرِ المعتزلةِ كالقاضي أبي بكرٍ الباقِلَّانيِّ الأشعريِّ والقاضي أبي يعلى الحنبليِّ، وهو القولُ الأوَّلُ لأبي المَعالي الجُوينيِّ ثمَّ رجَعَ عنه(١٦).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في:١٣ رمضان ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ مـارس ٢٠٢٥ م
(١) انظر: «العين» للخليل (٥/ ٣١٥)، «مُعجَم ديوان الأدب» لأبي إبراهيمَ إسحاقَ الفارابيِّ (٢/ ١٤٦)، «كتاب الأفعال» لابن القوطيَّة (ص ٢٢٧)، «تهذيب اللُّغة» للأزهري (١٠/ ٤٨)، «المحيط في اللُّغة» للصاحب بنِ عبَّاد (٦/ ١٩٠)، «الصِّحاح» للجوهري (١/ ٢١٢)، «مُجمَل اللُّغة» (٧٨٥) و«مقاييس اللُّغة» (٥/ ١٧٩) كلاهما لابن فارس، «أساس البلاغة» للزَّمخشري (٢/ ١٣٤)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٣٤٧)، «النِّهاية» لابن الأثير (٤/ ١٧١)، «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد (٣/ ١٩٢٨).
👍1
وعرَّف ابن تيميَّة ـ رحمه الله ـ الكسبَ شرعًا في [«مجموع الفتاوى» (٨/ ٣٨٧)] بأنَّه «الفعلُ الَّذي يعود على فاعلِه بنفعٍ أو ضرٍّ»، وعرَّفه القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في [«تفسيره» (٥/ ٣٨٠)] بأنَّه «ما يجرُّ به الإنسانُ إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنه به ضررًا»، ثمَّ قال: «ولهذا لا يُسمَّى فعلُ الرَّبِّ تعالى كسبًا».
(٢) الكسب وقَعَ في القرآن على ثلاثةِ معانٍ: أحَدُها: عقدُ القلبِ وعزمُه وقصدُه كقوله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [البقرة: ٢٢٥] لأنَّه مِنْ عملِ القلب الَّذي هو مِنْ سعيِه وفيه تطلُّبٌ، ويجرُّ به إلى صاحبِه نفعًا أو ضرًّا لأنَّه مُؤاخَذٌ به، بخلاف الخَطَراتِ والوساوسِ وحديثِ النَّفسِ والهمِّ ما لم يَعزِمْ عليه أو يعمَلْ أو يتكلَّمْ به، والثَّاني: كسبُ المال مِنَ التِّجارةِ مثل قولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فالأوَّل: للتُّجَّار، والثَّاني: للزُّرَّاع، والمعنى الثَّالث: السَّعيُ والعمل كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿.. بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩، يونس: ٥٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَذَكِّرۡ بِهِۦٓ أَن تُبۡسَلَ نَفۡسُۢ بِمَا كَسَبَتۡ﴾ [الأنعام: ٧٠]؛ [انظر: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ٣٦٣)].
(٣) هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ الأشعريُّ، مِنْ نسلِ أبي بُردةَ بنِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه؛ قِيلَ: كان في الفِقه مالكيًّا وقِيلَ غيرُ ذلك، فتَنازعَتْه المذاهبُ الأربعة؛ إمامٌ مِنْ أئمَّةِ المُتكلِّمين، وهو مُؤسِّسُ مذهبِ الأشاعِرةِ بعدما كان على مذهب المعتزِلةِ أربعين سَنَةً؛ أخَذَ عِلمَ الكلامِ والاعتزالَ عن زوجِ أمِّه أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ شيخِ المعتزِلة وغيرِه، ثمَّ فارقه ورَجَع عن الاعتِزال وأَظهرَ ذلك، واتَّبع طريقةَ ابنِ كُلَّابٍ (ت: ٢٤١ﻫ ـ ٨٥٥م)، وشَرَع في الرَّدِّ على المعتزلةِ والتَّصنيفِ في خلافهم؛ ثمَّ رجَعَ عن بعضِ مقالاتِ ابنِ كُلَّابٍ إلى قولِ أهلِ السُّنَّة، وبَقِيَتْ عليه منهُ بقيَّةٌ ومِنْ بعضِ مقالاتِ المعتزلة، وانتسبَ في العقيدةِ إلى الإمام المُبجَّلِ أحمدَ بنِ حنبلٍ لِاعتقادِه إمامَتَه؛ ومِنْ كُتُبه: «إثباتُ القياس»، وكتابُ «اختلاف النَّاس في الأسماء والأحكام والخاصِّ والعامِّ»، و«مقالاتُ الإسلاميِّين»، و«إيضاحُ البرهان»، و«الإبانةُ عن أصول الدِّيانة» وهو آخِرُ مصنَّفاتِه الَّذي رجَعَ فيه عن كثيرٍ مِنْ أقوال الأشاعرةِ والكُلَّابيَّة؛ تُوُفِّيَ أبو الحسنِ الأشعريُّ ـ رحمه الله ـ سَنَةَ: (٣٢٤ﻫ ـ ٩٣٥م). [انظر ترجمته في مؤلَّفي: «الإعلام بمَنْثورِ تَراجِمِ المَشاهير والأعلام» (٥٢٦)].
(٤) للمزيد: انظر مؤلَّفي: «الحُلَل الذَّهبيَّة شرح العقائد الإسلاميَّة لابن باديس» (٦٢٠).
(٥) انظر: «العين» للخليل (٧/ ٤١٧)، «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (٢/ ٧٥٤)، «تهذيب اللُّغة» للأزهري (١٣/ ٢٢٥)، «المحيط في اللُّغة» للصَّاحب بنِ عباد (٩/ ١٦٢ ـ ١٦٣)، «الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٧٢٦)، «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد (٢/ ١٤٠٤).
(٦) هو أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ سيَّارِ بن هانئٍ البصريُّ مولى آلِ الحارثِ بنِ عُبادٍ البكريِّ المعروفُ بالنَّظَّام؛ سُمِّيَ بهذا لأنَّه كان يَنظمُ الكلامَ أو الشِّعرَ وقِيلَ: الخرزَ ؛ مُتكلِّمٌ، شيخُ الفِرقةِ النَّظَّاميَّةِ مِنَ المعتزلة؛ وُلِدَ سَنَةَ: (١٨٥هـ ـ ٨٠١م)؛ تَربَّى بالبصرةِ ثمَّ رحَلَ إلى بغدادَ؛ كان أَنبهَ تلاميذِ أبي الهُذَيْلِ العلَّاف المُعتزليِّ، وكان ذا ذكاءٍ وفصاحةٍ، وشاعرًا أديبًا بليغًا، تَبحَّرَ في علومِ الفلسفةِ والكلام، وقد كانت دراستُه مَزيجًا جامعًا بين آراء المعتزلةِ وآراءِ الفلاسفةِ الطَّبيعيِّين والإلهيِّين ومذهبِ المانويَّةِ مِنَ المجوس؛ ومِنْ أخصِّ تلاميذِه الجاحظُ، وحكى عنه كثيرًا مِنَ الحكايات؛ له ـ رغمَ فرطِ ذكائه ـ آراءٌ شاذَّةٌ انفرد بها في علم الكلام والفقهِ وفي أصول الفقه: كإنكاره حُجِّيَّةَ الإجماعِ والقياس، وانفرادِه بالطَّفرة المزعومة؛ مِنْ تصانيفه: كتابُ «النُّكَت»، وكتابُ «الطَّفرة»، وله كُتُبٌ كثيرةٌ أخرى في الفلسفةِ والاعتزال؛ اتُّهِمَ بالزَّندقةِ، وإدمانِ شُربِ الخمر؛ وقد أُلِّفَتْ كُتُبٌ في الرَّدِّ عليه، وكفَّره كثيرٌ مِنْ أصحابِه المُعتزلةِ فضلًا عن غيرِهم لشناعةِ أقوالِه عندهم؛ تُوُفِّيَ النَّظَّامُ في بغدادَ ما بين سَنَةِ: (٢٢٠هـ/ ٨٣٥م ـ ٢٣٠هـ / ٨٤٥م). [انظر ترجمته في: «الإعلام بمنثور تَراجِمِ المشاهير والأعلام» ـ تأليفي ـ (١٥)].
(٢) الكسب وقَعَ في القرآن على ثلاثةِ معانٍ: أحَدُها: عقدُ القلبِ وعزمُه وقصدُه كقوله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [البقرة: ٢٢٥] لأنَّه مِنْ عملِ القلب الَّذي هو مِنْ سعيِه وفيه تطلُّبٌ، ويجرُّ به إلى صاحبِه نفعًا أو ضرًّا لأنَّه مُؤاخَذٌ به، بخلاف الخَطَراتِ والوساوسِ وحديثِ النَّفسِ والهمِّ ما لم يَعزِمْ عليه أو يعمَلْ أو يتكلَّمْ به، والثَّاني: كسبُ المال مِنَ التِّجارةِ مثل قولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فالأوَّل: للتُّجَّار، والثَّاني: للزُّرَّاع، والمعنى الثَّالث: السَّعيُ والعمل كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿.. بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩، يونس: ٥٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَذَكِّرۡ بِهِۦٓ أَن تُبۡسَلَ نَفۡسُۢ بِمَا كَسَبَتۡ﴾ [الأنعام: ٧٠]؛ [انظر: «شفاء العليل» لابن القيِّم (١/ ٣٦٣)].
(٣) هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ الأشعريُّ، مِنْ نسلِ أبي بُردةَ بنِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه؛ قِيلَ: كان في الفِقه مالكيًّا وقِيلَ غيرُ ذلك، فتَنازعَتْه المذاهبُ الأربعة؛ إمامٌ مِنْ أئمَّةِ المُتكلِّمين، وهو مُؤسِّسُ مذهبِ الأشاعِرةِ بعدما كان على مذهب المعتزِلةِ أربعين سَنَةً؛ أخَذَ عِلمَ الكلامِ والاعتزالَ عن زوجِ أمِّه أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ شيخِ المعتزِلة وغيرِه، ثمَّ فارقه ورَجَع عن الاعتِزال وأَظهرَ ذلك، واتَّبع طريقةَ ابنِ كُلَّابٍ (ت: ٢٤١ﻫ ـ ٨٥٥م)، وشَرَع في الرَّدِّ على المعتزلةِ والتَّصنيفِ في خلافهم؛ ثمَّ رجَعَ عن بعضِ مقالاتِ ابنِ كُلَّابٍ إلى قولِ أهلِ السُّنَّة، وبَقِيَتْ عليه منهُ بقيَّةٌ ومِنْ بعضِ مقالاتِ المعتزلة، وانتسبَ في العقيدةِ إلى الإمام المُبجَّلِ أحمدَ بنِ حنبلٍ لِاعتقادِه إمامَتَه؛ ومِنْ كُتُبه: «إثباتُ القياس»، وكتابُ «اختلاف النَّاس في الأسماء والأحكام والخاصِّ والعامِّ»، و«مقالاتُ الإسلاميِّين»، و«إيضاحُ البرهان»، و«الإبانةُ عن أصول الدِّيانة» وهو آخِرُ مصنَّفاتِه الَّذي رجَعَ فيه عن كثيرٍ مِنْ أقوال الأشاعرةِ والكُلَّابيَّة؛ تُوُفِّيَ أبو الحسنِ الأشعريُّ ـ رحمه الله ـ سَنَةَ: (٣٢٤ﻫ ـ ٩٣٥م). [انظر ترجمته في مؤلَّفي: «الإعلام بمَنْثورِ تَراجِمِ المَشاهير والأعلام» (٥٢٦)].
(٤) للمزيد: انظر مؤلَّفي: «الحُلَل الذَّهبيَّة شرح العقائد الإسلاميَّة لابن باديس» (٦٢٠).
(٥) انظر: «العين» للخليل (٧/ ٤١٧)، «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (٢/ ٧٥٤)، «تهذيب اللُّغة» للأزهري (١٣/ ٢٢٥)، «المحيط في اللُّغة» للصَّاحب بنِ عباد (٩/ ١٦٢ ـ ١٦٣)، «الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٧٢٦)، «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد (٢/ ١٤٠٤).
(٦) هو أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ سيَّارِ بن هانئٍ البصريُّ مولى آلِ الحارثِ بنِ عُبادٍ البكريِّ المعروفُ بالنَّظَّام؛ سُمِّيَ بهذا لأنَّه كان يَنظمُ الكلامَ أو الشِّعرَ وقِيلَ: الخرزَ ؛ مُتكلِّمٌ، شيخُ الفِرقةِ النَّظَّاميَّةِ مِنَ المعتزلة؛ وُلِدَ سَنَةَ: (١٨٥هـ ـ ٨٠١م)؛ تَربَّى بالبصرةِ ثمَّ رحَلَ إلى بغدادَ؛ كان أَنبهَ تلاميذِ أبي الهُذَيْلِ العلَّاف المُعتزليِّ، وكان ذا ذكاءٍ وفصاحةٍ، وشاعرًا أديبًا بليغًا، تَبحَّرَ في علومِ الفلسفةِ والكلام، وقد كانت دراستُه مَزيجًا جامعًا بين آراء المعتزلةِ وآراءِ الفلاسفةِ الطَّبيعيِّين والإلهيِّين ومذهبِ المانويَّةِ مِنَ المجوس؛ ومِنْ أخصِّ تلاميذِه الجاحظُ، وحكى عنه كثيرًا مِنَ الحكايات؛ له ـ رغمَ فرطِ ذكائه ـ آراءٌ شاذَّةٌ انفرد بها في علم الكلام والفقهِ وفي أصول الفقه: كإنكاره حُجِّيَّةَ الإجماعِ والقياس، وانفرادِه بالطَّفرة المزعومة؛ مِنْ تصانيفه: كتابُ «النُّكَت»، وكتابُ «الطَّفرة»، وله كُتُبٌ كثيرةٌ أخرى في الفلسفةِ والاعتزال؛ اتُّهِمَ بالزَّندقةِ، وإدمانِ شُربِ الخمر؛ وقد أُلِّفَتْ كُتُبٌ في الرَّدِّ عليه، وكفَّره كثيرٌ مِنْ أصحابِه المُعتزلةِ فضلًا عن غيرِهم لشناعةِ أقوالِه عندهم؛ تُوُفِّيَ النَّظَّامُ في بغدادَ ما بين سَنَةِ: (٢٢٠هـ/ ٨٣٥م ـ ٢٣٠هـ / ٨٤٥م). [انظر ترجمته في: «الإعلام بمنثور تَراجِمِ المشاهير والأعلام» ـ تأليفي ـ (١٥)].
👍1
(٧) انظر: «مقالات الإسلاميِّين واختلاف المُصَلِّين» للأشعري (٣٢١)، «المِلَل والنِّحَل» للشهرستاني (١/ ٧٠).
(٨) انظر: «المعتزلة وأصولهم الخمسة» د. عواد المعتق (٥٦ ـ ٥٩).
(٩) تصحَّفَتْ في بعضِ النُّسَخِ إلى: «أكمل».
(١٠) في طبعةٍ أخرى: «وكان النَّظَّامُ».
(١١) في طبعةٍ أخرى: «في»، وهو تصحيف.
(١٢) «العقل والنَّقل عند ابن رشد» للجامي (١٠٠).
(١٣) هو أبو هاشمٍ عبدُ السَّلامِ ابنُ شيخِ المعتزلةِ أبي عليٍّ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّاب الجُبَّائيُّ البصريُّ المعتزليُّ، نسبةً إلى قريةِ جُبَّى مِنْ عملِ خُوزِسْتانَ، وهو مِنْ نسلِ حُمرانَ بنِ أبَانَ مَوْلَى عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه؛ المتكلِّمُ المشهور، كان بصيرًا بالنَّحو واللُّغة، وهو أحَدُ رؤوسِ المعتزلةِ وابنُ شيخِهم، وإليه تُنسَبُ البهشميَّةُ منهم؛ وهو أوَّلُ مَنْ قال: إنَّ الصِّفاتِ أحوالٌ؛ ألَّف أبو هاشمٍ كُتُبًا في علمِ الكلامِ مشحونةً بمَذاهِبِهما واعتقادهما، وله مُصنَّفاتٌ أخرى منها: «تفسيرُ القرآن»، و«الجامعُ الكبير»، و«الأبواب الكبير»؛ تُوُفِّيَ سَنَةَ: (٣٢١ﻫ ـ ٩٣٣م). [انظر ترجمته في مؤلَّفي: «الإعلام بمَنْثورِ تَراجِمِ المَشاهير والأعلام» (٤٧٦)].
(١٤) «الفَرْق بين الفِرَق» للبغدادي (١٨٢).
(١٥) «الفصل في المِلَل والأهواء والنِّحَل» لابن حزم (٥/ ٣١، ٣٢).
(١٦) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» لابن تيميَّة (٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦) .
(٨) انظر: «المعتزلة وأصولهم الخمسة» د. عواد المعتق (٥٦ ـ ٥٩).
(٩) تصحَّفَتْ في بعضِ النُّسَخِ إلى: «أكمل».
(١٠) في طبعةٍ أخرى: «وكان النَّظَّامُ».
(١١) في طبعةٍ أخرى: «في»، وهو تصحيف.
(١٢) «العقل والنَّقل عند ابن رشد» للجامي (١٠٠).
(١٣) هو أبو هاشمٍ عبدُ السَّلامِ ابنُ شيخِ المعتزلةِ أبي عليٍّ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّاب الجُبَّائيُّ البصريُّ المعتزليُّ، نسبةً إلى قريةِ جُبَّى مِنْ عملِ خُوزِسْتانَ، وهو مِنْ نسلِ حُمرانَ بنِ أبَانَ مَوْلَى عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه؛ المتكلِّمُ المشهور، كان بصيرًا بالنَّحو واللُّغة، وهو أحَدُ رؤوسِ المعتزلةِ وابنُ شيخِهم، وإليه تُنسَبُ البهشميَّةُ منهم؛ وهو أوَّلُ مَنْ قال: إنَّ الصِّفاتِ أحوالٌ؛ ألَّف أبو هاشمٍ كُتُبًا في علمِ الكلامِ مشحونةً بمَذاهِبِهما واعتقادهما، وله مُصنَّفاتٌ أخرى منها: «تفسيرُ القرآن»، و«الجامعُ الكبير»، و«الأبواب الكبير»؛ تُوُفِّيَ سَنَةَ: (٣٢١ﻫ ـ ٩٣٣م). [انظر ترجمته في مؤلَّفي: «الإعلام بمَنْثورِ تَراجِمِ المَشاهير والأعلام» (٤٧٦)].
(١٤) «الفَرْق بين الفِرَق» للبغدادي (١٨٢).
(١٥) «الفصل في المِلَل والأهواء والنِّحَل» لابن حزم (٥/ ٣١، ٣٢).
(١٦) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» لابن تيميَّة (٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦) .
👍1
تصوروا لو أن رجال الأمن في الحرمين لم يكونوا موجودين، أو لم يؤدوا واجبهم، أو أهملوا فيه، كيف سيكون الحال هناك؟
يا عبد الله رجال الأمن في الحرمين أمروا بحمايتك وحماية أخيك المسلم، وتنظيم حركة الناس وسيرهم؛ لسلامتهم، وليعبدوا الله في أمن وراحة واطمئنان.
فالاعتداء عليهم يؤدي إلى الفوضى وإثارة الفتن، فلا يجوز الاعتداء عليهم بالضرب أو السب أو غير ذلك، فاتقوا الله وتعاونوا معهم على الأمن والتنظيم.
ومن وجد من أحدهم تجاوزا يمكنه رفع أمره للمسؤولين عنه هناك.
مع أن تجربتي الشخصية معهم وتجربة الكثير من المسلمين؛ كانت طيبة، فلم أر منهم إلا الجد في أداء عملهم بأدب ومعاملة حسنة. وفقهم الله وجزاهم عنا خيرا.
كتبه الشيخ علي الرملي وفقه الله
يا عبد الله رجال الأمن في الحرمين أمروا بحمايتك وحماية أخيك المسلم، وتنظيم حركة الناس وسيرهم؛ لسلامتهم، وليعبدوا الله في أمن وراحة واطمئنان.
فالاعتداء عليهم يؤدي إلى الفوضى وإثارة الفتن، فلا يجوز الاعتداء عليهم بالضرب أو السب أو غير ذلك، فاتقوا الله وتعاونوا معهم على الأمن والتنظيم.
ومن وجد من أحدهم تجاوزا يمكنه رفع أمره للمسؤولين عنه هناك.
مع أن تجربتي الشخصية معهم وتجربة الكثير من المسلمين؛ كانت طيبة، فلم أر منهم إلا الجد في أداء عملهم بأدب ومعاملة حسنة. وفقهم الله وجزاهم عنا خيرا.
كتبه الشيخ علي الرملي وفقه الله
الحمد لله الذي بلغنا رمضان و أعاننا على صيامه و قيامه ، كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا و أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل إنه خير مسؤول .
*في ختام شهر رمضان*
قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله:
إذا كان المنافقُ يفرح بفراق شهر رمضان لينطلق إلى الشهوات والمعاصي التي كان محــبوسًا عنها طيلة الشهر،
فإن المؤمن إنّما يفرح بانتهاء الشهر بعد إتمام العمل
وإكماله رجـاء تحقيـق أجـوره وفضائله ويستتبعه بالاستغفار والتكبير والعبادة.
مقتبس من «الكلمة الشهرية » رقم: 12]
قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله:
إذا كان المنافقُ يفرح بفراق شهر رمضان لينطلق إلى الشهوات والمعاصي التي كان محــبوسًا عنها طيلة الشهر،
فإن المؤمن إنّما يفرح بانتهاء الشهر بعد إتمام العمل
وإكماله رجـاء تحقيـق أجـوره وفضائله ويستتبعه بالاستغفار والتكبير والعبادة.
مقتبس من «الكلمة الشهرية » رقم: 12]
💥 جديد الفتاوى الرمضانية 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس بعد عصر اليوم 29 رمضان 1446
عن رجل اقترض مالا قبل خمسة عشر سنة.. هل يرجعه الآن بنفس القيمة أم يزيد !؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أرأيت لو ترك وديعة -مالا- وبعد عشرين سنة عاد.. ماذا يردّ له ؟! يرد له نفس المبلغ الذي أخذه منه.. أمّا الفرقُ بين هذا وذاك.. فالوديعة يأخذ عليها أجر .. أما القرض فيأخذ المقرض الأجر.. يجري السّلف مجرى شطر الصدقة .. إذا تأخر عن الموعد يزيد ويصبح كأنه أنفق وتصدّق بمثل ما أقرض به..
هذا فيه خلاف .. وهو موجود على الموقع.. والراجِح هو الذي اختاره المجمع الفقهي العام الذي انتهى إلى هذا القول وهو مؤيد بما ذهبت إليه اللجنة الدائمة.. يرد له نفس المبلغ. والعلم عند اللّه.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الأثري
سئل فضيلة الشيخ فركوس بعد عصر اليوم 29 رمضان 1446
عن رجل اقترض مالا قبل خمسة عشر سنة.. هل يرجعه الآن بنفس القيمة أم يزيد !؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أرأيت لو ترك وديعة -مالا- وبعد عشرين سنة عاد.. ماذا يردّ له ؟! يرد له نفس المبلغ الذي أخذه منه.. أمّا الفرقُ بين هذا وذاك.. فالوديعة يأخذ عليها أجر .. أما القرض فيأخذ المقرض الأجر.. يجري السّلف مجرى شطر الصدقة .. إذا تأخر عن الموعد يزيد ويصبح كأنه أنفق وتصدّق بمثل ما أقرض به..
هذا فيه خلاف .. وهو موجود على الموقع.. والراجِح هو الذي اختاره المجمع الفقهي العام الذي انتهى إلى هذا القول وهو مؤيد بما ذهبت إليه اللجنة الدائمة.. يرد له نفس المبلغ. والعلم عند اللّه.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الأثري
[معني العيد ]
#العيد في معناه الديني كلمة شكر على تمام العبادة، لا يقولها المؤمن بلسانه، ولكنها تعتلج في سرائره رضًى واطمئنانًا، وتنبلج في علانيته فرحًا وابتهاجًا، وتسفر بين نفوس المؤمنين بالبشاشة والطلاقة والأنس. وتمسح ما بين الفقراء والأغنياء من جفوة
#أثار_الإبراهيمي ج3،ص479
#العيد في معناه الديني كلمة شكر على تمام العبادة، لا يقولها المؤمن بلسانه، ولكنها تعتلج في سرائره رضًى واطمئنانًا، وتنبلج في علانيته فرحًا وابتهاجًا، وتسفر بين نفوس المؤمنين بالبشاشة والطلاقة والأنس. وتمسح ما بين الفقراء والأغنياء من جفوة
#أثار_الإبراهيمي ج3،ص479
📌 فوائد منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
(بعد ذكر السائل كلاما للبشير الإبراهيمي -رحمه الله- (من آثاره) .. حول الاحتفال بالمولد النبوي ..)
كيف الردّ على المجيزين للاحتفال بالمولد؛ ويقولون أن ابن باديس الإبراهيمي -رحمهما الله- احتفلا؟! ..
الجواب:
"فيه محطات -إن شئت- للإجابة عن هذا السؤال ..
• أولا: اجتهادات المجتهدين ليست مصدرا من مصادر التشريع، التشريع هو الكتاب والسنة، وعلى نصوصهما وضوئهما يجتهد المجتهد.
• ثانيا: الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات هذه لابد لها من سند، أو نص؛ حتى نقضي بجوازها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدّد في ذلك الاحتفال بعيدين، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، هذا الأمر الثاني.
• لأن الاحتفالات إذا أُعطِي لها الطابع الشرعي؛ فهي من العبادات، كما هو الشأن بالنسبة للعيدين، هما من العبادات، ولا شك أننا لا نستطيع أن نشرّع عبادة إلا بنص.
• من جهة أخرى؛ لو كان هذا الاحتفال كما ذكر عموما القضايا التي يراها كل من أعضاء هذه الجمعية؛ يرونها جائزة، كإحياء ذكرى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيرته، وغير ذلك .. يكون الأصل مسبوقا بفعل السلف، وحيث أن السلف لم يحتفلوا بهذا؛ لا في القرون المفضّلة، ولا بعدها لم يحتفلوا بهذا المولد؛ فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع ذلك، إذ لو كان مشروعا لسبقونا إليه، إنما عُلِم ذلك بعد القرون المفضلة، وعند قوم كان ألصق بهذه الأعياد عيد النصارى؛ فالتمسوه من ذلك ..
لذلك ذكرنا أن البدعة تدور مع الأسباب الأربعة: الجهل، واتّباع الهوى، وتقليد الآباء، وتقليد اليهود والنصارى.
كثير من الناس يقعون في مثل هذا؛ ويحسّنون البدعة بالنظر إلى ما ذكره الشافعي -رحمه الله- من كونها تنقسم إلى بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة .. وهذه القسمة غير مُرتَضاة، أخذها -إن شئتم- من قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (نعم البدعة هي) على صلاة التراويح.
علما أنه يوجد فرق بين البدعة الشرعية؛ التي تَرِدُ في الشرع، والبدعة الدنيوية أو اللّغوية، فالبدعة اللغوية، أو الدنيوية؛ لا تُؤثّر، لأنها لا يُتعبّد بها؛ فضلا عن كونها بدعة من حيث هي جاءت محدثة؛ لكن لا تتعلّق بالدين.
صلاة الجماعة في التراويح فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى الليلة الأولى، والثانية، ولم يخرج الثالثة خشية أن تُفرَض عليهم، فهذه موجودة، وغاية ما في الأمر أن عمر -رضي الله عنه- لما رآهم يُصلونها أوزاعا وجماعات؛ جمعهم على إمام واحد، وقال: (نعم البدعة هي)، وليس المقصود البدعة المنبوذة أو المذمومة، لأنها موجودة شرعا، مقرّرة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعلها عمر والصحابة -رضي الله عنهم- متواجدون، ولم ينكر أحد، فكان إجماعا وحجّة، واستمر الإجماع والعمل على هذا ..
بقوله: (نعم البدعة هي) ظنّوا أن فيه بدعة حسنة، ومستحبّة، وسيّئة .. فاستحبّوا مثلا أن يصافح الرجل من عن يمينه وعن شماله بعد الصلاة، وعدّها النووي بدعة حسنة ومستحبّة، لأنه شافعي ..
الصحيح أن البدعة في الشّرع كلها سيئة، تستدرك على الشّرع كأنه تخلّف عن أحكام؛ وجاءت هذه الاجتهادات البدعيّة تستدرك؛ بعد أن جاءت النصوص تُبيّن أن شرع الله تعالى كامل تامّ؛ ليس فيه نقصان من جهة الأحكام، وما تخلّف منها فيه من القواعد التي بيّنها القرآن، فما وجدنا في كتاب الله وجدنا، وما لم نجده وجدنا أنه -القرآن- يرشد إلى السنّة، والإجماع، والقياس، ويحثّ على الاجتهاد، وهو النّظر بالقياس ونحوه؛ لإضافة بعض الفروع التي لم يَرِد الحكم فيها؛ وإلحاقها بالأصل المقرّر من الكتاب والسنة.
فالاجتهاد اعتبار، ومثل هذه الاعتبارات أجازها الشرع إذا كانت بشرطها.
إذًا؛ القول بهذا الكلام ليس صحيحا، وإلا فكل بدعة نختلق لها مزايا، وبعد ذلك نجيزها، مع أن الشرع أنكرها جميعا، لأنها تعمل على الاستدراك، وتضيف أمورا جديدة لم يأتِ بها الشرع.
كما حذّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها في قوله: (كل بدعة ضلالة).
- فـ (كلّ) تدلّ على جميع البدع؛ كثيرها وقليلها، جلّها ودقّها، وهي معدودة من المحرّمات، ومن محدثات الأمور.
- والتحذير جاء بقوله (إياكم ومحدثات الأمور)، كما يدلّ عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، فهل الاحتفال بالمولد هو من أمر الشرع؟! ليس كذلك.
- حتى ولو أتيت بكثير فوائد؛ يقال صحيحة؛ لكن ما لم يُحسّنه الشرع لا تحسين فيه، فالشّرع هو الذي يُحسّن ويُقبّح، وقد قبّح البدعة، ولو أتيت بكل محسّن فلا يتحسّن الشيء إذا لم يُحسّنه الشّرع.
وأيضا من حديث: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه، فيقال هذه لم يرِد فيها شيء، وهي من محدثات الأمور، حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، ولو كان الاحتفال بها مشروعا لسبقنا به الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعون، وغيرهم من أئمة الدين، ولم يقل أحد بهذا.
السؤال:
(بعد ذكر السائل كلاما للبشير الإبراهيمي -رحمه الله- (من آثاره) .. حول الاحتفال بالمولد النبوي ..)
كيف الردّ على المجيزين للاحتفال بالمولد؛ ويقولون أن ابن باديس الإبراهيمي -رحمهما الله- احتفلا؟! ..
الجواب:
"فيه محطات -إن شئت- للإجابة عن هذا السؤال ..
• أولا: اجتهادات المجتهدين ليست مصدرا من مصادر التشريع، التشريع هو الكتاب والسنة، وعلى نصوصهما وضوئهما يجتهد المجتهد.
• ثانيا: الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات هذه لابد لها من سند، أو نص؛ حتى نقضي بجوازها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدّد في ذلك الاحتفال بعيدين، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، هذا الأمر الثاني.
• لأن الاحتفالات إذا أُعطِي لها الطابع الشرعي؛ فهي من العبادات، كما هو الشأن بالنسبة للعيدين، هما من العبادات، ولا شك أننا لا نستطيع أن نشرّع عبادة إلا بنص.
• من جهة أخرى؛ لو كان هذا الاحتفال كما ذكر عموما القضايا التي يراها كل من أعضاء هذه الجمعية؛ يرونها جائزة، كإحياء ذكرى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيرته، وغير ذلك .. يكون الأصل مسبوقا بفعل السلف، وحيث أن السلف لم يحتفلوا بهذا؛ لا في القرون المفضّلة، ولا بعدها لم يحتفلوا بهذا المولد؛ فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع ذلك، إذ لو كان مشروعا لسبقونا إليه، إنما عُلِم ذلك بعد القرون المفضلة، وعند قوم كان ألصق بهذه الأعياد عيد النصارى؛ فالتمسوه من ذلك ..
لذلك ذكرنا أن البدعة تدور مع الأسباب الأربعة: الجهل، واتّباع الهوى، وتقليد الآباء، وتقليد اليهود والنصارى.
كثير من الناس يقعون في مثل هذا؛ ويحسّنون البدعة بالنظر إلى ما ذكره الشافعي -رحمه الله- من كونها تنقسم إلى بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة .. وهذه القسمة غير مُرتَضاة، أخذها -إن شئتم- من قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (نعم البدعة هي) على صلاة التراويح.
علما أنه يوجد فرق بين البدعة الشرعية؛ التي تَرِدُ في الشرع، والبدعة الدنيوية أو اللّغوية، فالبدعة اللغوية، أو الدنيوية؛ لا تُؤثّر، لأنها لا يُتعبّد بها؛ فضلا عن كونها بدعة من حيث هي جاءت محدثة؛ لكن لا تتعلّق بالدين.
صلاة الجماعة في التراويح فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى الليلة الأولى، والثانية، ولم يخرج الثالثة خشية أن تُفرَض عليهم، فهذه موجودة، وغاية ما في الأمر أن عمر -رضي الله عنه- لما رآهم يُصلونها أوزاعا وجماعات؛ جمعهم على إمام واحد، وقال: (نعم البدعة هي)، وليس المقصود البدعة المنبوذة أو المذمومة، لأنها موجودة شرعا، مقرّرة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعلها عمر والصحابة -رضي الله عنهم- متواجدون، ولم ينكر أحد، فكان إجماعا وحجّة، واستمر الإجماع والعمل على هذا ..
بقوله: (نعم البدعة هي) ظنّوا أن فيه بدعة حسنة، ومستحبّة، وسيّئة .. فاستحبّوا مثلا أن يصافح الرجل من عن يمينه وعن شماله بعد الصلاة، وعدّها النووي بدعة حسنة ومستحبّة، لأنه شافعي ..
الصحيح أن البدعة في الشّرع كلها سيئة، تستدرك على الشّرع كأنه تخلّف عن أحكام؛ وجاءت هذه الاجتهادات البدعيّة تستدرك؛ بعد أن جاءت النصوص تُبيّن أن شرع الله تعالى كامل تامّ؛ ليس فيه نقصان من جهة الأحكام، وما تخلّف منها فيه من القواعد التي بيّنها القرآن، فما وجدنا في كتاب الله وجدنا، وما لم نجده وجدنا أنه -القرآن- يرشد إلى السنّة، والإجماع، والقياس، ويحثّ على الاجتهاد، وهو النّظر بالقياس ونحوه؛ لإضافة بعض الفروع التي لم يَرِد الحكم فيها؛ وإلحاقها بالأصل المقرّر من الكتاب والسنة.
فالاجتهاد اعتبار، ومثل هذه الاعتبارات أجازها الشرع إذا كانت بشرطها.
إذًا؛ القول بهذا الكلام ليس صحيحا، وإلا فكل بدعة نختلق لها مزايا، وبعد ذلك نجيزها، مع أن الشرع أنكرها جميعا، لأنها تعمل على الاستدراك، وتضيف أمورا جديدة لم يأتِ بها الشرع.
كما حذّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها في قوله: (كل بدعة ضلالة).
- فـ (كلّ) تدلّ على جميع البدع؛ كثيرها وقليلها، جلّها ودقّها، وهي معدودة من المحرّمات، ومن محدثات الأمور.
- والتحذير جاء بقوله (إياكم ومحدثات الأمور)، كما يدلّ عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، فهل الاحتفال بالمولد هو من أمر الشرع؟! ليس كذلك.
- حتى ولو أتيت بكثير فوائد؛ يقال صحيحة؛ لكن ما لم يُحسّنه الشرع لا تحسين فيه، فالشّرع هو الذي يُحسّن ويُقبّح، وقد قبّح البدعة، ولو أتيت بكل محسّن فلا يتحسّن الشيء إذا لم يُحسّنه الشّرع.
وأيضا من حديث: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه، فيقال هذه لم يرِد فيها شيء، وهي من محدثات الأمور، حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، ولو كان الاحتفال بها مشروعا لسبقنا به الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعون، وغيرهم من أئمة الدين، ولم يقل أحد بهذا.
👍2
فالقول أنه يوم يتذكّر سيرته، وأخلاقه، ويسير على سيرته، يدعو إلى طريقته .. نقول نعم، هذه التي تدعون إليها صحيحة؛ لكن من غير احتفال.
يدعو إلى الالتزام بها قولا، وفعلا، وسيرة، وسلوكا، وأخلاقا .. وكان -صلى الله عليه وسلم- خُلقه القرآن، وهو أمر بالأخلاق، والصدق، والأمانة، والعدل، والاستقامة، والاعتدال، وغيرها .. كلّها من أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجب أن نلتزمها، ونسلك طريقه في الدعوة والمعاملة.
ولا يشترط أن نخصّص يوما من العام نحتفل فيه مثلما يحتفل به النصارى بأنبيائهم -زعموا- وهم لم يرشدوهم إلى ذلك.
حاصله: لعلّ الخطأ في الاجتهاد؛ وهو قسمة البدعة إلى هذه الأقسام؛ وقع بها الناس في الخطأ، والصحيح أن كل بدعة ضلالة.
- يؤيّده قوله (كلّ بدعة ..)
- ويؤيده حديث عائشة -رضي الله عنها-، فما من عمل لا شاهد اعتبار له من الشرع إلا وهو مردود على صاحبه.
- وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، في أمر الدين لا يوجد احتفال بهذا، لم يحتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء الّذين سبقوا، ولم يأمر الصحابة بالاحتفال بمولده، فليس فيه ما يدلّ على جواز هذا، وليس من أمر ديننا.
هذا العذر الّذي يمكن أن نضيفه لعلماء الجمعية، ومهما على كعبهم، وسما علمهم؛ فهم مجتهدون، يصيبون ويخطئون، وربّما مقدمة خاطئة يبني عليها؛ فيصل إلى نتيجه خاطئة، خاصة إذا عوّل على القسمة هذه.
ونظرتهم لألّا يذهبوا إلى عيد ميلاد النصارى؛ فيجلبونهم للارتباط بالإسلام، وهذا ليس دعوى -على كلٍّ-، لكن قلت لعلّ هذا، وإلا فحكمه ظاهر.
الإنسان دائما معياره العودة إلى الرّعيل الأول، كيف كانوا؟!
هل كانوا يحتفلون؟!
لم يكن ذلك في وقتهم، ولا من أمرِهم، ولا دينا لهم، فلا يكون الآن دينا -كما قال مالك رحمه الله-، لأن الوحي انقطع بموت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
نشيد بالجمعية ليس معناه أنهم معصومون، مثلا نقول قال ابن باديس كذا .. لكن تجد في كتاب العقائد كثيرا من التعقيبات ذكرناها، وكثيرا من الأخطاء وجدناها أثناء الشرح، هي كثيرة باعتبار .. وحتى في مقالاته تعقّبنا هذا، وسيصدر -إن شاء الله- قريبا [فلسفة الجمعية للإبراهيمي]، جعلت فيه تعليقات وتعقيبات، بدءا بكلمة فلسفة، وفيه أمور نوافق فيها، وأمور كثيرة لا نوافق، وتُعدّ من الأخطاء والمؤاخذات عليه في هذا الباب، مع عدم إجحاف حقّه، واحترام مكانته ..
لكن الحق يُقال مهما كان، سواء علينا أو عليهم، فإن أخطأ فنبيّن، وإن أخطأنا نعود .. والأصل أن الناس لا يتبعون في الخطأ، وهكذا يكون العلم متكاملا، فلا نترك أمورا تدخل فيه بحُكم أن فلانا قال كذا .. لأنه مهما علا علمه فهو قاصر، والعلم الكامل لله تعالى، وما يُدركه الإنسان نقطة في بحر، لأن العلم كثير جدا، وقدرته محدودة على تحصيل كل ذلك.
اللغة العربية فقط؛ لا يستطيع الإنسان استحكامها؛ وهو من أهلها، فما بالك بالعلوم الأخرى؛ من علوم القرآن، والسنة، وعلم الرجال .. والعلم عند الله تعالى."
يدعو إلى الالتزام بها قولا، وفعلا، وسيرة، وسلوكا، وأخلاقا .. وكان -صلى الله عليه وسلم- خُلقه القرآن، وهو أمر بالأخلاق، والصدق، والأمانة، والعدل، والاستقامة، والاعتدال، وغيرها .. كلّها من أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجب أن نلتزمها، ونسلك طريقه في الدعوة والمعاملة.
ولا يشترط أن نخصّص يوما من العام نحتفل فيه مثلما يحتفل به النصارى بأنبيائهم -زعموا- وهم لم يرشدوهم إلى ذلك.
حاصله: لعلّ الخطأ في الاجتهاد؛ وهو قسمة البدعة إلى هذه الأقسام؛ وقع بها الناس في الخطأ، والصحيح أن كل بدعة ضلالة.
- يؤيّده قوله (كلّ بدعة ..)
- ويؤيده حديث عائشة -رضي الله عنها-، فما من عمل لا شاهد اعتبار له من الشرع إلا وهو مردود على صاحبه.
- وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، في أمر الدين لا يوجد احتفال بهذا، لم يحتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء الّذين سبقوا، ولم يأمر الصحابة بالاحتفال بمولده، فليس فيه ما يدلّ على جواز هذا، وليس من أمر ديننا.
هذا العذر الّذي يمكن أن نضيفه لعلماء الجمعية، ومهما على كعبهم، وسما علمهم؛ فهم مجتهدون، يصيبون ويخطئون، وربّما مقدمة خاطئة يبني عليها؛ فيصل إلى نتيجه خاطئة، خاصة إذا عوّل على القسمة هذه.
ونظرتهم لألّا يذهبوا إلى عيد ميلاد النصارى؛ فيجلبونهم للارتباط بالإسلام، وهذا ليس دعوى -على كلٍّ-، لكن قلت لعلّ هذا، وإلا فحكمه ظاهر.
الإنسان دائما معياره العودة إلى الرّعيل الأول، كيف كانوا؟!
هل كانوا يحتفلون؟!
لم يكن ذلك في وقتهم، ولا من أمرِهم، ولا دينا لهم، فلا يكون الآن دينا -كما قال مالك رحمه الله-، لأن الوحي انقطع بموت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
نشيد بالجمعية ليس معناه أنهم معصومون، مثلا نقول قال ابن باديس كذا .. لكن تجد في كتاب العقائد كثيرا من التعقيبات ذكرناها، وكثيرا من الأخطاء وجدناها أثناء الشرح، هي كثيرة باعتبار .. وحتى في مقالاته تعقّبنا هذا، وسيصدر -إن شاء الله- قريبا [فلسفة الجمعية للإبراهيمي]، جعلت فيه تعليقات وتعقيبات، بدءا بكلمة فلسفة، وفيه أمور نوافق فيها، وأمور كثيرة لا نوافق، وتُعدّ من الأخطاء والمؤاخذات عليه في هذا الباب، مع عدم إجحاف حقّه، واحترام مكانته ..
لكن الحق يُقال مهما كان، سواء علينا أو عليهم، فإن أخطأ فنبيّن، وإن أخطأنا نعود .. والأصل أن الناس لا يتبعون في الخطأ، وهكذا يكون العلم متكاملا، فلا نترك أمورا تدخل فيه بحُكم أن فلانا قال كذا .. لأنه مهما علا علمه فهو قاصر، والعلم الكامل لله تعالى، وما يُدركه الإنسان نقطة في بحر، لأن العلم كثير جدا، وقدرته محدودة على تحصيل كل ذلك.
اللغة العربية فقط؛ لا يستطيع الإنسان استحكامها؛ وهو من أهلها، فما بالك بالعلوم الأخرى؛ من علوم القرآن، والسنة، وعلم الرجال .. والعلم عند الله تعالى."
👍1
🖋 تعليق على الفرقة الحاصلة بين الملبس والمنكر
📜 السؤال: تعليق على الفرقة الحاصلة بين الملبس والمنكر.
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّدٍ عَلِي فَرْكُوسَ حَفِظَهُ اللَّهُ:
فَـ إنَّ الأمرَ لم يَعُدْ يُحْدِثُ فِتْنَةً أو تَشْوِيشًا لِمَنْ صَدَقَتْ نَظْرَتُهُ وَظَهَرَ عُمْرُهُ، إلَّا مَنْ هُوَ فِي التِّيْهِ المَنْهَجِيِّ وَلَا يَزَالُ يُحْسِنُ الظَّنَّ فِيهِمْ. وَغَالِبِيَّتُهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الحَقَّ ظَاهِرٌ، وَالنَّاسُ الَّذِينَ اشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الزَّعَامَةِ وَالمَنَاصِبِ وَالمَصَالِحِ المَادِّيَّةِ، حَتَّى مِنْ جِهَةِ الوَزْنِ العِلْمِيِّ تَجِدُ نَقْصَانًا كَبِيرًا، وَلَكِنْ تَجِدُهُمْ يَخْتَارُونَ تِلْكَ العِبَارَاتِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ رُدُودٍ سَابِقَةٍ فِي زَعْمِهِمْ لِلشَّيْخِ رَبِيعٍ، وَيَضَعُونَ بَعْضَ العِبَارَاتِ، وَمِنْ حَيْثُ التَّأْسِيسُ وَالتَّأْصِيلُ غَائِبُونَ تَمَامًا، خَاصَّةً المَسَائِلَ الَّتِي تَطَرَّقْتُ إلَيْهَا وَأَخَذُونِي عَلَيْهَا، مِنْهَا المُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ التَّشْرِيعِ لِلّهِ، وَأَنَا حَتَّى مِنْ هَذَا القَبِيلِ وَبَيَّنْتُ الكَثِيرَ، الآنَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ أَنَّ التَّشْرِيعَ حَقٌّ لِلشَّعْبِ، وَأَجَبْتُ عَلَى المَسْأَلَةِ بِالأَدِلَّةِ بَيَّنْتُهَا بِطَرِيقَتِي وَبِغَايَةِ أَنْ يَفْهَمَهَا النَّاسُ بِكَلامِ العُلَمَاءِ، وَهُمْ فَهِمُوا أَنَّ الأَمْرَ أَنِّي أُحَاكِي كَلامَ سَيِّدِ قُطْبٍ، وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ يَتَّهِمُونَنِي! وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِمْ وَنِقْصِ رُؤْيَتِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ.
وَأَنَا بَيَّنْتُ كَيْفَ تُعَالَجُ المَسْأَلَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالشِّرْكِ المَوْجُودِ وَإِسْنَادِ الحُكْمِ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ شِرْكًا، وَالتَّحَاكُمَ إلَيْهِ وَالتَّشْرِيعَ فِي ذَاتِهِ وَالقَضَاءَ بِهِ دَاخِلٌ فِي شِرْكِ الأُلُوهِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي العَمَلِ وَيَنْفِي التَّوْحِيدَ، فَإِذَا اتَّخَذْتَ إِلَهًا يُشَرِّعُ الحُكَّامَ، وَأَخَذْتَ بِهِ فَهَذَا شِرْكٌ فِي الأُلُوهِيَّةِ مُتَّهَمٌ بِالعَمَلِ.
وَشِرْكُ السِّيَادَةِ وَمُتَعَلِّقٌ بِالعِلْمِ وَمَا يُفْضِي إلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَشَدُّ، وَشِرْكُ الأُلُوهِيَّةِ أَشَدُّ، وَالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُنَبِّهَ، وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأُمُورِ. وَلَمَّا نَتَكَلَّمُ عَنْ هَذِهِ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ لَا نَقُولُ بِجَوَازِهَا؛ لِأَنَّهَا وَلِيدَةُ هَذَا الأَصْلِ البَاطِلِ.
هُمْ لَا يَفْهَمُونَ وَيُلْصِقُونَ مَا التُهَمَ فِيكَ وَلِيُغْرُوا بِالنَّاسِ، وَأَنَا نَصَحْتُ وَالنَّاسُ وَالحَمْدُ لِلّهِ، مِنْهُمْ مَنِ اسْتَفَاقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عِنْدَهُ عَقْلٌ رَشِيدٌ اسْتَفَاقَ وَنَظَرَ إلَى الوَاقِعِ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنَ المُلَازِمِينَ لَهُمْ وَبَعْدَهَا ابْتَعَدَ عَنْهُمْ وَتَبَيَّنَتْ لَهُ هَذِهِ الأُمُورُ.
وَفِي شَهَادَةٍ لِلتَّارِيخِ ابْتَعَدْتُ عَنْهُمْ، وَلَا يُمْكِنُ العَمَلُ مَعَهُمْ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَنَّكَ أَنْتَ تُرِيدُ الحَقَّ وَهُوَ يُرِيدُ أُمُورًا أُخْرَى! كَيْفَ يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تَآزُرٌ؟! وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ كَتِفًا إلَى كَتِفٍ فِي الدَّعْوَةِ جَنْبًا إلَى جَنْبٍ، ثُمَّ تَجِدُ أَنَّكَ تَبْنِي وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ! مَتَى يَبْلُغُ البُنْيَانُ تَمَامَهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنِي وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ؟! فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوَاصِلَ مَعَهُمُ المَسَارَ الدَّعَوِيَّ، هَذَا مِنَ النَّاحِيَةِ الحِسِّيَّةِ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بِنَاءٍ حَقِيقِيٍّ وَهُوَ يَحْفِرُ مِنَ الأَسْفَلِ! وَلَمَّا يَحْدُثُ أَمْرٌ جَرَّاءَ إنْكَارِ المُنْكَرِ يَتَبَرَّأُ مِنْكَ وَيَرْمِيهَا عَلَيْكَ!
لَا يُمْكِنُ أَنْ تَسِيرَ مَعَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى:
«كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» [سورة الإسراء: 84].
وَالحَقُّ يَظْهَرُ، وَهَذَا أَزْعَجَ وَأَثَارَ ثَائِرَتَهُمْ.
الأُمُورُ وَاضِحَةٌ عِنْدِي، وَلَا أَدْخُلُ فِي هَذِهِ التَّفَاصِيلِ.
السَّائِلُ: لَعَلَّ دَعْوَتَكَ أَصَابَتْهُمْ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ: كُلُّ مَنْ يُخَالِفُ الحَقَّ وَيَأْخُذُ بِالبَاطِلِ، اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُ.
الإِنْسَانُ يَقُولُ الحَقَّ بِقَدْرِ الإمكان وَمَا أُوتِيَ مِنْ عِلْمٍ، وَلَا يَدَّعِي الخَطَأَ، وَيُصَحِّحُ الخَطَأَ بِالتَّصْوِيبِ، وَيَمْضِي فِي طَرِيقِهِ وَيَكُونُ مُلْتَزِمًا بِالصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ. وَمَنْ كَادَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ.
📜 السؤال: تعليق على الفرقة الحاصلة بين الملبس والمنكر.
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّدٍ عَلِي فَرْكُوسَ حَفِظَهُ اللَّهُ:
فَـ إنَّ الأمرَ لم يَعُدْ يُحْدِثُ فِتْنَةً أو تَشْوِيشًا لِمَنْ صَدَقَتْ نَظْرَتُهُ وَظَهَرَ عُمْرُهُ، إلَّا مَنْ هُوَ فِي التِّيْهِ المَنْهَجِيِّ وَلَا يَزَالُ يُحْسِنُ الظَّنَّ فِيهِمْ. وَغَالِبِيَّتُهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الحَقَّ ظَاهِرٌ، وَالنَّاسُ الَّذِينَ اشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الزَّعَامَةِ وَالمَنَاصِبِ وَالمَصَالِحِ المَادِّيَّةِ، حَتَّى مِنْ جِهَةِ الوَزْنِ العِلْمِيِّ تَجِدُ نَقْصَانًا كَبِيرًا، وَلَكِنْ تَجِدُهُمْ يَخْتَارُونَ تِلْكَ العِبَارَاتِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ رُدُودٍ سَابِقَةٍ فِي زَعْمِهِمْ لِلشَّيْخِ رَبِيعٍ، وَيَضَعُونَ بَعْضَ العِبَارَاتِ، وَمِنْ حَيْثُ التَّأْسِيسُ وَالتَّأْصِيلُ غَائِبُونَ تَمَامًا، خَاصَّةً المَسَائِلَ الَّتِي تَطَرَّقْتُ إلَيْهَا وَأَخَذُونِي عَلَيْهَا، مِنْهَا المُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ التَّشْرِيعِ لِلّهِ، وَأَنَا حَتَّى مِنْ هَذَا القَبِيلِ وَبَيَّنْتُ الكَثِيرَ، الآنَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ أَنَّ التَّشْرِيعَ حَقٌّ لِلشَّعْبِ، وَأَجَبْتُ عَلَى المَسْأَلَةِ بِالأَدِلَّةِ بَيَّنْتُهَا بِطَرِيقَتِي وَبِغَايَةِ أَنْ يَفْهَمَهَا النَّاسُ بِكَلامِ العُلَمَاءِ، وَهُمْ فَهِمُوا أَنَّ الأَمْرَ أَنِّي أُحَاكِي كَلامَ سَيِّدِ قُطْبٍ، وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ يَتَّهِمُونَنِي! وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِمْ وَنِقْصِ رُؤْيَتِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ.
وَأَنَا بَيَّنْتُ كَيْفَ تُعَالَجُ المَسْأَلَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالشِّرْكِ المَوْجُودِ وَإِسْنَادِ الحُكْمِ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ شِرْكًا، وَالتَّحَاكُمَ إلَيْهِ وَالتَّشْرِيعَ فِي ذَاتِهِ وَالقَضَاءَ بِهِ دَاخِلٌ فِي شِرْكِ الأُلُوهِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي العَمَلِ وَيَنْفِي التَّوْحِيدَ، فَإِذَا اتَّخَذْتَ إِلَهًا يُشَرِّعُ الحُكَّامَ، وَأَخَذْتَ بِهِ فَهَذَا شِرْكٌ فِي الأُلُوهِيَّةِ مُتَّهَمٌ بِالعَمَلِ.
وَشِرْكُ السِّيَادَةِ وَمُتَعَلِّقٌ بِالعِلْمِ وَمَا يُفْضِي إلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَشَدُّ، وَشِرْكُ الأُلُوهِيَّةِ أَشَدُّ، وَالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُنَبِّهَ، وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأُمُورِ. وَلَمَّا نَتَكَلَّمُ عَنْ هَذِهِ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ لَا نَقُولُ بِجَوَازِهَا؛ لِأَنَّهَا وَلِيدَةُ هَذَا الأَصْلِ البَاطِلِ.
هُمْ لَا يَفْهَمُونَ وَيُلْصِقُونَ مَا التُهَمَ فِيكَ وَلِيُغْرُوا بِالنَّاسِ، وَأَنَا نَصَحْتُ وَالنَّاسُ وَالحَمْدُ لِلّهِ، مِنْهُمْ مَنِ اسْتَفَاقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عِنْدَهُ عَقْلٌ رَشِيدٌ اسْتَفَاقَ وَنَظَرَ إلَى الوَاقِعِ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنَ المُلَازِمِينَ لَهُمْ وَبَعْدَهَا ابْتَعَدَ عَنْهُمْ وَتَبَيَّنَتْ لَهُ هَذِهِ الأُمُورُ.
وَفِي شَهَادَةٍ لِلتَّارِيخِ ابْتَعَدْتُ عَنْهُمْ، وَلَا يُمْكِنُ العَمَلُ مَعَهُمْ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَنَّكَ أَنْتَ تُرِيدُ الحَقَّ وَهُوَ يُرِيدُ أُمُورًا أُخْرَى! كَيْفَ يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تَآزُرٌ؟! وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ كَتِفًا إلَى كَتِفٍ فِي الدَّعْوَةِ جَنْبًا إلَى جَنْبٍ، ثُمَّ تَجِدُ أَنَّكَ تَبْنِي وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ! مَتَى يَبْلُغُ البُنْيَانُ تَمَامَهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنِي وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ؟! فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوَاصِلَ مَعَهُمُ المَسَارَ الدَّعَوِيَّ، هَذَا مِنَ النَّاحِيَةِ الحِسِّيَّةِ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بِنَاءٍ حَقِيقِيٍّ وَهُوَ يَحْفِرُ مِنَ الأَسْفَلِ! وَلَمَّا يَحْدُثُ أَمْرٌ جَرَّاءَ إنْكَارِ المُنْكَرِ يَتَبَرَّأُ مِنْكَ وَيَرْمِيهَا عَلَيْكَ!
لَا يُمْكِنُ أَنْ تَسِيرَ مَعَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى:
«كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» [سورة الإسراء: 84].
وَالحَقُّ يَظْهَرُ، وَهَذَا أَزْعَجَ وَأَثَارَ ثَائِرَتَهُمْ.
الأُمُورُ وَاضِحَةٌ عِنْدِي، وَلَا أَدْخُلُ فِي هَذِهِ التَّفَاصِيلِ.
السَّائِلُ: لَعَلَّ دَعْوَتَكَ أَصَابَتْهُمْ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ: كُلُّ مَنْ يُخَالِفُ الحَقَّ وَيَأْخُذُ بِالبَاطِلِ، اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُ.
الإِنْسَانُ يَقُولُ الحَقَّ بِقَدْرِ الإمكان وَمَا أُوتِيَ مِنْ عِلْمٍ، وَلَا يَدَّعِي الخَطَأَ، وَيُصَحِّحُ الخَطَأَ بِالتَّصْوِيبِ، وَيَمْضِي فِي طَرِيقِهِ وَيَكُونُ مُلْتَزِمًا بِالصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ. وَمَنْ كَادَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ.
👍4
📍 مِنْ مَجْلِسِ القُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ ...... [الشَّهْرُ الهِجْرِيُّ] 1446، المُوَافِقُ لِـ ...... [الشَّهْرُ المِيلَادِيُّ] 2025م.