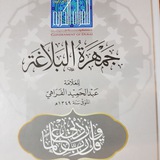إذا حاجة أعيتك لا تستطيعها
ولا سبب في نيلها يتيسر
فصل على خير الأنام محمد
صلاة بها تكفى الهموم ويُغفر
اللهم صل وسلم على محمد
ولا سبب في نيلها يتيسر
فصل على خير الأنام محمد
صلاة بها تكفى الهموم ويُغفر
اللهم صل وسلم على محمد
الشجاعة تغني ربها عن الكذب والتلجلج في الكلام والرمي إلى الغرض من بعيد والإجمال والكناية في موضع التفصيل والتصريح ، وضرب الأمثلة المتكلفة .
وتنقص عند الشجاع القوة المتخيلة والقوة المتصنعة .
وقد كان مبنى بلاغة العرب على الصدق لغلبة الشجاعة والكرم وهو أخو الشجاعة على أخلاقهم .
وتختلف بلاغة العرب عن غيرهم كما تختلف أخلاقهم عن غيرهم .
وقد حدث في العصور الخالفة نزول مرتبة الشعر إذ كان شعراء الجاهلية ساداتهم وشجعانهم وحكماؤهم
كان امرؤ القيس من الملوك
وكان عنترة وعمرو بن كلثوم أشجع الناس
وكان زهير وعبيد بن الأبرص حكيمين عفيفين
وكان لبيد جواداً ينحر كل هبوب صباً
وكان النابغة سيداً وجليساً للملوك .
وتنقص عند الشجاع القوة المتخيلة والقوة المتصنعة .
وقد كان مبنى بلاغة العرب على الصدق لغلبة الشجاعة والكرم وهو أخو الشجاعة على أخلاقهم .
وتختلف بلاغة العرب عن غيرهم كما تختلف أخلاقهم عن غيرهم .
وقد حدث في العصور الخالفة نزول مرتبة الشعر إذ كان شعراء الجاهلية ساداتهم وشجعانهم وحكماؤهم
كان امرؤ القيس من الملوك
وكان عنترة وعمرو بن كلثوم أشجع الناس
وكان زهير وعبيد بن الأبرص حكيمين عفيفين
وكان لبيد جواداً ينحر كل هبوب صباً
وكان النابغة سيداً وجليساً للملوك .
Forwarded from تقييدات أبي الحسن
للبوصيري ميمية ذائعة في مدح النبي ﷺ ، اعتنى الناس بها كثيرا ، وفيها أبيات بديعة حسنة ، غير أنه شانها بمواضع غلا فيها على طريقة جهلة الشعراء.
وأشنع ما فيها وأبعده عن التوجيه الممكن ، لاشتمال معناه على الكفر الذي لا يجدي فيه التأويل = قوله :
٤٦- لو ناسبت قدرَه آياتُه عظما ..
أحيا اسمه حين يتلى دارس الرمم
٨٠- ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به ..
إلا ونلت جوارًا منه لم يُضَم
ففي الأول امتناع مناسبة آيات النبي ﷺ لقدره ، وهذا إزراء بالقرآن أكبر الآيات ، وهو صفة الله الفائقة لأقدار الخلق جميعًا.
وقد ذكر الشراح في توجيه ذلك أن القرآن مخلوق ، وليس في ذلك ما يخرج معنى البيت من الكفر ، (فيتهاونون ويظنون أنه هين ، ولا يدرون ما فيه من الكفر) كما يقول الإمام أحمد.
على أن البوصيري ليس متكلما فيضبط القول ، ففي كلامه زيادة على القول بخلق القرآن ، إذ يقول :
آياتُ حق من الرحمن مُحدثةٌ
قديمةٌ صفة الموصوف بالقدمِ
فالآيات التي عناها تشمل ما يقوم بذات الرب سبحانه ، وهذا من أشد الكفر الذي لا يقوله أشعري ولا معتزلي !
وأما البيت الثاني فيقول فيه إنه لم يظلمه الدهر بمصيبة فطلب جوار رسول الله = إلا وأجاره ﷺ ، فهذا دعاء لغير الله ونسبة التصرف له ، وذلك إشراك في الإلهية والربوبية معا ، تنزه ربنا وتقدس ، فهو المستحق للاستجارة المطلقة ، المختص بالإجارة التامة ، والمنفرد بهذا الثناء الفخم وحده جل جلاله.
وقد احتمل بعض الشراح حمل البيت على توسل الدعاء ، وأن الباء فيه للسببية ، فمفعول الاستجارة هو الله ، أي استجرت الله بالنبي ﷺ ، وهذا التوجيه مخالف لمراد الناظم ، والكلام يفسر على مراد قائله ، لا على ما يذهب الشناعة عنه ، فالباء هنا زائدة للتعدية ، والمفعول هو النبي ﷺ ، وذلك من وجوه :
- ما يفيده السياق من مدح النبي ﷺ بكونه لا يضام جواره ، فذكر الجوار دليل على أن الجوار مطلوب منه ، فهو المطلوب الفاعل للإجارة ، وليس السبب المتوسل به ، فإن ذلك أقصر في المدح ، وإن كان أحسن في الدين.
- أن الحمل على الطلب نظير ما جاء بعده في البيت التالي : "ولا التمست غنى الدارين من يده" ، وما له نظير من الكلام أولى بالحمل من غيره.
- أن هذا المعنى كرره البوصيري في غير البردة ، ففي الهمزية :
وأبى الله أن يمسني السو ..
ء بحال ولي إليك التجاءُ
فأغثنا يا من هو الغوث والغيـ ..
ـث إذا أجهد الورى اللأواءُ
فكلام الرجل يفسر بعضه بعضًا ، وعلى ذلك أكثر الشراح كالجاديري وزكريا والهيتمي.
ومنه تعلم حرمة إذاعة هذه الميمية بين العامة ، والتعبد بما فيها من الباطل ، لا سيما في الموالد المحدثة لمحبة رسول ﷺ ، ففيها من الكفر المعارض لملته ما يوجب الارتداد عن دينه ، وعداوته ﷺ لصاحبه ، وكيف تقر شريعته هذا الغلو وقد خطب رجل عنده ، فقال : "من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال رسول الله ﷺ : بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله" ، فما حال من ينشد مثل هذه الأبيات ؟!
وفي الشعر تجوز واتساع تعرفه العرب ، ولا يحل للفقيه أن يقول فيه شيئا حتى يحصل معرفة ذلك ويعرف وجوهه ، لكن هذا له لا يلقي حبل الباطل على غاربه ، فيصير حجة لكل مبطل يقول الباطل الذي تشهد طرائق الكلام بإرادته له ، ثم يرمي أهل الحق بالعجمة والجهل بالعربية ، ويجعل نكيرهم من جنس الغفلة عن مخصصات العام وأضراب هذا مما لا يغفل عنه الطلبة.
وأشنع ما فيها وأبعده عن التوجيه الممكن ، لاشتمال معناه على الكفر الذي لا يجدي فيه التأويل = قوله :
٤٦- لو ناسبت قدرَه آياتُه عظما ..
أحيا اسمه حين يتلى دارس الرمم
٨٠- ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به ..
إلا ونلت جوارًا منه لم يُضَم
ففي الأول امتناع مناسبة آيات النبي ﷺ لقدره ، وهذا إزراء بالقرآن أكبر الآيات ، وهو صفة الله الفائقة لأقدار الخلق جميعًا.
وقد ذكر الشراح في توجيه ذلك أن القرآن مخلوق ، وليس في ذلك ما يخرج معنى البيت من الكفر ، (فيتهاونون ويظنون أنه هين ، ولا يدرون ما فيه من الكفر) كما يقول الإمام أحمد.
على أن البوصيري ليس متكلما فيضبط القول ، ففي كلامه زيادة على القول بخلق القرآن ، إذ يقول :
آياتُ حق من الرحمن مُحدثةٌ
قديمةٌ صفة الموصوف بالقدمِ
فالآيات التي عناها تشمل ما يقوم بذات الرب سبحانه ، وهذا من أشد الكفر الذي لا يقوله أشعري ولا معتزلي !
وأما البيت الثاني فيقول فيه إنه لم يظلمه الدهر بمصيبة فطلب جوار رسول الله = إلا وأجاره ﷺ ، فهذا دعاء لغير الله ونسبة التصرف له ، وذلك إشراك في الإلهية والربوبية معا ، تنزه ربنا وتقدس ، فهو المستحق للاستجارة المطلقة ، المختص بالإجارة التامة ، والمنفرد بهذا الثناء الفخم وحده جل جلاله.
وقد احتمل بعض الشراح حمل البيت على توسل الدعاء ، وأن الباء فيه للسببية ، فمفعول الاستجارة هو الله ، أي استجرت الله بالنبي ﷺ ، وهذا التوجيه مخالف لمراد الناظم ، والكلام يفسر على مراد قائله ، لا على ما يذهب الشناعة عنه ، فالباء هنا زائدة للتعدية ، والمفعول هو النبي ﷺ ، وذلك من وجوه :
- ما يفيده السياق من مدح النبي ﷺ بكونه لا يضام جواره ، فذكر الجوار دليل على أن الجوار مطلوب منه ، فهو المطلوب الفاعل للإجارة ، وليس السبب المتوسل به ، فإن ذلك أقصر في المدح ، وإن كان أحسن في الدين.
- أن الحمل على الطلب نظير ما جاء بعده في البيت التالي : "ولا التمست غنى الدارين من يده" ، وما له نظير من الكلام أولى بالحمل من غيره.
- أن هذا المعنى كرره البوصيري في غير البردة ، ففي الهمزية :
وأبى الله أن يمسني السو ..
ء بحال ولي إليك التجاءُ
فأغثنا يا من هو الغوث والغيـ ..
ـث إذا أجهد الورى اللأواءُ
فكلام الرجل يفسر بعضه بعضًا ، وعلى ذلك أكثر الشراح كالجاديري وزكريا والهيتمي.
ومنه تعلم حرمة إذاعة هذه الميمية بين العامة ، والتعبد بما فيها من الباطل ، لا سيما في الموالد المحدثة لمحبة رسول ﷺ ، ففيها من الكفر المعارض لملته ما يوجب الارتداد عن دينه ، وعداوته ﷺ لصاحبه ، وكيف تقر شريعته هذا الغلو وقد خطب رجل عنده ، فقال : "من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال رسول الله ﷺ : بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله" ، فما حال من ينشد مثل هذه الأبيات ؟!
وفي الشعر تجوز واتساع تعرفه العرب ، ولا يحل للفقيه أن يقول فيه شيئا حتى يحصل معرفة ذلك ويعرف وجوهه ، لكن هذا له لا يلقي حبل الباطل على غاربه ، فيصير حجة لكل مبطل يقول الباطل الذي تشهد طرائق الكلام بإرادته له ، ثم يرمي أهل الحق بالعجمة والجهل بالعربية ، ويجعل نكيرهم من جنس الغفلة عن مخصصات العام وأضراب هذا مما لا يغفل عنه الطلبة.
العلاقة بين فقه التسمية وبين قوانين اللغة
قال الأصمعي: كل ما فاق جنسه فهو خارجي قال طفيل :
وعارضتها رهواً على متتابع
شديد القصيرى خارجي محنّب
قال ابن جني : ومن هذا عندي منع العرب الفعل الذي يراد به المبالغة في معناه في التصرف كنعم وبئس وعسى، وذلك أنها لما بالغوا في معانيها أخرجوها عن حال نظائرها في التصرف .
قال الأصمعي: كل ما فاق جنسه فهو خارجي قال طفيل :
وعارضتها رهواً على متتابع
شديد القصيرى خارجي محنّب
قال ابن جني : ومن هذا عندي منع العرب الفعل الذي يراد به المبالغة في معناه في التصرف كنعم وبئس وعسى، وذلك أنها لما بالغوا في معانيها أخرجوها عن حال نظائرها في التصرف .
جبر الله مصاب أهل الشام وتركيا
استشرف أحدهم أن الزلزال لعله مؤذن بنهاية سنوات البلاء
وهو استشراف نرجو أن يكون صحيحاً بإذن الله تعالى .
فإن اشتداد الكرب علامة على قرب الفرج .
وإن اجتماع البلاء من كل جهة قاطع للطمع في الأسباب ومعين على التوجه لرب الأرباب .
وما أشبه حالهم بحال المؤمنين في غزوة الأحزاب .
خوف وبرد شديد وزلزلة قلوب وعدو متربص والله الناصر .
نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في معونتهم وذنوبنا وأن يعجل بالفرج لنا ولهم .
استشرف أحدهم أن الزلزال لعله مؤذن بنهاية سنوات البلاء
وهو استشراف نرجو أن يكون صحيحاً بإذن الله تعالى .
فإن اشتداد الكرب علامة على قرب الفرج .
وإن اجتماع البلاء من كل جهة قاطع للطمع في الأسباب ومعين على التوجه لرب الأرباب .
وما أشبه حالهم بحال المؤمنين في غزوة الأحزاب .
خوف وبرد شديد وزلزلة قلوب وعدو متربص والله الناصر .
نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في معونتهم وذنوبنا وأن يعجل بالفرج لنا ولهم .
Forwarded from قناة د. ياسر المطيري
فصاحة النبي ﷺ
كلامُه ﷺ قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجَلَّ عن الصنعة، ونُزِّه عن التكلف، واستَعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصورَ في موضع القصر، وهَجَر الغريب الوحشي، ورغِب عن الهجين السُّوقي، فلم ينطِقُ إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفَّ بالعصمة، وشُيِّد بالتأييد، ويُسِّر بالتوفيق.
الكلامُ الذى ألقى الله عليه المحبة، وغشَّاه بالقَبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبَيْن حُسنِ الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلّة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارَتْ له حُجَّة، ولم يَقُم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبذُّ الخُطَبَ الطِّوال بالكلم القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفَلْج إلا بالحق، ولا يستعين بالخِلابة، ولا يَستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا يَعْجَل، ولا يُسهب ولا يَحصَر، ﷺ.
البيان والتبين (٢/ ١٨).
كلامُه ﷺ قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجَلَّ عن الصنعة، ونُزِّه عن التكلف، واستَعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصورَ في موضع القصر، وهَجَر الغريب الوحشي، ورغِب عن الهجين السُّوقي، فلم ينطِقُ إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفَّ بالعصمة، وشُيِّد بالتأييد، ويُسِّر بالتوفيق.
الكلامُ الذى ألقى الله عليه المحبة، وغشَّاه بالقَبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبَيْن حُسنِ الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلّة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارَتْ له حُجَّة، ولم يَقُم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبذُّ الخُطَبَ الطِّوال بالكلم القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفَلْج إلا بالحق، ولا يستعين بالخِلابة، ولا يَستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا يَعْجَل، ولا يُسهب ولا يَحصَر، ﷺ.
البيان والتبين (٢/ ١٨).
Forwarded from أ. د. عبد الرحمن بودرع
شاعَ خطأ تركيبي بين المثقفين ، مصدرُه الترجمَة أو النقلُ عمّن تأثّر بالتّرجَمة، وهو تقديم الجملَة الحالية على الفعل المتضمن فاعلاً ظاهراً أو مُضمراً، وهذا الفاعلُ هو صاحبُ الحال، وذلكَ نحو قولهم:
وأنا أقلبُ صفحات الكتاب وجدتُ...
وأنا أتجولُ بين رفوف المكتبات عثرتُ على كتاب...
ويكثُر هذا الضّربُ من الخطأ في كتابات القصص والروايات، ويُعللُ أصحابُها رُكوبَهم هذه الأساليبَ المترجَمَة بأنها أدقُّ في وصف الحال التي يصفونَها، وهُم لا يَعلمونَ أو يعلمون ويَتغافَلونَ أن تقديمَ ذلك الفعل المتضمن لفاعل كان صاحبَ حالٍ سيُسقطُ اللحنَ ويُبْرئ السَّقَم الأسلوبيَّ ويُعيدُ للتركيب عافيتَه المَسلوبَةَ، نعَم يَجوزُ تقديمُ الحالِ على صاحبِها ولكنّ تقديمَ جملة الحالِ على صاحب الحالِ المُفْرَد خلطٌ واضحٌ، وعنايةٌ بالمعنى وإهمالٌ لقواعِدِ الصنعَة، وهو من مزالِقِ التركيبِ والتعبيرِ والإعرابِ؛ ما الذي يَمنعُنا من أن نَقولَ:
وجدتُ، وأنا أقلبُ صفحات الكتاب...
عثرتُ، وأنا أتجول بين الرفوف، على كتاب...
أو نصرفُ النظرَ عن تصويب التركيب إلى تركيب آخَر أجملَ وأوفى، نحو قولنا:
بينما أنا أقلبُ صفحات الكتاب إذ وجدتُ...
بينَما نحنُ نتجولُ في رفوف المكتبَة إذ عَثرْنا...
وشاهدُه الحديثُ النبويُّ الشريفُ الذي رَواه عُمر رضي الله عنه [صحيح مسلم]: بينَما نحنُ جلوسٌ عند رَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إذْ طلَعَ عليْنا رجلٌ...(1)
هلْ نُفضِّلُ الأسلوبَ الشائعَ المترجَمَ على أسلوب الحَديث، ونقولُ: أسلوبُنا أدقُّ وأوفى بالمَعْنى؟ فمَن أجابَ بالإيجابِ وقالَ إنّ الأسلوبَ المرتَكَبَ اقتضاه العصرُ أو اقتضتْه الدّقّة في التعبير عن المَعْنى، قُلنا له: ما وجه الاقتضاء، وما وجه الدّقّة الدّلاليّة، وما علّةُ الخروج على التركيب العربيّ السليم الذي يشهدُ له ما لا حصر له من الشواهد الفصيحَة، أيُّ تعليل هذا وأيّ تنكُّرٍ؟ ليس للقضيّةِ إلا تفسيرٌ واحدٌ هو الترجمةُ الحرفيّةُ التي تُلقي بقبضتِها على رقابِنا.
فالقضية التي نناقشها هي تقديم جملة الحال على صاحبها، أو بناء الجملة لما لم يُسمَّ فاعلُه ثُم ذكرُ الفاعل، فهذه تراكيبُ منقولةٌ لا شك في ذلك، منقولة من لغة أخرى وليسَت تطورا أفضى إلى تغيير تركيبٍ بتركيب آخَر، وليسَت إبداعاً أو ذكاءً لغوياً، إنه لُجوءُ المتكلم إلى استعارةِ تركيب من لغة أخرى، وليس على سبيل الاختيار والتفضيل بين لغتين أو بين تركيبَيْن، والسبب هو أن المتكلم الذي يرتكب هذا التركيب الأجنبيَّ يَجهلُ تراكيبَ لغته "فيملأ خانةَ الفراغ التركيبي" الذي في نفسه بنموذج لغة أخرى في التركيب، وحينئذ يحدثُ الخلطُ.
ــــــــــــــــــــ
(1) هذا تركيبٌ صحيح، ففي الحديثِ: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذْ طَلَعَ علينا رجلٌ... نستطيع أن نقيسَ عليه أمثلةً: "بينما أنا قائمٌ إذ جاء زيدٌ" وتفسيرُه: بينَ أوقاتِ قيامي مَجيءُ زيدٍ، وتُعرَبُ "بينما" ظرفاً متعلقاً بعاملٍ محذوفٍ يُفسرُه فعلُ المجيءِ الواقعُ بعدَ إذْ، ولا يتعلقُ بينما بجاء للفاصل الحاجز وهو المُضافُ "إذ".
وأنا أقلبُ صفحات الكتاب وجدتُ...
وأنا أتجولُ بين رفوف المكتبات عثرتُ على كتاب...
ويكثُر هذا الضّربُ من الخطأ في كتابات القصص والروايات، ويُعللُ أصحابُها رُكوبَهم هذه الأساليبَ المترجَمَة بأنها أدقُّ في وصف الحال التي يصفونَها، وهُم لا يَعلمونَ أو يعلمون ويَتغافَلونَ أن تقديمَ ذلك الفعل المتضمن لفاعل كان صاحبَ حالٍ سيُسقطُ اللحنَ ويُبْرئ السَّقَم الأسلوبيَّ ويُعيدُ للتركيب عافيتَه المَسلوبَةَ، نعَم يَجوزُ تقديمُ الحالِ على صاحبِها ولكنّ تقديمَ جملة الحالِ على صاحب الحالِ المُفْرَد خلطٌ واضحٌ، وعنايةٌ بالمعنى وإهمالٌ لقواعِدِ الصنعَة، وهو من مزالِقِ التركيبِ والتعبيرِ والإعرابِ؛ ما الذي يَمنعُنا من أن نَقولَ:
وجدتُ، وأنا أقلبُ صفحات الكتاب...
عثرتُ، وأنا أتجول بين الرفوف، على كتاب...
أو نصرفُ النظرَ عن تصويب التركيب إلى تركيب آخَر أجملَ وأوفى، نحو قولنا:
بينما أنا أقلبُ صفحات الكتاب إذ وجدتُ...
بينَما نحنُ نتجولُ في رفوف المكتبَة إذ عَثرْنا...
وشاهدُه الحديثُ النبويُّ الشريفُ الذي رَواه عُمر رضي الله عنه [صحيح مسلم]: بينَما نحنُ جلوسٌ عند رَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إذْ طلَعَ عليْنا رجلٌ...(1)
هلْ نُفضِّلُ الأسلوبَ الشائعَ المترجَمَ على أسلوب الحَديث، ونقولُ: أسلوبُنا أدقُّ وأوفى بالمَعْنى؟ فمَن أجابَ بالإيجابِ وقالَ إنّ الأسلوبَ المرتَكَبَ اقتضاه العصرُ أو اقتضتْه الدّقّة في التعبير عن المَعْنى، قُلنا له: ما وجه الاقتضاء، وما وجه الدّقّة الدّلاليّة، وما علّةُ الخروج على التركيب العربيّ السليم الذي يشهدُ له ما لا حصر له من الشواهد الفصيحَة، أيُّ تعليل هذا وأيّ تنكُّرٍ؟ ليس للقضيّةِ إلا تفسيرٌ واحدٌ هو الترجمةُ الحرفيّةُ التي تُلقي بقبضتِها على رقابِنا.
فالقضية التي نناقشها هي تقديم جملة الحال على صاحبها، أو بناء الجملة لما لم يُسمَّ فاعلُه ثُم ذكرُ الفاعل، فهذه تراكيبُ منقولةٌ لا شك في ذلك، منقولة من لغة أخرى وليسَت تطورا أفضى إلى تغيير تركيبٍ بتركيب آخَر، وليسَت إبداعاً أو ذكاءً لغوياً، إنه لُجوءُ المتكلم إلى استعارةِ تركيب من لغة أخرى، وليس على سبيل الاختيار والتفضيل بين لغتين أو بين تركيبَيْن، والسبب هو أن المتكلم الذي يرتكب هذا التركيب الأجنبيَّ يَجهلُ تراكيبَ لغته "فيملأ خانةَ الفراغ التركيبي" الذي في نفسه بنموذج لغة أخرى في التركيب، وحينئذ يحدثُ الخلطُ.
ــــــــــــــــــــ
(1) هذا تركيبٌ صحيح، ففي الحديثِ: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذْ طَلَعَ علينا رجلٌ... نستطيع أن نقيسَ عليه أمثلةً: "بينما أنا قائمٌ إذ جاء زيدٌ" وتفسيرُه: بينَ أوقاتِ قيامي مَجيءُ زيدٍ، وتُعرَبُ "بينما" ظرفاً متعلقاً بعاملٍ محذوفٍ يُفسرُه فعلُ المجيءِ الواقعُ بعدَ إذْ، ولا يتعلقُ بينما بجاء للفاصل الحاجز وهو المُضافُ "إذ".
البارحة كنت في هم وشغل بال وكنت قد انقطعت عن كتبي لفترة فقلت أسري الهم بالعلم وأخرج من حال الى حال فتصفحت حاشية جديدة في علم البلاغة وهي متقدمة جداً الأصل أن لا يسمع بها إلا المتخصص ولا يحققها إلا المتمكن
ومر في الحاشية ذكر نجم الأئمة الرضي فتبرع المحقق بذكر ترجمة الشريف الرضي !؟
فضلاً عن أن المتبادر للذهن عند ذكر الرضي في مسالة نحوية هو نجم الأئمة الأستراباذي فالمؤلف قطع العذر عندما ذكر لقبه ( نجم الأئمة )
أغلقت الكتاب وتأملت فخامة الطباعة وحداثة الطبع وينشر لأول مرة وكثرة النسخ الخطية وضحكت وسرّي عني من الهم أكثر مما لو رأيت فائدة جليلة .
ومر في الحاشية ذكر نجم الأئمة الرضي فتبرع المحقق بذكر ترجمة الشريف الرضي !؟
فضلاً عن أن المتبادر للذهن عند ذكر الرضي في مسالة نحوية هو نجم الأئمة الأستراباذي فالمؤلف قطع العذر عندما ذكر لقبه ( نجم الأئمة )
أغلقت الكتاب وتأملت فخامة الطباعة وحداثة الطبع وينشر لأول مرة وكثرة النسخ الخطية وضحكت وسرّي عني من الهم أكثر مما لو رأيت فائدة جليلة .
إذا ما دعوت الله فاحمده أولا
ولا تبتدئ في حاجة متعجلا
وأثن عليه بالجميل ولا تخف
فرب مراد بالثناء تسهلا
هو الملك الوهاب يعطيك مثنيا
عليه كما يعطي العفاة وأفضلا
تمهل فقد ناداك قبل فجئته
ولم تأته من عند نفسك أولا
إذا جئته جئت الكريم فلم تعد
تؤمل بابا غيره ووسائلا
وقل يا جميل الستر عفوك سابغ
بحمدك أمشي في الورى متجملا
ويا منعش المكروب وعدك صادق
ويا ساتر العورات يا كاشف البلا
ويا جابر المكسور فضلك واسع
رأينا_ فأملنا _ عطاياك في الملا
تغيث من اللأوا وتهدي من العمى
وتشفي من الأدوا وترزق في الغلا
أتينا بمزجاة البضائع في الثنا
فأوف لنا الكيل المرجى وأفضلا
وصل على من جاءنا بكتابه
وعلمنا من وحيه ما تنزلا
أب هو أحنى من أب ومعلم
فأيسر ما تجزيه أن تكثر الصلا
صلى الله عليه وسلم
ولا تبتدئ في حاجة متعجلا
وأثن عليه بالجميل ولا تخف
فرب مراد بالثناء تسهلا
هو الملك الوهاب يعطيك مثنيا
عليه كما يعطي العفاة وأفضلا
تمهل فقد ناداك قبل فجئته
ولم تأته من عند نفسك أولا
إذا جئته جئت الكريم فلم تعد
تؤمل بابا غيره ووسائلا
وقل يا جميل الستر عفوك سابغ
بحمدك أمشي في الورى متجملا
ويا منعش المكروب وعدك صادق
ويا ساتر العورات يا كاشف البلا
ويا جابر المكسور فضلك واسع
رأينا_ فأملنا _ عطاياك في الملا
تغيث من اللأوا وتهدي من العمى
وتشفي من الأدوا وترزق في الغلا
أتينا بمزجاة البضائع في الثنا
فأوف لنا الكيل المرجى وأفضلا
وصل على من جاءنا بكتابه
وعلمنا من وحيه ما تنزلا
أب هو أحنى من أب ومعلم
فأيسر ما تجزيه أن تكثر الصلا
صلى الله عليه وسلم
ذكر البيهقي أن حسن التأليف يأتي بالإيجاز وذكر الحجج وحسن النظم والترتيب .
فالأول هدفه عدم الإملال والثاني هدفه الإقناع والثالث هدفه الإفهام .
فالأول هدفه عدم الإملال والثاني هدفه الإقناع والثالث هدفه الإفهام .
"أغلب القضايا والأسئلة التي يقولها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا "
لودفيج فتجنشتاين
لودفيج فتجنشتاين
الزمخشري أكثر الناس أخذاً بالاختصاص لخدمة مذهبه .
بهاء الدين السبكي _ عروس الأفراح
بهاء الدين السبكي _ عروس الأفراح
منزلة المخاطب عند سيبويه
"سيبويه _ فيما يبدو _ كان ينطلق في تقديره للأسئلة وافتراضها من فلسفة مفادها أن الكلام في أصله أجوبة أو كالأجوبة عن سؤالات المخاطب بناءً على أن الأصل أن المتكلم إنما يذكر في كلامه ما يحتاج إليه مخاطَبه ويمسك عما لا حاجة لمخاطَبه به .
والسؤال فرع عن الاحتياج ومن هذا الباب نزل المحتاج منزلة السائل .
وهذا المعنى هو الذي التقطه أبو العباس المبرد من كلام وفلسفة سيبويه فقال : إنما وضعت الأخبار جوابات للاستفهام" .
ظاهرة السؤال المقدر في كتاب سيبويه
لعبد الله الصليمي
"سيبويه _ فيما يبدو _ كان ينطلق في تقديره للأسئلة وافتراضها من فلسفة مفادها أن الكلام في أصله أجوبة أو كالأجوبة عن سؤالات المخاطب بناءً على أن الأصل أن المتكلم إنما يذكر في كلامه ما يحتاج إليه مخاطَبه ويمسك عما لا حاجة لمخاطَبه به .
والسؤال فرع عن الاحتياج ومن هذا الباب نزل المحتاج منزلة السائل .
وهذا المعنى هو الذي التقطه أبو العباس المبرد من كلام وفلسفة سيبويه فقال : إنما وضعت الأخبار جوابات للاستفهام" .
ظاهرة السؤال المقدر في كتاب سيبويه
لعبد الله الصليمي
يشتهر لدى المتأخرين تعريف الحمد بالثناء على الجميل الاختياري وهو تعريف غير صحيح
أصله أن بعض المفسرين ذكر أن الفرق بين الحمد والمدح هو أن الحمد للحي فقط أما المدح فيصح أن يمدح الحي والجماد .
وهذا التفريق الذي ذكره تحول عند من بعده إلى جزء من التعريف .
وهو خطأ
فالحمد يطلق على الحي والجماد ثم لو افترضنا اختصاصه بالحي فلا علاقة لذلك بالاختيار ثم لا يصلح أن يبنى التعريف على مثل هذه الفروق .
أما الدلالة على عدم اختصاص الحمد بالحي المختار فيقول الله تعالى
(( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ))
ويقول الشاعر :
أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب
ويقول الراجز:
عند الصباح يحمد القوم السرى
ويقول ذو الرمة يصف مرعى :
ألقى عصي النوى عنهن ذو زهرٍ
وحف على ألسن الرواد محمود
وقد نبه بعض المحققين على خطأ اختصاص الحمد بالجميل الاختياري كابن كمال باشا وابن هشام إلا أن المشهور بين الناس اعتبار ذلك ، وقد راج هذا على كبار علماء اللغة حتى أبطلوا القول بأن الحمد مقلوب مدح استناداً إلى مثل هذه الفروق المزعومة .
أصله أن بعض المفسرين ذكر أن الفرق بين الحمد والمدح هو أن الحمد للحي فقط أما المدح فيصح أن يمدح الحي والجماد .
وهذا التفريق الذي ذكره تحول عند من بعده إلى جزء من التعريف .
وهو خطأ
فالحمد يطلق على الحي والجماد ثم لو افترضنا اختصاصه بالحي فلا علاقة لذلك بالاختيار ثم لا يصلح أن يبنى التعريف على مثل هذه الفروق .
أما الدلالة على عدم اختصاص الحمد بالحي المختار فيقول الله تعالى
(( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ))
ويقول الشاعر :
أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب
ويقول الراجز:
عند الصباح يحمد القوم السرى
ويقول ذو الرمة يصف مرعى :
ألقى عصي النوى عنهن ذو زهرٍ
وحف على ألسن الرواد محمود
وقد نبه بعض المحققين على خطأ اختصاص الحمد بالجميل الاختياري كابن كمال باشا وابن هشام إلا أن المشهور بين الناس اعتبار ذلك ، وقد راج هذا على كبار علماء اللغة حتى أبطلوا القول بأن الحمد مقلوب مدح استناداً إلى مثل هذه الفروق المزعومة .
من عادة العرب أنها إذا ذكرت صنفين قد اجتمعا في صفة بدأت بأهمهما أمراً وأشدهما حالاً .
البيهقي
البيهقي