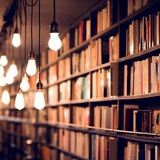[ فضائل يوم عرفة ]
يوم عرفة له فضائل متعددة :
منها: أنه يومُ إكمال الدين وإتمام النّعمة.
ومنها: أنّه عيدٌ لأهل الإسلام.. لكنّه عيدٌ لأهل الموقف خاصّة..
ومنها: أنّه قد قيل: إنّه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه، وأنّ الوتر يوم النّحر..
وقيل: إنّه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه، فقال تعالى: (وشاهد ومشهود).
ومنها: أنه روي أنّه أفضل الأيام.. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء.
ومنهم من قال: يوم النّحر أفضل الأيام.
ومنها: أنّه روي عن أنس بن مالك أنّه قال: كان يقال: يومُ عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل.. وروي عن عطاء قال: من صام يومَ عرفة كان له كأجر ألفي يوم.
ومنها: أنّه يوم الحجّ الأكبر عند جماعة من السلف، منهم عُمر وغيره. وخالفهم آخرون، وقالوا: يومُ الحجّ الأكبر يوم النّحر.
ومنها: أنّ صيامه كفّارة سنتين.
ومنها: أنّه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق من النّار، والمباهاة بأهل الموقف.
[لطائف المعارف (ص/488) لابن رجب]
يوم عرفة له فضائل متعددة :
منها: أنه يومُ إكمال الدين وإتمام النّعمة.
ومنها: أنّه عيدٌ لأهل الإسلام.. لكنّه عيدٌ لأهل الموقف خاصّة..
ومنها: أنّه قد قيل: إنّه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه، وأنّ الوتر يوم النّحر..
وقيل: إنّه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه، فقال تعالى: (وشاهد ومشهود).
ومنها: أنه روي أنّه أفضل الأيام.. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء.
ومنهم من قال: يوم النّحر أفضل الأيام.
ومنها: أنّه روي عن أنس بن مالك أنّه قال: كان يقال: يومُ عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل.. وروي عن عطاء قال: من صام يومَ عرفة كان له كأجر ألفي يوم.
ومنها: أنّه يوم الحجّ الأكبر عند جماعة من السلف، منهم عُمر وغيره. وخالفهم آخرون، وقالوا: يومُ الحجّ الأكبر يوم النّحر.
ومنها: أنّ صيامه كفّارة سنتين.
ومنها: أنّه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق من النّار، والمباهاة بأهل الموقف.
[لطائف المعارف (ص/488) لابن رجب]
من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التى يرجى بها العتق والمغفرة..
فمنها: صيام ذلك اليوم.
ومنها: حفظ جوراحه عن المحرمات في ذلك اليوم.
ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق فإنها أصل دين الإسلام الذي أكلمه الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه.
ومنها: أن يعتق رقبة إن أمكنه.
ومنها: كثرة الدعاء بالمغفرة، والعتق؛ فإنّه يرجى إجابة الدعاء فيه..
وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق:
فمنها: الاختيال..
ومنها: الإصرار على الكبائر..
[لطائف المعارف (ص/493) لابن رجب]
فمنها: صيام ذلك اليوم.
ومنها: حفظ جوراحه عن المحرمات في ذلك اليوم.
ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق فإنها أصل دين الإسلام الذي أكلمه الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه.
ومنها: أن يعتق رقبة إن أمكنه.
ومنها: كثرة الدعاء بالمغفرة، والعتق؛ فإنّه يرجى إجابة الدعاء فيه..
وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق:
فمنها: الاختيال..
ومنها: الإصرار على الكبائر..
[لطائف المعارف (ص/493) لابن رجب]
اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفة، وكان الإمام أحمد لا يفعله ولا يُنكِر على من فعله؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة.
[لطائف المعارف (ص/475) لابن رجب]
[لطائف المعارف (ص/475) لابن رجب]
مد إليه يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار، وارفع قصة ندمك مرقومةً على صحيفة خدِّك بمداد الدموع الغزار وقل: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: ٢٣]
[لطائف المعارف (ص/497) لابن رجب]
[لطائف المعارف (ص/497) لابن رجب]
إذا طلب الأسيرُ الأمان من الملك الكريم أمَّنَه.
الأمانَ الأمانَ وزري ثقيلُ ... وذنوبي إذا عُددن تطولُ
أوبقتنِي وأوثقتنِي ذنُوبي ... فترى لي إلى الخلاص سبيلُ
[لطائف المعارف (ص/498) لابن رجب]
الأمانَ الأمانَ وزري ثقيلُ ... وذنوبي إذا عُددن تطولُ
أوبقتنِي وأوثقتنِي ذنُوبي ... فترى لي إلى الخلاص سبيلُ
[لطائف المعارف (ص/498) لابن رجب]
من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه.
من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله، وقد قرّبه وأزلفه.
من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف، فليقم لله بحق الرجاء والخوف.
من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى.
من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت؛ فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد.
[لطائف المعارف (ص/501) لابن رجب]
من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله، وقد قرّبه وأزلفه.
من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف، فليقم لله بحق الرجاء والخوف.
من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى.
من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت؛ فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد.
[لطائف المعارف (ص/501) لابن رجب]
قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد.
واستحبه الشافعي.
وخرَّج البيهقي بإسناد صحيح، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
[فتح الباري (415/8) لابن رجب]
واستحبه الشافعي.
وخرَّج البيهقي بإسناد صحيح، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
[فتح الباري (415/8) لابن رجب]
الغسل للعيدين..قد نص أحمد على استحبابه.
وحكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ.
وكان ابن عمر يفعله، كذا رواه نافع عنه.
[فتح الباري (415/8) لابن رجب]
وحكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ.
وكان ابن عمر يفعله، كذا رواه نافع عنه.
[فتح الباري (415/8) لابن رجب]
أيام التشريق :
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ]
وذكر الله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة:
1️⃣منها: ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي وابن عباس. وفيه حديث مرفوع في إسناده ضعف.
2️⃣ومنها: ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك؛ فإن وقت ذبح الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلماء وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وفيه حديث مرفوع: "كل أيام منى ذبح" وفي إسناده مقال. وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر وهو المشهور عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة والأكثرين.
3️⃣ومنها: ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره وفي الحديث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها"..
4️⃣ومنها: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق وهذا يختص به أهل الموسم.
5️⃣ومنها: ذكر الله تعالى المطلق؛ فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، وقد كان عمر يكبر بمنى في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا.
[لطائف المعارف (ص/504) لابن رجب]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ]
وذكر الله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة:
1️⃣منها: ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي وابن عباس. وفيه حديث مرفوع في إسناده ضعف.
2️⃣ومنها: ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك؛ فإن وقت ذبح الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلماء وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وفيه حديث مرفوع: "كل أيام منى ذبح" وفي إسناده مقال. وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر وهو المشهور عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة والأكثرين.
3️⃣ومنها: ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره وفي الحديث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها"..
4️⃣ومنها: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق وهذا يختص به أهل الموسم.
5️⃣ومنها: ذكر الله تعالى المطلق؛ فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، وقد كان عمر يكبر بمنى في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرا.
[لطائف المعارف (ص/504) لابن رجب]
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل]
إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.
وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا وهو جدير أن يسلبها كما قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها = فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله = فشكر الإله يزيل النقم
[لطائف المعارف (ص/507) لابن رجب]
إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.
وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا وهو جدير أن يسلبها كما قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها = فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله = فشكر الإله يزيل النقم
[لطائف المعارف (ص/507) لابن رجب]
﴿وَمِنهُم مَن يَقولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]
قد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق.
قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}..
وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه وروي: أنه كان أكثر دعائه. وكان إذا دعا بدعاء جعله معه؛ فإنه يجمع خيري الدنيا والآخرة.
[لطائف المعارف (ص/505) لابن رجب]
قد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق.
قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}..
وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه وروي: أنه كان أكثر دعائه. وكان إذا دعا بدعاء جعله معه؛ فإنه يجمع خيري الدنيا والآخرة.
[لطائف المعارف (ص/505) لابن رجب]
أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة.
وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمةً أخرى، فيحتاج إلى شكر آخر، ولا ينتهي الشكر أبدا.
إذا كان شكري نعمةَ الله نعمةً ... علي له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ... وإن طالت الأيام واتصل العمر
[لطائف المعارف (ص/507) لابن رجب]
وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمةً أخرى، فيحتاج إلى شكر آخر، ولا ينتهي الشكر أبدا.
إذا كان شكري نعمةَ الله نعمةً ... علي له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ... وإن طالت الأيام واتصل العمر
[لطائف المعارف (ص/507) لابن رجب]
{فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}
في الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أنّ سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باق لا ينقضي ولا يُفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة.
[لطائف المعارف (ص/506) لابن رجب]
في الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أنّ سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باق لا ينقضي ولا يُفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة.
[لطائف المعارف (ص/506) لابن رجب]
الظلمُ المحرَّم تارة يكُون في النّفوس، وأشدّه في الدماء،
وتارة في الأموال،
وتارة في الأعراض؛
ولهذا قال ﷺ في خُطبته في حجّة الوداع: (إنّ دِماءَكُمْ وأموالكُم وأعراضكُم عليكُم حرامٌ كحُرمَةِ يَوْمِكُم هذا في شهركُم هذا في بلدكُم هذا)
فجانب الظلم لا تسلك طريقته ... عواقب الظلم تُخشى وهي تُنْتَظَرُ
[مجموع الرسائل (134/1) لابن رجب]
وتارة في الأموال،
وتارة في الأعراض؛
ولهذا قال ﷺ في خُطبته في حجّة الوداع: (إنّ دِماءَكُمْ وأموالكُم وأعراضكُم عليكُم حرامٌ كحُرمَةِ يَوْمِكُم هذا في شهركُم هذا في بلدكُم هذا)
فجانب الظلم لا تسلك طريقته ... عواقب الظلم تُخشى وهي تُنْتَظَرُ
[مجموع الرسائل (134/1) لابن رجب]
الطالبُ النَّابغ أو الذكيُّ سببٌ في تدفُّق علم الأستاذ:
كان ابنُ ناصر السلامي -محدِّث بغداد في القرن السَّادس- يقول عن تلميذه ابن الجوزي:
"إذا قرأ عليَّ فلانٌ استفدتُّ بقراءته، وأذكرَني ما قد نسيتُه".
[ذيل طبقات الحنابلة (489/2) لابن رجب]
كان ابنُ ناصر السلامي -محدِّث بغداد في القرن السَّادس- يقول عن تلميذه ابن الجوزي:
"إذا قرأ عليَّ فلانٌ استفدتُّ بقراءته، وأذكرَني ما قد نسيتُه".
[ذيل طبقات الحنابلة (489/2) لابن رجب]
كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها.
صنع عبد الواحد بن زيد طعاما لإخوانه فقام عتبة الغلام على رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم، فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه النظر ودموع عتبة تجري، فسأله بعد ذلك عن بكائه حينئذ، فقال: ذكرت موائد الجنة والولدان قائمون على رؤوسهم فصعق عبد الواحد.
أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة.
جسمي معي غير أن الروح عندكم ... فالجسم في غربة والروح في وطن
[لطائف المعارف (ص/512) لابن رجب]
صنع عبد الواحد بن زيد طعاما لإخوانه فقام عتبة الغلام على رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم، فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه النظر ودموع عتبة تجري، فسأله بعد ذلك عن بكائه حينئذ، فقال: ذكرت موائد الجنة والولدان قائمون على رؤوسهم فصعق عبد الواحد.
أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة.
جسمي معي غير أن الروح عندكم ... فالجسم في غربة والروح في وطن
[لطائف المعارف (ص/512) لابن رجب]
من أحسن عمله وأتقنه وعمله على الحضور والمراقبة، فلا ريب أنه يتضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه على وجه السهو والغفلة.
ولهذا روي في حديث عمار المرفوع: "إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ العشر"، فليس ثواب من كتب له عشر عمله كثواب من كتب له نصف ولا ثواب من كتب له نصف عمله كثواب من كتب له عمله كله.
[فتح الباري (163/1) لابن رجب]
ولهذا روي في حديث عمار المرفوع: "إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ العشر"، فليس ثواب من كتب له عشر عمله كثواب من كتب له نصف ولا ثواب من كتب له نصف عمله كثواب من كتب له عمله كله.
[فتح الباري (163/1) لابن رجب]
" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ".
ومعنى الحديث:
النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة مالا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لن يشاد الدين أحد إلا غلبه " يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد الدين غلبه وقطعه..
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سددوا وقاربوا وأبشروا ":
التسديد: هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم يخطه. والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه؛ لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦] وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "..
وقيل:أراد التسديد: العمل بالسداد -وهو القصد والتوسط في العبادة- فلا يقصر فيما أمر به وولا يتحمل منها مالا يطيقه.
قال النضر بن شميل: السداد: القصد في الدين والسبيل، وكذلك المقاربة المراد بهما: التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد.
وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات، وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات. وقيل فيهما غير ذلك.
وقوله " أبشروا " يعني: أن من قصد المراد فليبشر..
وقوله" واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة "
يعني: أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله، وهي: أول النهار وآخره، وآخر الليل. فالغدوة: أول النهار، والروحة آخره، والدلجة:سير آخر الليل.
وفي " سنن أبي داود " عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل ".
فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال..
من دام على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد؛ بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ..
قال الحسن: نفوسكم مطاياكم؛ فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل، والله أعلم.
[فتح الباري (149/1) لابن رجب]
ومعنى الحديث:
النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة مالا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لن يشاد الدين أحد إلا غلبه " يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد الدين غلبه وقطعه..
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سددوا وقاربوا وأبشروا ":
التسديد: هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم يخطه. والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه؛ لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦] وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "..
وقيل:أراد التسديد: العمل بالسداد -وهو القصد والتوسط في العبادة- فلا يقصر فيما أمر به وولا يتحمل منها مالا يطيقه.
قال النضر بن شميل: السداد: القصد في الدين والسبيل، وكذلك المقاربة المراد بهما: التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد.
وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات، وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات. وقيل فيهما غير ذلك.
وقوله " أبشروا " يعني: أن من قصد المراد فليبشر..
وقوله" واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة "
يعني: أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله، وهي: أول النهار وآخره، وآخر الليل. فالغدوة: أول النهار، والروحة آخره، والدلجة:سير آخر الليل.
وفي " سنن أبي داود " عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا سافرتم فعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل ".
فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال..
من دام على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد؛ بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ..
قال الحسن: نفوسكم مطاياكم؛ فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل، والله أعلم.
[فتح الباري (149/1) لابن رجب]
رويَ عن بعض السَّلف أنَّه قال: أدركتُ قوماً لم يكن لهم عيوبٌ، فذكروا عيوبَ الناس، فذكر الناسُ لهم عيوباً، وأدركتُ أقواماً كانت لهم عيوبٌ، فكفُّوا عن عُيوب الناس، فنُسِيَت عيوبهم، أو كما قال.
وشاهد هذا حديث أبي بَرْزَةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: «يا معشرَ من آمن بلسانه، ولم يدخُلِ الإيمانُ في قلبه، لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تتبعُوا عوراتهم، فإنَّه منِ اتَّبَع عوراتهم، تتبَّع الله عورته، ومن تتبَّع الله عورته، يفضحه في بيته» خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/737) لابن رجب]
وشاهد هذا حديث أبي بَرْزَةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: «يا معشرَ من آمن بلسانه، ولم يدخُلِ الإيمانُ في قلبه، لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تتبعُوا عوراتهم، فإنَّه منِ اتَّبَع عوراتهم، تتبَّع الله عورته، ومن تتبَّع الله عورته، يفضحه في بيته» خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/737) لابن رجب]