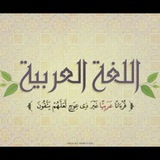من الظواهر المشهورة في اللغة العربيّة (النحت).
فبدلًا من قولك: قُل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، تقول: حَولِقْ.
ومن التطبيقات المحدثة قولهم لركوب الموج: ركمجة.
والركمجة اصطلاحًا لا تقتصر على ركوب موج البحر، بل وعلى ركوب موجات الانتصار.
بلاغة_نحت
فبدلًا من قولك: قُل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، تقول: حَولِقْ.
ومن التطبيقات المحدثة قولهم لركوب الموج: ركمجة.
والركمجة اصطلاحًا لا تقتصر على ركوب موج البحر، بل وعلى ركوب موجات الانتصار.
بلاغة_نحت
سبع 7 معلومات مميزة و غريبة أعرفها لأول مرة .
عجائب وغرائب اللغة العربية :
✒١- كل كلمة تبدأ بحرف (الكاف) غالبًا ما تعطي معنى الإحتواء، مثل : " كيس ، كوكب ، كهف ، كفن ، كف ... ".
✒2-كل كلمة تبدأ بحرف (الغين) غالبًا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل:
" غيم ، غمام ، غبار ، غدر فهي جميعا تعني عدم الوضوح ،
الغباء عدم وضوح الشيء أو تمييز الحقيقة"
✒3-كل كلمة تحتوي على حرفي (الجيم والنون) تعطي معنى الخفاء والإستتار، مثل:
" الجنين ، الجن ، الجنّة وهي الأرض التي أُحيطت بالاشجار فلا يظهر ما بداخلها ، الجنون وهو الذي خفي عقله واستتر ".
✒4-ومن العجائب ما يسمى بالـ " النحت " وهو أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحد، مثل:
الأحرف " ب ح ر " كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والإتساع (بحر ، رحب ، حبر ، حرب )
✒5-يمكن لكلمة واحدة أن تُشكّل جملة كاملة مثل:
كلمة (فأسقيناكموه)
لفظة واحدة احتوت على: حرف عطفٍ، وفعلٍ، وفاعلٍ، ومفعول به أول، ومفعول به ثانٍ.
✒6-المعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل يأكل، يذهب، ينام.
لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل:
مِ : وهي تعني الإيماء.
قِ: وهي تعني الوقاية.
عِ : تعني فهم القول وأدراكه.
رِ: وهي تأتي بمعنى أنظر.
✒7-يبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية 12.302.912 كلمة بلا تكرار.
أي أكثر من 20 ضعف عدد الكلمات الإنجليزية 600.000 كلمة، وهذا المؤشر اللغوي يدل على ثراء اللغة العربية مقارنة بغيرها من اللغات.
وكانت هذه المعلومات القليلة مشاركة في الاحتفاء بلغتنا الخالدة.
عجائب وغرائب اللغة العربية :
✒١- كل كلمة تبدأ بحرف (الكاف) غالبًا ما تعطي معنى الإحتواء، مثل : " كيس ، كوكب ، كهف ، كفن ، كف ... ".
✒2-كل كلمة تبدأ بحرف (الغين) غالبًا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل:
" غيم ، غمام ، غبار ، غدر فهي جميعا تعني عدم الوضوح ،
الغباء عدم وضوح الشيء أو تمييز الحقيقة"
✒3-كل كلمة تحتوي على حرفي (الجيم والنون) تعطي معنى الخفاء والإستتار، مثل:
" الجنين ، الجن ، الجنّة وهي الأرض التي أُحيطت بالاشجار فلا يظهر ما بداخلها ، الجنون وهو الذي خفي عقله واستتر ".
✒4-ومن العجائب ما يسمى بالـ " النحت " وهو أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحد، مثل:
الأحرف " ب ح ر " كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والإتساع (بحر ، رحب ، حبر ، حرب )
✒5-يمكن لكلمة واحدة أن تُشكّل جملة كاملة مثل:
كلمة (فأسقيناكموه)
لفظة واحدة احتوت على: حرف عطفٍ، وفعلٍ، وفاعلٍ، ومفعول به أول، ومفعول به ثانٍ.
✒6-المعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل يأكل، يذهب، ينام.
لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل:
مِ : وهي تعني الإيماء.
قِ: وهي تعني الوقاية.
عِ : تعني فهم القول وأدراكه.
رِ: وهي تأتي بمعنى أنظر.
✒7-يبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية 12.302.912 كلمة بلا تكرار.
أي أكثر من 20 ضعف عدد الكلمات الإنجليزية 600.000 كلمة، وهذا المؤشر اللغوي يدل على ثراء اللغة العربية مقارنة بغيرها من اللغات.
وكانت هذه المعلومات القليلة مشاركة في الاحتفاء بلغتنا الخالدة.
.
لمحة من:
#قواعد_اللغة_العربية_المبسطة
للأستاذ: عبد اللطيف السعيد.. (1)
︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾
◼️ أقسام الكلام:
يُقسم الكلامُ إلى اسمٍ وفعلٍ وحرف.
▪️ الاسمُ:
هوَ ما دلَّ على معنىً أو شيءٍ، مثل: التّطوُّر - الشّجرة، وهو أنواعٌ:
1- اسمُ إنسانٍ: أحمدُ - فاطمةُ.
2- اسمُ حيوانٍ: غزالٌ - حصانٌ.
3- اسمُ نباتٍ: شجرةٌ - قمحٌ.
4- اسمُ جمادٍ: جدارٌ - طاولةٌ.
سماته:
ا- يقبل دخول ( ال) عليه: جدارٌ - الجدارُ.
ب- يقبل دخول أداة النّداء عليه: يا أحمدُ!
▪️ الفعلُ:
هوَ ما دلَّ على حدثٍ أو عملٍ مرتبطاً بالزّمن.
فإن كانَ الحدثُ ماضياً كانَ الفعلُ ماضياً، مثل: (حضرَ)، وإن كانَ الحدثُ حاضراً كانَ الفعلُ مضارعاً، مثل: (يحضرُ)، وإن دلَّ الفعلُ على طلبِ حدوثِ العملِ كانَ الفعلُ فعلَ أمرٍ،مثلُ:(احضرْ).
▪️ الحرفُ:
هو ما استعملَ للرّبطِ بينَ الأسماءِ والأفعالِ أو بينَ أجزاءِ الجملةِ، مثلُ: من - إلى.
* * *
الأسماء:
الجامد والمشتقّ:
- الجامدُ: هو الاسمُ الّذي لا يُؤخذُ من غيرِه، مثل (باب).
- والمشتقُّ: هو الاسمُ الّذي يُؤخذُ من غيره، مثلُ (مَطْلَع) من الطّلوعِ.…
الاسمُ الجامدُ نوعان:
ا- اسمُ ذاتٍ: هو الاسمُ الّذي يُدركُ بالحواسِّ، مثل: شمسٌ - نحلةٌ.
ب- اسمُ معنىً: هو الاسمُ الّذي يُدركُ بالعقلِ ويسمَّى المصدر، مثلُ: احترامٌ - صدقٌ.
يتبــــع...
┄┉❈❖❀✺❀❖❈┉┄
من مختارات:
سلطان نعمان البركاني
لمحة من:
#قواعد_اللغة_العربية_المبسطة
للأستاذ: عبد اللطيف السعيد.. (1)
︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾
◼️ أقسام الكلام:
يُقسم الكلامُ إلى اسمٍ وفعلٍ وحرف.
▪️ الاسمُ:
هوَ ما دلَّ على معنىً أو شيءٍ، مثل: التّطوُّر - الشّجرة، وهو أنواعٌ:
1- اسمُ إنسانٍ: أحمدُ - فاطمةُ.
2- اسمُ حيوانٍ: غزالٌ - حصانٌ.
3- اسمُ نباتٍ: شجرةٌ - قمحٌ.
4- اسمُ جمادٍ: جدارٌ - طاولةٌ.
سماته:
ا- يقبل دخول ( ال) عليه: جدارٌ - الجدارُ.
ب- يقبل دخول أداة النّداء عليه: يا أحمدُ!
▪️ الفعلُ:
هوَ ما دلَّ على حدثٍ أو عملٍ مرتبطاً بالزّمن.
فإن كانَ الحدثُ ماضياً كانَ الفعلُ ماضياً، مثل: (حضرَ)، وإن كانَ الحدثُ حاضراً كانَ الفعلُ مضارعاً، مثل: (يحضرُ)، وإن دلَّ الفعلُ على طلبِ حدوثِ العملِ كانَ الفعلُ فعلَ أمرٍ،مثلُ:(احضرْ).
▪️ الحرفُ:
هو ما استعملَ للرّبطِ بينَ الأسماءِ والأفعالِ أو بينَ أجزاءِ الجملةِ، مثلُ: من - إلى.
* * *
الأسماء:
الجامد والمشتقّ:
- الجامدُ: هو الاسمُ الّذي لا يُؤخذُ من غيرِه، مثل (باب).
- والمشتقُّ: هو الاسمُ الّذي يُؤخذُ من غيره، مثلُ (مَطْلَع) من الطّلوعِ.…
الاسمُ الجامدُ نوعان:
ا- اسمُ ذاتٍ: هو الاسمُ الّذي يُدركُ بالحواسِّ، مثل: شمسٌ - نحلةٌ.
ب- اسمُ معنىً: هو الاسمُ الّذي يُدركُ بالعقلِ ويسمَّى المصدر، مثلُ: احترامٌ - صدقٌ.
يتبــــع...
┄┉❈❖❀✺❀❖❈┉┄
من مختارات:
سلطان نعمان البركاني
"الأشخاص الذين يصحّحون الأخطاء الإملائية مصابون بمرض نفسي".
(دراسة أجراها باحث راسب في الإملاء).
(دراسة أجراها باحث راسب في الإملاء).
مع النحو
....
الحال
.....
الحال من أكبر الدروس النحوية وأوسعها
إضافة لدرس التمييز
وسنقف في هذه الوقفة الخاطفة مع الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق
الحال لا بد أن تكون مشتقة
لكنها -ولاحظ أننا ننطق الحال مؤنثة- قد تأتي جامدة مؤولة بالمشتق
ومجيؤها على ذلك لا يؤدي لأي ارتباك أو إشكال
إنما قد يقع الارتباك والإشكال في حال مجيئها جامدة غير مؤولة
لكن هذا الإشكال يتلاشى بحصر المسألة على النحو التالي.
تجيئ الحال جامدة غير مؤولة في سبع وضعيات:
ـ أن تكون جزءا من صاحبها أو متكونة منه أو فرعا لها
تقول:
هذا بيتك غرفا
فالغرف فرع عن البيت إذ فيه المجالس والصالات والأبهاء
ومنه قول الله:
(وتنحتون من الجبال بيوتا)
فبيوتا متكونة ومتفرعة من هذه الجبال
.....
أن تكون موصوفة
قال تعالى:
(فتمثل لها بشرا سريعا)
فبشر حال جامدة موصوفة كما تلاحظ
ومثلها قول الله أيضا:
"إنا أنزلناه قرآنا عربيا"
فقرآن حال جامدة موصوفة
....
أن تدل على تسعير:
تقول: اشتريت الثوب مترا بخمسة آلاف
فمترا حال جامدة لدلاتها على التسعير
.....
أن تدل على عدد
تقول:
تمت عدد أيام تأليفي للكتاب تسعين يوما
فتسعين حال جامدة
ومنها قول الله:
(فتم ميقات ربه أربعين ليلة)
......
أن تكون أصلا لصاحبها
تقول:
هذا جسمك طينا
ومن قول الله حكاية عن إبليس:
( أأسجد لمن خلقت طينا)
ومعلوم أن أصل الإنسان طين
....
أن تدل على أحوال تفضيلية
تقول:
كلامُك شعرا أفضل منه رواية
فشعر ورواية حالان جامدتان للتفضيل الحاصل
.....
تلك أهم الوضيعات فانظر فيها
فإنها مهمة
ولا تنس عارضها بدعوة
....
مختار ناجي.
....
الحال
.....
الحال من أكبر الدروس النحوية وأوسعها
إضافة لدرس التمييز
وسنقف في هذه الوقفة الخاطفة مع الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق
الحال لا بد أن تكون مشتقة
لكنها -ولاحظ أننا ننطق الحال مؤنثة- قد تأتي جامدة مؤولة بالمشتق
ومجيؤها على ذلك لا يؤدي لأي ارتباك أو إشكال
إنما قد يقع الارتباك والإشكال في حال مجيئها جامدة غير مؤولة
لكن هذا الإشكال يتلاشى بحصر المسألة على النحو التالي.
تجيئ الحال جامدة غير مؤولة في سبع وضعيات:
ـ أن تكون جزءا من صاحبها أو متكونة منه أو فرعا لها
تقول:
هذا بيتك غرفا
فالغرف فرع عن البيت إذ فيه المجالس والصالات والأبهاء
ومنه قول الله:
(وتنحتون من الجبال بيوتا)
فبيوتا متكونة ومتفرعة من هذه الجبال
.....
أن تكون موصوفة
قال تعالى:
(فتمثل لها بشرا سريعا)
فبشر حال جامدة موصوفة كما تلاحظ
ومثلها قول الله أيضا:
"إنا أنزلناه قرآنا عربيا"
فقرآن حال جامدة موصوفة
....
أن تدل على تسعير:
تقول: اشتريت الثوب مترا بخمسة آلاف
فمترا حال جامدة لدلاتها على التسعير
.....
أن تدل على عدد
تقول:
تمت عدد أيام تأليفي للكتاب تسعين يوما
فتسعين حال جامدة
ومنها قول الله:
(فتم ميقات ربه أربعين ليلة)
......
أن تكون أصلا لصاحبها
تقول:
هذا جسمك طينا
ومن قول الله حكاية عن إبليس:
( أأسجد لمن خلقت طينا)
ومعلوم أن أصل الإنسان طين
....
أن تدل على أحوال تفضيلية
تقول:
كلامُك شعرا أفضل منه رواية
فشعر ورواية حالان جامدتان للتفضيل الحاصل
.....
تلك أهم الوضيعات فانظر فيها
فإنها مهمة
ولا تنس عارضها بدعوة
....
مختار ناجي.
مع النحو
....
أقسام الحال
.....
تقول:
جاء خالد راكبا
وتقول:
تبسم خالد ضاحكا
فما الفرق بين الحالين:
راكبا
ضاحكا؟!
إذا لاحظت الجملة الأولى فستجد أن الحال فيها ذُكرت للتوضيح والبيان
أي توضيح الكيفية التي جاء بها خالد وهو وكونه راكبا
وهذه الحال تسمى بالحال المؤسسة أي الأصلية وهي الأكثر ورودا بطبيعة الحال
....
وبملاحظة الحال الثانية تجد أنها جاءت للتوكيد فالضحك هو ذاته الابتسام لكن الضحك أقوى
وهذه الحال تسمى الحال المؤكدة وهي على ثلاثة أنواع:
١ـ حال مؤكدة لعاملها وهي تلك التي تطابق عاملها معنى فقط أو معنى ولفظا
فمعنى كقول الله:
"ولا تعثوا في الأرض مفسدين"
والفساد يعني العثو
وكذلك قول الله:
"فتبسم ضاحكا من قولها"
والضحك يعني الابتسام وزيادة
.....
أما لفظا فكقول الله:
"وأرسلناك للناس رسولا"
فرسولا طابق أرسلناك لفظا ومعنى
.....
٢ـ حال مؤكدة لصاحبها
كقولك:
نجح التلاميذ جميعا
وكقول الله:
"إلي مرجعكم جميعا"
.....
٣ـ حال مؤكدة لمضمون جملة مؤلفة من اسمين معرفتين جامدين
تقول:
هو الإسلام منتصرا
هو البدر ساطعا
....
وكقول الشاعر:
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي
وهل بدارة يا للناس من عار؟
....
مختار ناجي.
....
أقسام الحال
.....
تقول:
جاء خالد راكبا
وتقول:
تبسم خالد ضاحكا
فما الفرق بين الحالين:
راكبا
ضاحكا؟!
إذا لاحظت الجملة الأولى فستجد أن الحال فيها ذُكرت للتوضيح والبيان
أي توضيح الكيفية التي جاء بها خالد وهو وكونه راكبا
وهذه الحال تسمى بالحال المؤسسة أي الأصلية وهي الأكثر ورودا بطبيعة الحال
....
وبملاحظة الحال الثانية تجد أنها جاءت للتوكيد فالضحك هو ذاته الابتسام لكن الضحك أقوى
وهذه الحال تسمى الحال المؤكدة وهي على ثلاثة أنواع:
١ـ حال مؤكدة لعاملها وهي تلك التي تطابق عاملها معنى فقط أو معنى ولفظا
فمعنى كقول الله:
"ولا تعثوا في الأرض مفسدين"
والفساد يعني العثو
وكذلك قول الله:
"فتبسم ضاحكا من قولها"
والضحك يعني الابتسام وزيادة
.....
أما لفظا فكقول الله:
"وأرسلناك للناس رسولا"
فرسولا طابق أرسلناك لفظا ومعنى
.....
٢ـ حال مؤكدة لصاحبها
كقولك:
نجح التلاميذ جميعا
وكقول الله:
"إلي مرجعكم جميعا"
.....
٣ـ حال مؤكدة لمضمون جملة مؤلفة من اسمين معرفتين جامدين
تقول:
هو الإسلام منتصرا
هو البدر ساطعا
....
وكقول الشاعر:
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي
وهل بدارة يا للناس من عار؟
....
مختار ناجي.
#الضعف_الإملائي عند طلبة المدارس والجامعات.
==========
إنّ مشكلة الضعف الإملائي مشكلة لطالما أقلقت المعلمين وأولياء الأمور وطبقة كبيرة من المثقفين، وما أسباب هذا القلق إلا لمعرفتهم بأهمية الإملاء.
إن للإملاء منزلة كبيرة فهو من الأسس الهامة للتعبير الكتابي والضعف الإملائي يشوه الكتابة ويعيق الفهم.
كما أن الأخطاء الإملائية تدعو إلى احتقار الكاتب وازدرائه ولم يسلم كثير من المثقفين وأصحاب الشهادات العليا من الضعف الإملائي الذي أصبح يشكل لهم حرجاً كبيراً عند كتاباتهم.
ولقد علمت مؤخراً أن بعضهم يتجنب كتابة الكلمات التي فيها همزة متوسطة أو متطرفة ويبحث فـي قاموسه عن كلمات رديفة تؤدي نفس المعنى ولكن دون همزات!!
إن الكتابة الصحيحة عامل مهم فـي التعليم وعنصر أساسي من عناصر الثقافة. ولذا كان لابد من علاج المشكلة.
ولطالما تمنيت أن يكون الضعف الإملائي من الأمراض التي يمكن علاجها بالأدوية والعقاقير!! ولكن هيهات إن علاج الضعف الإملائي يتطلب علاجاً من نوعٍ آخر يصاحبه حلم وصبر طويل.
أولاً: مظاهر الضعف الإملائي :
من تأمل كثيراً فـي مظاهر الضعف الإملائي فإنه يراها لا تخرج عن:
أ - الهمزات فـي وسط الكلمة:
مثل: 1- عباءة 2- فؤاد 3- مسألة 4- فجأة 5- تألمون. يكتبها بالشكل التالي: 1- عبائة 2- فوأد 3- مساءلة 4- فجئة 5- تاءلمون.
ب - الهمزات فـي آخر الكلمة:
مثل: 1- بيداء 2- تباطؤ 3- القارئ 4- امرؤ 5- ينبئ.
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- بيدأ 2- تباطوء 3- القاري 4- امروء 5- ينبيء
جـ - همزة الوصل والقطع:
مثل: 1- اختبار 2- اشتراك 3- التحق 4- استخرج 5- استقبال.
كلمات كلها بهمزات وصل يكتبها الطالب بهمزات قطع بالشكل التالي: 1- إختبار 2- إشتراك 3- إلتحق
4- إستخراج 5- إستقبال
أو كلمات بهمزة قطع مثل: إعراب، 2- أسماء، 3- أحمد، 4- إلمام 5- إزالة.يكتبها الطالب بهمزات قطع كالتالي: 1- اعراب 2- اسماء 3- احمد 4- المام 5- ازالة.
جـ - التاء المربوطة والتاء المفتوحة:
مثل الكلمات التالية: 1- كرة 2- نافذة 3- قضاة 4- سبورة 5- صلاة. هذه كلها كلمات تنتهي بتاء مربوطة يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1- كرت 2- نافذت 3- قضات
4- سبورت 5- صلات. أو كلمات تنتهي بتاء مفتوحة مثل: 1- مؤمنات 2- بيوت 3- أموات 4- علامات
5- صفات. يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1- مؤمناة 2- بيوة 3- أمواة 4-علاماة 5- صفاة
د - اللام الشمسية واللام القمرية:
مثل الكلمات التالية بلام شمسية: 1- الشمس 2- النهار 3- السمع 4- التاء 5- الرعاية. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- اشمس 2- انهار 3- اسمع 4- اتاء 5- ارعاية.
هـ - الحروف التي تنطق ولا تكتب:
مثل: 1- إله 2- لكن 3- أولئك 4- هذا 5- عبد الرحمن يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- إلاه 2- لاكن
3- أولائك 4- هاذا 5- عبدالرحمان.
و- الحروف التي تكتب ولا تنطق:
مثل الكلمات التالية: 1- عمرو (فـي حالتي الرفع والجر) 2- أكلوا 3- بذلوا 4- لن يهملوا 5- كتبوا. يكتبها الطالب بالشكل بالتالي: 1- عمر 2- أكلو 3- بذلو 4- لن يهملو 5- كتبو.
ز- الألف اللينة المتطرفة:
1- علا الصقر 2- دعا الشيخ لك 3- أعيا المرض صاحبه 4- عصا الأعمى طويلة 5- بكى. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- على الصقر 2- دعى الشيخ لك 3- أعيى المرض صاحبه 4- عصى 5- بكا.
حـ- الخلط بين الحروف المتشابهة رسماً أو صوتاً:
مثل كلمات بها حرف الظاء: 1- ظاهر 2- نظر 3- عظم
4- ظلام 5- ظلم. يكتبها الطالب بحرف الضاد بالشكل التالي: 1- ضاهر 2- نضر 3- عضم 4- ضلام 5- ضلم. أو كلمات بها حرف الضاد مثل: 1- مريض 2- عوض 3- رفض 4- محاضرة 5- بغضاء. يكتبها الطالب بحرف الظاء بالشكل التالي: 1- مريظ 2- عوظ 3- رفظ 4- محاظرة 5- بغظاء.
وهذا الخلط ناتج عن عدم إخراج الحرف من مخرجه بشكل صحيح.
فمخرج الضاد الصحيح هو: إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا، ومخرج الظاء الصحيح هو: طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. وهناك كلمات يخطئ فيها الطالب بسبب تشابه المخرج مثل:
1- صابر 2- استطلاع 3- غريق. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- سابر 2- اصتطلاع 3- قريق.
ط- الإشباع (قلب الحركات):
1- قلب الضمة واواً مثل: 1- أحبُ 2- نحنُ 3- لهُ
يكتبها الطالب: 10- أحبو 2- نحنو 3- لهو.
2- قلب الفتحة ألفاً مثل: 1- يلعبونَ 2- لن تندمَ 3- إن كتابَ
يكتبها الطالب: 1- يلعبونا 2- لن تندما 3- إن كتابا
3- قلب الكسرة ياء: مثل: 1- إليهِ 2- إلى الفصلِ 3- بالقلمِ.
يكتبها الطالب: 1- إليهي 2- إلى الفصلي 3- بالقلمي.
ثانياً أسباب الضعف الإملائي :
1- ضعف السمع والبصر وعدم الرعاية الصحية والنفسية.
2- عدم القدرة على التمييز بين الأصوات المتقاربة.
3- نسيان القاعدة الإملائية الضابطة.
4- الضعف فـي القراءة وعدم التدريب الكافـي عليها.
5- تدريس الإملاء على أنه طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ فـي كلمات صعبة بعيدة عن القاموس الكتابي للتلميذ.
==========
إنّ مشكلة الضعف الإملائي مشكلة لطالما أقلقت المعلمين وأولياء الأمور وطبقة كبيرة من المثقفين، وما أسباب هذا القلق إلا لمعرفتهم بأهمية الإملاء.
إن للإملاء منزلة كبيرة فهو من الأسس الهامة للتعبير الكتابي والضعف الإملائي يشوه الكتابة ويعيق الفهم.
كما أن الأخطاء الإملائية تدعو إلى احتقار الكاتب وازدرائه ولم يسلم كثير من المثقفين وأصحاب الشهادات العليا من الضعف الإملائي الذي أصبح يشكل لهم حرجاً كبيراً عند كتاباتهم.
ولقد علمت مؤخراً أن بعضهم يتجنب كتابة الكلمات التي فيها همزة متوسطة أو متطرفة ويبحث فـي قاموسه عن كلمات رديفة تؤدي نفس المعنى ولكن دون همزات!!
إن الكتابة الصحيحة عامل مهم فـي التعليم وعنصر أساسي من عناصر الثقافة. ولذا كان لابد من علاج المشكلة.
ولطالما تمنيت أن يكون الضعف الإملائي من الأمراض التي يمكن علاجها بالأدوية والعقاقير!! ولكن هيهات إن علاج الضعف الإملائي يتطلب علاجاً من نوعٍ آخر يصاحبه حلم وصبر طويل.
أولاً: مظاهر الضعف الإملائي :
من تأمل كثيراً فـي مظاهر الضعف الإملائي فإنه يراها لا تخرج عن:
أ - الهمزات فـي وسط الكلمة:
مثل: 1- عباءة 2- فؤاد 3- مسألة 4- فجأة 5- تألمون. يكتبها بالشكل التالي: 1- عبائة 2- فوأد 3- مساءلة 4- فجئة 5- تاءلمون.
ب - الهمزات فـي آخر الكلمة:
مثل: 1- بيداء 2- تباطؤ 3- القارئ 4- امرؤ 5- ينبئ.
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- بيدأ 2- تباطوء 3- القاري 4- امروء 5- ينبيء
جـ - همزة الوصل والقطع:
مثل: 1- اختبار 2- اشتراك 3- التحق 4- استخرج 5- استقبال.
كلمات كلها بهمزات وصل يكتبها الطالب بهمزات قطع بالشكل التالي: 1- إختبار 2- إشتراك 3- إلتحق
4- إستخراج 5- إستقبال
أو كلمات بهمزة قطع مثل: إعراب، 2- أسماء، 3- أحمد، 4- إلمام 5- إزالة.يكتبها الطالب بهمزات قطع كالتالي: 1- اعراب 2- اسماء 3- احمد 4- المام 5- ازالة.
جـ - التاء المربوطة والتاء المفتوحة:
مثل الكلمات التالية: 1- كرة 2- نافذة 3- قضاة 4- سبورة 5- صلاة. هذه كلها كلمات تنتهي بتاء مربوطة يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1- كرت 2- نافذت 3- قضات
4- سبورت 5- صلات. أو كلمات تنتهي بتاء مفتوحة مثل: 1- مؤمنات 2- بيوت 3- أموات 4- علامات
5- صفات. يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1- مؤمناة 2- بيوة 3- أمواة 4-علاماة 5- صفاة
د - اللام الشمسية واللام القمرية:
مثل الكلمات التالية بلام شمسية: 1- الشمس 2- النهار 3- السمع 4- التاء 5- الرعاية. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- اشمس 2- انهار 3- اسمع 4- اتاء 5- ارعاية.
هـ - الحروف التي تنطق ولا تكتب:
مثل: 1- إله 2- لكن 3- أولئك 4- هذا 5- عبد الرحمن يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- إلاه 2- لاكن
3- أولائك 4- هاذا 5- عبدالرحمان.
و- الحروف التي تكتب ولا تنطق:
مثل الكلمات التالية: 1- عمرو (فـي حالتي الرفع والجر) 2- أكلوا 3- بذلوا 4- لن يهملوا 5- كتبوا. يكتبها الطالب بالشكل بالتالي: 1- عمر 2- أكلو 3- بذلو 4- لن يهملو 5- كتبو.
ز- الألف اللينة المتطرفة:
1- علا الصقر 2- دعا الشيخ لك 3- أعيا المرض صاحبه 4- عصا الأعمى طويلة 5- بكى. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- على الصقر 2- دعى الشيخ لك 3- أعيى المرض صاحبه 4- عصى 5- بكا.
حـ- الخلط بين الحروف المتشابهة رسماً أو صوتاً:
مثل كلمات بها حرف الظاء: 1- ظاهر 2- نظر 3- عظم
4- ظلام 5- ظلم. يكتبها الطالب بحرف الضاد بالشكل التالي: 1- ضاهر 2- نضر 3- عضم 4- ضلام 5- ضلم. أو كلمات بها حرف الضاد مثل: 1- مريض 2- عوض 3- رفض 4- محاضرة 5- بغضاء. يكتبها الطالب بحرف الظاء بالشكل التالي: 1- مريظ 2- عوظ 3- رفظ 4- محاظرة 5- بغظاء.
وهذا الخلط ناتج عن عدم إخراج الحرف من مخرجه بشكل صحيح.
فمخرج الضاد الصحيح هو: إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا، ومخرج الظاء الصحيح هو: طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. وهناك كلمات يخطئ فيها الطالب بسبب تشابه المخرج مثل:
1- صابر 2- استطلاع 3- غريق. يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- سابر 2- اصتطلاع 3- قريق.
ط- الإشباع (قلب الحركات):
1- قلب الضمة واواً مثل: 1- أحبُ 2- نحنُ 3- لهُ
يكتبها الطالب: 10- أحبو 2- نحنو 3- لهو.
2- قلب الفتحة ألفاً مثل: 1- يلعبونَ 2- لن تندمَ 3- إن كتابَ
يكتبها الطالب: 1- يلعبونا 2- لن تندما 3- إن كتابا
3- قلب الكسرة ياء: مثل: 1- إليهِ 2- إلى الفصلِ 3- بالقلمِ.
يكتبها الطالب: 1- إليهي 2- إلى الفصلي 3- بالقلمي.
ثانياً أسباب الضعف الإملائي :
1- ضعف السمع والبصر وعدم الرعاية الصحية والنفسية.
2- عدم القدرة على التمييز بين الأصوات المتقاربة.
3- نسيان القاعدة الإملائية الضابطة.
4- الضعف فـي القراءة وعدم التدريب الكافـي عليها.
5- تدريس الإملاء على أنه طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ فـي كلمات صعبة بعيدة عن القاموس الكتابي للتلميذ.
6- عدم ربط الإملاء بفروع اللغة العربية.
7- إهمال أسس التهجي السليم الذي يعتمد على العين والأذن واليد.
8- عدم تصويب الأخطاء مباشرة.
9- التصحيح التقليدي لأخطاء التلاميذ وعدم مشاركة التلميذ فـي تصحيح الأخطاء.
10- استخدام اللهجات العامية فـي الإملاء.
11- السرعة فـي إملاء القطعة وعدم الوضوح وعدم النطق السليم للحروف والحركات.
12- قلة التدريبات المصاحبة لكل درس.
13- طول القطعة الإملائية مما يؤدي إلى التعب والوقوع فـي الخطأ الإملائي.
14- عدم الاهتمام بأخطاء التلاميذ الإملائية خارج كراسات الإملاء.
15- عدم التنويع فـي طرائق التدريس مما يؤدي إلى الملل والانصراف عن الدرس.
16- عدم إلمام بعض المعلمين بقواعد الإملاء إلماماً كافياً ولا سيماً فـي الهمزات والألف اللينة.
17- عدم استخدام الوسائل المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما بالبطاقات والسبورة الشخصية والشرائح الشفافة.
18- عوامل نفسية كالتردد والخوف من الوقوع فـي الخطأ.
19- كثرة أعداد الطلاب فـي الفصول.
ثالثاً أساليب علاج الضعف الإملائي :
1- أن يحسن المعلم اختيار القطع الإملائية بحيث تتناسب مع مستوى التلاميذ وتخدم أهدافاً متعددة: دينية وتربوية ولغوية.
2- كثرة التدريبات والتطبيقات المختلفة على المهارات المطلوبة.
3- أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة واضحة لا غموض فيها.
4- تكليف الطالب استخراج المهارات من المقروء.
5- تكليف التلاميذ بواجبات منزلية تتضمن مهارات مختلفة كأن يجمع التلميذ عشرين كلمة تنتهي بالتاء المربوطة وهكذا.
6- توافر قطعة فـي نهاية كل درس تشتمل على المهارات تدريجياً ويدرب من خلالها التلميذ فـي المدرسة والبيت.
7- الإكثار من الأمثلة المتشابهة للمهارة التي يتناولها المعلم فـي الحصة.
8- الاهتمام باستخدام السبورة فـي تفسير معاني الكلمات الجديدة وربط الإملاء بالمواد الدراسية الأخرى.
9- تدريب الأذن على حسن الإصغاء لمخارج الحروف.
10- تدريب اللسان على النطق الصحيح.
11- تدريب اليد المستمر على الكتابة.
12- تدريب العين على الرؤية الصحيحة للكلمة.
13- جمع الكلمات الصعبة التي يشكو منها كثير من التلاميذ وكتابتها ثم تعليقها على لوحات فـي طرقات وساحات المدرسة.
14- تخصيص دفاتر لضعاف التلاميذ تكون فـي معيتهم كل حصة.
15- معالجة ظاهرة ضعف القراءة عند التلاميذ وترغيب القراءة للطلاب بمختلف الوسائل.
16- عدم التهاون فـي عملية الصحيح.
17- أن يعتني المعلم بتدريب تلاميذه على أصوات الحروف ولا سيما الحروف المتقاربة فـي مخارجها الصوتية وفـي رسمها.
18- أن يستخدم المعلم فـي تصحيح الأخطاء الإملائية، الأساليب المناسبة وخير ما يحقق الغاية، مساعدة التلميذ على كشف خطئه وتعرف الصواب بجهده هو.
19- محاسبة التلاميذ على أخطائهم الإملائية فـي المواد الأخرى.
20- ألا يحرص المعلم على إملاء قطعة إملائية على تلاميذه فـي كل حصة، بل يجب عليه أن يخصص بعض الحصص للشرح والتوضيع والاكتفاء بكتابة كلمات مفردة حتى تثبت القاعدة الإملائية فـي أذهان التلاميذ.
21- أن يطلب المعلم من تلاميذه أن يستذكروا عدة أسطر ثم يختبرهم فـي إملائها فـي اليوم التالي مع الاهتمام بالمعنى والفهم معا.
22- تنويع طرق تدريس الإملاء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق الفردية.
23- الاهتمام بالوسائل المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما السبورة الشخصية والبطاقات والشرائح الشفافة.
24- تشجيع وتحفيز الطلاب الذين تحسنوا بمختلف أساليب التحفيز والتشجيع.
25- حصر القواعد الإملائية الشاذة والتدريب الكافـي عليها.
7- إهمال أسس التهجي السليم الذي يعتمد على العين والأذن واليد.
8- عدم تصويب الأخطاء مباشرة.
9- التصحيح التقليدي لأخطاء التلاميذ وعدم مشاركة التلميذ فـي تصحيح الأخطاء.
10- استخدام اللهجات العامية فـي الإملاء.
11- السرعة فـي إملاء القطعة وعدم الوضوح وعدم النطق السليم للحروف والحركات.
12- قلة التدريبات المصاحبة لكل درس.
13- طول القطعة الإملائية مما يؤدي إلى التعب والوقوع فـي الخطأ الإملائي.
14- عدم الاهتمام بأخطاء التلاميذ الإملائية خارج كراسات الإملاء.
15- عدم التنويع فـي طرائق التدريس مما يؤدي إلى الملل والانصراف عن الدرس.
16- عدم إلمام بعض المعلمين بقواعد الإملاء إلماماً كافياً ولا سيماً فـي الهمزات والألف اللينة.
17- عدم استخدام الوسائل المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما بالبطاقات والسبورة الشخصية والشرائح الشفافة.
18- عوامل نفسية كالتردد والخوف من الوقوع فـي الخطأ.
19- كثرة أعداد الطلاب فـي الفصول.
ثالثاً أساليب علاج الضعف الإملائي :
1- أن يحسن المعلم اختيار القطع الإملائية بحيث تتناسب مع مستوى التلاميذ وتخدم أهدافاً متعددة: دينية وتربوية ولغوية.
2- كثرة التدريبات والتطبيقات المختلفة على المهارات المطلوبة.
3- أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة واضحة لا غموض فيها.
4- تكليف الطالب استخراج المهارات من المقروء.
5- تكليف التلاميذ بواجبات منزلية تتضمن مهارات مختلفة كأن يجمع التلميذ عشرين كلمة تنتهي بالتاء المربوطة وهكذا.
6- توافر قطعة فـي نهاية كل درس تشتمل على المهارات تدريجياً ويدرب من خلالها التلميذ فـي المدرسة والبيت.
7- الإكثار من الأمثلة المتشابهة للمهارة التي يتناولها المعلم فـي الحصة.
8- الاهتمام باستخدام السبورة فـي تفسير معاني الكلمات الجديدة وربط الإملاء بالمواد الدراسية الأخرى.
9- تدريب الأذن على حسن الإصغاء لمخارج الحروف.
10- تدريب اللسان على النطق الصحيح.
11- تدريب اليد المستمر على الكتابة.
12- تدريب العين على الرؤية الصحيحة للكلمة.
13- جمع الكلمات الصعبة التي يشكو منها كثير من التلاميذ وكتابتها ثم تعليقها على لوحات فـي طرقات وساحات المدرسة.
14- تخصيص دفاتر لضعاف التلاميذ تكون فـي معيتهم كل حصة.
15- معالجة ظاهرة ضعف القراءة عند التلاميذ وترغيب القراءة للطلاب بمختلف الوسائل.
16- عدم التهاون فـي عملية الصحيح.
17- أن يعتني المعلم بتدريب تلاميذه على أصوات الحروف ولا سيما الحروف المتقاربة فـي مخارجها الصوتية وفـي رسمها.
18- أن يستخدم المعلم فـي تصحيح الأخطاء الإملائية، الأساليب المناسبة وخير ما يحقق الغاية، مساعدة التلميذ على كشف خطئه وتعرف الصواب بجهده هو.
19- محاسبة التلاميذ على أخطائهم الإملائية فـي المواد الأخرى.
20- ألا يحرص المعلم على إملاء قطعة إملائية على تلاميذه فـي كل حصة، بل يجب عليه أن يخصص بعض الحصص للشرح والتوضيع والاكتفاء بكتابة كلمات مفردة حتى تثبت القاعدة الإملائية فـي أذهان التلاميذ.
21- أن يطلب المعلم من تلاميذه أن يستذكروا عدة أسطر ثم يختبرهم فـي إملائها فـي اليوم التالي مع الاهتمام بالمعنى والفهم معا.
22- تنويع طرق تدريس الإملاء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق الفردية.
23- الاهتمام بالوسائل المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما السبورة الشخصية والبطاقات والشرائح الشفافة.
24- تشجيع وتحفيز الطلاب الذين تحسنوا بمختلف أساليب التحفيز والتشجيع.
25- حصر القواعد الإملائية الشاذة والتدريب الكافـي عليها.
.
قطوف من: #الخلاصة_في_علوم_البلاغة_لعلي_الشحود (1)
︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾
🔳 الفصاحةُ (1):
تعريفُها: لغةً: البيانُ والظهورُ، قال الله تعالى: {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي...}[القصص: 34]، أي أبينُ منِّي منطقاً وأظهرُ منَّي قولاً.
والفصاحةُ في اصطلاحِ أهل المعاني: عبارةٌ عن الألفاظِ البيِّنةِ الظاهرةِ، المتبادرةِ إلى الفهم، والمأنوسةِ الاستعمال بين الكتَّابِ والشّعراء لمكانِ حُسنها.
فالفصاحةُ تشملُ الكلمةَ، والكلامَ، والمتكلِّمَ، فيقالُ: كلمةٌ فصيحةٌ، وكلامٌ فصيحٌ، ومتكلمٌ فصيحٌ.
▪️ فصاحةُ الكلمةِ:
تكون الكلمةُ فصيحةً إذا كانت مألوفة َالاستعمال بين النابهينَ من الكتَّابِ والشعراء، لأنها لم تتداولْها ألسنتهُم ولم تجرِ بها أقلامُهم إلا لمكانتِها من الحُسن باستكمالها عناصر َالجودةِ، وصفاتِ الجمالِ.
▪️ شروطُ فصاحةِ الكلمة:
يجبُ أن تكون الكلمةُ سالمةً من عيوبٍ ثلاثةٍ:
- تنافرُ الحروفِ.
- الغرابة.ُ
- مخالفةُ الوضعِ.
▪️ تنافرُ الحروفِ:
فهو ثقلُ الكلمة عند وقعِها على السمعِ وصعوبةُ أدائها باللسانِ، نحو كالظشِّ (للموضع الخشن) ونحو: سَلِجَ (سَلِجَ اللُقْمة بالكسر، يَسْلَجُها سَلْجَاً وسَلَجاناً، أي بَلِعها)، وكالنقنقة (لصوتِ الضفادعِ)، ونحو: مستشزراتٌ (بمعنى مرتفعاتٍ)، من قول امرئ القيس يصف شَعر ابنة عمه:
غَدائِرُه مُسْتَشْزَرَاتٌ إِلى العُلاَ
تَضِلُّ العِقَاصُ في مُثَنىً ومُرْسَلِ
فقد وَصَفها بكَثْرة الشَّعرِ والْتِفَافِه.
▪️ الغرابةُ:
هي كونُ الكلمة غيرَ ظاهرةِ الدلالة على المعنى الموضوعِ له، وذلك لسببين:
أحدهُما - أنَّ الكلمة غيرُ متداولةٍ في لغة العربِ، فيحتاجُ لمعرفةِ معناها الرجوعُ إلى المعاجم والقواميس، مثالُ ذلك قولُ عيسى بن عمرو النَّحوي وقد سقطَ عن دابته فالتفَّ حوله الناسُ فقال:
ما لَكُمْ تَكَأْكَأْتُم عليَّ تكَأْكُؤَكُم على ذِي جِنَّةٍ؟ افْرَنْقِعُوا عنّي.
فكلمة ُ(تكاكأتم) وكلمة (افرنقعوا) غريبتان، أي مالكم اجتَمَعْتم تنَحُّوا عنِّي.
والثاني - عدمُ تداول الكلمة في لغة العربِ الشائعة، (كمسّرج)، من قول رؤبة بن العجاج:
ومقلةً وحاجباً مزججا
وفاحِماً ومَرْسِناً مُسَرَّجَا
فلا يعلمُ ما أرادَ بقوله: (مسرَّجا) حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه.
▪️ مخالفة ُالوضعِ:
هو كونُ الكلمة ِ مخالفةً لما ثبتَ معناهُ عند علماء اللغة مثل (الأجلل) في قول أبي النجم:
الحَمْدُ لِلّهِ العَلِيُّ الأَجْلَلِ
الواحد الفرد القديم الأوَّل
فإن القياس (الأجلِّ) بالإدغام، ولا مسوّغ لفكّه، فهو يريدُ الأَجَلّ وأظْهَر التضعيف ضَرورةً.
يتبـــــع...
┄┉❈❖❀✺❀❖❈┉┄
من مختارات:
سلطان نعمان البركاني
قطوف من: #الخلاصة_في_علوم_البلاغة_لعلي_الشحود (1)
︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾
🔳 الفصاحةُ (1):
تعريفُها: لغةً: البيانُ والظهورُ، قال الله تعالى: {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي...}[القصص: 34]، أي أبينُ منِّي منطقاً وأظهرُ منَّي قولاً.
والفصاحةُ في اصطلاحِ أهل المعاني: عبارةٌ عن الألفاظِ البيِّنةِ الظاهرةِ، المتبادرةِ إلى الفهم، والمأنوسةِ الاستعمال بين الكتَّابِ والشّعراء لمكانِ حُسنها.
فالفصاحةُ تشملُ الكلمةَ، والكلامَ، والمتكلِّمَ، فيقالُ: كلمةٌ فصيحةٌ، وكلامٌ فصيحٌ، ومتكلمٌ فصيحٌ.
▪️ فصاحةُ الكلمةِ:
تكون الكلمةُ فصيحةً إذا كانت مألوفة َالاستعمال بين النابهينَ من الكتَّابِ والشعراء، لأنها لم تتداولْها ألسنتهُم ولم تجرِ بها أقلامُهم إلا لمكانتِها من الحُسن باستكمالها عناصر َالجودةِ، وصفاتِ الجمالِ.
▪️ شروطُ فصاحةِ الكلمة:
يجبُ أن تكون الكلمةُ سالمةً من عيوبٍ ثلاثةٍ:
- تنافرُ الحروفِ.
- الغرابة.ُ
- مخالفةُ الوضعِ.
▪️ تنافرُ الحروفِ:
فهو ثقلُ الكلمة عند وقعِها على السمعِ وصعوبةُ أدائها باللسانِ، نحو كالظشِّ (للموضع الخشن) ونحو: سَلِجَ (سَلِجَ اللُقْمة بالكسر، يَسْلَجُها سَلْجَاً وسَلَجاناً، أي بَلِعها)، وكالنقنقة (لصوتِ الضفادعِ)، ونحو: مستشزراتٌ (بمعنى مرتفعاتٍ)، من قول امرئ القيس يصف شَعر ابنة عمه:
غَدائِرُه مُسْتَشْزَرَاتٌ إِلى العُلاَ
تَضِلُّ العِقَاصُ في مُثَنىً ومُرْسَلِ
فقد وَصَفها بكَثْرة الشَّعرِ والْتِفَافِه.
▪️ الغرابةُ:
هي كونُ الكلمة غيرَ ظاهرةِ الدلالة على المعنى الموضوعِ له، وذلك لسببين:
أحدهُما - أنَّ الكلمة غيرُ متداولةٍ في لغة العربِ، فيحتاجُ لمعرفةِ معناها الرجوعُ إلى المعاجم والقواميس، مثالُ ذلك قولُ عيسى بن عمرو النَّحوي وقد سقطَ عن دابته فالتفَّ حوله الناسُ فقال:
ما لَكُمْ تَكَأْكَأْتُم عليَّ تكَأْكُؤَكُم على ذِي جِنَّةٍ؟ افْرَنْقِعُوا عنّي.
فكلمة ُ(تكاكأتم) وكلمة (افرنقعوا) غريبتان، أي مالكم اجتَمَعْتم تنَحُّوا عنِّي.
والثاني - عدمُ تداول الكلمة في لغة العربِ الشائعة، (كمسّرج)، من قول رؤبة بن العجاج:
ومقلةً وحاجباً مزججا
وفاحِماً ومَرْسِناً مُسَرَّجَا
فلا يعلمُ ما أرادَ بقوله: (مسرَّجا) حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه.
▪️ مخالفة ُالوضعِ:
هو كونُ الكلمة ِ مخالفةً لما ثبتَ معناهُ عند علماء اللغة مثل (الأجلل) في قول أبي النجم:
الحَمْدُ لِلّهِ العَلِيُّ الأَجْلَلِ
الواحد الفرد القديم الأوَّل
فإن القياس (الأجلِّ) بالإدغام، ولا مسوّغ لفكّه، فهو يريدُ الأَجَلّ وأظْهَر التضعيف ضَرورةً.
يتبـــــع...
┄┉❈❖❀✺❀❖❈┉┄
من مختارات:
سلطان نعمان البركاني
*🔸| من أجمل الألغاز التي تُروى عن العرب في الجاهلية قبل الإسلام*
ما جاء في " ديوان امرئ القيس بن حُجر الكِنديّ " أن عبيد بن الأبرص لقي امرء القيس فقال له : " كيف معرفتك بالأوابد؟" فقال امرؤ القيس : " قل ما شئت تجدني كما أحببت "
*فقال عبيد بن الأبرص مُلغزاً :*
ماحيّةٌ ميتةٌ قامت بميِتتِها
درداءُ ما أنبتتْ سناً وأضراسا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك الشعيرةُ تُسقى في سنابلها
قد أخرجتْ بعد طول المُكث أكداسا
*فقال عبيد :*
ماالسُّودُ والبيضُ والأسماءُ واحدةٌ
لايستطيعُ لهُنّ النّاسُ تَمسَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك السحابُ إذا الرّحمنُ أرسلها
روى بها من مُحول الأرضِ أيْبَاسَا
*فقال عبيد :*
ما مُرتجاتٌ على هَولٍ مراكِبُها
يقطعنَ طولَ المدى سَيراً وَإمرَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ النّجُومُ إذا حانَتْ مَطالِعُهَا
شبّهتُهَا في سَوَادِ اللّيلِ أقبَاسَا
*قال عبيد بن الأبرص :*
ما القَاطِعاتُ لأرضٍ لا أنيس بها
تأتي سِراعاً وماتَرجِعنَ أنْكاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك الرّياحُ إذا هَبّتْ عَوَاصِفُها
كفى بأذيالهَا للتُّربِ كنّاسَا
*فقال عبيد :*
ما الفَاجِعاتُ جَهَاراً في عَلانِيَةٍ
أشدُّ من فَيْلَقٍ مَملُوءةٍ بَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ المَنايَا فَمَا يُبقِينَ مِنْ أحدٍ
يكفِتنَ حمقَى ومايُبقينَ أكيَاسَا
*فقال عبيد :*
مَا السّابِقَاتُ سِرَاعَ الطَّيرِ في مَهَلٍ
لا تستَكينُ وَلَو ألجَمتَها فَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الجِيادُعليَها القَومُ قد سبحوا
كانوا لهُنّ غَدَاةَ الرَّوْعِ أحلاسَا
*فقال عبيد :*
مَا القَاطِعَاتُ لأرْضِ الجَوّ في طَلَقٍ
قبل الصّباحِ وَما يَسرِينَ قِرْطَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الأمَانيُّ يَترُكنَ الفَتى مَلِكاً
دونَ السّمَاءِ وَلم تَرْفَعْ لَه رَاسَا
*فقال عبيد :*
مَا الحاكمُونَ بلا سَمْعٍ وَلا بَصَرٍ
ولا لِسَانٍ فَصِيحٍ يُعْجِبُ النّاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الموَازِينُ وَالرّحْمَنُ أنْزَلهَا
ربُّ البَرِيّةِ بَينَ النّاسِ مِقيَاسَا
*هذه هي الألغاز بين فحــول شعراء العرب وهذه هي لغتنا العربية العظيمة في احتوائها موسوعـــة من المفردات بين الترادف والتضاد والمحسنات البديعية في الشعر العربي*
ما جاء في " ديوان امرئ القيس بن حُجر الكِنديّ " أن عبيد بن الأبرص لقي امرء القيس فقال له : " كيف معرفتك بالأوابد؟" فقال امرؤ القيس : " قل ما شئت تجدني كما أحببت "
*فقال عبيد بن الأبرص مُلغزاً :*
ماحيّةٌ ميتةٌ قامت بميِتتِها
درداءُ ما أنبتتْ سناً وأضراسا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك الشعيرةُ تُسقى في سنابلها
قد أخرجتْ بعد طول المُكث أكداسا
*فقال عبيد :*
ماالسُّودُ والبيضُ والأسماءُ واحدةٌ
لايستطيعُ لهُنّ النّاسُ تَمسَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك السحابُ إذا الرّحمنُ أرسلها
روى بها من مُحول الأرضِ أيْبَاسَا
*فقال عبيد :*
ما مُرتجاتٌ على هَولٍ مراكِبُها
يقطعنَ طولَ المدى سَيراً وَإمرَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ النّجُومُ إذا حانَتْ مَطالِعُهَا
شبّهتُهَا في سَوَادِ اللّيلِ أقبَاسَا
*قال عبيد بن الأبرص :*
ما القَاطِعاتُ لأرضٍ لا أنيس بها
تأتي سِراعاً وماتَرجِعنَ أنْكاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تلك الرّياحُ إذا هَبّتْ عَوَاصِفُها
كفى بأذيالهَا للتُّربِ كنّاسَا
*فقال عبيد :*
ما الفَاجِعاتُ جَهَاراً في عَلانِيَةٍ
أشدُّ من فَيْلَقٍ مَملُوءةٍ بَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ المَنايَا فَمَا يُبقِينَ مِنْ أحدٍ
يكفِتنَ حمقَى ومايُبقينَ أكيَاسَا
*فقال عبيد :*
مَا السّابِقَاتُ سِرَاعَ الطَّيرِ في مَهَلٍ
لا تستَكينُ وَلَو ألجَمتَها فَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الجِيادُعليَها القَومُ قد سبحوا
كانوا لهُنّ غَدَاةَ الرَّوْعِ أحلاسَا
*فقال عبيد :*
مَا القَاطِعَاتُ لأرْضِ الجَوّ في طَلَقٍ
قبل الصّباحِ وَما يَسرِينَ قِرْطَاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الأمَانيُّ يَترُكنَ الفَتى مَلِكاً
دونَ السّمَاءِ وَلم تَرْفَعْ لَه رَاسَا
*فقال عبيد :*
مَا الحاكمُونَ بلا سَمْعٍ وَلا بَصَرٍ
ولا لِسَانٍ فَصِيحٍ يُعْجِبُ النّاسَا
*فقال امرؤ القيس :*
تِلكَ الموَازِينُ وَالرّحْمَنُ أنْزَلهَا
ربُّ البَرِيّةِ بَينَ النّاسِ مِقيَاسَا
*هذه هي الألغاز بين فحــول شعراء العرب وهذه هي لغتنا العربية العظيمة في احتوائها موسوعـــة من المفردات بين الترادف والتضاد والمحسنات البديعية في الشعر العربي*
سمّي العيد عيدًا لأنّه يعود كلّ عامٍ بفرحٍ مجدّد.
- ابن الأعرابي.
كلّ عامٍ وأنتم وأهلوكم بألف خيرٍ يا أصدقاء ❤️
- ابن الأعرابي.
كلّ عامٍ وأنتم وأهلوكم بألف خيرٍ يا أصدقاء ❤️
قالت العرب: "إياكَ وَأنْ يَضْرِبَ لِسَانُكَ عُنُقَكَ".
أي: إياك أن تَلفِظَ بما فيه هلاكك، ونُسِبَ الضربُ إلى اللسان لأنه السبب.
أي: إياك أن تَلفِظَ بما فيه هلاكك، ونُسِبَ الضربُ إلى اللسان لأنه السبب.
مجددًا وبناء على طلب الإخوة والأخوات المهتمين بالشأن اللغوي، أعيد نشر هذه المادة من كتابي (اللغة العربية ومهاراتها في ضوء المناهج والنماذج)، متمنيًّا التوفيق لأبنائنا وبناتنا الذين يختبرون حاليًّا:
الأخطاء الإملائيَّة الشَّائعة
......
كتابات معظم المُتعلِّمين ـ بل كذلك كتابات كثيرٍ من المُعلِّمين ـ اليوم، لا تخلو من الأخطاء الإملائيَّة، على الرّغم من وجود برامج التدقيق الإملائي؛ وذلك أنَّ عقل الإنسان هو الذي يحدِّد صيغ مدخلات الآلة.
ومن خلال استقصاء المؤلِّف وملاحظاته، فقد رأى أنَّ الأخطاء الإملائيَّة الأكثر شيوعًا هي التالية:
أولًا: أخطاء كتابة التاء المربوطة هاء والعكس:
ومن ذلك كتابة الكلمات: الله، وجه، تنويه، تنبيه، به، عليه، منه، إليه، بتاءٍ مربوطة، أي: اللة، وجة، تنوية، تنبية، بة، علية، منة، إلية.
وفي المقابل كتابة الكلمات: (فاطمة، خديجة، سميَّة، مدرسة، جامعة، مدينة، قرية)، بالهاء، أي: (فاطمه، خديجه، سميَّه، مدرسه، جامعه، مدينه، قريه).
والسبب في مثل هذه الأخطاء هو عدم معرفة أساليب التفريق بين التاء المربوطة والهاء صوتيًا وصرفيًا، فالتَّفريق بينهما صوتيًا يكون بوصل الكلمة بكلمة افتراضية بعدها.
فمثلًا: لفظ الجلالة (الله) لو قلنا: اللهُ أكبر، فإننا ننطق الهاء المضمومة في لفظ الجلالة بصورة واضحة، ولا تظهر تاء في اللسان، أي سيكون النطق صوتيًّا (اللهو أكبر)، لكن مع عدم اعتماد هذا النطق الصوتي في الكتابة، بل نكتب: اللهُ، دون وضع نقطتين فوق الهاء.
لكن كلمة (فاطمة) لو وصلناها بكلمة افتراضيَّةٍ بعدها فإن التّاء ستظهر في نحو قولنا: فاطمةُ بنت محمد، أي عدم وجود هاء في نطق الكلمة هنا، فسنقول: فاطمتو، نطقًا صوتيًّا، لكن نكتبها: فاطمة، بتاء مربوطة، أي نضع فوق التاء نقطتين.
والتفريق بينها صرفيًا أو تركيبيًا يكون إما بالتثنية او الجمع، ومثال ذلك أن كلمة وجه مثناها وجهان وجمعها وجوه، بينما كلمة جامعة مثناها جامعتان وجمعها جامعات، ونلاحظ من خلال ذلك أن الهاء والتاء تظهران لدى تثنية الكلمة أو جمعها.
كذلك بقي أن نشير إلى الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وهو أن التاء المربوطة لدى الوقف عليها تنطق هاء (وعلينا ألَّا ننسى أنها تكتب تاء)، بينما التاء المفتوحة تنطق لدى الوقف عليها تاء أيضًا، نحو: بيت، زيت، قوت، حوت.
ثانيًا: أخطاء كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة:
وهذه الأخطاء تتعلَّق بكتابة الألف الليِّنة، وسبب الوقوع فيها عدم معرفة أصل الكلمة، ومن ذلك مثلًا: كتابة كلمات (أفعال) من قبيل: دعا، رجا، عفا، بالصورة: دعى، رجى، عفى، وبالمقابل كتابة الكلمات: قضى، رمى، سعى، بالصورة: قضا، رما، سعا.
فالقاعدة هنا تقول: إنه إذا كان أصل الألف في الكلمة هو الواو كُتبت ممدودة، وإذا كان أصلها الياء كُتبت مقصورة.
ولمعرفة الأصل نأتي بالفعل المضارع أو المصدر، فمثلًا: الكلمة (عفا) مضارعها يعفو ومصدرها العفو، والكلمة (رمى) مضارعها يرمي ومصدرها الرَّمي.
وقس على ذلك ـ مثلًا ـ دنا، وبدا، وحلا، مِن: يدنو ويبدو ويحلو، وجنى، وهمى، وجرى، مِن: يجني ويهمي ويجري...
وإذا تعددت مصادر الفعل/ الكلمة، فإنَّ كُلًّا من الأفعال/ الكلمات موضع الإشكال يُكتَب بحسب الأصل الَّذي يدلُّ عليه السياق؛ فمثلًا: كلمة (غلا ـ غلى)، إن كانت من غلاء الأسعار أو ارتفاع القيمة أو من التطرف والتشدد والغلو في الدِّين، كُتبت (غلا)؛ لأنها من (يغلو)، وإن كانت من الغليان كُتبت (غلى)؛ لأنها من (يغلي).
وبالنِّسبة إلى الأسماء الأعجميَّة المنتهية بألف ليِّنة، فقد قال العلماء إنها تكتب بالمدودة، نحو: إيليا، زكريا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واستثنوا من ذلك خمسة أسماء، هي: موسى، وعيسى، وكسرى، وبخارى، ومتَّى، وأضافت بعض المجامع اللُّغويَّة الحديثة: بُصرى، وبَرَدى، وسقطرى، ونينوى، وديالى، وكمَّثرى.
وبالنِّسبة إلى الحروف فالألف المتطرِّفة في الحروف كلها ممدودة، ما عدا: إلى، على، حتَّى، بلى.
ثالثًا: أخطاء كتابة الهمزة:
1ـ الهمزة الابتدائيَّة:
والمقصود بالهمزة الابتدائيَّة أو الأوليَّة: همزة الوصل، وهمزة القطع.
ومن أخطاء كتابتهما كتابة الكلمات، من نحو: إبراهيم، إسماعيل، أسامة، أكرم، أحمد، إتقان، إجهاد،،، بالشكل الآتي: ابراهيم، اسماعيل، اسامة، اكرم، احمد، اتقان، اجهاد،،، وفي المقابل كتابة الكلمات: اقرأ، انتصار، انطلاق، اختبار، استغفار، استخراج، استنباط،،، بالشكل الآتي: إقرأ، إنتصار، إنطلاق، إختبار، إستغفار، إستخراج، إستنباط...
ويعود السبب في مثل هذه الأخطاء إلى عدم معرفة قواعد كتابة الهمزة الابتدائية التي في أول الكلمة، تلك التي نطبق عليها قواعد همزتي الوصل والقطع، حيث إن الأسماء كلها همزاتها همزات قطع ما عدا سبعة أسماء (وزاد بعضهم عليها أسماء أخرى أقلّ استعمالًا ـ هي: ابنم، ايم وايمن الله، است ـ ليوصلها إلى عشرة).
الأخطاء الإملائيَّة الشَّائعة
......
كتابات معظم المُتعلِّمين ـ بل كذلك كتابات كثيرٍ من المُعلِّمين ـ اليوم، لا تخلو من الأخطاء الإملائيَّة، على الرّغم من وجود برامج التدقيق الإملائي؛ وذلك أنَّ عقل الإنسان هو الذي يحدِّد صيغ مدخلات الآلة.
ومن خلال استقصاء المؤلِّف وملاحظاته، فقد رأى أنَّ الأخطاء الإملائيَّة الأكثر شيوعًا هي التالية:
أولًا: أخطاء كتابة التاء المربوطة هاء والعكس:
ومن ذلك كتابة الكلمات: الله، وجه، تنويه، تنبيه، به، عليه، منه، إليه، بتاءٍ مربوطة، أي: اللة، وجة، تنوية، تنبية، بة، علية، منة، إلية.
وفي المقابل كتابة الكلمات: (فاطمة، خديجة، سميَّة، مدرسة، جامعة، مدينة، قرية)، بالهاء، أي: (فاطمه، خديجه، سميَّه، مدرسه، جامعه، مدينه، قريه).
والسبب في مثل هذه الأخطاء هو عدم معرفة أساليب التفريق بين التاء المربوطة والهاء صوتيًا وصرفيًا، فالتَّفريق بينهما صوتيًا يكون بوصل الكلمة بكلمة افتراضية بعدها.
فمثلًا: لفظ الجلالة (الله) لو قلنا: اللهُ أكبر، فإننا ننطق الهاء المضمومة في لفظ الجلالة بصورة واضحة، ولا تظهر تاء في اللسان، أي سيكون النطق صوتيًّا (اللهو أكبر)، لكن مع عدم اعتماد هذا النطق الصوتي في الكتابة، بل نكتب: اللهُ، دون وضع نقطتين فوق الهاء.
لكن كلمة (فاطمة) لو وصلناها بكلمة افتراضيَّةٍ بعدها فإن التّاء ستظهر في نحو قولنا: فاطمةُ بنت محمد، أي عدم وجود هاء في نطق الكلمة هنا، فسنقول: فاطمتو، نطقًا صوتيًّا، لكن نكتبها: فاطمة، بتاء مربوطة، أي نضع فوق التاء نقطتين.
والتفريق بينها صرفيًا أو تركيبيًا يكون إما بالتثنية او الجمع، ومثال ذلك أن كلمة وجه مثناها وجهان وجمعها وجوه، بينما كلمة جامعة مثناها جامعتان وجمعها جامعات، ونلاحظ من خلال ذلك أن الهاء والتاء تظهران لدى تثنية الكلمة أو جمعها.
كذلك بقي أن نشير إلى الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وهو أن التاء المربوطة لدى الوقف عليها تنطق هاء (وعلينا ألَّا ننسى أنها تكتب تاء)، بينما التاء المفتوحة تنطق لدى الوقف عليها تاء أيضًا، نحو: بيت، زيت، قوت، حوت.
ثانيًا: أخطاء كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة:
وهذه الأخطاء تتعلَّق بكتابة الألف الليِّنة، وسبب الوقوع فيها عدم معرفة أصل الكلمة، ومن ذلك مثلًا: كتابة كلمات (أفعال) من قبيل: دعا، رجا، عفا، بالصورة: دعى، رجى، عفى، وبالمقابل كتابة الكلمات: قضى، رمى، سعى، بالصورة: قضا، رما، سعا.
فالقاعدة هنا تقول: إنه إذا كان أصل الألف في الكلمة هو الواو كُتبت ممدودة، وإذا كان أصلها الياء كُتبت مقصورة.
ولمعرفة الأصل نأتي بالفعل المضارع أو المصدر، فمثلًا: الكلمة (عفا) مضارعها يعفو ومصدرها العفو، والكلمة (رمى) مضارعها يرمي ومصدرها الرَّمي.
وقس على ذلك ـ مثلًا ـ دنا، وبدا، وحلا، مِن: يدنو ويبدو ويحلو، وجنى، وهمى، وجرى، مِن: يجني ويهمي ويجري...
وإذا تعددت مصادر الفعل/ الكلمة، فإنَّ كُلًّا من الأفعال/ الكلمات موضع الإشكال يُكتَب بحسب الأصل الَّذي يدلُّ عليه السياق؛ فمثلًا: كلمة (غلا ـ غلى)، إن كانت من غلاء الأسعار أو ارتفاع القيمة أو من التطرف والتشدد والغلو في الدِّين، كُتبت (غلا)؛ لأنها من (يغلو)، وإن كانت من الغليان كُتبت (غلى)؛ لأنها من (يغلي).
وبالنِّسبة إلى الأسماء الأعجميَّة المنتهية بألف ليِّنة، فقد قال العلماء إنها تكتب بالمدودة، نحو: إيليا، زكريا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واستثنوا من ذلك خمسة أسماء، هي: موسى، وعيسى، وكسرى، وبخارى، ومتَّى، وأضافت بعض المجامع اللُّغويَّة الحديثة: بُصرى، وبَرَدى، وسقطرى، ونينوى، وديالى، وكمَّثرى.
وبالنِّسبة إلى الحروف فالألف المتطرِّفة في الحروف كلها ممدودة، ما عدا: إلى، على، حتَّى، بلى.
ثالثًا: أخطاء كتابة الهمزة:
1ـ الهمزة الابتدائيَّة:
والمقصود بالهمزة الابتدائيَّة أو الأوليَّة: همزة الوصل، وهمزة القطع.
ومن أخطاء كتابتهما كتابة الكلمات، من نحو: إبراهيم، إسماعيل، أسامة، أكرم، أحمد، إتقان، إجهاد،،، بالشكل الآتي: ابراهيم، اسماعيل، اسامة، اكرم، احمد، اتقان، اجهاد،،، وفي المقابل كتابة الكلمات: اقرأ، انتصار، انطلاق، اختبار، استغفار، استخراج، استنباط،،، بالشكل الآتي: إقرأ، إنتصار، إنطلاق، إختبار، إستغفار، إستخراج، إستنباط...
ويعود السبب في مثل هذه الأخطاء إلى عدم معرفة قواعد كتابة الهمزة الابتدائية التي في أول الكلمة، تلك التي نطبق عليها قواعد همزتي الوصل والقطع، حيث إن الأسماء كلها همزاتها همزات قطع ما عدا سبعة أسماء (وزاد بعضهم عليها أسماء أخرى أقلّ استعمالًا ـ هي: ابنم، ايم وايمن الله، است ـ ليوصلها إلى عشرة).
والأسماء التي همزاتها همزات وصل هي: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، وما يثنى من هذه الأسماء، فهمزته تكون همزة وصلٍ أيضًا، نحو: اسمان/ اسمين، ابنان/ ابنين، ابنتان/ ابنتين، اثنان/ اثنين، اثنتان/ اثنتين، امرأتان/ امرأتين... لكن في حالة الجمع تصبح همزاتها همزات قطع، نحو: أسماء، أبناء.
وأما بالنِّسبة إلى الأفعال فالأفعال الرُّباعية ومصادرها همزاتها همزات قطع مثل: أكرم إكرامًا، أنقذ إنقاذًا، أنعم إنعامًا، أوجد إيجادًا، والمصارع المتحدث عن نسه همزته همزة قطع في جميع الأحوال، نحو: أُكرِمُ، أَنطلقُ، أَستغفرُ؛ والأفعال الخماسية والسداسية ومصادرها همزاتها همزات وصل، نحو: اختبر اختبارًا، انطلق انطلاقًا، اجتهد اجتهادًا (خماسية)، ونحو: استغفر استغفارًا، استخرج استخراجًا، استنبط استنباطًا (سداسية).
وبالنِّسبة إلى الحروف، فالحروف كلها همزاتها همزات قطع، ما عدا (أل) التعريف، حيث إذا دخلت على الاسم لا نكتب همزتها، وأما كتابتها هنا بين قوسين بالهمزة فخاص بحال الحديث عنها اصطلاحًا. وعلى هذا نكتب الحروف كلها بهمزات سواء فوقها أو تحتها، فمن ذلك: إلى (حرف جر)، أيا (حرف نداء)، أو (حرف عطف)، إنَّ (حرف توكيد ونسخ)، وأما مثال (أل) التعريف حال دخولها على اسم فخذ هذه الأمثلة وقس عليها: الجامعة ـ المدرسة ـ البيت ـ الشارع ـ الملعب ـ المسجد... فلا تكتب: ألجامعة ـ ألمدرسة ـ ألبيت ـ ألشارع ـ ألملعب ـ ألمسجد...
وهنالك طريقة لتسهيل التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع وهي أن نضع حرف عطف قبل الكلمة فإذا نطقناها باتصال حرف العطف بما بعد الهمزة وسقطت الهمزة نطقًا فإنها همزة وصل، مثال ذلك أن نضع حرف الواو او الفاء قبل كلمة: انتصر أو كلمة استغفر سنقول: وانتصر فانتصر، واستغفر فاستغفر، بِوَصلٍ صوتيٍّ ما بين حرف العطف والنُّون في: انتصر، وكذلك ما بين حرف العطف والسين في استغفر، فكأننا نقول: وَنْتصر، فَنْتصر، وَسْتغفر، فسْتغفر، لكننا لا نكتب بهذه الطريقة كما هو بّيِّن.
وإذا لم يستقم النطق في اللسان إلا بظهور الهمزة، فإنها همزة قطع، ومثال ذلك: أحمد، إذا قلنا وأحمد أو فأحمد فإن الهمزة تظهر في النطق، ومثل ذلك الحرف: إلى، إذا سبقته واو أو فاء نقول: وإلى، فإلى، ولا تسقط الهمزة في النطق فهي همزة قطع.
وعليه، فإنَّ همزة الوصل هي الهمزة التي تُنطَق ولا تُكتَب، وهمزة القطع هي الهزة التي تُنطَق وتُكتَب.
ولعلَّ من الجدير الإشارة ـ بعد هذا ـ إلى أنَّه إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، حذفنا همزة الوصل، فمثلًا إذا أردت سؤال (جميل) عن اسمه لتتأكد ما إذا كان هو؟ فستقول: أسْمُكَ جميل؟ وإذن فقد حذفتَ همزة الوصل لدخول همزة الاستفهام عليها.
2ـ الهمزة المتوسّطة:
وهي الهمزة التي تكون في وسط الكلمة، ونطبّق عليها قاعدة أقوى الحركات، وأقوى الحركات هي الكسرة تليها الضمة ثم الفتحة وأخيرًا السكون، فإذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورًا كُتبت على نبرة نحو: بئر، رئيس، زئير، شئنا، وإذا كانت مضمومة أو كان ما قبها مضمومًا كُتبت على واو نحو: سؤال، فؤاد، رؤى، شؤون، وإذا كانت مفتوحة أو كان ما قبلها مفتوحًا كُتبت على ألف نحو: سأل، رأى، نأى، فأس، كأس.
ولا بُدَّ أن نشير ـ أيضًا ـ إلى أن ثمَّة خِلافًا في كتابة بعض الكلمات بهمزة متوسطة أو متطرفة، ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ كتابة: يقرؤون، ويبدؤون، هل تكتب هكذا على اعتبار أنَّ الهمزة هنا همزة متوسطة، أم تكتب: يقرأون، ويبدأون، على اعتبار أن الهمزة في الأصل هي همزة متطرفة؟.. فبعضهم أجاز كتابتها بالطَّريقتين، وبعضهم تعصَّبَ لإحداهما، والذي نراه هنا جواز كتابتها بالطَّريقتين، مع ترجيح معاملتها معاملة الهمزة المتوسطة.
3ـ الهمزة المتطرِّفة:
وهي الهمزة التي تكون في آخر الكلمة، وننظر فيها إلى حركة الحرف الذي يسبقها.
فإن كانت تلك الحركة هي الكسرة كُتبت الهمزة المتطرفة على نبرة، نحو: قارئ، قُرئ، أنبئ، يهيِّئ.
وإن كانت حركة الحرف الذي قبلها الضمة كُتبت على واوٍ، نحو: لؤلؤ، بؤبؤ، تنبؤ، تلكؤ.
وإن كانت حركة ما قبلها هي الفتحة كُتبت على ألف، نحو: نبأ، سبأ، ملأ، بَدَأَ، قَرَأَ.
وإن كانت حركة الحرف قبلها هي السُّكون كُتبت على السطر، نحو: شَيْء، بُطْء، دِفْء، عِبْء، بَدْء.
وإن كان قبلها مدٌّ كُتبت على السَّطر أيضًا، نحو: بناء، سماء، فضاء، قضاء، دعاء، رجاء، لجوء، نشوء، هدوء، مجيء، رديء، جريء.
ـ ولنتذكَّر أنَّ حروف المدِّ في العربيَّة ثلاثة، هي: الألف، والواو، والياء.
رابعًا: أخطاء الكسرة والياء في خطاب المؤنث:
ومن ذلك كتابة ضمير المخاطبة أنتِ، وتاء الفاعل للمؤنث، وكاف المخاطبة، بالشكل الآتي ـ مثلًا ـ :
وأما بالنِّسبة إلى الأفعال فالأفعال الرُّباعية ومصادرها همزاتها همزات قطع مثل: أكرم إكرامًا، أنقذ إنقاذًا، أنعم إنعامًا، أوجد إيجادًا، والمصارع المتحدث عن نسه همزته همزة قطع في جميع الأحوال، نحو: أُكرِمُ، أَنطلقُ، أَستغفرُ؛ والأفعال الخماسية والسداسية ومصادرها همزاتها همزات وصل، نحو: اختبر اختبارًا، انطلق انطلاقًا، اجتهد اجتهادًا (خماسية)، ونحو: استغفر استغفارًا، استخرج استخراجًا، استنبط استنباطًا (سداسية).
وبالنِّسبة إلى الحروف، فالحروف كلها همزاتها همزات قطع، ما عدا (أل) التعريف، حيث إذا دخلت على الاسم لا نكتب همزتها، وأما كتابتها هنا بين قوسين بالهمزة فخاص بحال الحديث عنها اصطلاحًا. وعلى هذا نكتب الحروف كلها بهمزات سواء فوقها أو تحتها، فمن ذلك: إلى (حرف جر)، أيا (حرف نداء)، أو (حرف عطف)، إنَّ (حرف توكيد ونسخ)، وأما مثال (أل) التعريف حال دخولها على اسم فخذ هذه الأمثلة وقس عليها: الجامعة ـ المدرسة ـ البيت ـ الشارع ـ الملعب ـ المسجد... فلا تكتب: ألجامعة ـ ألمدرسة ـ ألبيت ـ ألشارع ـ ألملعب ـ ألمسجد...
وهنالك طريقة لتسهيل التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع وهي أن نضع حرف عطف قبل الكلمة فإذا نطقناها باتصال حرف العطف بما بعد الهمزة وسقطت الهمزة نطقًا فإنها همزة وصل، مثال ذلك أن نضع حرف الواو او الفاء قبل كلمة: انتصر أو كلمة استغفر سنقول: وانتصر فانتصر، واستغفر فاستغفر، بِوَصلٍ صوتيٍّ ما بين حرف العطف والنُّون في: انتصر، وكذلك ما بين حرف العطف والسين في استغفر، فكأننا نقول: وَنْتصر، فَنْتصر، وَسْتغفر، فسْتغفر، لكننا لا نكتب بهذه الطريقة كما هو بّيِّن.
وإذا لم يستقم النطق في اللسان إلا بظهور الهمزة، فإنها همزة قطع، ومثال ذلك: أحمد، إذا قلنا وأحمد أو فأحمد فإن الهمزة تظهر في النطق، ومثل ذلك الحرف: إلى، إذا سبقته واو أو فاء نقول: وإلى، فإلى، ولا تسقط الهمزة في النطق فهي همزة قطع.
وعليه، فإنَّ همزة الوصل هي الهمزة التي تُنطَق ولا تُكتَب، وهمزة القطع هي الهزة التي تُنطَق وتُكتَب.
ولعلَّ من الجدير الإشارة ـ بعد هذا ـ إلى أنَّه إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، حذفنا همزة الوصل، فمثلًا إذا أردت سؤال (جميل) عن اسمه لتتأكد ما إذا كان هو؟ فستقول: أسْمُكَ جميل؟ وإذن فقد حذفتَ همزة الوصل لدخول همزة الاستفهام عليها.
2ـ الهمزة المتوسّطة:
وهي الهمزة التي تكون في وسط الكلمة، ونطبّق عليها قاعدة أقوى الحركات، وأقوى الحركات هي الكسرة تليها الضمة ثم الفتحة وأخيرًا السكون، فإذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورًا كُتبت على نبرة نحو: بئر، رئيس، زئير، شئنا، وإذا كانت مضمومة أو كان ما قبها مضمومًا كُتبت على واو نحو: سؤال، فؤاد، رؤى، شؤون، وإذا كانت مفتوحة أو كان ما قبلها مفتوحًا كُتبت على ألف نحو: سأل، رأى، نأى، فأس، كأس.
ولا بُدَّ أن نشير ـ أيضًا ـ إلى أن ثمَّة خِلافًا في كتابة بعض الكلمات بهمزة متوسطة أو متطرفة، ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ كتابة: يقرؤون، ويبدؤون، هل تكتب هكذا على اعتبار أنَّ الهمزة هنا همزة متوسطة، أم تكتب: يقرأون، ويبدأون، على اعتبار أن الهمزة في الأصل هي همزة متطرفة؟.. فبعضهم أجاز كتابتها بالطَّريقتين، وبعضهم تعصَّبَ لإحداهما، والذي نراه هنا جواز كتابتها بالطَّريقتين، مع ترجيح معاملتها معاملة الهمزة المتوسطة.
3ـ الهمزة المتطرِّفة:
وهي الهمزة التي تكون في آخر الكلمة، وننظر فيها إلى حركة الحرف الذي يسبقها.
فإن كانت تلك الحركة هي الكسرة كُتبت الهمزة المتطرفة على نبرة، نحو: قارئ، قُرئ، أنبئ، يهيِّئ.
وإن كانت حركة الحرف الذي قبلها الضمة كُتبت على واوٍ، نحو: لؤلؤ، بؤبؤ، تنبؤ، تلكؤ.
وإن كانت حركة ما قبلها هي الفتحة كُتبت على ألف، نحو: نبأ، سبأ، ملأ، بَدَأَ، قَرَأَ.
وإن كانت حركة الحرف قبلها هي السُّكون كُتبت على السطر، نحو: شَيْء، بُطْء، دِفْء، عِبْء، بَدْء.
وإن كان قبلها مدٌّ كُتبت على السَّطر أيضًا، نحو: بناء، سماء، فضاء، قضاء، دعاء، رجاء، لجوء، نشوء، هدوء، مجيء، رديء، جريء.
ـ ولنتذكَّر أنَّ حروف المدِّ في العربيَّة ثلاثة، هي: الألف، والواو، والياء.
رابعًا: أخطاء الكسرة والياء في خطاب المؤنث:
ومن ذلك كتابة ضمير المخاطبة أنتِ، وتاء الفاعل للمؤنث، وكاف المخاطبة، بالشكل الآتي ـ مثلًا ـ :
(أنتي ذهبتي ولم أسلِّم عليكي).
وهذا الخطأ سببه عدم فهم القواعد النحوية والأشكال الصرفية للفظ والتركيب العربيَّيْن، فضمير المؤنث المخاطب (أنتِ) هو بكسر التاء لا بالياء، وتاء الفاعل المؤنث في آخر الفعل الماضي لا تعقبها الياء، وكذلك كاف المخاطبة، فشكلها الصرفي يكتب هكذا في العربية، وأمَّا ياء المخاطبة فتكون في المضارع والأمر، كقولنا: تذهبين، لم تذهبي، لن تذهبي، اذهبي.
خامسًا: الأخطاء المتعلِّقة بكتابة حرفَي الضاد (ض) والظاء (ظ):
ومن ذلك كتابة الكلمات: فرض، فاضل، ضمير، أضاف، حضور، هضبة، الضالين،،، بالشكل الآتي: فرظ، فاظل، ظمير، أظاف، حظور، هظبة، الظالين،،، وبالمقابل كتابة الكلمات: ظرف، حفظ، عظيم، ظهور، نظام، وعظ، ظلم،،، بالشكل الآتي: ضرف، حفض، عضيم، ضهور، نضام، وعض، ضلم.
وبشأن هذين الحرفين (الضاد والظاء)، فإنَّ أسهل قاعدةٍ للتفريق بينهما هي قاعدة نطقهما على وفق أصوات لهجة إخوتنا المصريين، مع أنَّها ليست طريقةً منهجيَّةً، ولكن بالإمكان الاستئناس بها؛ ولاحظوا تحوُّل الظاء في لهجتهم إلى ما يشبه الزاي، في مثل: ظالم، وفظيع، وعظيم. بخلاف نطقهم للضاد في نحو: الأرض، حضرتك، افرض..
وعمومًا، يمكن الوقوف على أهمِّ الكلمات التي اشترك فيها الحرفان فأشكل تشابههما على الكُتَّاب، أما الكلمات المشهورة من قبيل: أرض، وضوء، وبعض، فنادرًا ما يقع فيها الخطأ، ومن هنا فقد جمع المؤلف أبرز الكلمات المتشابهة ببن الحرفين؛ ليسهل بالتالي التفريق بين هذه الكلمات، ومن ثَمَّ حفظ بقية الكلمات التي عداها بالسماع.
وأهمّ الكلمات المتشابهة في الرسم الكتابي بين الضاد والظاء هي:
ـ (ضلَّ) و(ظلَّ):
نقول: ضلَّ طريقه، من الضلال والتيه والضياع، ونقول: ظلَّ واقفًا: من البقاء والديمومة والاستمرار، وكذلك (ضلَّل) من التضليل وحرف النظر عن الصواب والهدى، و(ظلَّل) من التظليل وتوفير الظِّلِّ، كقولنا: ضلَّل اللصُّ رجال الشُّرطة، وظلَّل الطالب الإجابة الصائبة.
ـ (حضر) و(حظر):
حضرَ، من الحضور، وحظَر من المنع، نقول: حضر الطالب إلى الجامعة، من الحضور والمجيء، ونقول: (حظر) أكرم أصدقاء صفحته، من الحظر والمنع.
ـ (حضّ) و(حظّ):
(الحضُّ) بالضاد من الحث، و(الحظُّ) بالظاء البخت والنصيب، نقول: حضَّ المؤمن على الخير، ونقول: حظُّ الجميلات قد لا يكون سعيدًا.
ـ (نضر) و(نظر):
فبالضاد من النضرة والارتواء، وبالظاء من النظر والمشاهدة أو من الانتظار، قال تعالى: "وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة" (القيامة: 22 ـ 23).
ـ (غيض) و(غيظ):
فبالضاد من القلة وبالظاء من الغضب، نقول: هذا (غيض) من فيض، أي قليل من كثير، ونقول: أثنى الله على الكاظمين الـ(غيظ) أي الحابسين الغضب.
ـ (فض) و(فظ):
فبالضاد من التفريق والتفكيك، وبالظاء من الغلظة والقساوة، نقول: (فضّ) الجيش مظاهرات طلابية، ونقول: بيَّن الله ـ تعالى ـ في كتابه أنَّ رسوله لم يكن (فظُّ) القلب.
(ضن) و(ظن):
فبالضاد من البخل والتقتير، وبالظاء من الشك والاعتقاد، فمن الأولى قول الشاعر:
بلادي وإنْ جارت عليَّ عزيزةٌ
وأهلي وإنْ ضنّوا عليَّ كرامُ
ومن الثانية قوله تعالى: "إنَّ بعض الظَّن إثم" (الحجرات: 12)، من الشك، وقوله: "إنِّي ظنَنْتُ أنِّي مُلاقٍ حِسابِيَه" (الحاقة: 20)، من اليقين والاعتقاد.
وإضافة إلى هذا لنتذكَّرْ أنه لا تجتمع عصوان في كلمة واحدة، فإذا صادفت كلمة فيها حرف الطاء، فاعرف أنَّ الحرف الثاني هو ضاد وليس ظاء، فمثلًا: ضابط، مضطرب، منضبط، مضطر، لا نكتبها: ظابط، مظطرب، منظبط، مظطر، أبدًا.
سادسًا: الأخطاء المتعلقة بالحروف التي تُنطَق ولا تُكتَب، والحروف التي تُكتَب ولا تُنطَق:
وتُعرَف بالحروف المحذوفة، والحروف الزائدة، ومن ذلك كتابة كلمات حروفها تُنطَق ولا تُكتَب، مِنْ مثلِ: الرحمن، لكن، هذا، هذه، ذلك، كذلك، بالشكل الآتي: الرحمان، لاكن، هاذا، هاذه، ذالك، كذالك، فهذه الكلمات كتابتها توقيفية وتشبه الحروف الصامتة في بعض كلمات اللغة الإنجليزية.
وبمقابل ذلك كتابة كلمات حروفها تُكتب ولا تُنطَق، كالواو في (عمرو) للتفريق بينها وبين (عمر)، والألف الفارقة التي تلحق واو الجماعة أو الألف الدالة على الجمع، في نحو: ذهبوا، لم يذهبوا، لن يذهبوا،،، بدون الواو أو بدون الألف الدالة على الجمع، وهو خطأ، فلا تكتب: عَمْر، ذهبو، لم يذهبو، لن يذهبو، بل اكتب "عَمْرًا" في حالة الرفع والجر بالواو، واكتب الأفعال: ذهبوا، لم يذهبوا، لن يذهبوا، بإضافة ألفها الدالة على الجمع، وهي ألِفٌ لا تلحق بالواو التي من أصل الكلمة في نحو: أرجو، أدعو، نرجو، ندعو، ولا بالواو التي في جمع المذكر السالم المضاف إلى ما بعده، نحو: موظفو الدولة، لاعبو المنتخب.
وهذا الخطأ سببه عدم فهم القواعد النحوية والأشكال الصرفية للفظ والتركيب العربيَّيْن، فضمير المؤنث المخاطب (أنتِ) هو بكسر التاء لا بالياء، وتاء الفاعل المؤنث في آخر الفعل الماضي لا تعقبها الياء، وكذلك كاف المخاطبة، فشكلها الصرفي يكتب هكذا في العربية، وأمَّا ياء المخاطبة فتكون في المضارع والأمر، كقولنا: تذهبين، لم تذهبي، لن تذهبي، اذهبي.
خامسًا: الأخطاء المتعلِّقة بكتابة حرفَي الضاد (ض) والظاء (ظ):
ومن ذلك كتابة الكلمات: فرض، فاضل، ضمير، أضاف، حضور، هضبة، الضالين،،، بالشكل الآتي: فرظ، فاظل، ظمير، أظاف، حظور، هظبة، الظالين،،، وبالمقابل كتابة الكلمات: ظرف، حفظ، عظيم، ظهور، نظام، وعظ، ظلم،،، بالشكل الآتي: ضرف، حفض، عضيم، ضهور، نضام، وعض، ضلم.
وبشأن هذين الحرفين (الضاد والظاء)، فإنَّ أسهل قاعدةٍ للتفريق بينهما هي قاعدة نطقهما على وفق أصوات لهجة إخوتنا المصريين، مع أنَّها ليست طريقةً منهجيَّةً، ولكن بالإمكان الاستئناس بها؛ ولاحظوا تحوُّل الظاء في لهجتهم إلى ما يشبه الزاي، في مثل: ظالم، وفظيع، وعظيم. بخلاف نطقهم للضاد في نحو: الأرض، حضرتك، افرض..
وعمومًا، يمكن الوقوف على أهمِّ الكلمات التي اشترك فيها الحرفان فأشكل تشابههما على الكُتَّاب، أما الكلمات المشهورة من قبيل: أرض، وضوء، وبعض، فنادرًا ما يقع فيها الخطأ، ومن هنا فقد جمع المؤلف أبرز الكلمات المتشابهة ببن الحرفين؛ ليسهل بالتالي التفريق بين هذه الكلمات، ومن ثَمَّ حفظ بقية الكلمات التي عداها بالسماع.
وأهمّ الكلمات المتشابهة في الرسم الكتابي بين الضاد والظاء هي:
ـ (ضلَّ) و(ظلَّ):
نقول: ضلَّ طريقه، من الضلال والتيه والضياع، ونقول: ظلَّ واقفًا: من البقاء والديمومة والاستمرار، وكذلك (ضلَّل) من التضليل وحرف النظر عن الصواب والهدى، و(ظلَّل) من التظليل وتوفير الظِّلِّ، كقولنا: ضلَّل اللصُّ رجال الشُّرطة، وظلَّل الطالب الإجابة الصائبة.
ـ (حضر) و(حظر):
حضرَ، من الحضور، وحظَر من المنع، نقول: حضر الطالب إلى الجامعة، من الحضور والمجيء، ونقول: (حظر) أكرم أصدقاء صفحته، من الحظر والمنع.
ـ (حضّ) و(حظّ):
(الحضُّ) بالضاد من الحث، و(الحظُّ) بالظاء البخت والنصيب، نقول: حضَّ المؤمن على الخير، ونقول: حظُّ الجميلات قد لا يكون سعيدًا.
ـ (نضر) و(نظر):
فبالضاد من النضرة والارتواء، وبالظاء من النظر والمشاهدة أو من الانتظار، قال تعالى: "وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة" (القيامة: 22 ـ 23).
ـ (غيض) و(غيظ):
فبالضاد من القلة وبالظاء من الغضب، نقول: هذا (غيض) من فيض، أي قليل من كثير، ونقول: أثنى الله على الكاظمين الـ(غيظ) أي الحابسين الغضب.
ـ (فض) و(فظ):
فبالضاد من التفريق والتفكيك، وبالظاء من الغلظة والقساوة، نقول: (فضّ) الجيش مظاهرات طلابية، ونقول: بيَّن الله ـ تعالى ـ في كتابه أنَّ رسوله لم يكن (فظُّ) القلب.
(ضن) و(ظن):
فبالضاد من البخل والتقتير، وبالظاء من الشك والاعتقاد، فمن الأولى قول الشاعر:
بلادي وإنْ جارت عليَّ عزيزةٌ
وأهلي وإنْ ضنّوا عليَّ كرامُ
ومن الثانية قوله تعالى: "إنَّ بعض الظَّن إثم" (الحجرات: 12)، من الشك، وقوله: "إنِّي ظنَنْتُ أنِّي مُلاقٍ حِسابِيَه" (الحاقة: 20)، من اليقين والاعتقاد.
وإضافة إلى هذا لنتذكَّرْ أنه لا تجتمع عصوان في كلمة واحدة، فإذا صادفت كلمة فيها حرف الطاء، فاعرف أنَّ الحرف الثاني هو ضاد وليس ظاء، فمثلًا: ضابط، مضطرب، منضبط، مضطر، لا نكتبها: ظابط، مظطرب، منظبط، مظطر، أبدًا.
سادسًا: الأخطاء المتعلقة بالحروف التي تُنطَق ولا تُكتَب، والحروف التي تُكتَب ولا تُنطَق:
وتُعرَف بالحروف المحذوفة، والحروف الزائدة، ومن ذلك كتابة كلمات حروفها تُنطَق ولا تُكتَب، مِنْ مثلِ: الرحمن، لكن، هذا، هذه، ذلك، كذلك، بالشكل الآتي: الرحمان، لاكن، هاذا، هاذه، ذالك، كذالك، فهذه الكلمات كتابتها توقيفية وتشبه الحروف الصامتة في بعض كلمات اللغة الإنجليزية.
وبمقابل ذلك كتابة كلمات حروفها تُكتب ولا تُنطَق، كالواو في (عمرو) للتفريق بينها وبين (عمر)، والألف الفارقة التي تلحق واو الجماعة أو الألف الدالة على الجمع، في نحو: ذهبوا، لم يذهبوا، لن يذهبوا،،، بدون الواو أو بدون الألف الدالة على الجمع، وهو خطأ، فلا تكتب: عَمْر، ذهبو، لم يذهبو، لن يذهبو، بل اكتب "عَمْرًا" في حالة الرفع والجر بالواو، واكتب الأفعال: ذهبوا، لم يذهبوا، لن يذهبوا، بإضافة ألفها الدالة على الجمع، وهي ألِفٌ لا تلحق بالواو التي من أصل الكلمة في نحو: أرجو، أدعو، نرجو، ندعو، ولا بالواو التي في جمع المذكر السالم المضاف إلى ما بعده، نحو: موظفو الدولة، لاعبو المنتخب.
سابعًا: أخطاء كتابية وأسلوبية شائعة:
وأشهرها:
ـ كتابة الكلمة (صلِّ) في عبارة: (اللهم صلِّ على النبي) بالياء أي صلِّي، وهذا خطأ لأننا في فعل الأمر أو الطلب أو الدعاء المعتل الآخر نحذف حرف العلة، ولكن إذا كنا نخاطب المؤنث نكتب: صلِّي؛ لأن الياء هنا ياء المخاطبة.
ـ كتابة عبارة (إن ِشاء الله) بالصورة: (إنشاء الله)؛ فالإنشاء متصلة تعني التعبير أو التعمير، ومن ذلك مثلًا قولنا: مادة الإنشاء والتعبير، أو: البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وأما في قولنا: سنزور الحديدة إن شاء الله، فالمقصود هنا: إذا شاء الله، فتكتب (إن) منفصلة.
ـ كتابة (مُنذُ) بالواو، أي: منذو، وهو خطأ فادح، إذ لا توجد واو في أصل الكلمة.
ـ كتابة بعض الكلمات المنتهية بالمقصورة بتنقيطها وكأن ألفها المقصورة ياء، نحو: إلى، وبلى، وعلى، وحتَّى، حيث يكتبها بعضهم: إلي، بلي، علي، حتي؛ ما قد يثير اللبس خاصة مع تشابه التركيب الصرفي في بعض الكلمات، مثل: على (الحرف)، وعلي (الاسم)، وعليَّ (حرف الجر مع الضمير المتصل ياء المتكلم).
ـ كتابة (ما) مع الحروف دون إدراك ما إذا كانت متصلة أم منفصلة:
فإذا كانت (ما) بمعنى الذي، فاكتبها وحدها مستقلةً منفصلة عمَّا قبلها، وإذا لم تكن كذلك فاكتبها ملتصقة متصلة بما قبلها، ومثال ذلك:
(فيما) كان الأساتذة مجتمعين يتشاورون (في ما) يمكن حذفه من المنهج، دخل أحد الطلاب فتوقفوا عن الحديث وتبادلوا النظرات (فيما) بينهم، حتى لا يتسرَّعوا في الخوض (في ما) يقال وما لا يقال، (إنَّما) فاجأهم الطالب بقوله: (إنَّ ما) أخذناه من المنهج كان قليلاً جدًّا.
ـ كتابة (كي) مع (لا)، مع جهل كونهما متصلتين أو منفصلتين:
فمتى نصل (كي) بـ (لا)؟ ومتى نفصلها عنها؟
الجواب: نصِلها إذا سبقتها (اللام)، فنكتب: لكيلا، ونفصلها إذا لم تسبقها (اللام)، فنكتب: كي لا.
ـ كتابة بعض الكلمات المتشابهة في النطق المختلفة في الدلالة:
ومن أبرزها:
. يحيا، ويحيى، فبالممدودة للفعل وبالمقصورة للاسم، نقول مثلًا: سميتُه يحيى ليحيا.
. عصا، وعصى، فبالممدودة للاسم، وبالمقصورة للفعل، نقول مثلًا: العصا لمن عصى.
. علا، وعلى، فبالممدودة للفعل، وبالمقصورة للحرف، نقول مثلًا: علا عليٌّ على أقرانه.
ـ استصعاب كتابة (إذن) أو (إذًا):
وتجوز كتابتهما بالطريقتين؛ فكلتاهما قد وردت، حيث إن بعضهم رجح كتابتها بالنون إطلاقًا، وبعضهم الآخر رجح كتابتها بالتنوين إطلاقًا، وفريق ثالث فصل ما بين حالتَي الإعمال والإهمال، والذي نراه أنها تكتب بالنون إطلاقًا؛ لسببين وجيهين، أولهما: أنها في حالة الوقف عليها تنطق نونًا لا ألفًا، فهي مثل لن وأن كما قال بعض العلماء، وثانيهما لأن كتابتها بالنون وخاصة مع الوقف تساعد في التفريق بينها وبين إذا الشرطية، ولا سيما أن أكثرهم يجهل التفريق بينهما، فضلاً عن أن بعض مجامع اللغة العربية ذهبت إلى كتابتها بالنُّونِ إطلاقًا.
#إبراهيم_طلحة
كتابنا: اللغة العربية ومهاراتها في ضوء المناهج والنماذج.
وأشهرها:
ـ كتابة الكلمة (صلِّ) في عبارة: (اللهم صلِّ على النبي) بالياء أي صلِّي، وهذا خطأ لأننا في فعل الأمر أو الطلب أو الدعاء المعتل الآخر نحذف حرف العلة، ولكن إذا كنا نخاطب المؤنث نكتب: صلِّي؛ لأن الياء هنا ياء المخاطبة.
ـ كتابة عبارة (إن ِشاء الله) بالصورة: (إنشاء الله)؛ فالإنشاء متصلة تعني التعبير أو التعمير، ومن ذلك مثلًا قولنا: مادة الإنشاء والتعبير، أو: البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وأما في قولنا: سنزور الحديدة إن شاء الله، فالمقصود هنا: إذا شاء الله، فتكتب (إن) منفصلة.
ـ كتابة (مُنذُ) بالواو، أي: منذو، وهو خطأ فادح، إذ لا توجد واو في أصل الكلمة.
ـ كتابة بعض الكلمات المنتهية بالمقصورة بتنقيطها وكأن ألفها المقصورة ياء، نحو: إلى، وبلى، وعلى، وحتَّى، حيث يكتبها بعضهم: إلي، بلي، علي، حتي؛ ما قد يثير اللبس خاصة مع تشابه التركيب الصرفي في بعض الكلمات، مثل: على (الحرف)، وعلي (الاسم)، وعليَّ (حرف الجر مع الضمير المتصل ياء المتكلم).
ـ كتابة (ما) مع الحروف دون إدراك ما إذا كانت متصلة أم منفصلة:
فإذا كانت (ما) بمعنى الذي، فاكتبها وحدها مستقلةً منفصلة عمَّا قبلها، وإذا لم تكن كذلك فاكتبها ملتصقة متصلة بما قبلها، ومثال ذلك:
(فيما) كان الأساتذة مجتمعين يتشاورون (في ما) يمكن حذفه من المنهج، دخل أحد الطلاب فتوقفوا عن الحديث وتبادلوا النظرات (فيما) بينهم، حتى لا يتسرَّعوا في الخوض (في ما) يقال وما لا يقال، (إنَّما) فاجأهم الطالب بقوله: (إنَّ ما) أخذناه من المنهج كان قليلاً جدًّا.
ـ كتابة (كي) مع (لا)، مع جهل كونهما متصلتين أو منفصلتين:
فمتى نصل (كي) بـ (لا)؟ ومتى نفصلها عنها؟
الجواب: نصِلها إذا سبقتها (اللام)، فنكتب: لكيلا، ونفصلها إذا لم تسبقها (اللام)، فنكتب: كي لا.
ـ كتابة بعض الكلمات المتشابهة في النطق المختلفة في الدلالة:
ومن أبرزها:
. يحيا، ويحيى، فبالممدودة للفعل وبالمقصورة للاسم، نقول مثلًا: سميتُه يحيى ليحيا.
. عصا، وعصى، فبالممدودة للاسم، وبالمقصورة للفعل، نقول مثلًا: العصا لمن عصى.
. علا، وعلى، فبالممدودة للفعل، وبالمقصورة للحرف، نقول مثلًا: علا عليٌّ على أقرانه.
ـ استصعاب كتابة (إذن) أو (إذًا):
وتجوز كتابتهما بالطريقتين؛ فكلتاهما قد وردت، حيث إن بعضهم رجح كتابتها بالنون إطلاقًا، وبعضهم الآخر رجح كتابتها بالتنوين إطلاقًا، وفريق ثالث فصل ما بين حالتَي الإعمال والإهمال، والذي نراه أنها تكتب بالنون إطلاقًا؛ لسببين وجيهين، أولهما: أنها في حالة الوقف عليها تنطق نونًا لا ألفًا، فهي مثل لن وأن كما قال بعض العلماء، وثانيهما لأن كتابتها بالنون وخاصة مع الوقف تساعد في التفريق بينها وبين إذا الشرطية، ولا سيما أن أكثرهم يجهل التفريق بينهما، فضلاً عن أن بعض مجامع اللغة العربية ذهبت إلى كتابتها بالنُّونِ إطلاقًا.
#إبراهيم_طلحة
كتابنا: اللغة العربية ومهاراتها في ضوء المناهج والنماذج.
الذي يكتب لمتابعيه: متابعيني الكرام، وشكرا متابعيني، ونحو ذلك، خطأ ❌
والصواب: متابعيَّ الكرام. ☑️
حيث اجتمعت فيها ياءان؛ ياء نصب جمع المذكر السالم، وياء المتكلم.
ومن المعلوم أن نون جمع المذكر السالم تحذف للإضافة، وتدغم ياء جمع المذكر في ياء المتكلم.
والصواب: متابعيَّ الكرام. ☑️
حيث اجتمعت فيها ياءان؛ ياء نصب جمع المذكر السالم، وياء المتكلم.
ومن المعلوم أن نون جمع المذكر السالم تحذف للإضافة، وتدغم ياء جمع المذكر في ياء المتكلم.
فائدة:
إذا اجتمعت التّاءان (تاء المضارعة والتّاء الأصلية) في فعل واحد (فعل مضارع)، فأنت بالخيار، أثبتّهما أو حذفت إحداهما، ومثال ذلك: تتنزّل أو تنزّل، تتلظّى أو تلظّى.
إذا اجتمعت التّاءان (تاء المضارعة والتّاء الأصلية) في فعل واحد (فعل مضارع)، فأنت بالخيار، أثبتّهما أو حذفت إحداهما، ومثال ذلك: تتنزّل أو تنزّل، تتلظّى أو تلظّى.
أخطاءٌ لُغويّةٌ شائعةٌ وتصويبها:
.......................................
الأخطاء الشَّائعة في الكتابة هي انحرافُ الكتابة السَّليمة عن أصولها. هي الأخطاء الَّتي شاعت شيوعًا شديدًا فصارت أخطاءً مُعتمدة؛ إلى درجة أنَّ الكاتبَ نفسه يُدهَشُ عندما تُخبرهُ عنها لأنَّها صارت أصيلةً في لُغتهِ وثقافتهِ.
هاكُم عشرون خطأً لغويًّا، وتصويبها...
قائمة الأخطاء الشائعة في الكتابة
1-
اعتبر
منَ الأخطاءِ اللُّغويَّة شديدة الانتشار، استخدام الفعل «اعتبر» بمعنى (عَدَّ)، فيقولون: اعتبرتُ فُلانًا صديقًا أو يقولون:
يُعتَبرُ الإعلامُ وسيلةً من وسائلِ التَّرويج.
يُعتَبرُ فلانٌ خبيرًا في مجاله.
أعتَبرُ الأمرَ مُنتهيًا.
«اعتبرَ» فِعْلٌ على وزنِ (افْتَعَلَ)، ومعناهُ: (أخذَ العبرة واتَّعظ)، ومعناه: (التَّعجُّب والتَّأمل). قال تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ)، أي: خُذوا العبرة واتَّعظوا؛ لذلك فإنَّ من الصَّواب أن نقول: عَدَدتُ فُلانًا صديقًا. أو نقول:
يُعدُّ الإعلامُ وسيلةً من وسائلِ التَّرويج.
يُعدُّ فلان خبيرًا في مجالهِ.
أَعُدُّ الأمرَ مُنتهيًّا.
2-
قام وتَمَّ
من أكثرِ الأخطاءِ اللُّغويَّة الشَّائعة الّتي يقَعُ فيها حتَّى كبار الكتَّاب هي استخدام الفعلين «قامَ» و «تمَّ» في غير موضعهما، ومن أمثلة ذلك:
قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي.
تمَّ إقامة حفل للخرِّيجين.
الصَّواب أنْ نقول
علَّق صديقي على كلامي.
أُقيم حفل للخرِّيجين.
ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل «قام» فهو يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة.
تَمَّ
أمّا الفعل «تمَّ» فهو يُستخدم عوضًا عن استخدامِ الفعل المبني للمجهولِ، والعربيَّةُ لم تعرفْ هذا التَّركيب أيضًا. إنَّما من وجهٍ آخر: تعني (تَمَّ): [كُمَل، أو اكتَمَلَ]؛ لذلك منَ الصَّوابِ القول: [تَمَّ عقدُ الاجتماعِ في تاريخ: (2020/02/20)].
حسنًا، كيف أعرفُ؟ ضع بدلًا من (تَمَّ) كلمة (كُمَل أو اكتَمَل أو يكتمل) فإذا لم يَفسدِ المعنى فاستخدامك صائب. مثال: [يتمُّ مُناقشة القضيَّة في المَحكمة]. ضع (يكتمل) لتُصبح: (يكتملُ مُناقشة القضيَّة في المحكمة)، نُلاحظُ فساد المَعنى، والصَّواب أن نضعَ فعلًا يُناسبُ السِّياق، مثل: (يَجري) أو (يَحدُثُ): [يجري مُناقشة القضيَّة في المحكمةِ]، أو استخدام البناء للمجهول: [تُناقَشُ القضيَّةُ في المحكمة].
3-
مديرون أم مدراء؟
اللَّغةُ العربيَّةُ لا يوجد فيها وزن (فُعِيْل)، إنَّما هو منْ أوزانِ العامَّة، ومنَ الأخطاءِ اللُّغوية الشَّائعةِ قياس كلمة على وزنِ (فُعِيل) -في العاميَّة- ككلمةِ «مُدير» وكتابتها «مُدَرَاءْ» بجمعها جمع تكسير، والصَّوابُ جمعها على المُذكّر السَّالم (مُديرين، مُديرون)؛ لأنَّها على وزنِ (مُفْعِل)، وأصلهُ من الفِعْلِ (أَدَارَ) على وزنِ (أَفْعَل).
مثل: «مُدْبِر» الَّذي أصلهُ منَ الفعلِ «أَدْبَر». أمَّا «مُدَرَاءْ» فهي على وزنِ (فُعَلاءْ) وهذا الوزن لا يأتي جمعًا (لفَعيلِ) إلَّا إذا كانَ وصفًا، والمراد بالصِّفات ما يكون لغيرهِ منَ الأسماء مثل: (ظَريف، ظُرَفاء)، (بَخيل، بُخَلاء). بَيْدَ أنَّهم لم يكسروا كلَّ الصِّفاتِ: فامتنعوا من تكسيرِ اسم الفاعلِ من فوق الثُّلاثي: نحو، مُدير (من أدارَ)، فقالوا: (مديرون)، (لا: مُدراء).
4-
الفعلُ المُتَعدِّي أكَّدَ
الأفعالُ المُتعدِّية هي الأفعالُ الَّتي تتجاوزُ الفاعل إلى مفعولٍ بهِ. أي أنَّ معناه لا يتمُّ إلَّا بذكرِ المفعولِ بهِ، والفعلُ (أَكَّدَ) من الأفعال المُتعدِّية. من الأخطاءِ الشَّائعة تعدية الفعل «أَكَّدَ» بحرفِ الجرِّ «عَلَى». مثال: [أَكَّدَ على] الأمر، والصَّواب: [أَكَّدَ الأمرَ]. أي تعديتها إلى مفعولهِ مُباشرةً.
5-
أجاب على أم أجاب عن؟
يستخدمُ كثيرٌ من النَّاس حرف الجر «على» بعدَ الفعلِ أجابَ ومُشتقَّاتهِ، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ «عن»، مثال:
أجابَ على السُّؤال. (خطأ).
أجابَ عن السُّؤال. (صواب).
يُمكنُ الرُّجوع إلى أيِّ قَاموسٍ من قواميسِ اللُّغةِ لإثباتِ صحَّةِ ذلك. مع التَّنويه، إلى عدمِ الالتفاتِ إلى إجازةِ مَجْمَعِ اللُّغةِ القاهريِّ لاستخدام «على) بدل «عن»؛ لأنَّ المَجْمَعَ مشهورٌ بالتَّساهلِ، وقد خالفهُ كبارُ اللُّغويّين في كثيرٍ من المسائلِ.
6-
كُلَّما- كُلَّما
منَ الأخطاءِ الَّتي شاعتْ، تَكرار «كلّما». مثال: [كلَّما ازددتَ اجتهادًا كلَّما زادتْ فرصُ تفوُّقك]. الصَّواب: [كلَّما ازددتَ اجتهادًا زادتْ فرصُ تفوُّقك]، أي: حذْف «كلَّما» الثَّانية، وفي التَّنْزيل العزيزِ: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا}.
.......................................
الأخطاء الشَّائعة في الكتابة هي انحرافُ الكتابة السَّليمة عن أصولها. هي الأخطاء الَّتي شاعت شيوعًا شديدًا فصارت أخطاءً مُعتمدة؛ إلى درجة أنَّ الكاتبَ نفسه يُدهَشُ عندما تُخبرهُ عنها لأنَّها صارت أصيلةً في لُغتهِ وثقافتهِ.
هاكُم عشرون خطأً لغويًّا، وتصويبها...
قائمة الأخطاء الشائعة في الكتابة
1-
اعتبر
منَ الأخطاءِ اللُّغويَّة شديدة الانتشار، استخدام الفعل «اعتبر» بمعنى (عَدَّ)، فيقولون: اعتبرتُ فُلانًا صديقًا أو يقولون:
يُعتَبرُ الإعلامُ وسيلةً من وسائلِ التَّرويج.
يُعتَبرُ فلانٌ خبيرًا في مجاله.
أعتَبرُ الأمرَ مُنتهيًا.
«اعتبرَ» فِعْلٌ على وزنِ (افْتَعَلَ)، ومعناهُ: (أخذَ العبرة واتَّعظ)، ومعناه: (التَّعجُّب والتَّأمل). قال تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ)، أي: خُذوا العبرة واتَّعظوا؛ لذلك فإنَّ من الصَّواب أن نقول: عَدَدتُ فُلانًا صديقًا. أو نقول:
يُعدُّ الإعلامُ وسيلةً من وسائلِ التَّرويج.
يُعدُّ فلان خبيرًا في مجالهِ.
أَعُدُّ الأمرَ مُنتهيًّا.
2-
قام وتَمَّ
من أكثرِ الأخطاءِ اللُّغويَّة الشَّائعة الّتي يقَعُ فيها حتَّى كبار الكتَّاب هي استخدام الفعلين «قامَ» و «تمَّ» في غير موضعهما، ومن أمثلة ذلك:
قامَ صديقي بالتَّعليقِ عَلى كلامي.
تمَّ إقامة حفل للخرِّيجين.
الصَّواب أنْ نقول
علَّق صديقي على كلامي.
أُقيم حفل للخرِّيجين.
ذلكَ لأنَّ استخدام هذينِ الفعلينِ بهذه الطَّريقةِ جاء نتيجة التَّأثرِ بالتَّرجمة مِنَ اللُّغةِ الإنجليزيَّة. الفعل «قام» فهو يُستخدم كفعلٍ مساعدٍ، والعربيَّةُ ليس فيها أفعالٌ مساعدةٌ مثل الإنجليزيَّة.
تَمَّ
أمّا الفعل «تمَّ» فهو يُستخدم عوضًا عن استخدامِ الفعل المبني للمجهولِ، والعربيَّةُ لم تعرفْ هذا التَّركيب أيضًا. إنَّما من وجهٍ آخر: تعني (تَمَّ): [كُمَل، أو اكتَمَلَ]؛ لذلك منَ الصَّوابِ القول: [تَمَّ عقدُ الاجتماعِ في تاريخ: (2020/02/20)].
حسنًا، كيف أعرفُ؟ ضع بدلًا من (تَمَّ) كلمة (كُمَل أو اكتَمَل أو يكتمل) فإذا لم يَفسدِ المعنى فاستخدامك صائب. مثال: [يتمُّ مُناقشة القضيَّة في المَحكمة]. ضع (يكتمل) لتُصبح: (يكتملُ مُناقشة القضيَّة في المحكمة)، نُلاحظُ فساد المَعنى، والصَّواب أن نضعَ فعلًا يُناسبُ السِّياق، مثل: (يَجري) أو (يَحدُثُ): [يجري مُناقشة القضيَّة في المحكمةِ]، أو استخدام البناء للمجهول: [تُناقَشُ القضيَّةُ في المحكمة].
3-
مديرون أم مدراء؟
اللَّغةُ العربيَّةُ لا يوجد فيها وزن (فُعِيْل)، إنَّما هو منْ أوزانِ العامَّة، ومنَ الأخطاءِ اللُّغوية الشَّائعةِ قياس كلمة على وزنِ (فُعِيل) -في العاميَّة- ككلمةِ «مُدير» وكتابتها «مُدَرَاءْ» بجمعها جمع تكسير، والصَّوابُ جمعها على المُذكّر السَّالم (مُديرين، مُديرون)؛ لأنَّها على وزنِ (مُفْعِل)، وأصلهُ من الفِعْلِ (أَدَارَ) على وزنِ (أَفْعَل).
مثل: «مُدْبِر» الَّذي أصلهُ منَ الفعلِ «أَدْبَر». أمَّا «مُدَرَاءْ» فهي على وزنِ (فُعَلاءْ) وهذا الوزن لا يأتي جمعًا (لفَعيلِ) إلَّا إذا كانَ وصفًا، والمراد بالصِّفات ما يكون لغيرهِ منَ الأسماء مثل: (ظَريف، ظُرَفاء)، (بَخيل، بُخَلاء). بَيْدَ أنَّهم لم يكسروا كلَّ الصِّفاتِ: فامتنعوا من تكسيرِ اسم الفاعلِ من فوق الثُّلاثي: نحو، مُدير (من أدارَ)، فقالوا: (مديرون)، (لا: مُدراء).
4-
الفعلُ المُتَعدِّي أكَّدَ
الأفعالُ المُتعدِّية هي الأفعالُ الَّتي تتجاوزُ الفاعل إلى مفعولٍ بهِ. أي أنَّ معناه لا يتمُّ إلَّا بذكرِ المفعولِ بهِ، والفعلُ (أَكَّدَ) من الأفعال المُتعدِّية. من الأخطاءِ الشَّائعة تعدية الفعل «أَكَّدَ» بحرفِ الجرِّ «عَلَى». مثال: [أَكَّدَ على] الأمر، والصَّواب: [أَكَّدَ الأمرَ]. أي تعديتها إلى مفعولهِ مُباشرةً.
5-
أجاب على أم أجاب عن؟
يستخدمُ كثيرٌ من النَّاس حرف الجر «على» بعدَ الفعلِ أجابَ ومُشتقَّاتهِ، والصَّواب تعديته بحرفِ الجرِّ «عن»، مثال:
أجابَ على السُّؤال. (خطأ).
أجابَ عن السُّؤال. (صواب).
يُمكنُ الرُّجوع إلى أيِّ قَاموسٍ من قواميسِ اللُّغةِ لإثباتِ صحَّةِ ذلك. مع التَّنويه، إلى عدمِ الالتفاتِ إلى إجازةِ مَجْمَعِ اللُّغةِ القاهريِّ لاستخدام «على) بدل «عن»؛ لأنَّ المَجْمَعَ مشهورٌ بالتَّساهلِ، وقد خالفهُ كبارُ اللُّغويّين في كثيرٍ من المسائلِ.
6-
كُلَّما- كُلَّما
منَ الأخطاءِ الَّتي شاعتْ، تَكرار «كلّما». مثال: [كلَّما ازددتَ اجتهادًا كلَّما زادتْ فرصُ تفوُّقك]. الصَّواب: [كلَّما ازددتَ اجتهادًا زادتْ فرصُ تفوُّقك]، أي: حذْف «كلَّما» الثَّانية، وفي التَّنْزيل العزيزِ: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا}.