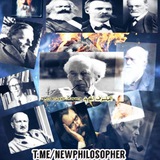والذي يريد السعادة ويحرص عليها يجب ان يقتنيها في ذاته .فالطبيعة البشرية في راي السفسطائيين هي طبيعة الذات القوية التي لا تخضع ولا تسمح باستعبادها . هسي طيسعة متمردة تنشد الفرادة والتميز والتفوق . هي طبيعة تكره الضعف وتنادي بـ " إرادة القوة "
لم يتزوج بروتاغوراس طوال حياته ، حتى يتجنب كما يقول في محاورة افلاطون " عبئا ثقيلا يقع عليه " عاش حياته متجولا ، يهتم بالجدال مع الناس ، وينسب اليه انه اول من ابتكر ذلك تانوع تاذي سمي " الجدل السقراطي " ، ووفقا لما يقوله افلاطون فان بروتاغوراس اول من اوضح الكيفية التي يتسنى بها للمحاور ان يدحض القضايا المطروحة امامه للنقاش . يحبرنا ديوجينيس في كتابه مشاهير الفلاسفة ان بروتاغوراس توفي بعد ان غرقت سفينته عندما كان يقوم باحدى رحلاته البحرية ، وقد كان عمرة قد قارب التسعين عاما.وقد القيت في رثاءه قصيدة جاء فيها :
" إي بروتاغوراس
لقد سمعت عنك قولا
مؤداه أنك قضيت نحبك
وانت رجل هرم " .
اليوم ونحن نحتفل بالفلسفة ، نتساءل : هل الفلسفة تقف في مواجهة مشكلة التعايش السلمي بين البشر في العالم كله ؟ . وهل لا يزال الفيلسوف يساهم في السؤال المطروح دوما عن معنى ان ننحترم حق الاخر في الحياة ؟ .. لعل موقف بعض كبار فلاسفة الغرب من الحرب الهمجية التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين يجيب على بعض الاسئلة التي تراودنا عن موقف الفلسفة تجاه ما يجري في العالم . في الايام الاخيرة وصفت الفيلسوفة الامريكية جوديث بتلر ما يجري في غزة بالابادة الجماعية التي يريد من خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي القضاء على شعب باكمله ومنعه من الحصول على حقع في اقامة بلد يعيش فيه بامان .فيما عبر الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك عن ادانته لاسرائيل التي وصفها بالكيان المتشدد الذي يسعى الى الغاء الاخر ، فيما عبر الفيلسوف الايطالي جورجيو اغاميين عن خيبة امله من الحكومات الغربية التي تتفرج على المحازر ولا تحرك شيئا . في الوقت الذي اصدر فيه اكثر من " 80 " فيلسوفا واستاذا للفلسفة بيانا اعلنوا فيه تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإدانتهم المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا ادانة شديدة لحكومات بلدانهم لكونها تقف مع اسرائيل وطالبوهم بموقف انساني واضح امام ما يحدث من انتهاكات للانسانية ، ونجد مفكرا كبيرا مثل الامريكي نعوم تشومسكي يصف ما يجري في عزة بانه تطهير عرقي ، مطالبا العالم بان يقفوا مع الانسانية المضطهدة ، فلا شيْ اهم من الانسان وحريته وحقه في العيش بامان واستقرار وكرامة .
لم يتزوج بروتاغوراس طوال حياته ، حتى يتجنب كما يقول في محاورة افلاطون " عبئا ثقيلا يقع عليه " عاش حياته متجولا ، يهتم بالجدال مع الناس ، وينسب اليه انه اول من ابتكر ذلك تانوع تاذي سمي " الجدل السقراطي " ، ووفقا لما يقوله افلاطون فان بروتاغوراس اول من اوضح الكيفية التي يتسنى بها للمحاور ان يدحض القضايا المطروحة امامه للنقاش . يحبرنا ديوجينيس في كتابه مشاهير الفلاسفة ان بروتاغوراس توفي بعد ان غرقت سفينته عندما كان يقوم باحدى رحلاته البحرية ، وقد كان عمرة قد قارب التسعين عاما.وقد القيت في رثاءه قصيدة جاء فيها :
" إي بروتاغوراس
لقد سمعت عنك قولا
مؤداه أنك قضيت نحبك
وانت رجل هرم " .
اليوم ونحن نحتفل بالفلسفة ، نتساءل : هل الفلسفة تقف في مواجهة مشكلة التعايش السلمي بين البشر في العالم كله ؟ . وهل لا يزال الفيلسوف يساهم في السؤال المطروح دوما عن معنى ان ننحترم حق الاخر في الحياة ؟ .. لعل موقف بعض كبار فلاسفة الغرب من الحرب الهمجية التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين يجيب على بعض الاسئلة التي تراودنا عن موقف الفلسفة تجاه ما يجري في العالم . في الايام الاخيرة وصفت الفيلسوفة الامريكية جوديث بتلر ما يجري في غزة بالابادة الجماعية التي يريد من خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي القضاء على شعب باكمله ومنعه من الحصول على حقع في اقامة بلد يعيش فيه بامان .فيما عبر الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك عن ادانته لاسرائيل التي وصفها بالكيان المتشدد الذي يسعى الى الغاء الاخر ، فيما عبر الفيلسوف الايطالي جورجيو اغاميين عن خيبة امله من الحكومات الغربية التي تتفرج على المحازر ولا تحرك شيئا . في الوقت الذي اصدر فيه اكثر من " 80 " فيلسوفا واستاذا للفلسفة بيانا اعلنوا فيه تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإدانتهم المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا ادانة شديدة لحكومات بلدانهم لكونها تقف مع اسرائيل وطالبوهم بموقف انساني واضح امام ما يحدث من انتهاكات للانسانية ، ونجد مفكرا كبيرا مثل الامريكي نعوم تشومسكي يصف ما يجري في عزة بانه تطهير عرقي ، مطالبا العالم بان يقفوا مع الانسانية المضطهدة ، فلا شيْ اهم من الانسان وحريته وحقه في العيش بامان واستقرار وكرامة .
👍3
ستطالب الصهيونية، وفي ما بعد، دولة إسرائيل، الفلسطينيين بالاعتراف بها قانونيا. ومن جهتها، فإن دولة إسرائيل لم تتوقف عن إنكار وجود شعب فلسطيني. فلا حديث عندها عن فلسطينيين، وإنما عن عرب فلسطين، وكأنهم وجدوا أنفسهم هناك صدفة أو خطأ. لاحقا، سيتم الأمر وكأن الفلسطينيين المهجّرين جاؤوا من خارج. ولن يتم الحديث قط عن حرب المقاومة الأولى التي خاضوها وحدهم. وسيعتبرون من سلالة هتلر، ما داموا لم يعترفوا بحق دولة إسرائيل. إلا أن إسرائيل تحتفظ بحقها في إنكار وجودهم الفعلي. وهنا تبدأ سردية سيزداد انتشارها أكثر فأكثر لتثقل كاهل كل أولئك الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية".
الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز..
قبل 40 عامًا..
الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز..
قبل 40 عامًا..
👍17❤2
أنضم الآن.. ولا تفوت الفرصة.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
• مدخلٌ إلى فلسفةِ "جاك دريدا "
( التأجيل - الاختلاف - الحضور )
- لا يزال "جاك دريدا" الفيلسوف الأكثر إثارة للجدل في القرن العشرين وفي قرننا الحالي. يقترن اسمه في المقام الأول بالنظرية التفكيكية. وهي نظرية ذات نهج مُعقَّد ودقيق لكيفية قراءة وفهم طبيعة النصوص المكتوبة. والمقولة الأشهر لدريدا : "لا شيء خارج النص". ولنفهم ما تعنيه هذه العبارة لابُدّ من نظرة فاحصة عن نهج دريدا التفكيكي بشكل عام.
- يرى دريدا أنّنا عندما نختار كتاباً ما لمطالعته ، ككتاب فلسفة أو رواية مثلاً ، فإننا نتخيّل أن مابين أيدينا موضوع يمكن أن نفهمه وأن نُفسِّره كعمل متكامل قائم بحدِّ ذاته. فعلى سبيل المثال : تخيّل أنك ذهبت إلى المكتبة وحصلت على كتاب "في علم الكتابة" لمؤلِّفه "جاك دريدا" ، فإنك تتوقع بأنه سيكون لديك فكرة عامة وشاملة بمجرد قراءتك لهذا الكتاب. والواقع - برأي دريدا نفسه - أن النصوص لا تعمل على هذه الشاكلة بما في ذلك النصوص البديهية والبسيطة. لأنه - أي دريدا - يعتقد بأن كل النصوص تحتوي على ثغرات وتناقضات ، ولذا فإن مهمة التفكيكية هي إيجاد تلك الثغرات والتناقضات ، ومن خلال اكتشاف هذه الثغرات يتم توسيع دائرة فهمنا لتلك النصوص.
- النظرية التفكيكية إذن هي طريقة لقراءة النصوص وإظهار المفارقات والتناقضات الخفية إلى العلن ، أو بعبارة أخرى ( قراءة مابين السطور ). ويجب الأخذ في الاعتبار أنها - أي التفكيكية - ليست مجرد طريقة لقراءة الفلسفة والأدب ، فنظرية دريدا تثير التساؤل حول العلاقة بين اللغة والفكر والأخلاق.
- ومن المصطلحات التقنيّة المهمة التي تدور حولها نظرية دريدا : مصطلح "الإرجاء" أو "التأجيل" ، ومصطلح "الاختلاف". لنبدأ بفكرة "التأجيل" : نقول مثلاً ( رأى صديقي ) و نضيف ( سيارة بيضاء ) ثم نكمل ( في الشارع ) ونتابع الحديث (.....). مع كل كلمة نضيفها يطرأ تغييراً على معنى العبارة ، ويتغيّر معنى كلمة ( سيارة ) ، وبالتالي فإن كل معلومة تُضاف تؤدي إلى تأجيل المعنى الكامل للعبارة. وهناك أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار : حيث أن كلمة ( سيارة ) لا يرتكز معناها على السيارة الحقيقية الموجودة في العالم الخارجي ، لأن الكلمة تأخذ معناها من خلال موقعها في نسق اللغة ونظامها. ولذلك فكلمة ( سيارة ) لا تكتسب معناها بسبب الرابط الخفي بينها وبين السيارة الحقيقية بل تكتسب معناها من اختلافها عن كلمة ( دراجة ) أو ( عربة ) مثلاً ، وذلك ما يسميه دريدا ( الاختلاف ).
- النتيجة التي نتوصّل إليها من خلال مفهومي "التأجيل"
و "الاختلاف" : إن معنى أي شيء نقوله دائماً مؤجَّل لأنه يعتمد على ما سنضيفه ، والأمر الذي سنضيفه يعتمد معناه على ما سنضيفه لاحقاً ؛ وهكذا. ثم إن أي كلمة نقولها يعتمد معناها على الأمور الأخرى التي لا تعنيها أيضاً.
- لقد اعتاد الفلاسفة منذ القدم على اعتبار الكتابة انعكاس شاحب للكلمة المنطوقة. وتلك الأخيرة كانت تعدّ الوسيلة الأساسية للتواصل آنذاك. لكن دريدا يرى عكس ذلك : إذ عنده أن الكلمة المكتوبة تُظهِر أموراً لا يمكن للكلمة المنطوقة أن تكشفها. حتى أنه يُعتقد في الماضي أن المعنى يأتي من خلال الحضور ، ذلك أننا حين نتكلّم مع شخص ما بشكل مباشر ، وحصل التباس معين أثناء الحديث ، فإننا نستطيع أن نطلب من هذا الشخص أن يوضِّح ويزيل الالتباس ، وهذا أدى إلى الاعتقاد بأن المعنى بشكل عام يظهر من خلال هذا الحضور ؛ أي حضور الشخص بشكل مباشر. لكن دريدا يرى أننا حين نتعامل مع النص المكتوب ، فإننا نتحرِّر من طغيان هذا الحضور ، فمثلاً عندما نقرأ نصّاً لا يكون مؤلِّفه حاضراً ، فإننا نتخلّص من تفسيراته وأعذاره ، ونبدأ بملاحظة التناقضات والطرق المسدودة في النص.
- فعندما يقول دريدا "لاشيء خارج النص" فهو لا يعني أن كل ما يهم هو عالم الكتب والكتابة ، وأن العالم الحقيقي ليس مهماً ، إذ أنه لا يُقلِّل من أهمية القضايا الاجتماعية الكامنة وراء النص. بل إن ما يرفضه دريدا هو القراءة التقليدية والتاريخية وتقسيم العصور ، لأنها تبحث في مؤثرات غير لغوية وتبعد الباحث عن الاختلافات اللغوية في النصوص. فكل شيء يوجد في المغايرة والتأجيل وسلسلة الاختلافات. أي أن النص يخلق واقعه ويفرض نفسه ويُكوِّن مجاله.
____
في علم الكتابة ، جاك دريدا ، ترجمة أنور مغيث ، منى طلبة ، المركز القومي للترجمة ، مصر.
مدخل إلى فلسفة جاك دريدا ، روجي لابورت ، ترجمة إدريس كثير - عز الدين الخطابي ، أفريقيا الشرق.
( التأجيل - الاختلاف - الحضور )
- لا يزال "جاك دريدا" الفيلسوف الأكثر إثارة للجدل في القرن العشرين وفي قرننا الحالي. يقترن اسمه في المقام الأول بالنظرية التفكيكية. وهي نظرية ذات نهج مُعقَّد ودقيق لكيفية قراءة وفهم طبيعة النصوص المكتوبة. والمقولة الأشهر لدريدا : "لا شيء خارج النص". ولنفهم ما تعنيه هذه العبارة لابُدّ من نظرة فاحصة عن نهج دريدا التفكيكي بشكل عام.
- يرى دريدا أنّنا عندما نختار كتاباً ما لمطالعته ، ككتاب فلسفة أو رواية مثلاً ، فإننا نتخيّل أن مابين أيدينا موضوع يمكن أن نفهمه وأن نُفسِّره كعمل متكامل قائم بحدِّ ذاته. فعلى سبيل المثال : تخيّل أنك ذهبت إلى المكتبة وحصلت على كتاب "في علم الكتابة" لمؤلِّفه "جاك دريدا" ، فإنك تتوقع بأنه سيكون لديك فكرة عامة وشاملة بمجرد قراءتك لهذا الكتاب. والواقع - برأي دريدا نفسه - أن النصوص لا تعمل على هذه الشاكلة بما في ذلك النصوص البديهية والبسيطة. لأنه - أي دريدا - يعتقد بأن كل النصوص تحتوي على ثغرات وتناقضات ، ولذا فإن مهمة التفكيكية هي إيجاد تلك الثغرات والتناقضات ، ومن خلال اكتشاف هذه الثغرات يتم توسيع دائرة فهمنا لتلك النصوص.
- النظرية التفكيكية إذن هي طريقة لقراءة النصوص وإظهار المفارقات والتناقضات الخفية إلى العلن ، أو بعبارة أخرى ( قراءة مابين السطور ). ويجب الأخذ في الاعتبار أنها - أي التفكيكية - ليست مجرد طريقة لقراءة الفلسفة والأدب ، فنظرية دريدا تثير التساؤل حول العلاقة بين اللغة والفكر والأخلاق.
- ومن المصطلحات التقنيّة المهمة التي تدور حولها نظرية دريدا : مصطلح "الإرجاء" أو "التأجيل" ، ومصطلح "الاختلاف". لنبدأ بفكرة "التأجيل" : نقول مثلاً ( رأى صديقي ) و نضيف ( سيارة بيضاء ) ثم نكمل ( في الشارع ) ونتابع الحديث (.....). مع كل كلمة نضيفها يطرأ تغييراً على معنى العبارة ، ويتغيّر معنى كلمة ( سيارة ) ، وبالتالي فإن كل معلومة تُضاف تؤدي إلى تأجيل المعنى الكامل للعبارة. وهناك أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار : حيث أن كلمة ( سيارة ) لا يرتكز معناها على السيارة الحقيقية الموجودة في العالم الخارجي ، لأن الكلمة تأخذ معناها من خلال موقعها في نسق اللغة ونظامها. ولذلك فكلمة ( سيارة ) لا تكتسب معناها بسبب الرابط الخفي بينها وبين السيارة الحقيقية بل تكتسب معناها من اختلافها عن كلمة ( دراجة ) أو ( عربة ) مثلاً ، وذلك ما يسميه دريدا ( الاختلاف ).
- النتيجة التي نتوصّل إليها من خلال مفهومي "التأجيل"
و "الاختلاف" : إن معنى أي شيء نقوله دائماً مؤجَّل لأنه يعتمد على ما سنضيفه ، والأمر الذي سنضيفه يعتمد معناه على ما سنضيفه لاحقاً ؛ وهكذا. ثم إن أي كلمة نقولها يعتمد معناها على الأمور الأخرى التي لا تعنيها أيضاً.
- لقد اعتاد الفلاسفة منذ القدم على اعتبار الكتابة انعكاس شاحب للكلمة المنطوقة. وتلك الأخيرة كانت تعدّ الوسيلة الأساسية للتواصل آنذاك. لكن دريدا يرى عكس ذلك : إذ عنده أن الكلمة المكتوبة تُظهِر أموراً لا يمكن للكلمة المنطوقة أن تكشفها. حتى أنه يُعتقد في الماضي أن المعنى يأتي من خلال الحضور ، ذلك أننا حين نتكلّم مع شخص ما بشكل مباشر ، وحصل التباس معين أثناء الحديث ، فإننا نستطيع أن نطلب من هذا الشخص أن يوضِّح ويزيل الالتباس ، وهذا أدى إلى الاعتقاد بأن المعنى بشكل عام يظهر من خلال هذا الحضور ؛ أي حضور الشخص بشكل مباشر. لكن دريدا يرى أننا حين نتعامل مع النص المكتوب ، فإننا نتحرِّر من طغيان هذا الحضور ، فمثلاً عندما نقرأ نصّاً لا يكون مؤلِّفه حاضراً ، فإننا نتخلّص من تفسيراته وأعذاره ، ونبدأ بملاحظة التناقضات والطرق المسدودة في النص.
- فعندما يقول دريدا "لاشيء خارج النص" فهو لا يعني أن كل ما يهم هو عالم الكتب والكتابة ، وأن العالم الحقيقي ليس مهماً ، إذ أنه لا يُقلِّل من أهمية القضايا الاجتماعية الكامنة وراء النص. بل إن ما يرفضه دريدا هو القراءة التقليدية والتاريخية وتقسيم العصور ، لأنها تبحث في مؤثرات غير لغوية وتبعد الباحث عن الاختلافات اللغوية في النصوص. فكل شيء يوجد في المغايرة والتأجيل وسلسلة الاختلافات. أي أن النص يخلق واقعه ويفرض نفسه ويُكوِّن مجاله.
____
في علم الكتابة ، جاك دريدا ، ترجمة أنور مغيث ، منى طلبة ، المركز القومي للترجمة ، مصر.
مدخل إلى فلسفة جاك دريدا ، روجي لابورت ، ترجمة إدريس كثير - عز الدين الخطابي ، أفريقيا الشرق.
👍20👎1
Forwarded from فريدريك نيتشه
اقتباسات مأخوذة من متن الدفاتر توضح بعض الأفكار الإشكالية وتسبر أسرارا
الفيلسوف نيتشه تعيد فرنسا تقديمه (مؤسسة نيتشه)
صدر حديثاً في باريس المجلد الثالث والأخير المخصص لكتابات الفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك نيتشه (1844-1900) في سلسلة "لا بلياد"، وهي أرقى سلسلة كتب تصدرها دار "غاليمار" الفرنسية، تضم روائع النصوص الأدبية والفلسفية الكلاسيكية منها والمعاصرة. فكل أديب أو فيلسوف تنشر أعماله في هذه السلسلة يحاط بهالة من الإعجاب، لكن هذه الهالة لا تعود لفخامة كتب السلسلة وطريقة صناعتها المتقنة، ولوريقات صفحاتها المذهبة التي تكاد لا تكون موازية لرقتها وحسب، بل لأسماء العمالقة من الأدباء والشعراء والفلاسفة الذين تنشر أعمالهم، بعد أن قضوا العمر في وضع نصوص إبداعية أثرت في تاريخ الأدب والفلسفة، فدخلوا بذلك الخلود من بابه الواسع.
خلافاً للجزأين الأولين المخصصين في المجموعة لمؤلفات نيتشه، لم يحمل الجزء الثالث عنوان "أعمال"، بل "هكذا تكلم زرادشت وكتابات أخرى"، إذ سلط الضوء على ترجمة فرنسية جديدة تناولت الكتاب الأشهر لفيلسوف "العود الأبدي. في هذا الجزء الثالث كما في الجزأين السابقين، انطلق القائمون على هذا المشروع من الطبعة العلمية الأولى لمؤلفات نيتشه التي حققها العالمان الإيطاليان جورجيو كولي ومازينو مونتيناري، والتي أصبحت على مر السنين مرجعاً لدراسة فريديريك نيتشه. وقد تولت دار غاليمار ترجمة هذه الطبعة العلمية بأكملها ونشرتها ضمن ما يعرف ب"السلسلة الرمادية". تجمع هذه الطبعة بين ثلاثة أنواع من النصوص: تلك التي نشرها نيتشه بنفسه، ثم تلك التي كتبها خلال السنة الأخيرة من حياته، أي في سنة 1888 قبل انهياره ودخوله مصحة الأمراض العقلية، وأخيراً النصوص التي كان قد أعدها للنشر. لم تكن هناك من مشكلة في نشر مراسلات نيتشه، التي حظيت بترجمة جديدة تحت إشراف جان لاكوست.
مشكلات وملاحظات
بدأت المشكلات الكبيرة تواجه القائمين على مشروع "لا بلياد"، حين وقعوا على كمية هائلة من الملاحظات والتأملات والمسودات خطها الفيلسوف على مفكرات ودفاتر غير منشورة، رافقت مجموع النصوص التي أعدها للنشر، من دون أي ترتيب آخر، سوى ترتيب التماعها في ذهنه.
كانت هذه الملاحظات كبيرة جداً، بحيث أمكن مقارنة حجمها بحجم كل الكتب التي نشرها نيتشه في حياته. كان القرار المنطقي أن يتم اختيار الملاحظات والتأملات المتسقة والأكثر قابلية للقراءة، لكن مصير الملاحظات والتأملات والتعليقات التي أعرض الناشر عن اعتمادها ظل يؤرق بال كثر، إذ غالباً ما اعتقد الباحثون أن أعمال نيتشه المنشورة تمثل ما قرر نيتشه أنه الأنسب للنشر. أما ما احتفظ به لنفسه، أي هذه الدفاتر التي يحيطها كثير من الجدل والتي تتعارض أحياناً مع بعض الآراء التي سبق لنيتشه نشرها، هي بالفعل ما يعبر عن آرائه الأكثر أصالة.
يعرف الدارسون لفكر فريديريك نيتشه أن الفيلسوف عمل لفترة طويلة على إعداد كتاب لم ينشره، اعتزم تسميته "إرادة القوة" أو "الاقتدار". غير أنه استعان في وضعه بعديد من الأفكار الواردة في متن الدفاتر، التي بثها أيضاً في كتابيه الصغيرين "المسيح الدجال" و"غروب الأوثان". فكان السؤال الملح عن مغزى استخدام هذه الدفاتر مجدداً وعن مغزى نشر ما ورد فيها كاملاً.
يروي القيمون على العمل كذلك أن الأمور سرعان ما تعقدت، بسبب من خاصية الكتابة النيتشوية واستخدامها المفرط للعبارات الاستفزازية والعنيفة أحياناً، لا سيما أن نيتشه كان متخصصاً بفقه اللغات اليونانية واللاتينية وعالماً بالآداب القديمة. ففي حين عبر الفيلسوف مراراً وتكراراً عن كراهيته للبانجرمانية ومعاداة السامية، فإنه ليس من الصعب الوقوع في دفاتره على صياغات كتابية، إن تم تنسيقها بشكل معين، تظهره كما لو أنه كان بالفعل معادياً للسامية وقريباً من الأيديولوجية النازية. أمام هذه الأخطار كان الحل المنطقي الوحيد هو الذي اعتمده وأوصى به في ما مضى كل من كولي ومونتيناري، ونشر مفكرات نيتشه ودفاتره بأكملها، بحسب ترتيب ظهورها الزمني، لذا كان هذا الإصدار هائلاً ومذهلاً، إذ شكل كنزاً لكل الدارسين والباحثين في فكر نيتشه. وقد تبنى القيمون عليه خيار تغذية تعليقاتهم التوضيحية في هوامش الكتب والنصوص المختلفة، باقتباسات استلت من متن هذه الدفاتر التي بإمكانها أن توضح بعض الأفكار الواردة في الكتب المنشورة. استعان المحررون، على سبيل المثال لا الحصر، بمجموعة من التعليقات والملاحظات كان نيتشه قد كتبها لـلو أندرياس سالومي توضيحاً لفكرته عن العود الأبدي، وقد وردت العبارة في مخطط كتابيه "إرادة القوة" و"هوذا الإنسان" وفي غيرهما من الكتب.
1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
Forwarded from فريدريك نيتشه
إعادة نظر
غير أنه من المؤسف اعتماد الترجمة الفرنسية نفسها لهذه الأفكار والتعليقات كما صدرت في المجموعة الرمادية منذ عام 1975، علماً أنها لم تكن سيئة، لكنها قديمة وتعود بشكل رئيس إلى نصف قرن تقريباً، ولو استفادت في بعض الأحيان من إعادة نظر ومراجعة. أما رائعة نيتشه "هكذا تكلم زرادشت"، التي نشرها عام 1883 فقد حظيت بترجمة جديدة تماماً، على رغم أن موريس دو غاندياك الذي تولى مهمة ترجمتها لأول مرة إلى اللغة الفرنسية كان عالماً متبحراً في الفلسفة اليونانية القديمة ونهضة العصور الوسطى وكتابات ديونيسيوس الأريوباجي، إلا أنه لم يكن شاعراً عالماً بفكر القرن الـ19.
لحظت الترجمة الجديدة للكتاب خصوصيات اللغتين الألمانية والفرنسية وجمالية كتابة شذرات نيتشه الشعرية في نص مثل "زرادشت" يقدمه الفيلسوف نفسه كنص مؤسس لحكمة شاعرية ودينية، واصفاً إياه بإنجيله الشخصي. والواقع أن نيتشه في "زرادشت" كان شاعراً أكثر منه فيلسوفاً، إذ قال عنه الأديب الألماني توماس مان إنه "أفضل من كتب باللغة الألمانية"، بعد أن اعترف نيتشه أنه أوصل اللغة الألمانية في هذا الكتاب إلى ذروة كمالها.
لا يسعنا في هذا المقال إلا أن نشيد بحساسية المترجمين الشاعرية، عنيت مارك دو لوناي ودوريان آستور. فليس كافياً إتقان اللغة الألمانية لكي تكون ترجمة كتب نيتشه جيدة، بل من الجيد أيضاً أن يكون لدى المترجم روح شاعرية وعمق فكري واستيعاب لفكر الفيلسوف الألماني الذي هدم بمطرقته العمارات النظرية والماورائيات، وتفكر في ابتكار قيم أخلاقية تتوافق مع نضالات الحياة الإنسانية وتطلعها نحو الإنسان الأعلى، الذي يملك وحده بحسبه القدرة على احتمال فكرة العود الأبدي، التي أعلنها في كتابه "العلم الجذل".
لو سالومه روضت نيتشه وفتنت فرويد وحنت على ريلكه
في النهاية إن قراءة نصوص نيتشه وأعماله الكاملة في سلسلة "لا بلياد" هي بالتأكيد متعة حقيقية، إن لناحية ترجمتها الفرنسية الجديدة التي أزالت بعض الصيغ اللغوية القديمة وما رافقها من التباسات وتحريفات طاولت مصطلحاته وأفكاره الأساسية إن نحن قارناها بالترجمات الأخرى التي فصلها بعض المترجمين أحياناً على مقاس معارفهم، أو لناحية إدراجها في سلسلة الخالدين من دون إغفال أي جملة أو فكرة خطها قلم هذا العبقري.
قدمت هذه الفلسفة معايير ثقافية جديدة من جهة ثوريتها وشاعريتها وجمال لغتها ودقة معانيها المتأصلة في الفيلولوجيا الكلاسيكية، ومن جهة تأثرها بالموسيقى، وقراءة كاتبها لشوبنهاور والمسرحيين والفلاسفة اليونانيين وإحباطاته من الثقافة الألمانية في أيامه.
جاهد نيتشه في حياته لطبع مؤلفاته، ولم يساوره الشك إطلاقاً أن كتبه ستترك أثراً ثقافياً كبيراً وأنها ستلعب دوراً في دفع عجلة تسريح الطاقات الديونيزية الكامنة في الإنسان التي أعلن زرادشت إطلاقها، ناظراً إليها كمنقذ محتمل من عدمية الثقافة الأوروبية في القرن الـ19، رافضاً فكرة الثوابت الكونية قائلاً إن ما ندعوه "حقيقة"، هو في الواقع "كم من الاستعارات والكنايات والتشبيهات والأوهام". وعلى هذا النحو يكون كتابه المسمى "هكذا تكلم زرادشت"، الذي وصفه مؤلفه بأنه "كتاب للجميع وليس لأحد"، والذي عده من ضمن أهم أعماله، قد أظهر بجلاء فكره، وهو إلى ذلك بيان في التغلب على الذات ومصدر إلهام لكثر.
في "زرادشت" وظف نيتشه الحيوان والأرض والهواء والنار والماء والنباتات والكواكب السماوية لخدمة بيان الارتقاء الروحي لهذا النبي المتأمل صاحب الإرادة القوية والعقل الراجح والصوت الضاحك الراقص، تاركاً دلالات تأملاته الفلسفية مفتوحة على باب التأويلات التي لا تحد ولا تحصر.
(فريدريش نيتشه: هكذا تكلم زرادشت وكتابات أخرى. الجزء الثالث. أشرف على نشرها مارك دو لوناي بالتعاون مع دوريان أستور، باريس، غاليمار، مجموعة "لا بلياد")
2
👍2
▪️ الفلسفة عندما تصبح متاحة للجميع عبر لذة القراءة
الفرنسي أندريه كونت سبونفيل يجمع 600 اقتباس من فلاسفة العالم
يعد أندريه كونت-سبونفيل المولود في باريس سنة 1952 واحداً من جيل الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين الذين حاولوا جعل الفلسفة متاحة لعدد كبير من الناس، محققاً أمنية ديدرو الذي دعا منذ ما يقارب القرون الثلاثة إلى وضع الفكر الفلسفي في متناول الجميع، وقول لودفيغ فيتغنشتاين المشدد على أن الفلسفة ليست مذهباً أو تياراً أو عقيدة بقدر ما هي نشاط فكري بحت. طبع سبونفيل بعفويته وحيويته الساحة الفلسفية الفرنسية، بعد أن سلك مسلكاً مغايراً لمسلك سارتر أو ميرلوبونتي أو فوكو أو دريدا أو دولوز، مذ نشر كتابه "مقالة صغيرة في الفضائل الكبيرة" (1995) الذي بيع كثيراً، وترجم إلى أكثر من 24 لغة.
من أحدث إصدارات كونت - سبونفيل كتابه المسمى "لذة التفكير" (منشورات فويبير). شجع فيه كل من أراد ممارسة النشاط الفلسفي، أي فهم الأفكار والتفكير بنفسه، أن ينطلق أولاً من أفكار الآخرين، لا سيما أفكار كبار الفلاسفة. ذاك أن "طريق الاستقلال الفلسفي" مغامرة تتطلب جهداً وقراءة وتملك أدوات التساؤل والمفاهيم وطرائق التحليل ودقة المنطق والتأمل ومهارات أخرى مختلفة، لن يستطيع أحد أن يصل إليها بمفرده ما لم يستند في البداية إلى قراءة نصوص وأفكار الآخرين، وقد فاضت بها قرائح مبدعين منذ ما يزيد على الـ20 قرناً، مما جعل من الفلسفة معيناً لا ينضب.
لذا جمع كونت-سبونفيل في كتابه هذا نحو 600 اقتباس واستشهاد، اختارها بدقة من كتابات عظماء الفلاسفة منذ ولادة الفلسفة في القرن السادس قبل الميلاد حتى اليوم، موزعاً إياها على 12 موضوعاً رئيساً هي: الأخلاق والسياسة والحب والموت والمعرفة والحرية والله والإلحاد والفن والزمان والإنسان والحكمة. شكلت هذه الاقتباسات والاستشهادات، بمعنى ما، مقدمة عامة أو لنقل مدخلاً جميلاً إلى الفلسفة سيثير بالتأكيد اهتمام كل من أراد "التفكير بشكل أفضل، لكي يعيش بصورة أفضل".
ويقول كونت - سبونفيل إن تعلم التفكير الفلسفي لا عمر له، مؤكداً أن الإنسان يستطيع أن يفكر دون أن يكون فيلسوفاً، كما في العلوم، كما يمكن له أن يعيش دون أن يفكر، فيسترشد بعاطفته أو يكتفي بأنه لا يدري أنه لا يدري، لكن الإنسان لا يمكن له أن يفكر في حياته وأن يعيش بحسب أفكاره على أفضل وجه بعيداً من الفلسفة. فما الفلسفة؟ وما طرائق التفكير الفلسفي؟
يجيب أندريه كونت-سبونفيل على هذا السؤال بقوله إن "الفلسفة ليست علماً، ولا حتى معرفة، بل هي تأمل في المعارف المتاحة"، أسئلة أكثر منها أجوبة، ومسار "أكثر منها نقطة وصول".
ليست الفلسفة إذاً مجموعة من المعارف التي يمكن تعلمها، بل هي طريقة في استخراج الأسئلة من الموضوعات، لذا لا يمكن، وفق ما قال إيمانويل كانط (1724-1804)، تعلم الفلسفة، لكن الإنسان يستطيع تعلم كيفية التفلسف، أي كيفية طرح الأسئلة والتفكير بنفسه، من خلال مساءلة أفكاره الخاصة وأفكار الآخرين، ومن خلال مساءلة العالم والمجتمع، وإعادة النظر في كل ما حصله من تجارب واختبارات حياتية، والبحث عما يجهله أو خفي عنه. من هذه الزاوية تصبح كتابات كبار الفلاسفة سراجاً ينير سبيل التفكير بشكل أفضل. ولعل كل واحد منا إن تمكن من قراءة نصوص هؤلاء الفلاسفة، سيحقق بحسب كونت-سبونفيل هدف التفكير بنفسه بشكل أسرع وأعمق. فليست هذه النصوص وكتابها، على ما يقول الفيلسوف الفرنسي في استعادة لفكرة كانطية، إلا مجرد فرصة لممارسة فكرية حرة، ولمراجعة الأفكار بأنفسنا، وسبر أغوارها في عملية تفكيك دائمة، إذ ليس من أحد يستطيع أن يفكر بدلاً منا. ولئن كان للفلسفة متخصصوها ومحترفوها ومعلموها، فأنها ليست تخصصاً أو مهنة، بقدر ما هي، في المقام الأول، بعد أساس من أبعاد الوجود الإنساني.
يقول كونت-سبونفيل، على سبيل المثال لا الحصر، إن "البيولوجيا لن تخبر عالم الأحياء أبداً عن كيفية العيش، أو عن ضرورته، أو عما إذا كان عليه أن يكون عالم أحياء". ولن تخبر العلوم الإنسانية الفرد كذلك عن قيمة الإنسانية. لذا كانت الفلسفة ضرورية، لأن الإنسان مدعو بطبعه للتأمل، مدفوع إلى النظر في معارفه وفي أنماط عيشه ورغباته. فليس من معرفة كافية تقيه "شر السؤال". لا الفن ولا الدين ولا السياسة ولا الأخلاق ولا حتى العلوم المختلفة، على أهميتها، قادرة على الإجابة عن كل التساؤلات الإنسانية. ولعلها هي نفسها في حاجة إلى أن تكون موضع تساؤل. هكذا يبدأ، بحسب كونت-سبونفيل، السير على دروب الفلسفة وتفكيرها المنطقي المستقل، غير الخاضع لإجماع الآخرين على أفكار معينة.
1
الفرنسي أندريه كونت سبونفيل يجمع 600 اقتباس من فلاسفة العالم
مارلين كنعان أستاذة الفلسفة والحضارات، كاتبة وباحثة
يعد أندريه كونت-سبونفيل المولود في باريس سنة 1952 واحداً من جيل الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين الذين حاولوا جعل الفلسفة متاحة لعدد كبير من الناس، محققاً أمنية ديدرو الذي دعا منذ ما يقارب القرون الثلاثة إلى وضع الفكر الفلسفي في متناول الجميع، وقول لودفيغ فيتغنشتاين المشدد على أن الفلسفة ليست مذهباً أو تياراً أو عقيدة بقدر ما هي نشاط فكري بحت. طبع سبونفيل بعفويته وحيويته الساحة الفلسفية الفرنسية، بعد أن سلك مسلكاً مغايراً لمسلك سارتر أو ميرلوبونتي أو فوكو أو دريدا أو دولوز، مذ نشر كتابه "مقالة صغيرة في الفضائل الكبيرة" (1995) الذي بيع كثيراً، وترجم إلى أكثر من 24 لغة.
من أحدث إصدارات كونت - سبونفيل كتابه المسمى "لذة التفكير" (منشورات فويبير). شجع فيه كل من أراد ممارسة النشاط الفلسفي، أي فهم الأفكار والتفكير بنفسه، أن ينطلق أولاً من أفكار الآخرين، لا سيما أفكار كبار الفلاسفة. ذاك أن "طريق الاستقلال الفلسفي" مغامرة تتطلب جهداً وقراءة وتملك أدوات التساؤل والمفاهيم وطرائق التحليل ودقة المنطق والتأمل ومهارات أخرى مختلفة، لن يستطيع أحد أن يصل إليها بمفرده ما لم يستند في البداية إلى قراءة نصوص وأفكار الآخرين، وقد فاضت بها قرائح مبدعين منذ ما يزيد على الـ20 قرناً، مما جعل من الفلسفة معيناً لا ينضب.
لذا جمع كونت-سبونفيل في كتابه هذا نحو 600 اقتباس واستشهاد، اختارها بدقة من كتابات عظماء الفلاسفة منذ ولادة الفلسفة في القرن السادس قبل الميلاد حتى اليوم، موزعاً إياها على 12 موضوعاً رئيساً هي: الأخلاق والسياسة والحب والموت والمعرفة والحرية والله والإلحاد والفن والزمان والإنسان والحكمة. شكلت هذه الاقتباسات والاستشهادات، بمعنى ما، مقدمة عامة أو لنقل مدخلاً جميلاً إلى الفلسفة سيثير بالتأكيد اهتمام كل من أراد "التفكير بشكل أفضل، لكي يعيش بصورة أفضل".
الفلسفة بلا عمر
ويقول كونت - سبونفيل إن تعلم التفكير الفلسفي لا عمر له، مؤكداً أن الإنسان يستطيع أن يفكر دون أن يكون فيلسوفاً، كما في العلوم، كما يمكن له أن يعيش دون أن يفكر، فيسترشد بعاطفته أو يكتفي بأنه لا يدري أنه لا يدري، لكن الإنسان لا يمكن له أن يفكر في حياته وأن يعيش بحسب أفكاره على أفضل وجه بعيداً من الفلسفة. فما الفلسفة؟ وما طرائق التفكير الفلسفي؟
يجيب أندريه كونت-سبونفيل على هذا السؤال بقوله إن "الفلسفة ليست علماً، ولا حتى معرفة، بل هي تأمل في المعارف المتاحة"، أسئلة أكثر منها أجوبة، ومسار "أكثر منها نقطة وصول".
ليست الفلسفة إذاً مجموعة من المعارف التي يمكن تعلمها، بل هي طريقة في استخراج الأسئلة من الموضوعات، لذا لا يمكن، وفق ما قال إيمانويل كانط (1724-1804)، تعلم الفلسفة، لكن الإنسان يستطيع تعلم كيفية التفلسف، أي كيفية طرح الأسئلة والتفكير بنفسه، من خلال مساءلة أفكاره الخاصة وأفكار الآخرين، ومن خلال مساءلة العالم والمجتمع، وإعادة النظر في كل ما حصله من تجارب واختبارات حياتية، والبحث عما يجهله أو خفي عنه. من هذه الزاوية تصبح كتابات كبار الفلاسفة سراجاً ينير سبيل التفكير بشكل أفضل. ولعل كل واحد منا إن تمكن من قراءة نصوص هؤلاء الفلاسفة، سيحقق بحسب كونت-سبونفيل هدف التفكير بنفسه بشكل أسرع وأعمق. فليست هذه النصوص وكتابها، على ما يقول الفيلسوف الفرنسي في استعادة لفكرة كانطية، إلا مجرد فرصة لممارسة فكرية حرة، ولمراجعة الأفكار بأنفسنا، وسبر أغوارها في عملية تفكيك دائمة، إذ ليس من أحد يستطيع أن يفكر بدلاً منا. ولئن كان للفلسفة متخصصوها ومحترفوها ومعلموها، فأنها ليست تخصصاً أو مهنة، بقدر ما هي، في المقام الأول، بعد أساس من أبعاد الوجود الإنساني.
يقول كونت-سبونفيل، على سبيل المثال لا الحصر، إن "البيولوجيا لن تخبر عالم الأحياء أبداً عن كيفية العيش، أو عن ضرورته، أو عما إذا كان عليه أن يكون عالم أحياء". ولن تخبر العلوم الإنسانية الفرد كذلك عن قيمة الإنسانية. لذا كانت الفلسفة ضرورية، لأن الإنسان مدعو بطبعه للتأمل، مدفوع إلى النظر في معارفه وفي أنماط عيشه ورغباته. فليس من معرفة كافية تقيه "شر السؤال". لا الفن ولا الدين ولا السياسة ولا الأخلاق ولا حتى العلوم المختلفة، على أهميتها، قادرة على الإجابة عن كل التساؤلات الإنسانية. ولعلها هي نفسها في حاجة إلى أن تكون موضع تساؤل. هكذا يبدأ، بحسب كونت-سبونفيل، السير على دروب الفلسفة وتفكيرها المنطقي المستقل، غير الخاضع لإجماع الآخرين على أفكار معينة.
1
👍6❤1🎉1
العيش فلسفياً
وإذا كانت الفلسفة تتحدد بوصفها العيش بحسب العقل، وهو القدرة الذهنية على الربط والتوحيد والتفسير والتأسيس، ولا تقبل معياراً آخراً سواه، ولو وضعت ما جاء به هذا العقل دوماً على بساط البحث، فهي من ثم عبارة عن استنطاق جذري لكل شيء، وسعي دائم نحو الحقيقة القصوى. والفلسفة بخلاف العلوم، لا تسعى وراء حقائق فردية، بل تتطلع من خلال إنشاء واستخدام المفاهيم، ونظر العقل في ذاته والتأمل في تاريخه الخاص وتاريخ الإنسانية، وفي بعض الأحيان، في تاريخ الأنظمة والنظريات، إلى نقد الأوهام والأحكام المسبقة والأيديولوجيات، وفق اتساق فكري ومنطقي صارم، غرضه بناء عمارة فكرية متماسكة ومترابطة، خالية من التناقضات. فكل فلسفة هي معركة بمعنى ما، سلاحها العقل وأعداؤها الغباء والتعصب والظلمة الفكرية. أما حلفاؤها، فهم بالتأكيد العلوم والمعارف والإنسان نفسه.
لا تبقي الفلسفة إذاً ميداناً من الميادين خارج إطار بحثها. فكل المسائل من وجهة نظر كونت-سبونفيل قابلة للتحول إلى موضوع فلسفي، مؤكداً بذلك قول موريس ميرلوبونتي (1908-1961) إن "مركز الفلسفة في كل مكان ودائرتها اللامكان".
هكذا يراجع كتاب أندريه كونت-سبونفيل على طريقته الأسئلة الأربعة التي لخص بها الفيلسوف الألماني كانط ميدان التفكير الفلسفي حين أراد أن يكشف عن مهامه وضرورته، وهي على التوالي: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟ ماذا يجوز لي أن آمل؟ ما الإنسان؟ غير أن كونت-سبونفيل أضاف إلى هذه الأسئلة في هذا الكتاب سؤالاً خامساً: كيف يجب عليَّ أن أعيش؟ ولعل محاولة الإجابة بذكاء عن هذا السؤال تشكل بظنه الخطوة الأولى في ممارسة الفعل الفلسفي. وبما أنه من الصعب جداً على الإنسان تجنب طرح هذا السؤال، يستنتج الفيلسوف الفرنسي أن الإنسان لا يمكنه الهرب من الفلسفة، فهي له دوماً بالمرصاد، مما يعني أن لذة الفلسفة تكمن في السؤال الدائم عن العالم والإنسان والعدالة والسعادة والموت والله والمعرفة والجهل. "فليس الإنسان سوى كائن يفكر".
من هذه الزاوية كان التفكير الفلسفي عند كونت-سبونفيل ضرورة، حتى يستطيع كل واحد منا عيش حياة أكثر إنسانية ووضوحاً وسكينة وعقلانية، حياة أكثر سعادة وكثافة وحرية. وهذا بالضبط تحديد الحكمة في التراث الفلسفي. فهل يمكن للإنسان بلوغ الحكمة وتحقيق السعادة؟ يجيب أندريه كونت-سبونفيل عن هذا السؤال بقوله إن الوصول إلى الحكمة التامة والسعادة الكاملة أمر غير متاح لنا، لكن ذلك لن يمنعنا من السعي نحو الحكمة والعمل الدؤوب على الاقتراب منها. ولعل الفلسفة، كما كتب كانط، هي بالتحديد هذا الجهد غير المكتمل الذي يبذله الإنسان في سبيل تطلعه نحو الحكمة والسعادة.
في إطار هذا المسعى يتساءل أندريه كونت-سبونفيل في "لذة التفكير" عن الفلسفة الواجب درسها، بسبب من وجود عديد من المقاربات والمدارس والتيارات الفلسفية. فكان جوابه أن كل التيارات الفلسفية على تباينها مهمة، بقدر ما تحثنا على التفكير والعمل على الوصول إلى الحكمة والسعادة، ذلك أن وظيفة الفلسفة لم تعد بحسبه بناء المفاهيم والأنساق الفكرية ونقلها من جيل إلى جيل، بقدر ما أصبحت نمط عيش. هكذا يتلاقى جواب الفيلسوف الفرنسي مع ما أراده للفلسفة المفكرون الأولون أمثال أبيقور وديوجينس وسنيكا أو الفلاسفة الكلاسيكيون أمثال ميشيل دو مونتاني وبليز باسكال وباروخ سبينوزا وغيرهم من الذين اهتموا بالوجود بدلاً من الاهتمام بالمشكلات الإبستيمولوجية الصرفة. فليست الفلسفة بالنسبة إليهم سوى طريق، وليس أساتذتها ومعلموها سوى بطاقات دخول أو ومضات تضيء سواء السبيل. من هنا كانت قراءة فلسفات الآخرين بالنسبة إلى كونت-سبونفيل نقطة الانطلاق في كل مشروع فكري جدي يريد الوصول إلى لذة التفكير الذاتي، ذلك أن قراءة كتابات كبار الفلاسفة تعني في الوقت عينه الاستناد إلى أفكارهم ومجابهتها، في محاولة للوصول إلى رؤيتنا الخاصة، ولو شكلت هذه الأفكار، بمعنى ما، عقبة أمام بناء فكرنا، لعمقها وعظمتها.
هذا هو برأي كونت-سبونفيل التحدي الحقيقي الذي يواجه الفكر الفلسفي المعاصر، ولعله هو الذي يدفعنا إلى التفكير بذاتنا بغية إيجاد فهمنا الخاص للحياة وللعالم ولإعطائهما معنى يصعب على الإنسان العيش من دونه. أشير في الختام إلى أن كتاب "لذة التفكير" كتاب ملهم وجميل وغني بموضوعاته. هو عبارة عن تمرين في الفلسفة للجميع، ينطلق من استشهادات قيمة اختارها، وعلق عليها واحد من أشهر الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين
2
👍9
الذي ليس لديه أيّ حسٍّ فلسفيّ، هو انسانٌ يعبر الوجود وهو مسجونٌ في الأحكام القبلية التي يتلقاها من الحس المشترك والمعتقدات المألوفة لزمانه ووطنه والقناعات المتراكمة التي طوّرها دون تعاون وموافقة عقله.
- برتراند راسل
- برتراند راسل
👍21
Forwarded from فرانز كافكا
لعل ما يميز كافكا هو تعدد تصنيف فكره من قبل دارسيه، فهناك من يعتبره بأنه مفكر ديني لأنه يؤمن بالمطلق أو الإله-هذا التصنيف نجده عند صديقه ماكس برود- وبالمقابل هناك من يعتبره بأنه ينتمي إلى النزعة الإنسانية التي تنتصر للإنسان بغض النظر عن ارتباطه بالإله. بالإضافة إلى ذلك فهناك تأويلات مختلفة فيما يخص حياة كافكا، فمثلا" بيير كلوسوسكي" يرى أن حياة كافكا وسيرته الذاتية هي نموذج لشخص مريض يرغب في الشفاء ، بينما يرى "جون ستاغوبينسكي" بأن كافكا مثل رجل غريب مسه سوء الطالع .
يرى موريس بلانشو بأن هذه القراءات والتأويلات المتعددة لفكر كافكا وحياته الخاصة تعكس سوء فهم لقراءة تريد أن تحفظ لنفسها حق حل الأحجية . إن ما يفسر هذا المعطى المرتبط بالقراءة الفكرية لكافكا هو أن أسلوبه في الكتابة يعتمد على الأسلوب الشذري في الكتابة ، بالإضافة إلى هذا فالعالم الكافكوي- القصصي والروائي- هو عالم على حد تعبير بلانشو عالم متهم وغير مقفل، انه عالم اللاعدالة والخطأ بمعنى أن أدب كافكا لامتناهي من حيث المعنى يفرض على القارئ أن يكون قارئا مؤولا مطالب باحترام مقتضيات النص أي بدراسته في شكله وتشكُّله وباحترام مقتضيات الفهم أي بتتبع حركية المعنى ومحاولة الوقوف على الأرض الصلبة. ومن الممكن أن نذكر من المراحل التي يتبعها المؤول، مرحلة الوصف ومرحلة التفسير ومرحلة التأويل ومرحلة التقييم.
1 – الوصف أو التوصيف: هو تحديد مجموع المواصفات والشروط والعلاقات التي تؤسس النص أي تحديد المستوى السيمانطيقي ومعرفة الطبيعة النوعية للكتابة التي ينتمي إليها. وبما أن لغة الأدب قد تجعل العلامات منفصلة عن الأشياء ومنفتحة على الخيال فإنها تقدم إمكانية إيجاد أبنية جديدة تجعل النص في صورته الخاصة موجودا بالقوة فقط أو موجودا مع وقف التنفيذ. ولذلك ينبغي للمؤول في هذه المرحلة أن يستفيد من الدراسات اللغوية أو من الدراسات البنيوية ليفتح منفذا إلى الاضطراب الحاصل بين كيان النص وكينونته أو بين عالمه وحقيقته أو بين إشكالية الكتابة وإشكالية القراءة …على أن الوصف قد لا يكون موضوعيا أو تاما ومن ثم قد يكون موجِّها لعملية التأويل منذ البداية، وتلك إحدى المزالق التي يحف بها .
2 – التفسير: وهو محاولة إقامة تلاؤم سيمانطيقي جديد في النص لإزالة الغرابة واستعادة أو خلق الألفة المفقودة فيه، بمعنى التعرف على المقامات أو السياقات التي تفيد في فهمه أو تجعله ذا معنى يساعد على إنجاز المرجعية التي ظلت معلقة. ورغم أن الأثر يفيد بما يجعل منه آلية تمثُّل البنيات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، وبما ينم عن انشغالات القراء زمن إنشائه، وبما يحدد دوره ومنزلته ضمن صيرورة التاريخ وفي جدلية الفن والواقع، فإن السياقات الخارجية قد لا تفيد كثيرا في عملية التأويل، لأن القارئ أو الناقد المؤول ينظر إلى ملابسات الجانب التقني في بناء النص وليس إلى مُرْفَقَاته. فالنص الشعري مثلا يفسر في نطاق مستلزمات الشعر ومقومات النوع وليس فقط فيما قد يحتويه من أثر السياقات الخارجية وعليه فإن مشكلة التأويل تتجاوز ما يدعي النص أنه يقوله أو لا يقوله، وتعني بالأحرى تلك الكيفية التي يحدد بها السياق تأويل المقول. ومع ذلك أو لذلك فإن التفسير قد لا يزيل كل الغموض، وبالتالي قد لا يصل التأويل إلى المدى المطلوب.
3 – التأويل: يتتبع التأويل إذن وفق المراحل السابقة حركية المعنى في النص متجها إلى العالم ومستهدفا استخلاص الحقيقة من الفن أو معرفة الباطن من وراء الظاهر. فهو بسط للوسائط الممكنة بين الأدب أو غير الأدب والناس.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from فرانز كافكا
وإذا كان الكاتب غائبا لحظة القراءة فهو محمول حسابه في التأويل، أي في فهمه من خلال فهم كتابته، وهو مصداق قولة ( ديلتي Dilthey ) مثلا: « إن الغاية النهائية للتأويل هي أن نفهم الكاتب أكثر مما فهم هو نفسه »
4 – التقويم: وهو الحكم أو التقدير الذي يأتي في نهاية التأويل، ورغم أنه قد لا يكون صائبا أو شاملا إلا أنه يدفع إلى امتلاك المعنى العميق في النص برمته وتنزيله منزلته ضمن مراتب المعرفة العامة.
يعتبر موريس بلانشو أن كافكا كان شغوفا بالأدب إلى حد القول "أنه لا يريد أن يكون شيئا أخر غير الأدب" . من خلال هذا المقتطف نستنتج أن الأدب بالنسبة لكافكا يحتل مكانة رفيعة في حياته، انه الملاذ الوحيد من ضجر الحياة التي كان يعيشهاً. فالكتابة الأدبية الكافكوية هي تعبير عن رفض الأشياء التافهة، رفض للعمل اليومي الذي تطبعه الرتابة والآلية، ورفض للعلاقة مع الآخرين، ورفض حتى لذاته ، كل ذلك تثبته لنا يوميات كافكا.
إن قراءة الأدب الكافكوي لن تكون ممكنة إلا إذا قراناه في تاريخيته ، فالأعمال الأدبية لكافكا مستقاة من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان يعيش فيه، وهي الفترة الزمنية التي ظهرت فيها أشكال متعددة من السلط القهرية على الإنسان المعاصر. ولعل أبرز هذه القوى التسلطية هي الأنظمة الشمولية التي ظهرت في القرن العشرين في أروبا، كالنازية في ألمانيا، والفاشية في ايطاليا. وما يميز وضعية الإنسان آنذاك هو فقدانه لحريته وإحساسه بالاغتراب، وتحوله إلى أداة وعبد للآلة التي اقتحمت حياته اقتحاما لتنزوي أمام ذلك إنسانية الإنسان والجانب الروحي فيه إلى أقصى درجات الانزواء. في ظل تلك الظروف التاريخية التي عاش فيها كافكا كان من البديهي أن يتأثر بهذه الوضعية التراجيدية للإنسان المعاصر، نجد هذا المعطى حاضر بشكل واضح في روياته الأدبية مثل: "القلعة"و"القضية" و"أمريكا". يذهب الكثير من النقاد الأدبيين أن هذه الرويات إنما ينتقد فيها كافكا نظام وسلوك البيروقراطية كنموذج من نماذج السلطة التي تنزل كل أشكال الظلم والجور والتعامل اللانساني على البطل الفرد في روياته، ويقابلها فعلا على مستوى الواقع وضعية الأفراد الذين فقدوا قدرتهم على الفعل أمام هذه السلطة البيروقراطية.
يعتبر "جون ماكوري" بأن كافكا هو أعظم الكتاب الوجوديين، فمن خلال روايته "المحاكمة" يمكن أن نجد فيها هذا المعطى حاضر بشكل قوي، حيث يجد البطل نفسه فجأة ماثلا أمام المحكمة ولا يستطيع حتى أن يكتشف طبيعة التهمة الموجهة إليه. هذه القراءة لفكر كافكا إنما هي قراءة خاصة لأن كل قراءة كما يؤكد على ذلك موريس بلانشو إلا وتكون خائنة بشكل من الأشكال.
يقول كافكا في يومياته" كل ما لا يمث صلة بالأدب أشمئز منه وأبغضه "، من خلال هذا المقتطف لكافكا نستشف المكانة الكبيرة التي يليها للأدب، يراه موريس بلانشو أنه مرتبط أشد الارتباط بالكتابة إلى حد أنه يوما ما فكر في الموت عندما كان ملزما بالعمل داخل معمل أبيه لمدة خمسة عشر يوما ستمنعه من الكتابة .
يفترض هذا الشيء حسب بلانشو التساؤل حول ماهية الأدب عند كافكا، فكيف إذن يقرأ بلانشو الكتابة الأدبية عند كافكا؟
إن الأدب عند كافكا هو سؤال حول معنى الحياة، هو ذلك السؤال الذي يغوص في الأعماق وفي التفاصيل، وهذا حسب بلانشو هو جوهر الأدب عندما يصبح سؤالا. الكتابة عند كافكا لا تؤسس على وظيفة جمالية، ولا تستهدف أن تكون تعبيرا عن رواية واقعية، إن ذلك ليس من الكتابة في شيء، بل الكتابة عند كافكا هي الملاذ الوحيد للخلاص من ضجر الحياة ورتابتها وفقدان المعنى . يعتبر موريس بلانشو أن الأدب عند كافكا يشبه تلك الطريقة التي كانت سائدة في القرن العشرين، وهي الكتابة التلقائية، ما فحوى هذه الطريقة في الكتابة؟
الكتابة التلقائية هو ذلك النوع الأدبي الذي ساد في القرن العشرين مع ظهور تيارات أدبية كالسريالية، وهي اتجاه أدبي حاول محاربة عنصر الوعي في الكتابة، فأداعت في بعض الأذهان، أن الكتابة ليست دائما لحظات من الوعي متصلة، بل إنها كثيرا ما تنفلت من سلطان الوعي، وقد تتخلص من هيمنته، وحينئذ يكون اللاوعي وحده هو مصدر العطاء والتدفق والثراء.
إن الأدب حسب بلانشو لن يكون ممكنا إلا بوجود مجموعة من الشروط من بينها:
- أن يكون الكاتب فنانا جيدا
- أن يتحلى الكاتب بحس جمالي
- أن يتقن الكاتب مهنة البحث عن الكلمات والصور.
2️⃣
4 – التقويم: وهو الحكم أو التقدير الذي يأتي في نهاية التأويل، ورغم أنه قد لا يكون صائبا أو شاملا إلا أنه يدفع إلى امتلاك المعنى العميق في النص برمته وتنزيله منزلته ضمن مراتب المعرفة العامة.
يعتبر موريس بلانشو أن كافكا كان شغوفا بالأدب إلى حد القول "أنه لا يريد أن يكون شيئا أخر غير الأدب" . من خلال هذا المقتطف نستنتج أن الأدب بالنسبة لكافكا يحتل مكانة رفيعة في حياته، انه الملاذ الوحيد من ضجر الحياة التي كان يعيشهاً. فالكتابة الأدبية الكافكوية هي تعبير عن رفض الأشياء التافهة، رفض للعمل اليومي الذي تطبعه الرتابة والآلية، ورفض للعلاقة مع الآخرين، ورفض حتى لذاته ، كل ذلك تثبته لنا يوميات كافكا.
إن قراءة الأدب الكافكوي لن تكون ممكنة إلا إذا قراناه في تاريخيته ، فالأعمال الأدبية لكافكا مستقاة من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان يعيش فيه، وهي الفترة الزمنية التي ظهرت فيها أشكال متعددة من السلط القهرية على الإنسان المعاصر. ولعل أبرز هذه القوى التسلطية هي الأنظمة الشمولية التي ظهرت في القرن العشرين في أروبا، كالنازية في ألمانيا، والفاشية في ايطاليا. وما يميز وضعية الإنسان آنذاك هو فقدانه لحريته وإحساسه بالاغتراب، وتحوله إلى أداة وعبد للآلة التي اقتحمت حياته اقتحاما لتنزوي أمام ذلك إنسانية الإنسان والجانب الروحي فيه إلى أقصى درجات الانزواء. في ظل تلك الظروف التاريخية التي عاش فيها كافكا كان من البديهي أن يتأثر بهذه الوضعية التراجيدية للإنسان المعاصر، نجد هذا المعطى حاضر بشكل واضح في روياته الأدبية مثل: "القلعة"و"القضية" و"أمريكا". يذهب الكثير من النقاد الأدبيين أن هذه الرويات إنما ينتقد فيها كافكا نظام وسلوك البيروقراطية كنموذج من نماذج السلطة التي تنزل كل أشكال الظلم والجور والتعامل اللانساني على البطل الفرد في روياته، ويقابلها فعلا على مستوى الواقع وضعية الأفراد الذين فقدوا قدرتهم على الفعل أمام هذه السلطة البيروقراطية.
يعتبر "جون ماكوري" بأن كافكا هو أعظم الكتاب الوجوديين، فمن خلال روايته "المحاكمة" يمكن أن نجد فيها هذا المعطى حاضر بشكل قوي، حيث يجد البطل نفسه فجأة ماثلا أمام المحكمة ولا يستطيع حتى أن يكتشف طبيعة التهمة الموجهة إليه. هذه القراءة لفكر كافكا إنما هي قراءة خاصة لأن كل قراءة كما يؤكد على ذلك موريس بلانشو إلا وتكون خائنة بشكل من الأشكال.
يقول كافكا في يومياته" كل ما لا يمث صلة بالأدب أشمئز منه وأبغضه "، من خلال هذا المقتطف لكافكا نستشف المكانة الكبيرة التي يليها للأدب، يراه موريس بلانشو أنه مرتبط أشد الارتباط بالكتابة إلى حد أنه يوما ما فكر في الموت عندما كان ملزما بالعمل داخل معمل أبيه لمدة خمسة عشر يوما ستمنعه من الكتابة .
يفترض هذا الشيء حسب بلانشو التساؤل حول ماهية الأدب عند كافكا، فكيف إذن يقرأ بلانشو الكتابة الأدبية عند كافكا؟
إن الأدب عند كافكا هو سؤال حول معنى الحياة، هو ذلك السؤال الذي يغوص في الأعماق وفي التفاصيل، وهذا حسب بلانشو هو جوهر الأدب عندما يصبح سؤالا. الكتابة عند كافكا لا تؤسس على وظيفة جمالية، ولا تستهدف أن تكون تعبيرا عن رواية واقعية، إن ذلك ليس من الكتابة في شيء، بل الكتابة عند كافكا هي الملاذ الوحيد للخلاص من ضجر الحياة ورتابتها وفقدان المعنى . يعتبر موريس بلانشو أن الأدب عند كافكا يشبه تلك الطريقة التي كانت سائدة في القرن العشرين، وهي الكتابة التلقائية، ما فحوى هذه الطريقة في الكتابة؟
الكتابة التلقائية هو ذلك النوع الأدبي الذي ساد في القرن العشرين مع ظهور تيارات أدبية كالسريالية، وهي اتجاه أدبي حاول محاربة عنصر الوعي في الكتابة، فأداعت في بعض الأذهان، أن الكتابة ليست دائما لحظات من الوعي متصلة، بل إنها كثيرا ما تنفلت من سلطان الوعي، وقد تتخلص من هيمنته، وحينئذ يكون اللاوعي وحده هو مصدر العطاء والتدفق والثراء.
إن الأدب حسب بلانشو لن يكون ممكنا إلا بوجود مجموعة من الشروط من بينها:
- أن يكون الكاتب فنانا جيدا
- أن يتحلى الكاتب بحس جمالي
- أن يتقن الكاتب مهنة البحث عن الكلمات والصور.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
هذه الشروط حسب بلانشو لن يكون لها معنى وجدوى إلا إذا كان الأديب أديبا حتى النهاية، وأن يؤمن بالأدب وأن يضحي من أجله ، ويضرب بلانشو المثال بكافكا الذي أراد في أخر أيام حياته أن تحرق كتاباته القصصية والأدبية، ليس لأنه يراها مخلة أخلاقيا، بل كان يراها لا تصل لمرتبة الكمال، ولكن لحسن حظنا أن صديقه "ماكس برود" قام بإخراج كتابات كافكا إلى الوجود.
نستخلص من كل ما سبق أن الكتابة الكافكوية شكلت لحظة تاريخية مهمة في خريطة الأدب العالمي، وقد أثرت كتاباته على مجموعة من الروائيين والأدباء والفلاسفة في العالم سواء في الغرب أو الشرق. هذا التأثير الكفكاوي يرجع بالأساس إلى طبيعة الكتابة والأسلوب والقضايا التي كان كافكا يتناولها في رواياته وقصصه القصيرة؛ إذ أنه يلجأ في الكتابة إلى عنصر الخيال والإبداع الفني والأسلوب الشذري، كل ذلك أدى إلى خلق قراءات متعددة ومختلفة التأويلات، مما يؤكد على مكانته في الأدب العالمي برمته، فكافكا رغم قصر حياته أنتج لنا كقراء زخما هائلا من الإنتاجات الأدبية مستقاة من تجاربه في حياته الخاصة من جهة، ومن واقع الإنسان الأوروبي في بدايات القرن العشرين من جهة أخرى.
يري موريس بلانشو أن الأدب عند كافكا عالم منفتح من المعنى والدلالة، وهذا ما يجعله قابل لتأويلات متعددة قد تصل إلى حد التناقض.
3️⃣
🟧
📎 رابط قنواتنا الأدبية والفكرية 📘 🛎
نستخلص من كل ما سبق أن الكتابة الكافكوية شكلت لحظة تاريخية مهمة في خريطة الأدب العالمي، وقد أثرت كتاباته على مجموعة من الروائيين والأدباء والفلاسفة في العالم سواء في الغرب أو الشرق. هذا التأثير الكفكاوي يرجع بالأساس إلى طبيعة الكتابة والأسلوب والقضايا التي كان كافكا يتناولها في رواياته وقصصه القصيرة؛ إذ أنه يلجأ في الكتابة إلى عنصر الخيال والإبداع الفني والأسلوب الشذري، كل ذلك أدى إلى خلق قراءات متعددة ومختلفة التأويلات، مما يؤكد على مكانته في الأدب العالمي برمته، فكافكا رغم قصر حياته أنتج لنا كقراء زخما هائلا من الإنتاجات الأدبية مستقاة من تجاربه في حياته الخاصة من جهة، ومن واقع الإنسان الأوروبي في بدايات القرن العشرين من جهة أخرى.
يري موريس بلانشو أن الأدب عند كافكا عالم منفتح من المعنى والدلالة، وهذا ما يجعله قابل لتأويلات متعددة قد تصل إلى حد التناقض.
المرجع/Maurice blanchout/ De kafka a kafka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
صفاء ذياب
لم تتوقف الصرعات الثقافيَّة عراقياً، أو عربياً، عند حدٍّ معيّن، بل نعيش مع كلِّ عقد جديد صرعة جديدة تأخذ ردحاً من الزمن، يتفاعل الناس معها، وتبدأ تغيّر من طريقة حياتهم، حتَّى تبدأ بالخفوت، ومن ثمَّ تبرز صرعة أخرى نعيشها بتفاصيلها كلّها، في مرحلة أخرى.فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي، كان هناك ما عُرف حينها بالتنوير، على الرغم من تأخّرنا في التأثّر به، ففي الوقت الذي انطلق فيه في سبعينيات القرن التاسع عشر في حلب بسوريا وطرابلس بلبنان والقاهرة والإسكندرية في مصر، كنّا غائبين عن هذه التحوّلات التي طرأت على حياة جيراننا، حتَّى بدأنا نعي ذلك على يد الزهاوي والرصافي زمناً قصيراً، لتبدأ أزمات بناء الدولة وما تبعها من تحوّلات.
وإذا أردنا أن نقف عند الصرعات الثقافية الحقيقية، فلا نجد أكثر من الوجودية في خمسينيات القرن العشرين، وما تبعها من حركات ثقافية وفنية غيّرت من شأن الثقافة العراقية... غير أنَّ تلك الصرعات أو البنى الثقافية كانت مبنية على أسس علمية، أنتجها فلاسفة، ليس أولهم سارتر، ولا آخرهم كولن ولسون، وغيرهما.
إلاَّ أنَّ ما يحدث في زمن الميديا والتواصل الاجتماعي أنَّ هناك صرعات أخرى، بدأت بالرواية، حتَّى عُدَّ ديستويفسكي من الروائيين الذين أعيد اكتشافهم من جديد، فضلاً عن كتابات نيتشه، غير أنّنا نواجه حالياً مرحلة أخرى، وهو ظهور متحدّثين بالفلسفة، يسعون لتقديمها على طبق من السطحية والسذاجة، وكأنَّها مطيّة العصر الجديد.. إلى درجة أنَّهم يؤلفون كتباً لا تعرف مرجعياتها، ويدعون من قبل مؤتمرات عربية للحديث عن تجربتهم وقراءاتهم الفلسفية، من دون أن يكون لديهم أدنى معرفة حقيقية بها...
فهل تراجع دور الفيلسوف أو الباحث في الفلسفة مقابل الفاشنستا والبلوكر، وما الذي أدى إلى بروزهم على الواجهة بمقالات لا علاقة لها بفن التفكير، أو دعوتهم لمؤتمرات فلسفية لمجرد أنَّهم مشهورون؟
أفكار متناقضة
يؤكّد الدكتور علي المرهج أنّه لم يكن هناك دور فاعل للفيلسوف في ما سبق حتَّى نقول إنّه تراجع في زمن الفاشنيستا.. كما أنّه لم يكن للفلسفة والفيلسوف تأثير كبير في الحياة الاجتماعية المباشرة للناس في الزمن الكلاسيكي بقدر ما كان خطاباً نخبوياً قد تظهر تأثيراته في بناء الفكر والمجتمع لاحقاً، أي في مجتمع مستقبلي.. فلم تكن فلسفة الفارابي على سبيل المثال مؤثرة في المجتمع الذي كان يعيش فيه ولا الفلاسفة الذين جاؤوا بعده، قد يكون سقراط فاعلاً في الحياة العامة للناس، ولكنه مع ذلك حُكم عليه بالإعدام..
أن يبرز اليوم بعض المتحدّثين في الفلسفة ويجدون لهم حضوراً في وسائل التواصل الاجتماعي هذا أمر قد يبدو ضاراً في ما نعرفه عن شرفية الفلسفة النظرية، ولكنّه في الوقت نفسه قد يُقرب بعض الناس للفلسفة والسعي لمعرفة أهميتها.
في الأحوال كلّها، إنَّ دور من يتحدث في الفلسفة وقضاياها ويعمل على توكيد أهميتها في اليومي والمعاش لا يشبه في أيِّ حال من الأحوال ما تُقدّمه الفاشنستات ولا البلوكرات كما يُقال، لأنَّ الأول يدعو لتقريب الخطاب الفلسفي من المجتمع والناس، والثاني يمارس دور التغبية والتعمية على هذا الدور.
أن نعترض على من يقدّم القضايا الفلسفية بأسلوب مبسّط قد يفقدها بعض صرامتها لا يعني أنَّه يُشارك في تخريب مقاصد القول الفلسفي. فالفلسفة تبقى عصية على الفهم إن بقي الفلاسفة كما يقال في برجهم العاجي. نحتاج لمؤسّسات ثقافية وأكاديمية تدعمها الدولة لتكون ظهيراً لمن يتصدّى لنشر القول الفلسفي في الفضاء العام والكشف عن قيمته الجمالية ونقده إن كان فيه خروج عن مقتضيات هذا القول في الحفاظ على استقلالية القول الفلسفي ونزعته النقدية.
أتفق أنَّ شهرة البعض في نشرهم مقالات فلسفية أو تحدّثهم في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني أنَّهم يفقهون الفلسفة وتاريخها النقدي بقدر ما يقتنص فكرة من هذا الكاتب المعروف في عطائه الفلسفي أو ذاك ليملؤوا مقالاتهم وما ينشرونه من فيديوات بأقوال تبدو متناقضة أحياناً لأنَّها مأخوذة من كُتّاب لهم توجّهات فكرية متناقضة.
فيلسوف الزور
ويشير الدكتور علي عبود المحمداوي إلى أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي تؤدّي دوراً خطيراً على صعيد التسطيح والبلاهة والاستهلاك المفرط للصور والمعلومات، بغضِّ النظر عن معيارية الحقيقة.
عالم اليوم المليء بالصور المصطنعة لم يزد الطين إلَّا بلّة حتّى وصل الأمر إلى الفلسفة التي تُعدُّ أعلى مستويات التفكير الناقد والفاحص لتجرّد هذه الوسائل من جدّيتها ومنهجها، ولتصبح سلعة بيد من يريد التحلّي والادعاء والتلوّن بصبغة الفيلسوف.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍2
ونتيجةً لذلك أصبح الادعاء بالتفلسف موضة لمن هو أبعد ما يكون أصلاً عن الفلسفة، وأتاح الأمر كثرة ضخ المعلومات الزائفة ورواج العلوم الزائفة لكثرة مريديها ومدّعي الشهادات والتخصّص.
الفاشينيستا والبلوكرات بمختلف صورهم في وسائل التواصل أصبحوا يقرّرون الكثير ممَّا يسمّى حقيقةً ويقلبون الطاولة على كلِّ ما يجب أن يكون بمعيار كمّي يحدّده عدد المتابعين أو المريدين الإلكترونيين، وهذا ما ساهم في ديمومة علو كعب البعض على الفيلسوف الحقيقي ليتصدّر المشهد ما يسمى بفيلسوف الزور والميديا.
وما سبق هو جزء من طبيعة تنامي الوضع الاستهلاكي الرأسمالي الذي بدأ يتغوّل إلى مرحلة الاستهلاك الصوري المفرط الذي هيمن على ما يسمّى بالسيمولاكرا، وحوّل وقائعنا كلّها إلى صور شبحية بلا مرجعية حقيقية.
نظام الرثاثة
ويصف الدكتور حيدر دوشي هذا الإلحاح في الحاجة إلى الفلسفة في العراق والعالم العربي بعقدة (ألكترا)، فهو ظاهر في ما ينثر من كتابات (الصفحات الثقافية) للصحف والمجلات ومداخل الكتب وخواتيمها، بل قد خصّصت له كتب ومؤتمرات قائمة برأسها. مترافقاً مع الإحساس بغياب القول الفلسفي العراقي والعربي الأصيل والمتسق مع نفسه.
إنَّ شريحة من ذوي البساطة الفكرية تسيّدت الفضاء العام بإدمانها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، رأت في الفلسفة ترفاً فكرياً لا ضرر من الأخذ به إن تيسّر ذلك أو إكسسواراً لابدَّ من الإلمام به ظنَّاً في نفسها القدرة على سدِّ حاجة الفكر العراقي والعربي إلى غياب الفلسفة. فخرجت علينا بفيض من الطروحات ذات العناوين الفلسفية وبخيارات مزاجية سعياً وراء آخر الصيحات الفكرية في الغرب، لو فحصت لوجدناها، لا تعدو أن تكون تبسيطاً لمذاهب فكرية قائمة في بلاد المنشأ، أو ترويجاً لها. أو هي تعليقات شخصية، أو هوامش على متون غائمة في عقول كاتبيها. أريد لها أن تكون معاصرة برطانة عن الحداثة وما بعد الحداثة ونهاية التاريخ وموت الفلسفة، إلى ما هنالك من شعارات وكليشيهات جاهزة، ولا يكتفون بذلك، بل يرون أنَّها الحلول لمشكلات واقعنا.
في حين أنَّ ما ينتج عن هذه هو تدهور في متطلّبات الجودة، وغياب الرؤية، وتهشّم في منظومة القيم الثقافية، وبروز الذوق الرديء، وابتعاد ذوي الكفاءة، فتخلو الساحة من التحديات التي هي أحد الأسباب المهمة في بروز الأفكار المبدعة. ويجعل المجتمعات تكافئ الرداءة عوضاً عن السعي لإيجاد الجدّية والجودة. إنَّ ما يبدو فوضى في أماكن متناثرة، هو في الواقع نظام من الرثاثة الفكرية التي تمدُّ جذورها في المجتمعات بزحف مرعب.
جوهر الفلسفة
وبحسب الدكتور مؤيد الأعاجيبي، تُعَدُّ الفلسفة أحد العلوم التي تستهدف فهم الوجود وطبيعة الحياة من خلال التأمّل والتساؤل العميق. ينصبُّ هدفها في تحديد رؤية للحياة الجيدة التي ينبغي للإنسان أن يسعى لتحقيقها، وذلك من خلال التفكير النقدي والتطوُّر المستمر في مستوى المعرفة. يُعَدُّ هذا الانخراط في التفكير العميق والتحليل الفلسفي إنجازاً بحدِّ ذاته، تاريخيّاً منذ العصور اليونانية، مروراً بفترة النهضة، وصولاً إلى القرن العشرين.
وقد منح للفلسفة لقب “موضة العصر” في العصر الحديث نظراً لشهرتها وتأثيرها الكبير في الفكر والمجتمع. أمَّا اليوم فأصبح العكس، إذ أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الشهرة الفلسفية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يحظى هؤلاء الأفراد، المعروفون بالبلوكرات، بجماهير ضخمة، مستغلين إمكانيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لكنَّ الأمر اللافت هو أنَّ هؤلاء يظهرون في توجّه غير مألوف، إذ يصبحون متصدّين للفلسفة بليلة وضحاها برغم عدم تخصّصهم في هذا المجال. وهو ما أدّى إلى تراجع مكانة الفلسفة في المجتمع بنظر المتخصّصين فيها، إذ يُبرَز- الفاشنيستيون- بنشر محتوى فيديو سطحي حول الفلسفة، يقلّل من قيمتها الفكرية والنقدية، ويقترب من تقديمها كموضوع يُفاخرون به بدون أن يتسنّى لهم فهم جوهرها. تتسارع هذه الظاهرة بفعل تسليط الضوء على الفلسفة بشكل غير عميق ومبتذل، إذ يعتقد جمهورهم أنَّ هذه الأفكار البسيطة هي جوهر الفلسفة! ما يؤدّي إلى تقييمها بشكل سلبي بدون توجيه نظرة نقدية مستنيرة.
ويبيّن الدكتور رائد جبار كاظم أنَّه في كلِّ فن أو مجال يتقن صاحبه الخطاب البياني والأسلوب الإنشائي لا العلمي ولا التخصّص الأكاديمي الدقيق، احتمالية صعوده وسطوع نجمه في سماء ذلك المجال أمر وارد جداً، ولكن بنسب ضئيلة، حسب الظروف التي تمنحه تلك الشهرة، لكنَّ المتتبّع لتلك الفئة في المجتمع وذلك النمط من أنصاف المثقفين يجدهم يتطفّلون في تخصّصات مختلفة لا علاقة لهم بها ولا هم من ذوي التخصّص العام أو الدقيق في ذلك العلم أو الحقل الذي يكتبون أو يتكلمون فيه ومنه الفلسفة، إذ إنَّنا اليوم نجد أشخاصاً يكتبون ويتكلمون ويحاورون بالفلسفة ويخوضون غمارها في الندوات والمؤتمرات والمقالات بدون أيّ شهادة أو تحصيل علمي يؤهّل ذلك الشخص لخوض ذلك الغمار، الأمر الذي يجعل صاحبه يقع في الفخ
2️⃣
الفاشينيستا والبلوكرات بمختلف صورهم في وسائل التواصل أصبحوا يقرّرون الكثير ممَّا يسمّى حقيقةً ويقلبون الطاولة على كلِّ ما يجب أن يكون بمعيار كمّي يحدّده عدد المتابعين أو المريدين الإلكترونيين، وهذا ما ساهم في ديمومة علو كعب البعض على الفيلسوف الحقيقي ليتصدّر المشهد ما يسمى بفيلسوف الزور والميديا.
وما سبق هو جزء من طبيعة تنامي الوضع الاستهلاكي الرأسمالي الذي بدأ يتغوّل إلى مرحلة الاستهلاك الصوري المفرط الذي هيمن على ما يسمّى بالسيمولاكرا، وحوّل وقائعنا كلّها إلى صور شبحية بلا مرجعية حقيقية.
نظام الرثاثة
ويصف الدكتور حيدر دوشي هذا الإلحاح في الحاجة إلى الفلسفة في العراق والعالم العربي بعقدة (ألكترا)، فهو ظاهر في ما ينثر من كتابات (الصفحات الثقافية) للصحف والمجلات ومداخل الكتب وخواتيمها، بل قد خصّصت له كتب ومؤتمرات قائمة برأسها. مترافقاً مع الإحساس بغياب القول الفلسفي العراقي والعربي الأصيل والمتسق مع نفسه.
إنَّ شريحة من ذوي البساطة الفكرية تسيّدت الفضاء العام بإدمانها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، رأت في الفلسفة ترفاً فكرياً لا ضرر من الأخذ به إن تيسّر ذلك أو إكسسواراً لابدَّ من الإلمام به ظنَّاً في نفسها القدرة على سدِّ حاجة الفكر العراقي والعربي إلى غياب الفلسفة. فخرجت علينا بفيض من الطروحات ذات العناوين الفلسفية وبخيارات مزاجية سعياً وراء آخر الصيحات الفكرية في الغرب، لو فحصت لوجدناها، لا تعدو أن تكون تبسيطاً لمذاهب فكرية قائمة في بلاد المنشأ، أو ترويجاً لها. أو هي تعليقات شخصية، أو هوامش على متون غائمة في عقول كاتبيها. أريد لها أن تكون معاصرة برطانة عن الحداثة وما بعد الحداثة ونهاية التاريخ وموت الفلسفة، إلى ما هنالك من شعارات وكليشيهات جاهزة، ولا يكتفون بذلك، بل يرون أنَّها الحلول لمشكلات واقعنا.
في حين أنَّ ما ينتج عن هذه هو تدهور في متطلّبات الجودة، وغياب الرؤية، وتهشّم في منظومة القيم الثقافية، وبروز الذوق الرديء، وابتعاد ذوي الكفاءة، فتخلو الساحة من التحديات التي هي أحد الأسباب المهمة في بروز الأفكار المبدعة. ويجعل المجتمعات تكافئ الرداءة عوضاً عن السعي لإيجاد الجدّية والجودة. إنَّ ما يبدو فوضى في أماكن متناثرة، هو في الواقع نظام من الرثاثة الفكرية التي تمدُّ جذورها في المجتمعات بزحف مرعب.
جوهر الفلسفة
وبحسب الدكتور مؤيد الأعاجيبي، تُعَدُّ الفلسفة أحد العلوم التي تستهدف فهم الوجود وطبيعة الحياة من خلال التأمّل والتساؤل العميق. ينصبُّ هدفها في تحديد رؤية للحياة الجيدة التي ينبغي للإنسان أن يسعى لتحقيقها، وذلك من خلال التفكير النقدي والتطوُّر المستمر في مستوى المعرفة. يُعَدُّ هذا الانخراط في التفكير العميق والتحليل الفلسفي إنجازاً بحدِّ ذاته، تاريخيّاً منذ العصور اليونانية، مروراً بفترة النهضة، وصولاً إلى القرن العشرين.
وقد منح للفلسفة لقب “موضة العصر” في العصر الحديث نظراً لشهرتها وتأثيرها الكبير في الفكر والمجتمع. أمَّا اليوم فأصبح العكس، إذ أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الشهرة الفلسفية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يحظى هؤلاء الأفراد، المعروفون بالبلوكرات، بجماهير ضخمة، مستغلين إمكانيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لكنَّ الأمر اللافت هو أنَّ هؤلاء يظهرون في توجّه غير مألوف، إذ يصبحون متصدّين للفلسفة بليلة وضحاها برغم عدم تخصّصهم في هذا المجال. وهو ما أدّى إلى تراجع مكانة الفلسفة في المجتمع بنظر المتخصّصين فيها، إذ يُبرَز- الفاشنيستيون- بنشر محتوى فيديو سطحي حول الفلسفة، يقلّل من قيمتها الفكرية والنقدية، ويقترب من تقديمها كموضوع يُفاخرون به بدون أن يتسنّى لهم فهم جوهرها. تتسارع هذه الظاهرة بفعل تسليط الضوء على الفلسفة بشكل غير عميق ومبتذل، إذ يعتقد جمهورهم أنَّ هذه الأفكار البسيطة هي جوهر الفلسفة! ما يؤدّي إلى تقييمها بشكل سلبي بدون توجيه نظرة نقدية مستنيرة.
ويبيّن الدكتور رائد جبار كاظم أنَّه في كلِّ فن أو مجال يتقن صاحبه الخطاب البياني والأسلوب الإنشائي لا العلمي ولا التخصّص الأكاديمي الدقيق، احتمالية صعوده وسطوع نجمه في سماء ذلك المجال أمر وارد جداً، ولكن بنسب ضئيلة، حسب الظروف التي تمنحه تلك الشهرة، لكنَّ المتتبّع لتلك الفئة في المجتمع وذلك النمط من أنصاف المثقفين يجدهم يتطفّلون في تخصّصات مختلفة لا علاقة لهم بها ولا هم من ذوي التخصّص العام أو الدقيق في ذلك العلم أو الحقل الذي يكتبون أو يتكلمون فيه ومنه الفلسفة، إذ إنَّنا اليوم نجد أشخاصاً يكتبون ويتكلمون ويحاورون بالفلسفة ويخوضون غمارها في الندوات والمؤتمرات والمقالات بدون أيّ شهادة أو تحصيل علمي يؤهّل ذلك الشخص لخوض ذلك الغمار، الأمر الذي يجعل صاحبه يقع في الفخ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
منذ أوّل لقاء أو تقويم من قبل المتخصّصين في هذا المجال، ويعتقد ذلك الشخص أنَّه أتى بفصل المقال في ذلك المجال، ولا أحمّل ذلك الشخص المسؤولية وحدها، بل يتحمّلها الجميع، من متخصّصين ونقّاد وقرّاء، لأنَّ شيوع مثل تلك الظاهرة أمر يستحق الوقوف عنده وتقييمه، وبيان حسناته من سيئاته، ولا نرفض ذلك المتطفّل فقط، بل نعمل على تقدير من يجتهد ويجيد البحث والكتابة والقول في هذا المجال من خارج التخصّص ممّن تتوفّر فيه سمات الكاتب والباحث المجتهد الذي يرغب في تثقيف نفسه ثقافة صادقة تضعه في مصاف المثقفين المخلصين في بحثهم العلمي الأمين.
كما أنَّ عزوف المتخصّصين عن الكتابة والغياب الدائم في مجال تخصّصهم يلقي باللوم عليهم لأنَّهم تركوا الساحة فارغة وتخلّوا عن دورهم الأساس في الحضور الفكري والثقافي، ما جعل الآخرين من غير المتخصّصين يشغلون الفراغ ويملؤون الساحة بما يمتلكون من أدوات وجرأة، ولكنَّ الشيء الذي نخافه هو اتساع تلك الدائرة وتحوّلها إلى موضة تحرمنا من متعة التخصص والبحث العلمي الرصين.
أسمال الفيلسوف
ويختتم الباحث صلاح محسن حديثنا بقوله إنَّ القرن العشرين شهد ازدهاراً قلَّ نظيره للتيّارات والمذاهب الفلسفية، في فرنسا؛ موطن الموضة والأزياء، كانت الأوساط الثقافية والفكرية تتزيَّا بأحدث صرخات الموضة الخاصّة بها أيضاً، من الماركسية إلى الوجودية إلى البنيوية.. إلخ، فحتّى الجاكيت التي يرتديها هايدغر هي من تصميم أبيلوده، كان غادمير يقول كنَّا نسميها الجاكيت الوجودية، وظهرت طبقة من طلبته يقلّدونه حتّى في سعاله؟ طبعاً لا أنفي أنَّ هذه التيارات وليدة شروط اجتماعية وتاريخية كانت سبباً في ظهورها، من الاحتدام والصراع الأيديولوجي والحرب الباردة التي كانت أهم جبهاتها الجبهة الثقافية. وعلى الرغم من أهمية الفلسفة في تنشيط ونشر الوعي، ونشر ثقافة التفكير النقدي، لكنَّها ليست عصا سحرية وترياقاً شافياً لأزمة هذا العصر، وسط جهل مطبق للثقافة العلمية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والمستقبليات والتقنيات التي تؤثّر في حياتنا تأثيراً مباشراً... لدينا “فقر دم” واضح في الثقافة العلمية. من جهة أخرى أنا مع تسهيل الفلسفة ونشرها، لكن من دون الإساءة إلى جوهرها، الكل يطالب بالتبسيط، وهو يعلم أنَّ معرفته بالحساب وجمع الأرقام يختلف تماماً عن معادلات الرياضيات العليا وتعقيداتها الحسابية، لماذا لا يطلب من الرياضيين الشيء نفسه؟ عصر البلوكر الفلسفي علامة أفول للمجلّات الجادّة والجريدة الورقية التي كانت سابقاً الطريق الملكي والمصيدة المثلى للقرّاء الممكنين، وشكلاً من أشكال شعوذات التنمية البشرية يتزيّا بأسمال الفيلسوف. أمَّا من يدّعي وصلاً بها يدرك أنَّها إكسسوار ثقافي لامع وباهر، لكنَّه يهرب عند الوصول إلى أعقد أجزائها.
3️⃣
كما أنَّ عزوف المتخصّصين عن الكتابة والغياب الدائم في مجال تخصّصهم يلقي باللوم عليهم لأنَّهم تركوا الساحة فارغة وتخلّوا عن دورهم الأساس في الحضور الفكري والثقافي، ما جعل الآخرين من غير المتخصّصين يشغلون الفراغ ويملؤون الساحة بما يمتلكون من أدوات وجرأة، ولكنَّ الشيء الذي نخافه هو اتساع تلك الدائرة وتحوّلها إلى موضة تحرمنا من متعة التخصص والبحث العلمي الرصين.
أسمال الفيلسوف
ويختتم الباحث صلاح محسن حديثنا بقوله إنَّ القرن العشرين شهد ازدهاراً قلَّ نظيره للتيّارات والمذاهب الفلسفية، في فرنسا؛ موطن الموضة والأزياء، كانت الأوساط الثقافية والفكرية تتزيَّا بأحدث صرخات الموضة الخاصّة بها أيضاً، من الماركسية إلى الوجودية إلى البنيوية.. إلخ، فحتّى الجاكيت التي يرتديها هايدغر هي من تصميم أبيلوده، كان غادمير يقول كنَّا نسميها الجاكيت الوجودية، وظهرت طبقة من طلبته يقلّدونه حتّى في سعاله؟ طبعاً لا أنفي أنَّ هذه التيارات وليدة شروط اجتماعية وتاريخية كانت سبباً في ظهورها، من الاحتدام والصراع الأيديولوجي والحرب الباردة التي كانت أهم جبهاتها الجبهة الثقافية. وعلى الرغم من أهمية الفلسفة في تنشيط ونشر الوعي، ونشر ثقافة التفكير النقدي، لكنَّها ليست عصا سحرية وترياقاً شافياً لأزمة هذا العصر، وسط جهل مطبق للثقافة العلمية والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والمستقبليات والتقنيات التي تؤثّر في حياتنا تأثيراً مباشراً... لدينا “فقر دم” واضح في الثقافة العلمية. من جهة أخرى أنا مع تسهيل الفلسفة ونشرها، لكن من دون الإساءة إلى جوهرها، الكل يطالب بالتبسيط، وهو يعلم أنَّ معرفته بالحساب وجمع الأرقام يختلف تماماً عن معادلات الرياضيات العليا وتعقيداتها الحسابية، لماذا لا يطلب من الرياضيين الشيء نفسه؟ عصر البلوكر الفلسفي علامة أفول للمجلّات الجادّة والجريدة الورقية التي كانت سابقاً الطريق الملكي والمصيدة المثلى للقرّاء الممكنين، وشكلاً من أشكال شعوذات التنمية البشرية يتزيّا بأسمال الفيلسوف. أمَّا من يدّعي وصلاً بها يدرك أنَّها إكسسوار ثقافي لامع وباهر، لكنَّه يهرب عند الوصول إلى أعقد أجزائها.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤1🔥1
لا يتعلق الأمر بمدى قصر حياتنا ، ولكن يتعلق باضاعتنا الكثير منها . إن الحياة طويلة بالقدر الكافي إن استتغلناها بالطريقة المناسبة ، ولكن إن سكبناها في بالوعة الاهمال وإن لم نوظفها من اجل اهداف جيدة، فسنرى في النهاية أنها مرت وانتهت قبل أن نلحظ ذلك . وبالتالي حياتنا ليست قصيرة ، بل نحن من يجعلها قصيرة .
سنيكا من كتابه " محاوراة السعادة والشقاء "
سنيكا من كتابه " محاوراة السعادة والشقاء "
👍19❤7
الإله أو المحرك الأول عند أرسطو:
إن الطبيعة عند أرسطو هي مبدأ للحركة وللكون وبالتالي فإن دراسة الطبيعة تتطلب تفسيراً للحركة، وقسم أرسطو فعل الحركة إلى مُحرّك ومتحرك ووظيفة المحرك أن يخرج الجسم الساكن من حالة القوة إلى حالة الفعل. فالحركة عند ارسطو هي فعل ناقص يتطلب محرك لتتجه من القوة إلى الفعل.
وقد ربط أرسطو بين الحركة وطبيعة الأشياء وقال أن الحركة هي فعل مرسوم له غاية وهدف حسب صور الجسم الطبيعي وحسب القوى الكامنة فيه.
وأيضاً قال إنه يوجد لواحق للحركة فبعد حدوثها تولد عدة أشياء هي : اللامتناهي والمكان والزمان والتغير.
وقسم أرسطو الحركة إلى ثلاثة أنواع:
١- حركة العنصر الذي يتجه إلى مكانه الخاص
٢- حركة الكائن الحي
٣- حركة السماوات
ولأن الحركة لا تصدر من دون محرك عند أرسطو فإن المحرك، في حركة الجماد يستلزم محرك من خارج يحرك الجسم حسب طبيعته.
وحركة الكائن الحي، النفس هي المحرك والمتحرك هو الجسم.
أما حركة السماوات ترجع إلى المحرك الأول وتحته طائفة من المحركين الفرعيين وهم محركي الكواكب.
وليس في العقل الإلهي أو المحرك الأول أي نوع من العمليات العقلية الإنسانية كالإحساس والتخيل والتفكير.وهو غير منفعل لا عن طريق ذاته أو عن طريق سبب خارجي، وفعله واحد لا يتغير وهو يفعل بالضرورة لا اختياراً وهو خارج العالم وعلى غائية لحركته وبالرغم من انه علة للعالم إلا أنه لا يعلم شيئاً عن هذا العالم ولا يهتم به.
فالغرض من المحرك الأول عند أرسطو هو الدفعة الأولى للوجود، بالرغم من أن الوجود أزلي عند أرسطو لكن لابد من جوهر أزلي يمثل حركة السماوات.
المحرك الأول هو مصدر الحركة للسماوات تحته محركين آخرين مسئولين عن حركة الكواكب ولكل كوكب محرك خاص به. وهذا المحرك الأول لا يعلم عن العالم شيئاً ولا يهتم بما يحدث فيه ولا يهتم بأي كائن حي ولكن وجوده ضرورة منطقية فقط تسلسلا لمنطق أرسطو في الحركة وأن لكل حركة محرك.
لمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة كتاب: أرسطو ملامح الفكر الفلسفي والديني للدكتور محمد علي أبو ريان أستاذ الفلسفة كلية الآداب جامعة الاسكندرية.
❤12👍6🔥1