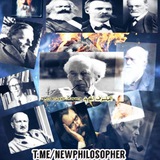من الناس من إذا أسدى جميلًا إلى شخص سارع بتسجيله في حسابه كدَينٍ مُستحَق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير أنه يضمر في نفسه أن هذا الشخص مدينٌ له ويعي جيدًا بما فعله. وهناك صنفٌ ثالثٌ هو بمعنى ما لا يعي ما أتاه ولا يَحشُد له ذِهنَه، وإنما هو كالكَرْمة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي مقابل.٤ الفَرسُ وقد أتم السباق، والكلبُ وقد طارد «اللصوص»، والنحلةُ وقد أَفرغَت عسلها، والإنسان الذي أَسدَى معروفًا؛ لا يلحظ أيٌّ من هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهودًا، بل يمضي إلى فعلٍ جديد كما تمضي الكَرْمة لِتُقدِّم عناقيدَ جديدةً في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون الخيرات دون أن يُلاحِظوها.
التأملات
ماركوس أوريليوس
التأملات
ماركوس أوريليوس
❤12👍1
… قلت إنني شككت في كل شيء على الإطلاق … في شهادة الحواس وأحكام العقل ووجود العالم، غير أني سرعان ما لاحظت أنه بينما كنت أريد أن أعتقد أن كل شيءٍ باطل، فقد كان حتمًا وبالضرورة أن أكون أنا صاحب هذا التفكير شيئًا من الأشياء … نعم إن شيئًا واحدًا يظل بمنجاةٍ من الشك، وهو الفكر، أنا واثق من أنني أفكر، وحتى لو شككت في أنني أفكر فهذا الشك يقتضي أن أفكر أيضًا، وأنا حين أشك، وحين أفكر، وحتى حين أخطئ في تفكيري لا بد أن أكون موجودًا.
أنا أفكر فأنا إذن موجود Cogito Ergo Sum.
ها أنا ذا قد أزحت التراب والحصى والأنقاض، فخلصت إلى الصخرة الثابتة التي أقيم عليها صرح الفلسفة التي أتحراها، أنا أفكر فأنا إذن موجود … قضيةٌ صحيحة بالضرورة كلما نطقت بها وكلما تصورتها في ذهني، وهي من الثبات والوثوق بحيث تعجز كل حجج الشكاك عن زعزعتها، ولو استطاع الروح الخبيث أن يضلني في كل شيء فلن يستطيع أن يمنعني من اليقين أن ذاتي موجودة حين أفكر.١
… غير أن الكوجيتو الذي يعطيني وجودي بأوثق الحدوس يجعلني من جهة أخرى في عزلةٍ تامة هي عزلة فكري الخاص، فلا أتبين سبيلًا للخروج منها ولا أبلغ أي وجودٍ من الموجودات خارج نفسي؛ لذا سأبذل جهدي للإفلات من عزلةٍ لو طالت لجعلت المعرفة البشرية كلها وهمًا وحلمًا، سألتمس للفكر سندًا في الوجود الواقع، سأثبت وجود الله بالفكر ذاته ليكون ضامنًا لمعرفتي الواضحة المتميزة عن العالم الخارجي.
ديكارت، مقال في المنهج
أنا أفكر فأنا إذن موجود Cogito Ergo Sum.
ها أنا ذا قد أزحت التراب والحصى والأنقاض، فخلصت إلى الصخرة الثابتة التي أقيم عليها صرح الفلسفة التي أتحراها، أنا أفكر فأنا إذن موجود … قضيةٌ صحيحة بالضرورة كلما نطقت بها وكلما تصورتها في ذهني، وهي من الثبات والوثوق بحيث تعجز كل حجج الشكاك عن زعزعتها، ولو استطاع الروح الخبيث أن يضلني في كل شيء فلن يستطيع أن يمنعني من اليقين أن ذاتي موجودة حين أفكر.١
… غير أن الكوجيتو الذي يعطيني وجودي بأوثق الحدوس يجعلني من جهة أخرى في عزلةٍ تامة هي عزلة فكري الخاص، فلا أتبين سبيلًا للخروج منها ولا أبلغ أي وجودٍ من الموجودات خارج نفسي؛ لذا سأبذل جهدي للإفلات من عزلةٍ لو طالت لجعلت المعرفة البشرية كلها وهمًا وحلمًا، سألتمس للفكر سندًا في الوجود الواقع، سأثبت وجود الله بالفكر ذاته ليكون ضامنًا لمعرفتي الواضحة المتميزة عن العالم الخارجي.
ديكارت، مقال في المنهج
❤10👍1
إن الإنسان وليد علل لا تفقه شيئًا عن كنه الغاية التي تحدثها، وما أصله ونموه وآماله ومخاوفه وميوله ومعتقداته إلا ثمرة التقاءات عرضية للذرات، وليس في وسع أي حمية أو بطولة أو توقد فكر وشعور أن تحفظ على المرء حياته فيما وراء القبر، وكل ما كسبته الإنسانية مدى الدهر من ثمرات الكدح والتفاني والإلهام، وما أفاضت عليها العبقرية من بريق نورها الوضاء، مصيره إلى الفناء طي فناء النظام الشمسي، ومحتوم على ذلك المعبد الجامع لما شيدته يد الإنسان أن يختفي في الأنقاض التي يخلفها خراب الكون — وهذه كلها قضايا إن لم تكن بمنأى عن الاعتراض فإنها تقرب من تمام اليقين قربًا يجعل أي فلسفة ترفضها غير قادرة على البقاء.
- برتراند راسل
التصوف والمنطق
ترجمة: محمد شفيق غربال
- برتراند راسل
التصوف والمنطق
ترجمة: محمد شفيق غربال
❤11👍2
▪️نيتشه" كما وصفه مفكر الخطيئة الألمانية ياسبرز: موقظ العالم
واحد من فيلسوفين "شماليين" نالا على تناقضهما مناصرة أكبر فلاسفة القرن الـ20
▪️إبراهيم العريس
حتى وإن كان الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز أبدى دائماً، في كتاباته المختلفة كما في ممارسته تدريس الفلسفة، تقديراً كبيراً لفيلسوفين "شماليين" سبقاه زمنياً في شكل مباشر، وهما كيركغارد ونيتشه، فإنه في حقيقة أمره لم يكن لا من أتباع هذا ولا من حواريي ذاك. بل إنه كان يرفضهما معاً من الناحية الفلسفية. يرفض كيركغارد لمسيحيته الزائدة عن الحد وفق تصوره، ويرفض نيتشه لعدائه المفرط للمسيحية. ومع هذا إذا توقفنا عند علاقة ياسبرز بهذا الأخير، سنجده وكرس له، بفارق زمني يصل إلى 18 عاماً، كتابين ضخمين. أولهما هو "نيتشه والمسيحية" (1919)، أما الثاني فهو الذي يعتبر من أكثر كتبه شعبية، بل حتى من أكثر الكتب التي وضعت عن نيتشة شعبية على الإطلاق، هو الذي ترجم إلى عدد لا بأس به من اللغات على عكس معظم كتب ياسبرز الأخرى. ومهما يكن فإن ياسبرز الذي سنعود لكتابه الثاني بعد أسطر، كان من أولئك الفلاسفة الذين - على عكس معظم مفكري القرن الـ20 الذين تحولوا إلى آيديولوجيين أو سياسيين أو رجال أحزاب - أصروا على البقاء داخل أطر التفكير الفلسفي إلى حد قضاء العمر كله في الكتابة والتدريس. بمعنى آخر عرف ياسبرز كيف يكون واحداً من الصادقين مع أنفسهم في مجال العمل الفلسفي إنما من دون أن يقيم في برج عاجي، بل نراه انكب على الفلسفة وحدها طوال حياته، واضعاً إياها فكرياً وعملياً في خدمة الحياة العامة للبشر. في هذا الإطار الفكري المميز يحتل الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز إذاً مكانة متقدمة، لا سيما اعتباراً من عام 1945، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار النازية التي كان ياسبرز واحداً من الذين بكروا في التنديد بعنفها وبطابعها الشمولي.
منذ 1945، واصل كارل ياسبرز تأمله في التاريخ، ولكن من موقع التماس مع الواقع الملموس. وهذا ما يتجلى بخاصة في كتبه التي نشرها طوال عقد ونصف العقد من الزمان ومن أبرزها "الخطيئة الألمانية" (1946) و"أصل التاريخ ومعناه" (1950) و"القنبلة الذرية ومستقبل الإنسانية" (1958) و"الحرية وإعادة التوحيد" (1960). لقد كان تدخل الفيلسوف في كتبه هذه تدخلاً سياسياً مباشراً أخذه عليه معاصروه من الذين يريدون للفلسفة أن تظل منزهة عن "الصغائر". وهو مأخذ كانت المفكرة الفيلسوفة صديقة ياسبرز وهايدغر حنة آرندت من أبرز الذين تحدثوا عنه، إذ نجدها كتبت تقول "إن تجاوب ياسبرز مع الحياة العامة يبدو لي فريداً من نوعه، لأنه يأتي من فيلسوف، ولأنه ينبع حقاً من صلب قناعته الفلسفية العميقة: إن القاسم المشترك بين الفلسفة والسياسة هو اهتمامهما بالعالم كله، وهذا هو السبب الذي يجعل الفلسفة على علاقة بالحياة العامة، إذ لا يكون ثمة مكان إلا للشخص وقدرته على البرهنة عن ذاته. إن الفيلسوف على خلاف العالم يشبه رجل السياسة في كونه مرغماً على أن يوضح شخصياً ما لديه من آراء. ولكن في هذا المجال يبقى وضع رجل الدولة مميزاً، بالنظر إلى أن رجل الدولة لا يكون مسؤولاً إلا أمام شعبه، أما ياسبرز وفي الأقل في كل الكتابات التي وضعها بعد 1933، فتحدث كما لو أنه يدافع عن آرائه أمام الإنسانية بأسرها".
وهذه الإنسانية هي بالتحديد تلك التي نراها تسيطر، ولو غالباً في شكل موارب، على الصفحات الـ500 في الأقل التي يشغلها كتاب ياسبرز الذي نتحدث عنه هنا "نيتشه، مدخل إلى فلسفته" المنجز عام 1936 بالألمانية، مع أن ياسبرز كان مقيماً في ذلك الحين في الولايات المتحدة الأميركية بعد مبارحته ألمانيا هرباً من حكمها النازي وعداء هتلرييها لكل ما هو فكر حر. وكان ياسبرز منذ وصوله بدأ يشارك في الحركة الفكرية الأميركية بحماسة شديدة. وهنا بصدد كتابه عن "نيتشه" لا بد من الإشارة إلى أن ياسبرز لم يكن يشارك نيتشه أفكاره، ومع ذلك تظهره صفحات الكتاب متعمقاً فيها مستوعباً كل كلمة وفكرة، بل أحياناً مفتوناً بقدرة نيتشه على صياغة أفكاره بلغة أدبية "نادرة الوجود في عالم الكتابة الفلسفية". مهما يكن فإن من النادر أن يبدو ياسبرز في الكتاب مناهضاً كلياً للفكر النيتشوي إلا في المجالات التقنية، أو حين يرى أن صاحب "هكذا تكلم زرادشت" يفرط في عدائه العضوي للمسيحية. ومن الواضح على أية حال أن غاية ياسبرز من وضع هذا الكتاب كانت غاية تعليمية مع ما يستتبعه هذا من موضوعية نلاحظها في تقسيم الكتاب كما في ثناياه.
ذلك أن المؤلف بعد مقدمة جعل عنوانها "كيف نفهم عمل نيتشه" واستعرض فيها الأنماط المتعددة لتفسير هذا العمل مركزاً بخاصة على مفهوم الحقيقة الذي يعرف ياسبرز أنه كان أساسياً لدى نيتشه، ينتقل في قسم أول إلى حياة نيتشه، إذ يرسم صورة متكاملة لتلك الحياة بدءاً من الطفولة وصولاً إلى زمن العزلة ثم المرض والموت، مركزاً على حدود إمكان ديمومة الصداقة لدى
واحد من فيلسوفين "شماليين" نالا على تناقضهما مناصرة أكبر فلاسفة القرن الـ20
▪️إبراهيم العريس
حتى وإن كان الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز أبدى دائماً، في كتاباته المختلفة كما في ممارسته تدريس الفلسفة، تقديراً كبيراً لفيلسوفين "شماليين" سبقاه زمنياً في شكل مباشر، وهما كيركغارد ونيتشه، فإنه في حقيقة أمره لم يكن لا من أتباع هذا ولا من حواريي ذاك. بل إنه كان يرفضهما معاً من الناحية الفلسفية. يرفض كيركغارد لمسيحيته الزائدة عن الحد وفق تصوره، ويرفض نيتشه لعدائه المفرط للمسيحية. ومع هذا إذا توقفنا عند علاقة ياسبرز بهذا الأخير، سنجده وكرس له، بفارق زمني يصل إلى 18 عاماً، كتابين ضخمين. أولهما هو "نيتشه والمسيحية" (1919)، أما الثاني فهو الذي يعتبر من أكثر كتبه شعبية، بل حتى من أكثر الكتب التي وضعت عن نيتشة شعبية على الإطلاق، هو الذي ترجم إلى عدد لا بأس به من اللغات على عكس معظم كتب ياسبرز الأخرى. ومهما يكن فإن ياسبرز الذي سنعود لكتابه الثاني بعد أسطر، كان من أولئك الفلاسفة الذين - على عكس معظم مفكري القرن الـ20 الذين تحولوا إلى آيديولوجيين أو سياسيين أو رجال أحزاب - أصروا على البقاء داخل أطر التفكير الفلسفي إلى حد قضاء العمر كله في الكتابة والتدريس. بمعنى آخر عرف ياسبرز كيف يكون واحداً من الصادقين مع أنفسهم في مجال العمل الفلسفي إنما من دون أن يقيم في برج عاجي، بل نراه انكب على الفلسفة وحدها طوال حياته، واضعاً إياها فكرياً وعملياً في خدمة الحياة العامة للبشر. في هذا الإطار الفكري المميز يحتل الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز إذاً مكانة متقدمة، لا سيما اعتباراً من عام 1945، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار النازية التي كان ياسبرز واحداً من الذين بكروا في التنديد بعنفها وبطابعها الشمولي.
فيلسوف يتأمل التاريخ
منذ 1945، واصل كارل ياسبرز تأمله في التاريخ، ولكن من موقع التماس مع الواقع الملموس. وهذا ما يتجلى بخاصة في كتبه التي نشرها طوال عقد ونصف العقد من الزمان ومن أبرزها "الخطيئة الألمانية" (1946) و"أصل التاريخ ومعناه" (1950) و"القنبلة الذرية ومستقبل الإنسانية" (1958) و"الحرية وإعادة التوحيد" (1960). لقد كان تدخل الفيلسوف في كتبه هذه تدخلاً سياسياً مباشراً أخذه عليه معاصروه من الذين يريدون للفلسفة أن تظل منزهة عن "الصغائر". وهو مأخذ كانت المفكرة الفيلسوفة صديقة ياسبرز وهايدغر حنة آرندت من أبرز الذين تحدثوا عنه، إذ نجدها كتبت تقول "إن تجاوب ياسبرز مع الحياة العامة يبدو لي فريداً من نوعه، لأنه يأتي من فيلسوف، ولأنه ينبع حقاً من صلب قناعته الفلسفية العميقة: إن القاسم المشترك بين الفلسفة والسياسة هو اهتمامهما بالعالم كله، وهذا هو السبب الذي يجعل الفلسفة على علاقة بالحياة العامة، إذ لا يكون ثمة مكان إلا للشخص وقدرته على البرهنة عن ذاته. إن الفيلسوف على خلاف العالم يشبه رجل السياسة في كونه مرغماً على أن يوضح شخصياً ما لديه من آراء. ولكن في هذا المجال يبقى وضع رجل الدولة مميزاً، بالنظر إلى أن رجل الدولة لا يكون مسؤولاً إلا أمام شعبه، أما ياسبرز وفي الأقل في كل الكتابات التي وضعها بعد 1933، فتحدث كما لو أنه يدافع عن آرائه أمام الإنسانية بأسرها".
500 صفحة مكرسة لنيتشه
وهذه الإنسانية هي بالتحديد تلك التي نراها تسيطر، ولو غالباً في شكل موارب، على الصفحات الـ500 في الأقل التي يشغلها كتاب ياسبرز الذي نتحدث عنه هنا "نيتشه، مدخل إلى فلسفته" المنجز عام 1936 بالألمانية، مع أن ياسبرز كان مقيماً في ذلك الحين في الولايات المتحدة الأميركية بعد مبارحته ألمانيا هرباً من حكمها النازي وعداء هتلرييها لكل ما هو فكر حر. وكان ياسبرز منذ وصوله بدأ يشارك في الحركة الفكرية الأميركية بحماسة شديدة. وهنا بصدد كتابه عن "نيتشه" لا بد من الإشارة إلى أن ياسبرز لم يكن يشارك نيتشه أفكاره، ومع ذلك تظهره صفحات الكتاب متعمقاً فيها مستوعباً كل كلمة وفكرة، بل أحياناً مفتوناً بقدرة نيتشه على صياغة أفكاره بلغة أدبية "نادرة الوجود في عالم الكتابة الفلسفية". مهما يكن فإن من النادر أن يبدو ياسبرز في الكتاب مناهضاً كلياً للفكر النيتشوي إلا في المجالات التقنية، أو حين يرى أن صاحب "هكذا تكلم زرادشت" يفرط في عدائه العضوي للمسيحية. ومن الواضح على أية حال أن غاية ياسبرز من وضع هذا الكتاب كانت غاية تعليمية مع ما يستتبعه هذا من موضوعية نلاحظها في تقسيم الكتاب كما في ثناياه.
ذلك أن المؤلف بعد مقدمة جعل عنوانها "كيف نفهم عمل نيتشه" واستعرض فيها الأنماط المتعددة لتفسير هذا العمل مركزاً بخاصة على مفهوم الحقيقة الذي يعرف ياسبرز أنه كان أساسياً لدى نيتشه، ينتقل في قسم أول إلى حياة نيتشه، إذ يرسم صورة متكاملة لتلك الحياة بدءاً من الطفولة وصولاً إلى زمن العزلة ثم المرض والموت، مركزاً على حدود إمكان ديمومة الصداقة لدى
👍5
نيتشه، مستعيناً في توضيح هذا بمثال علاقة الفيلسوف بفاغنر. وبعد ذلك ينتقل ياسبرز إلى شرح المواضيع النيتشوية الأساسية: الإنسان والإنسان الأعلى، والحقيقة، التاريخ والزمن الراهن، والسياسات الكبرى وصولاً إلى تفسيره للعالم. ليتوقف في القسم الثالث عند ما يسميه "فكر نيتشه على ضوء شمولية وجوده". والحال أن هذا القسم هو الذي توقف فيه ياسبرز، وبقدر كبير من الوضوح والتعمق عند الفكر النيتشوي، متوزعاً بين رفض أجزائه والقبول المشروط بكليته، مما أثار لدى قراء الكتاب ذلك الالتباس الذي جعل بعضهم يعتقد ياسبرز نيتشوياً، وهو ما أنكره صاحب العلاقة على أية حال، لا سيما إذ يؤكد في نهاية تحليله أن "نيتشه يبقى ضحية، ويظل حتى النهاية فكراً مفتوحاً، غير قابل لأن يستحوذ عليه أحد".
والحال أن ياسبرز، المولود في 1883 في أولدنبورغ، كان تبدى "نيتشوياً"، منذ 1931، وفي خضم اهتمامه المبكر بنيتشه، وبعدما كان شجب معاداة هذا الأخير للمسيحية في كتابه المبكر عنه، إنما فقط في مجال إعلانه رغبته، في كتابه "وضعية عصرنا الروحية"، في إيقاظ معاصريه على حقائق الأخطار المحيطة بهم. وكان ياسبرز درس الطب ثم علم النفس قبل أن ينصرف إلى الفلسفة، لكن نزعته الفلسفية، في البداية، ظلت تأملية ترتبط بعلم النفس. غير أنه سرعان ما وجد نفسه غير قادر على الفصل بين الفلسفة والفكر السياسي، بتأثير من الظروف العالمية المستجدة. وهو من دون أن يصل في طموحه إلى ما نادى به كارل ماركس من أن "على الفلسفة أن تغير العالم، بعد أن فسرته طويلاً"، وجد أن الفلسفة بإمكانها في الأقل أن تنشر الوعي لدى تلك النخب التي كانت تغوص في الوحل حتى الأعناق.
على رغم تنبيهه المبكر أحس ياسبرز أنه، مثل غيره من الألمان، مسؤول عما حدث وأن النازية وهتلرها لم يأتيا من فراغ، وهذا ما جعله يمضي الجزء الأكبر من سنوات عمره الأخيرة، وحتى رحيله عام 1969 في مدينة بال السويسرية، محاولاً أن يغوص في مسببات تلك "الخطيئة الألمانية"، وهو غوص أكسبه احتراماً كبيراً حتى لدى خصومه الفكريين، من أمثال الماركسي المجدد يورغان هابرماس، الذي خصه بثلاث دراسات شهيرة قال في واحدة منها إن "ياسبرز فهم في حينه أنه، من دون وعي المسؤولية السياسية، لن يكون من الممكن إحداث أي قطع مع التقاليد القاتلة لدولة نظمت معسكرات التجميع، ومع مجتمع كان فيه قتل الأقليات التي حددت هويتها في شكل تعسفي، أمراً ممكناً". إزاء هذا كله كان من الطبيعي لكارل ياسبرز أن يعتبر ابناً شرعياً للوعي الألماني الجديد، الوعي النابع من الخطيئة الألمانية، والراغب في تجاوز تلك الوضعية للوصول إلى تكوين إنسان ألماني منزه عن الخطيئة واع لها ومدين لها أيضاً. إزاء هذا هل يبدو من المهم حقاً أن يكون ياسبرز "وجودياً" في نظر سارتر، وفيلسوفاً يعتبر "الفشل هو الحد الضروري لكل مشروع إنساني" كما يقول الفيلسوف الشخصاني إيمانويل مونييه؟
نيتشوي ولكن
والحال أن ياسبرز، المولود في 1883 في أولدنبورغ، كان تبدى "نيتشوياً"، منذ 1931، وفي خضم اهتمامه المبكر بنيتشه، وبعدما كان شجب معاداة هذا الأخير للمسيحية في كتابه المبكر عنه، إنما فقط في مجال إعلانه رغبته، في كتابه "وضعية عصرنا الروحية"، في إيقاظ معاصريه على حقائق الأخطار المحيطة بهم. وكان ياسبرز درس الطب ثم علم النفس قبل أن ينصرف إلى الفلسفة، لكن نزعته الفلسفية، في البداية، ظلت تأملية ترتبط بعلم النفس. غير أنه سرعان ما وجد نفسه غير قادر على الفصل بين الفلسفة والفكر السياسي، بتأثير من الظروف العالمية المستجدة. وهو من دون أن يصل في طموحه إلى ما نادى به كارل ماركس من أن "على الفلسفة أن تغير العالم، بعد أن فسرته طويلاً"، وجد أن الفلسفة بإمكانها في الأقل أن تنشر الوعي لدى تلك النخب التي كانت تغوص في الوحل حتى الأعناق.
النازية لم تأت من فراغ
على رغم تنبيهه المبكر أحس ياسبرز أنه، مثل غيره من الألمان، مسؤول عما حدث وأن النازية وهتلرها لم يأتيا من فراغ، وهذا ما جعله يمضي الجزء الأكبر من سنوات عمره الأخيرة، وحتى رحيله عام 1969 في مدينة بال السويسرية، محاولاً أن يغوص في مسببات تلك "الخطيئة الألمانية"، وهو غوص أكسبه احتراماً كبيراً حتى لدى خصومه الفكريين، من أمثال الماركسي المجدد يورغان هابرماس، الذي خصه بثلاث دراسات شهيرة قال في واحدة منها إن "ياسبرز فهم في حينه أنه، من دون وعي المسؤولية السياسية، لن يكون من الممكن إحداث أي قطع مع التقاليد القاتلة لدولة نظمت معسكرات التجميع، ومع مجتمع كان فيه قتل الأقليات التي حددت هويتها في شكل تعسفي، أمراً ممكناً". إزاء هذا كله كان من الطبيعي لكارل ياسبرز أن يعتبر ابناً شرعياً للوعي الألماني الجديد، الوعي النابع من الخطيئة الألمانية، والراغب في تجاوز تلك الوضعية للوصول إلى تكوين إنسان ألماني منزه عن الخطيئة واع لها ومدين لها أيضاً. إزاء هذا هل يبدو من المهم حقاً أن يكون ياسبرز "وجودياً" في نظر سارتر، وفيلسوفاً يعتبر "الفشل هو الحد الضروري لكل مشروع إنساني" كما يقول الفيلسوف الشخصاني إيمانويل مونييه؟
👍2
بيتر سلوترديك ..تدجين البشر للبشر
- أماني أبو رحمة
يمثل الفيلسوف الألماني الشهير بيتر سلوترديك توجهات بعد ما بعد حداثية مهمة. يشارك سلوترديك في ما بات يعرف ب" الانعطافة نحو السياسات الحياتية" ونقاشات ما بعد الإنسانية والتنظيرات المهمة عن انهيار الحدود الذي بشرت به ما بعد الحداثة: انهيار الحدود بين الإنسان والآلة والإنسان والحيوان والآلة والحيوان، ضمن انهيارات حدودية أُخرى بالطبع. وتحت مظلة هذا النقاش الساخن الذي يدور في كافة المجالات وفي الإعلام والحياة اليومية يمكن وضع سلوترديك في خانة منظري الإنسانية العبورية. والانسانية العبورية توجه ينضوي تحت مظلة ما بعد الإنسانية بشكل عام والتي تشمل، فضلا عن الانسانية العبورية، ما بعد الإنسانية النقدية، وضد الانسانية، وما وراء الانسانية، واللا-انسانية وتوجهات المادية الجديدة المعاصرة. تعرف الإنسانية العبورية بوصفها امتدادا للإنسانية الحداثية التي لا تقتصر على الأساليب التقليدية (على سبيل المثال التعليم)، من أجل تحسين حالة "الجنس البشري". البشر العبوريون هم، ببساطة، بشر انتقاليون يسيرون على "طريق التعالي"، أناس يرون أنهم يؤدون بأجسادهم دور التجسير في العملية التطورية. قد تشمل علامات الإنسانية العبورية تكبير الجسم باستخدام الغرسات،، والتكاثر اللاجنسي، والهوية الموزعة. هؤلاء البشر يستعدون بنشاط ليصبحوا ما بعد البشر. كما توضح وثيقة الأسئلة الشائعة حول ما بعد الإنسانية، يمكن النظر إلى ما بعد الإنسان على أنه منحدر بشري تم تعزيزه تقنيًا لدرجة أنه لم يعد إنسانًا. القدرات العقلية والجسدية لما بعد الإنسان، بما في ذلك الذكاء والذاكرة والقوة والصحة وطول العمر، ستتجاوز جميعها بشكل كبير قدرات البشر الحاليين. نظرًا لأن ما بعد البشر يمكن أن يكونوا اصطناعيين تمامًا، فإن البعض ينظر إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنها أول كائنات ما بعد الإنسان. إن احتمالية العيش بدون جسد كنماذج معلوماتية على شبكات الكمبيوتر فائقة السرعة هو من بين أهداف الانسانية العبورية. شهدت مثل هذه الآراء تعبيرات مثيرة للجدل من قبل الفيلسوف الألماني بيتر سلوترديك. يرى سلوترديك أن الإنسانية الكلاسيكية هي محاولة "لتحسين" الناس من خلال القوة التحويلية للتعلم الإنساني. بعد أن رأى سلوترديك أن المشروع الإنساني الكلاسيكي قد انهار الآن، تساءل: "ما الذي يمكن أن يروض البشرعندما تفشل الإنسانية في أداء هذا الدور؟" وجادل بأن "تحسين" الجنس البشري يجب ألا يقتصر على التقنيات "اللينة" للتعليم والهندسة الاجتماعية. بدلاً من ذلك، فإن إمكانات "العلوم الصعبة" مثل الهندسة الوراثية وأشكال أخرى من البيولوجيا قد ورثت مهمة متابعة الكمال البشري، "في ضوء ذلك، يرتبط التعليم الإنساني والهندسة الجينية ارتباطًا وثيقًا: كلاهما جهود متعمدة لتحسين الطبيعة من الجنس البشري ".ويجادل سلوترديك بأننا نشهد "العصر القادم من القرارات السياسية للأنواع الحية"، ويدعو إلى مجال جديد من "التقانة الانثروبية"، موضحًا، "إذا كانت التكنولوجيا الحيوية تعني قبول تقسيم البشر إلى مهندِسين وراثيين ومهندَسين وراثيًا، الحيوانات في "حديقة الحيوانات البشرية"، فليكن ".
يشير مصطلح "التقانات الانثروبية " إلى حقيقة أن عملية تدجين البشر من قبل البشر، والتي بدأت في وقت مبكر جدًا، مفتوحة على كل الاحتمالات المستقبلية. يصف المصطلح الانفصال اللاواعي إلى حد كبير للبشر عن الحياة البحتة(الزوي) - حيث لم يصبحوا فقط أعضاء في "الأنواع الرمزية"، أو "حيوانات طقوسية"، بمعنى حيوان سردي أسطوري فحسب، ولكنه أيضًا مخلوق تقني. كما يشير إلى إمكانية مستقبلية لتشكيل الذات الواعية من خلال أشكال التدريب للعقل، والتعديلات الكيميائية، وربما حتى من خلال النبضات الجينية. وبالتالي، فإن "التقانات الانثروبية " تقود إلى التكوين الذاتي الكامل، أو الخلق الذاتي، "للبشرية" في تخصصاتها الثقافية العديدة. إنه تجريبي، وتعددي ومتكافئ من الألف إلى الياء - بمعنى أن جميع الأفراد، بوصفهم ورثة لذكرى البشر أحرار في التفوق على أنفسهم. بالإضافة إلى تأثير نيتشه الواضح، استوحى سلوترديك أيضًا من طموح فتجينشتاين في وضع حد لـ "الثرثرة حول الأخلاقيات". في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأنه يهدف إلى استبدال "الأخلاقيات " بـ "التقانات الانثروبية" من أجل فهم أفضل للممارسات الفعلية للبشر. إنه يرغب في إعطاء حقيقة جديدة للبصيرة التي طورها ماركس والشباب الهيغليين في أربعينيات القرن التاسع عشر والتي تؤكد أن "الإنسان ينتج الإنسان": باختصار، لا يُمنح الإنسان أبدًا لنفسه أو لأي شيء آخر، ولكنه ينتج ويعيد إنتاج ظروف الوجود الخاصة كمشروع للتنمية الشخصية، وحتى المغامرة. ومع ذلك، يختلف سلوترديك عن ماركس والهيغليين في عدم الرغبة في التركيز على الكدح أو العمل كفئة رئيسية يمكن من خلالها فهم عملية التكوين الذاتي للإنسان.
👍5❤1
يقترح أن يتم تغيير لغة العمل إلى لغة "السلوك الذاتي التكويني والمعزز للذات". نحن بحاجة إذن إلى تجاوز كل من أسطورة الهوموفابر والإنسان الديني وأن نفهم الإنسان كمخلوق ناتج عن التكرار. كما يلاحظ، يعيش البشر في عادات، وليس في مناطق. إذا كان من الممكن النظر إلى القرن التاسع عشر على أنه قرن الإنتاج، والقرن العشرين قرن الانعكاسية، فإننا نحتاج إذن إلى فهم المستقبل بوصفه خبرة، تطبيق عملي: تكنولوجيا حيوية. لا يخلو أي من أعمال التنقية والصقل هذه من أهمية فهمنا للحيوان البشري، لأنه يحمل القدرة على كشف أسرار الحيوان البشري من جديد، بما في ذلك إعادة النظر في الكلمات الرئيسية التي نفهم من خلالها ما يسمى بحياتنا الروحية: كلمات مثل "التقوى" و "الأخلاق" و "الأخلاق" و "الزهد".من الواضح أن هذا استمرار لفرع أساسي من مشروع التنوير، ويعترف سلوترديك بمثل هذا الالتزام. في الواقع، يسمى مهمته "مشروع التنوير المحافظ" الذي يقوم على الاهتمام بالحفظ. من ناحية أخرى، هناك رغبة في التمسك بسلسلة المعارف التراكمية التي تمثل التنوير وميراثه. يحرص سلوترديك على التقاط الخيوط، التي يبلغ عمرها آلاف السنين، والتي تربطنا بالمظاهر المبكرة للمعرفة الإنسانية عن الممارسة. إنها مهمة إلى حد كبير لجعل ما هو ضمني صريحًا، ويقر سلوترديك بأن عمله جزء من مجموعة غنية من تقاليد البحث الفكري. إن المفكرين والتقاليد التي يعتمد عليها لتحريك أطروحاته الأساسية ذات نطاق مذهل: فهو يشير إلى مصادر بوذية وكتابية ورواقية. نيتشه، الملهم الأول لما بعد الحداثة، وملهم سلوترديك على نحو خاص، هنا هو المشكك الأخلاقي العظيم ومعلم التنوير، يحذرنا من مخاطر التعصب، سواء كان ذلك أخلاقيًا أو دينيًا أو حتى فلسفيًا (إنه ينتقد بشكل خاص "الرتيلاء الأخلاقية"، لجان جاك روسو). على النقيض من "الدجل الدموي" للثورة الفرنسية، يفضل نيتشه نهج تنمية الذات والتحول الاجتماعي على أساس الحاجة إلى علاجات بطيئة وجرعات صغيرة، ترقى إلى فلسفة حقيقية في الصباح، و تبشر بالعديد من الانبثاقات الجديدة، فجر من المعرفة والتغلب على الذات.
هناك جانب مظلم للقصة، إذ ليس من المستغرب أن رؤية سلوترديك ما بعد الإنسانية للمستقبل ليست مثيرة للجدل فحسب، بل قد يُنظر إليها على أنها فاشية محتملة الظهور (خاصة بالنظر إلى التاريخ الألماني). هل تشير وجهة نظر سلوترديك إلى أن هناك إجبارًا متأصلًا على نوع معين من التفكير الأيديولوجي حول التكنولوجيا وإمكانياتها التي تعرض موقفًا شموليًا يروج لأوهام الكمال البشري، وبالتالي، يمكن للأعراق الخارقة أن تسود؟ إن ثمن وعواقب مثل هذه الإجراءات يذكرنا بشكل مخيف بعلم تحسين النسل النازي وقد تم انتقاده بالفعل على هذا الصعيد. فالثقافات المعاصرة، التي تعيد تقييم خطوط الفصل والحدود وتثمن الغريب والوحشي، تبتعد عن الأساطير التي بُنيت عليها حضاراتنا. بالإضافة إلى ذلك، لا تقتحم الاختراقات اليوم خطوط الأنواع فقط، حيث دخلت كل الكائنات في التعايش مع الحياة بعدة طرق: من أجهزة تنظيم ضربات القلب إلى العلامات الإلكترونية للحيوانات الأليفة، ومن غرسات الشبكية إلى العديد من الأدوات الاصطناعية المستخدمة كملحقات للجسم. تنطوي هذه الإختراقات على تحديات جديدة. تتشابك "ثقافة التقارب" السايبورغية الخاصة بنا مع الواقع الافتراضي والواقعي، والحيوي وغير الحيوي. إنه يجعل البشر والعديد من الحيوانات الأخرى يعتمدون بشكل متزايد على التقنيات ويغذي تقاليد الاستهلاك لدينا. إن التسليع الأسي للخدمات، حيث يخدم كل من الذوات والكائنات المصالح الاقتصادية، يؤدي إلى تشييء الكائنات الحية لصالح الشركات العالمية و النخب المهيمنة. كما يؤدي تسليع الحياة البشرية وغير البشرية في الهندسة الحيوية واعتماد البشر على التقنيات، مدفوعًا بالربح متعدد الجنسيات، إلى استغلال واستبعاد أفراد المجتمع الأقل قوة. لذلك، في القرن الحادي والعشرين، قرن ما بعد الداروينية وما بعد الإنسانية، يجب النظر إلى الإنسانية العبورية بحذر أكبر. يمكن الآن "خلق" الحياة وتسويقها لخدمة مصالح بشرية محددة، ويرى الكثيرون هذه التطورات على أنها أشكال جديدة من استعمار الحياة.
هناك جانب مظلم للقصة، إذ ليس من المستغرب أن رؤية سلوترديك ما بعد الإنسانية للمستقبل ليست مثيرة للجدل فحسب، بل قد يُنظر إليها على أنها فاشية محتملة الظهور (خاصة بالنظر إلى التاريخ الألماني). هل تشير وجهة نظر سلوترديك إلى أن هناك إجبارًا متأصلًا على نوع معين من التفكير الأيديولوجي حول التكنولوجيا وإمكانياتها التي تعرض موقفًا شموليًا يروج لأوهام الكمال البشري، وبالتالي، يمكن للأعراق الخارقة أن تسود؟ إن ثمن وعواقب مثل هذه الإجراءات يذكرنا بشكل مخيف بعلم تحسين النسل النازي وقد تم انتقاده بالفعل على هذا الصعيد. فالثقافات المعاصرة، التي تعيد تقييم خطوط الفصل والحدود وتثمن الغريب والوحشي، تبتعد عن الأساطير التي بُنيت عليها حضاراتنا. بالإضافة إلى ذلك، لا تقتحم الاختراقات اليوم خطوط الأنواع فقط، حيث دخلت كل الكائنات في التعايش مع الحياة بعدة طرق: من أجهزة تنظيم ضربات القلب إلى العلامات الإلكترونية للحيوانات الأليفة، ومن غرسات الشبكية إلى العديد من الأدوات الاصطناعية المستخدمة كملحقات للجسم. تنطوي هذه الإختراقات على تحديات جديدة. تتشابك "ثقافة التقارب" السايبورغية الخاصة بنا مع الواقع الافتراضي والواقعي، والحيوي وغير الحيوي. إنه يجعل البشر والعديد من الحيوانات الأخرى يعتمدون بشكل متزايد على التقنيات ويغذي تقاليد الاستهلاك لدينا. إن التسليع الأسي للخدمات، حيث يخدم كل من الذوات والكائنات المصالح الاقتصادية، يؤدي إلى تشييء الكائنات الحية لصالح الشركات العالمية و النخب المهيمنة. كما يؤدي تسليع الحياة البشرية وغير البشرية في الهندسة الحيوية واعتماد البشر على التقنيات، مدفوعًا بالربح متعدد الجنسيات، إلى استغلال واستبعاد أفراد المجتمع الأقل قوة. لذلك، في القرن الحادي والعشرين، قرن ما بعد الداروينية وما بعد الإنسانية، يجب النظر إلى الإنسانية العبورية بحذر أكبر. يمكن الآن "خلق" الحياة وتسويقها لخدمة مصالح بشرية محددة، ويرى الكثيرون هذه التطورات على أنها أشكال جديدة من استعمار الحياة.
👍2
- إذا واصلنا فقدان القراء بهذا المستوى، كيف سيكون مستقبل البشريّة؟
- بكل تأكيد يمكننا أن نعيش ونجد السعادة دون القراءة. ولكن بمجرد قبول هذا المبدأ يطرح السؤال: ماذا سنخسر حين لا نقرأ؟ الجواب بسيط: فقدنا أهم جزء يجعلنا بشرا. فليس صدفة أن الكتب واللغة كانت هدفا لأعتى الديكتاتوريات المرعبة. لقد أحرق النّازيون أكثر من ١٠٠ مليون كتاب، وكما بيّن الأكاديمي فيكتور كليمبير، فإنهم شرعوا في عملية تجهيل لغوي أشبه بتلك التي وصفها جورج أورويل في روايته ١٩٨٤. لقد صوّر هتلر الأدب في كتابه "كفاحي" على أنه سُمّ للناس. أفضل مثال يبيّن شكل العالم الخالي من القراءة هو كتاب ألدوس هكسلي "عالم جديد شجاع" حيث يصف فيه كتلة من التقنيّين المتفانين الذين شكّلوا لتلبية الاحتياجات الاقتصاديّة ويتغذّون قسرا بالترفيه السّخيف والاكتفاء بالعبوديّة الشريرة. وعلى النقيض من ذلك يصف هكسلي نخبةً صغيرة مزوّدة باللوازم اللغويّة والثقافيّة للتفكير. ذات الفكرة في رواية "فهرنهايت ٤٥١" لراي برادبري، فمن ناحية يقف مونتاغ رجل الإطفاء الذي ملّ من حرق الكتب وهو يفكر في العالم والمجتمع. ومن ناحية أخرى زوجته ميلدريد المدمنة على العقاقير ومشاهدة التلفاز. فالقراءة هي الترياق لميلدريد. إنها طريقٌ صوب التحرّر.
- ميشيل ديسمورجيت، باحثٌ وكاتب فرنسي متخصّص في علم الأعصاب الإدراكي.
- بكل تأكيد يمكننا أن نعيش ونجد السعادة دون القراءة. ولكن بمجرد قبول هذا المبدأ يطرح السؤال: ماذا سنخسر حين لا نقرأ؟ الجواب بسيط: فقدنا أهم جزء يجعلنا بشرا. فليس صدفة أن الكتب واللغة كانت هدفا لأعتى الديكتاتوريات المرعبة. لقد أحرق النّازيون أكثر من ١٠٠ مليون كتاب، وكما بيّن الأكاديمي فيكتور كليمبير، فإنهم شرعوا في عملية تجهيل لغوي أشبه بتلك التي وصفها جورج أورويل في روايته ١٩٨٤. لقد صوّر هتلر الأدب في كتابه "كفاحي" على أنه سُمّ للناس. أفضل مثال يبيّن شكل العالم الخالي من القراءة هو كتاب ألدوس هكسلي "عالم جديد شجاع" حيث يصف فيه كتلة من التقنيّين المتفانين الذين شكّلوا لتلبية الاحتياجات الاقتصاديّة ويتغذّون قسرا بالترفيه السّخيف والاكتفاء بالعبوديّة الشريرة. وعلى النقيض من ذلك يصف هكسلي نخبةً صغيرة مزوّدة باللوازم اللغويّة والثقافيّة للتفكير. ذات الفكرة في رواية "فهرنهايت ٤٥١" لراي برادبري، فمن ناحية يقف مونتاغ رجل الإطفاء الذي ملّ من حرق الكتب وهو يفكر في العالم والمجتمع. ومن ناحية أخرى زوجته ميلدريد المدمنة على العقاقير ومشاهدة التلفاز. فالقراءة هي الترياق لميلدريد. إنها طريقٌ صوب التحرّر.
- ميشيل ديسمورجيت، باحثٌ وكاتب فرنسي متخصّص في علم الأعصاب الإدراكي.
❤22✍1👍1
🔗 الإتجاهات المُعاصِرة في الفلسفة:
هناك مدارس عديدة تعبِّر عن هذا الإتجاه ، ولعلّ في مقدمتها "الواقعية المُحدَثة" في إنجلترا و أمريكا ، ومن أشهر مُمثِّليها "براتراند راسل" و "جورج إدوارد مور" . ثمّ "الوضعية المنطقية" في النمسا وإنجلترا وأمريكا ، ومن أشهر مُمثِّليها : أنصار دائرة فيينا في النمسا ، و "ألفرد آير" في إنجلترا ، و "رودلف كارناب" في أمريكا. وهناك أيضاً "المادية الجدلية" التي وضعها كارل ماركس ولازال لها مُمثِّلون عديدون في روسيا وغيرها.
ويعبِّر عن هذا الإتجاه أنصار المذهب المثالي ، من أمثال
"بنديتو كروتشه" في إيطاليا ، و "ليون برنشفيك" في فرنسا ، و "الكانطيون الجدد" في كل من النمسا وألمانيا وفرنسا ، ومن أشهرهم "ناتورب" و "كاسيرر" ، وغيرهما من أنصار مدرسة "ماربورغ" التي أسَّسها "هرمان كوهن" زعيم المدرسة الكانطية الجديدة.
ويعبِّر عن هذا الإتجاه "هنري برغسون" الذي تتلّمذ على يدّ كلّ من "لاشيلييه" و "بوترو" ثم "إدوار ليروا" الذي يعدّ خير مُعبِّر عن الروح البرغسونية في فرنسا. ومن الممكن أن نُدخِل في عِداد فلسفات الحياة مذاهب متعدِّدة في ألمانيا ، مثل مذهب "دلتاي" و "شبنجلر" و "كلاجس" وغيرهم. وأمّا في البلاد الإنجلوسكسونية ؛ فإن الفلسفة البراغماتية التي دعا إليها كلّ من "بيرس" و "جيمس" قد ظلّت حيّة على يدّ "ديوي" وتلاميذه في أمريكا.
وقد نشأ هذا الإتجاه بدايةً على يدّ "ماينونج" ثمّ تبلّور على صورة فلسفة الظواهر عند "إدموند هوسرل" الذي أثَّر بشكل كبير على معظم فلاسفة القرن العشرين ، وفي مقدِّمتهم دعاة المذهب الوجودي ، ومن أشهر المعبِّرين عن هذه النزعة "ماكس شيلر".
تلك هي النزعة الميتافيزيقية أو الأنطولوجية التي عبَّر عنها في انجلترا "صموئيل ألكسندر" و "هوايتهد" ، وفي فرنسا أنصار فلسفة الروح مثل : "لافيل" و "رينه لوسن" وفي ألمانيا "نقولا هارتمان". ومن الممكن أن نُدخِل في عِداد أنصار هذا الإتجاه أصحاب الفلسفة التوماوية الجديدة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأمريكا ، من أشهرهم "جاك ماريتان" و "جلسون" ، وطائفة من أساتذة جامعة "لوفان" في بلجيكا وغيرهم.
وهو الإتجاه الذي يُمكن الإرتداد به إلى "كيركجارد". ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه : "مارتن هايدغر" و "كارل يسبرز" في ألمانيا. وفي فرنسا "جان بول سارتر" و "جبريل مارسل" و "موريس ميرلوبونتي" الذي شغل كرسي الفلسفة خلفاً لبرغسون في "الكوليج دو فرانس".
وقد ظهرت في فرنسا مدرسة أُطلِق عليها إسم "مدرسة باريس" تأثرت بالوجودية ، من أهم أعلامها : "جان فال" و "جان جرانييه" و "ألكييه" وغيرهم.
ويتصل بهذا الإتِّجاه إتجاه آخر هو "الشخصانية" ومن أشهر ممثليه في فرنسا "مونييه" و "جان لاكروا" و "نِدونسيل" وغيرهم.
_______
دراسات في الفلسفة المعاصرة ، زكريا ابراهيم ، دار مصر للطباعة.
• الإتِّجاهُ الماديُّ : ( فلسفةُ المادَّة )
هناك مدارس عديدة تعبِّر عن هذا الإتجاه ، ولعلّ في مقدمتها "الواقعية المُحدَثة" في إنجلترا و أمريكا ، ومن أشهر مُمثِّليها "براتراند راسل" و "جورج إدوارد مور" . ثمّ "الوضعية المنطقية" في النمسا وإنجلترا وأمريكا ، ومن أشهر مُمثِّليها : أنصار دائرة فيينا في النمسا ، و "ألفرد آير" في إنجلترا ، و "رودلف كارناب" في أمريكا. وهناك أيضاً "المادية الجدلية" التي وضعها كارل ماركس ولازال لها مُمثِّلون عديدون في روسيا وغيرها.
الإتِّجاه الرُّوحي : ( فلسفةُ الفكر )
ويعبِّر عن هذا الإتجاه أنصار المذهب المثالي ، من أمثال
"بنديتو كروتشه" في إيطاليا ، و "ليون برنشفيك" في فرنسا ، و "الكانطيون الجدد" في كل من النمسا وألمانيا وفرنسا ، ومن أشهرهم "ناتورب" و "كاسيرر" ، وغيرهما من أنصار مدرسة "ماربورغ" التي أسَّسها "هرمان كوهن" زعيم المدرسة الكانطية الجديدة.
• الإتِّجاه الحيوي : ( فلسفةُ الحياةِ )
ويعبِّر عن هذا الإتجاه "هنري برغسون" الذي تتلّمذ على يدّ كلّ من "لاشيلييه" و "بوترو" ثم "إدوار ليروا" الذي يعدّ خير مُعبِّر عن الروح البرغسونية في فرنسا. ومن الممكن أن نُدخِل في عِداد فلسفات الحياة مذاهب متعدِّدة في ألمانيا ، مثل مذهب "دلتاي" و "شبنجلر" و "كلاجس" وغيرهم. وأمّا في البلاد الإنجلوسكسونية ؛ فإن الفلسفة البراغماتية التي دعا إليها كلّ من "بيرس" و "جيمس" قد ظلّت حيّة على يدّ "ديوي" وتلاميذه في أمريكا.
• الإتِّجاه الفينومينولوجي : ( فلسفةُ الماهيّةِ )
وقد نشأ هذا الإتجاه بدايةً على يدّ "ماينونج" ثمّ تبلّور على صورة فلسفة الظواهر عند "إدموند هوسرل" الذي أثَّر بشكل كبير على معظم فلاسفة القرن العشرين ، وفي مقدِّمتهم دعاة المذهب الوجودي ، ومن أشهر المعبِّرين عن هذه النزعة "ماكس شيلر".
• الإتِّجاه الأنطولوجي : ( فلسفةُ الكينونة )
تلك هي النزعة الميتافيزيقية أو الأنطولوجية التي عبَّر عنها في انجلترا "صموئيل ألكسندر" و "هوايتهد" ، وفي فرنسا أنصار فلسفة الروح مثل : "لافيل" و "رينه لوسن" وفي ألمانيا "نقولا هارتمان". ومن الممكن أن نُدخِل في عِداد أنصار هذا الإتجاه أصحاب الفلسفة التوماوية الجديدة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأمريكا ، من أشهرهم "جاك ماريتان" و "جلسون" ، وطائفة من أساتذة جامعة "لوفان" في بلجيكا وغيرهم.
• الإتِّجاه الوجوديّ : ( فلسفة الوجود )
وهو الإتجاه الذي يُمكن الإرتداد به إلى "كيركجارد". ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه : "مارتن هايدغر" و "كارل يسبرز" في ألمانيا. وفي فرنسا "جان بول سارتر" و "جبريل مارسل" و "موريس ميرلوبونتي" الذي شغل كرسي الفلسفة خلفاً لبرغسون في "الكوليج دو فرانس".
وقد ظهرت في فرنسا مدرسة أُطلِق عليها إسم "مدرسة باريس" تأثرت بالوجودية ، من أهم أعلامها : "جان فال" و "جان جرانييه" و "ألكييه" وغيرهم.
ويتصل بهذا الإتِّجاه إتجاه آخر هو "الشخصانية" ومن أشهر ممثليه في فرنسا "مونييه" و "جان لاكروا" و "نِدونسيل" وغيرهم.
_______
دراسات في الفلسفة المعاصرة ، زكريا ابراهيم ، دار مصر للطباعة.
❤9👍2
« فإن روسو الذي ألف بحثا عظيما في التربية قدم نفسه فيه على أنه الأب الحنون، لم يؤلفه على الرغم من تخليه عن أطفاله الخمسة، بل بسبب هذا التخلي » ص: 18
« فالفيلسوف فوكو في الوقت الذي كان فيه يعلم طلابه الشجاعة في قول الحقيقة، كان يخفي أمر إصابته بمرض السيدا الذي قضي عليه بعد أشهر قليلة من ذلك » ص: 19
« ففي الوقت نفسه الذي كانت فيه بوفوار تكتب الجنس الٱخر وتضع أسس الحركة النسوية، كانت تعيش حبا مستعرا مع كاتب أمريكي. فمن جهة كانت تنظر من أجل استقلالية النساء، ومن جهة أخرى كانت تدبج العديد من أوراقها التي تصف تلذذها في الوقوع في حب متيم مذل » ص: 21
« .. الفيلسوف التجريبي كيركيجارد الذي استطاع بفضل تأليفه تحت عدة أسماء مستعارة أن يناصر، ويعيش وفق نظريات متناقضة. فبينما يكتب خطابات دينية كان يعيش حياة ماجنة، وإذ يكتب في إحدى الصحف عن زير النساء كان يعيش حياة النسك والمتزهد » ص: 21
« فالفيلسوف فوكو في الوقت الذي كان فيه يعلم طلابه الشجاعة في قول الحقيقة، كان يخفي أمر إصابته بمرض السيدا الذي قضي عليه بعد أشهر قليلة من ذلك » ص: 19
« ففي الوقت نفسه الذي كانت فيه بوفوار تكتب الجنس الٱخر وتضع أسس الحركة النسوية، كانت تعيش حبا مستعرا مع كاتب أمريكي. فمن جهة كانت تنظر من أجل استقلالية النساء، ومن جهة أخرى كانت تدبج العديد من أوراقها التي تصف تلذذها في الوقوع في حب متيم مذل » ص: 21
« .. الفيلسوف التجريبي كيركيجارد الذي استطاع بفضل تأليفه تحت عدة أسماء مستعارة أن يناصر، ويعيش وفق نظريات متناقضة. فبينما يكتب خطابات دينية كان يعيش حياة ماجنة، وإذ يكتب في إحدى الصحف عن زير النساء كان يعيش حياة النسك والمتزهد » ص: 21
👍10❤6
الفيلسوف الجديد
لماذا نتفلسف - جان فرانسوا ليوتار
لماذا نتفلسف؟ هذا السؤال يقع في صميم عمل جان-فرانسوا ليوتار البارز، "لماذا نتفلسف؟"، مجموعة محاضرات تخترق سطح الاستفسارات الوجودية الحديثة لاستكشاف جوهر وإلحاح البحث الفلسفي. ليوتار، عملاق في عالم الفلسفة الفرنسية المعاصرة، يقدم رواية معقدة لا تقتصر فقط على استجواب دور الفلسفة في عالم اليوم، بل أيضًا على إعادة تعريف أهميتها في عصر غالبًا ما يكون متشككًا في الفكر المجرد.
يبدأ ليوتار بتحدي القارئ لمواجهة الفائض الظاهري للفلسفة في العصر الحديث، حيث تسود المعرفة العلمية والدليل التجريبي. يجادل بأن عملية التفلسف ليست بقايا متهالكة من التاريخ، ولكنها عملية حيوية، ديناميكية تمنح الحياة للهواء الراكد للحقائق والمعايير المقبولة. الفلسفة، في نظر ليوتار، تعمل كقوة لا تكل في استجواب الوضع الراهن، دافعة حدود الفهم والإدراك.
مع تكشف الرواية، يغوص ليوتار في التطور التاريخي للفكر الفلسفي، تتبع جذوره من اليونانيين القدماء إلى المفكرين الحديثين. يبرز القوة التحويلية للفلسفة ليس فقط لتفسير العالم، بل لتغييره. من خلال تحليله الثاقب، يظهر ليوتار كيف أن الاستفسار الفلسفي قدم باستمرار منصة لتحدي الأعراف الاجتماعية، والأخلاق، والمعتقدات، مما يحفز التقدم ويعزز فهمًا أعمق وأكثر تعقيدًا للوجود الإنساني.
في قلب حجة ليوتار تكمن فكرة أن الفلسفة تعمل كحارس للفكر النقدي والحرية الفكرية. في عصر يهيمن عليه التقدم التكنولوجي وزيادة المعلومات، يقول إن الفلسفة تقدم ملاذًا للتأمل النقدي، مساحة حيث يمكن استكشاف أسئلة الأخلاق، والمعنى دون قيود. هذا الرأي ذو صلة خاصة في سياق العالم اليوم، حيث تطالب التغيرات والشكوك السريعة بإطار قوي للتنقل في تعقيدات الحياة البشرية.
علاوة على ذلك، يدافع ليوتار بشغف عن ديمقراطية الفلسفة. يجادل بأن الفكر الفلسفي يجب ألا يقتصر على الأوساط الأكاديمية، بل يجب أن يتم تبنيه من الجميع كأداة للتفكير النقدي والتأمل الذاتي. هذه الديمقراطية، حسب ليوتار، ضرورية لتعزيز مجتمع أكثر تنويرًا قادرًا على مواجهة تحدياته بحكمة وبصيرة.
"لماذا نتفلسف؟" ليس مجرد سؤال بلاغي بل هو دعوة للعمل. يلح عمل ليوتار علينا للمشاركة في الفلسفة ليس كتمرين أكاديمي سلبي بل كممارسة نشطة، حيوية أساسية لفهم وتحسين عالمنا. يدعو القراء للشروع في رحلة فلسفية تتحدى الحكمة التقليدية، تشجع على الاستفسار العميق، وفي نهاية المطاف، تنمي تجربة أغنى وأكثر معنى للحياة. من خلال هذا العمل، يعيد ليوتار تأكيد القيمة الخالدة للفلسفة، مذكرًا بأنه في السعي وراء المعرفة والحقيقة، الرحلة مهمة بقدر الوجهة نفسها.
يبدأ ليوتار بتحدي القارئ لمواجهة الفائض الظاهري للفلسفة في العصر الحديث، حيث تسود المعرفة العلمية والدليل التجريبي. يجادل بأن عملية التفلسف ليست بقايا متهالكة من التاريخ، ولكنها عملية حيوية، ديناميكية تمنح الحياة للهواء الراكد للحقائق والمعايير المقبولة. الفلسفة، في نظر ليوتار، تعمل كقوة لا تكل في استجواب الوضع الراهن، دافعة حدود الفهم والإدراك.
مع تكشف الرواية، يغوص ليوتار في التطور التاريخي للفكر الفلسفي، تتبع جذوره من اليونانيين القدماء إلى المفكرين الحديثين. يبرز القوة التحويلية للفلسفة ليس فقط لتفسير العالم، بل لتغييره. من خلال تحليله الثاقب، يظهر ليوتار كيف أن الاستفسار الفلسفي قدم باستمرار منصة لتحدي الأعراف الاجتماعية، والأخلاق، والمعتقدات، مما يحفز التقدم ويعزز فهمًا أعمق وأكثر تعقيدًا للوجود الإنساني.
في قلب حجة ليوتار تكمن فكرة أن الفلسفة تعمل كحارس للفكر النقدي والحرية الفكرية. في عصر يهيمن عليه التقدم التكنولوجي وزيادة المعلومات، يقول إن الفلسفة تقدم ملاذًا للتأمل النقدي، مساحة حيث يمكن استكشاف أسئلة الأخلاق، والمعنى دون قيود. هذا الرأي ذو صلة خاصة في سياق العالم اليوم، حيث تطالب التغيرات والشكوك السريعة بإطار قوي للتنقل في تعقيدات الحياة البشرية.
علاوة على ذلك، يدافع ليوتار بشغف عن ديمقراطية الفلسفة. يجادل بأن الفكر الفلسفي يجب ألا يقتصر على الأوساط الأكاديمية، بل يجب أن يتم تبنيه من الجميع كأداة للتفكير النقدي والتأمل الذاتي. هذه الديمقراطية، حسب ليوتار، ضرورية لتعزيز مجتمع أكثر تنويرًا قادرًا على مواجهة تحدياته بحكمة وبصيرة.
"لماذا نتفلسف؟" ليس مجرد سؤال بلاغي بل هو دعوة للعمل. يلح عمل ليوتار علينا للمشاركة في الفلسفة ليس كتمرين أكاديمي سلبي بل كممارسة نشطة، حيوية أساسية لفهم وتحسين عالمنا. يدعو القراء للشروع في رحلة فلسفية تتحدى الحكمة التقليدية، تشجع على الاستفسار العميق، وفي نهاية المطاف، تنمي تجربة أغنى وأكثر معنى للحياة. من خلال هذا العمل، يعيد ليوتار تأكيد القيمة الخالدة للفلسفة، مذكرًا بأنه في السعي وراء المعرفة والحقيقة، الرحلة مهمة بقدر الوجهة نفسها.
👍7❤4
Forwarded from كتب فلسفية - كتب فلسفة
لماذا نتفلسف - جان فرانسوا ليوتار.pdf
2 MB
المضحك المبكي هو أن ترى أن كل هذه المعرفة والفهم لا يمارسان أي سلطة إطلاقاً على حياة البشر, وأن حياتهم لا تعبر بأقصى طريقة ماذا فهموا .
سورين كيركيغارد: كتاب المرض حتى الموت
سورين كيركيغارد: كتاب المرض حتى الموت
👍7❤5
اشتهر (ديموقريطوس) بـــشخصيته المرحة ولذلك أطلق عليه لقب "الفيلسوف الضاحك" ولكننا نرى عكس ذلك في هذه اللوحة التي رسمها الفنان الإيطالي (سلفاتور روزا) والتي تصور لنا الجانب الآخر من شخصيته..
ديموقريطوس أو ديمقريطس (460 - 370 قبل الميلاد) هو فيلسوف يوناني قديم ولد في أبديرة (تراقيا)، وهو أحد الفلاسفة المؤثرين حيث يعتبر رائدًا في الرؤية المبكرة للنظرية الذرية، ورث عن والده أموال طائلة أنفقها على رحلاته، فقد زار مصر وتعلم الرياضيات من العلماء المصريين، ثم سافر إلى بلاد فارس والهند، ثم عاد إلى أثينا..
عرف عن (ديمقريطس) أنه كان يميل بشكل دائم إلى العزلة وأنه كان يحتقر الشهرة حتى وصل به الأمر أنه استطاع التعرف على سقراط، ولكن سقراط لم يعرفه.
كما ذكر (ديوجين لايرتيوس) أيضًا في كتابه "حياة الفلاسفة البارزين" أن ديمقريطس كان يدرب نفسه عن طريق مجموعة مختلفة من الوسائل لاختبار انطباعاته الحسية، وذلك من خلال اللجوء أحيانًا إلى العزلة أو زيارة المقابر. وأنه عندما عاد من أسفاره، تحول إلى نمط حياة متواضع لأنه استنفد جميع أمواله..
وتماشيًا مع ما قاله (ديوجين) يبدو أن هذا العمل الفني للرسام الإيطالي (سلفاتور روزا) يصور ديموقريطوس وهو يتأمل نظرياته الفلسفية وسط بيئة متواضعة، ربما بالقرب من قبر...
__________
• Source: Stanford Encyclopedia of Philosophy (Democritus), published Sun, Aug 15, 2004..
• Painting: Democritus in meditation, by Salvator Rosa (c. 1615-1673)..
ديموقريطوس أو ديمقريطس (460 - 370 قبل الميلاد) هو فيلسوف يوناني قديم ولد في أبديرة (تراقيا)، وهو أحد الفلاسفة المؤثرين حيث يعتبر رائدًا في الرؤية المبكرة للنظرية الذرية، ورث عن والده أموال طائلة أنفقها على رحلاته، فقد زار مصر وتعلم الرياضيات من العلماء المصريين، ثم سافر إلى بلاد فارس والهند، ثم عاد إلى أثينا..
عرف عن (ديمقريطس) أنه كان يميل بشكل دائم إلى العزلة وأنه كان يحتقر الشهرة حتى وصل به الأمر أنه استطاع التعرف على سقراط، ولكن سقراط لم يعرفه.
كما ذكر (ديوجين لايرتيوس) أيضًا في كتابه "حياة الفلاسفة البارزين" أن ديمقريطس كان يدرب نفسه عن طريق مجموعة مختلفة من الوسائل لاختبار انطباعاته الحسية، وذلك من خلال اللجوء أحيانًا إلى العزلة أو زيارة المقابر. وأنه عندما عاد من أسفاره، تحول إلى نمط حياة متواضع لأنه استنفد جميع أمواله..
وتماشيًا مع ما قاله (ديوجين) يبدو أن هذا العمل الفني للرسام الإيطالي (سلفاتور روزا) يصور ديموقريطوس وهو يتأمل نظرياته الفلسفية وسط بيئة متواضعة، ربما بالقرب من قبر...
__________
• Source: Stanford Encyclopedia of Philosophy (Democritus), published Sun, Aug 15, 2004..
• Painting: Democritus in meditation, by Salvator Rosa (c. 1615-1673)..
👍3
" لكي تغيروا المجتمع ينبغي أولاً أن تغيروا العقليات السائدة فيه عن طريق التعليم والتثقيف والتهذيب ".
- إيمانويل كانط
- إيمانويل كانط
❤4👍2