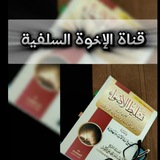💥 جديد النصائح والتوجيهات 💥
#نظرة٠عالم
🔴 سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك.. سائلة تقول:
أنا أدرس في الثانوية و يوجد بها إختلاط و أريد أن أغطي وجهي و المؤسسة تمنعني من ذلك.. و أريد أيضا عدم إكمال الدراسة و لكن والداي يمنعانني من ذلك..
📍 فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أولا لابد أن نعرف أن فيه فرقا مابين المحرم مقاصديا والمحرم لذاته و المحرم وسيلة.. وماما يكون ذريعة للحرام و هو المحرم لغيره..
🔸المحرم لذاته حُرم مقاصديّا كالربا و الزّنا و غيرها.. فحرمت الربا من أجل حفظ المال.. حرّمت الزّنا من أجل حفظ النّسب والأعراض.. وحُرّم القتل من أجل حفظ النّفس ونحو ذلك.
هذه المحرمات تسمى محرّمات لذاتها.. أمّا المحرّم لغيره فما ثبت تحريمه لأنه وسيلة إلى المحرّم لذاته.. كالزنا هو محرم لذاته؛ ولكن وسائله كثيرة؛ كالخلوة و الاختلاط والمراسلة بينهما..
🔸الأمور التي هي وسيلة للمحرم لذاته هذه تحرم وسيلة، و ما حُرم قصدا لا يجوز عند الحاجة.. أما ما حُرم وسيلة يجوز عند الحاجة ككشف الرجل عن عورته .. أو المرأة إذا احتاجت.. هو لا يجوز في الأصل و لكن عند الحاجة يجوز كأن تلد المرأة فيجوز هنا إخراج الولد و لا تخرجه القابلة إلا بالكشف عن العورة.. و القابلة ترى عورتها أيضا.. و الطبيب يرى للرجل سوأته و عورته مثلا إذا كان فيه أذى أو احتاج إلى إدخال أنبوب إستخراج البول المحتقن في مثانته فيما يعرف بالكبس الذي يخرج منه.. هنا جائز، ماكان من باب التطبيب جائز و لابد.. ويمكن يمسّ العورة إذا احتاج لذلك خاصّة الولد عند الولادة.. لا يستطيع أن يخرج من مهبل المرأة.. فلابد أن يوسّع بعملية جراحية خفيفة لكي يخرج إن كان كبيرا أو صغيرا هذا عند الحاجة.. و اذا انتفت الحاجة لا يجوز.
🔸 مثلا ايضا سفر المرأة لوحدها لا يجوز إلا مع ذي محرم لأن المحرم يكون سندا لها من أي عدوان و يبعد عنها كل ما يعرضها للتهلكة و لكنها إن كانت في الحاجة أو الضرورة يجيزها الشافعية و غيرهم مستدلين بالمرأة التي أمنت الطريق الحديث (فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله) ..
🔸لابد إذن من التفريق بين الأمرين و المحرّم لذاته هو الأشدّ والذي عليه مقاصد التشريع.. و ما حُرّم وسيلة هو أخفّ.. خاصة إن لم يقع في الأصل، فالخلوة و الاختلاط إذا لم يكن فيه زنا فقد أثم صاحبه و لكن إثمه ليس كالزنا.. فرق بينهما. ولهذا جاء في الأحاديث.. العينان تزنيان و اليدان و الرجلان كلها تزني.. هذا زنا مجازي ليس حقيقي و الفرج إما يصدق أو يكذب.. هذا مآله الى الزنا. فالنظرة و الابتسامة كلها سهام إبليس توصله إلى الغاية المقاصدية الدنيئة التي حرمها الشرع..
🔸ليس حكم الغاية كحكم الوسيلة هنا ينظر في هذا الباب.. فإذا كانت هناك مفاسد أو أضرار تترتب على التوقف .. ينظر.. وإذا لم يترتب أي شيئ.. تلتمس العلم عن طريق المراسلة أو طريق الإنترنت من غير أن تقع في مفسدة.. لها ذلك.
🔸إن لم ترتّب على نفسها ضررا.. وإذا ترتب ضرر تعمل على أن تستقل بالبنات و لا تجلس إلا معهن و تاخذ الاحتياطات اللاّزمة للابتعاد عن الإختلاط و تبغضه و لا ترضى به و إن أرادت أن تتوقف و ترتبت مفسدة تعمل بالأخذ بأقل المفسدتين و أدنى الضررين.. إذا كانت مفسدة الاختلاط هي أخف ضررا فتتم ولكن تجعل الوسائل و الضوابط الشرعية التي تحول بينهما و بين الوقوع في المحرم لغيره.. و إذا العكس فتقدّم التّوقّف.. إذا كان الضّرر الأشدّ هو الإختلاط من الضّرر الذي يمكن أن يقع في البيت.. تبقى على رأيها بعدم الذهاب..
🔸حاصله أحببت أن أبين لك ماهو محرم لغيره و ماهو محرم لذاته من حيث حجم الذّنب.. الذي يكون مع المحرم لغيره أخفّ ذنبا و لا يترتب عليه حد أو عقاب.. يكفيه العمل الصالح.. جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم.. أني قبّلت امرأة لا تحلّ لي قال أشهدتّ العصر معنا.. الحديث.
🔸إذا ندم و عاد.. فالصلوات و الصّيام و كل عمل صالح مكفرات.. لأن القبلة محرم لغيره و ليس لذاته.. لأنها وسيلة للزّنا.. فالمكفرات كثيرة.. و المرأة هنا أميرة نفسها و تعرف أمور بيتها و مواقف الوالدين..
أعطيتها كل الأمور التي من شأنها أن تقف موقفا على ما تراه و يكون بالضوابط الشرعية... و العلم عند الله. "
ونقله جهدو محمد الأمين
يوم الجمعة 21 رمضان 1446
الموافق ل 21 مارس 2025 .
#نظرة٠عالم
🔴 سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك.. سائلة تقول:
أنا أدرس في الثانوية و يوجد بها إختلاط و أريد أن أغطي وجهي و المؤسسة تمنعني من ذلك.. و أريد أيضا عدم إكمال الدراسة و لكن والداي يمنعانني من ذلك..
📍 فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أولا لابد أن نعرف أن فيه فرقا مابين المحرم مقاصديا والمحرم لذاته و المحرم وسيلة.. وماما يكون ذريعة للحرام و هو المحرم لغيره..
🔸المحرم لذاته حُرم مقاصديّا كالربا و الزّنا و غيرها.. فحرمت الربا من أجل حفظ المال.. حرّمت الزّنا من أجل حفظ النّسب والأعراض.. وحُرّم القتل من أجل حفظ النّفس ونحو ذلك.
هذه المحرمات تسمى محرّمات لذاتها.. أمّا المحرّم لغيره فما ثبت تحريمه لأنه وسيلة إلى المحرّم لذاته.. كالزنا هو محرم لذاته؛ ولكن وسائله كثيرة؛ كالخلوة و الاختلاط والمراسلة بينهما..
🔸الأمور التي هي وسيلة للمحرم لذاته هذه تحرم وسيلة، و ما حُرم قصدا لا يجوز عند الحاجة.. أما ما حُرم وسيلة يجوز عند الحاجة ككشف الرجل عن عورته .. أو المرأة إذا احتاجت.. هو لا يجوز في الأصل و لكن عند الحاجة يجوز كأن تلد المرأة فيجوز هنا إخراج الولد و لا تخرجه القابلة إلا بالكشف عن العورة.. و القابلة ترى عورتها أيضا.. و الطبيب يرى للرجل سوأته و عورته مثلا إذا كان فيه أذى أو احتاج إلى إدخال أنبوب إستخراج البول المحتقن في مثانته فيما يعرف بالكبس الذي يخرج منه.. هنا جائز، ماكان من باب التطبيب جائز و لابد.. ويمكن يمسّ العورة إذا احتاج لذلك خاصّة الولد عند الولادة.. لا يستطيع أن يخرج من مهبل المرأة.. فلابد أن يوسّع بعملية جراحية خفيفة لكي يخرج إن كان كبيرا أو صغيرا هذا عند الحاجة.. و اذا انتفت الحاجة لا يجوز.
🔸 مثلا ايضا سفر المرأة لوحدها لا يجوز إلا مع ذي محرم لأن المحرم يكون سندا لها من أي عدوان و يبعد عنها كل ما يعرضها للتهلكة و لكنها إن كانت في الحاجة أو الضرورة يجيزها الشافعية و غيرهم مستدلين بالمرأة التي أمنت الطريق الحديث (فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله) ..
🔸لابد إذن من التفريق بين الأمرين و المحرّم لذاته هو الأشدّ والذي عليه مقاصد التشريع.. و ما حُرّم وسيلة هو أخفّ.. خاصة إن لم يقع في الأصل، فالخلوة و الاختلاط إذا لم يكن فيه زنا فقد أثم صاحبه و لكن إثمه ليس كالزنا.. فرق بينهما. ولهذا جاء في الأحاديث.. العينان تزنيان و اليدان و الرجلان كلها تزني.. هذا زنا مجازي ليس حقيقي و الفرج إما يصدق أو يكذب.. هذا مآله الى الزنا. فالنظرة و الابتسامة كلها سهام إبليس توصله إلى الغاية المقاصدية الدنيئة التي حرمها الشرع..
🔸ليس حكم الغاية كحكم الوسيلة هنا ينظر في هذا الباب.. فإذا كانت هناك مفاسد أو أضرار تترتب على التوقف .. ينظر.. وإذا لم يترتب أي شيئ.. تلتمس العلم عن طريق المراسلة أو طريق الإنترنت من غير أن تقع في مفسدة.. لها ذلك.
🔸إن لم ترتّب على نفسها ضررا.. وإذا ترتب ضرر تعمل على أن تستقل بالبنات و لا تجلس إلا معهن و تاخذ الاحتياطات اللاّزمة للابتعاد عن الإختلاط و تبغضه و لا ترضى به و إن أرادت أن تتوقف و ترتبت مفسدة تعمل بالأخذ بأقل المفسدتين و أدنى الضررين.. إذا كانت مفسدة الاختلاط هي أخف ضررا فتتم ولكن تجعل الوسائل و الضوابط الشرعية التي تحول بينهما و بين الوقوع في المحرم لغيره.. و إذا العكس فتقدّم التّوقّف.. إذا كان الضّرر الأشدّ هو الإختلاط من الضّرر الذي يمكن أن يقع في البيت.. تبقى على رأيها بعدم الذهاب..
🔸حاصله أحببت أن أبين لك ماهو محرم لغيره و ماهو محرم لذاته من حيث حجم الذّنب.. الذي يكون مع المحرم لغيره أخفّ ذنبا و لا يترتب عليه حد أو عقاب.. يكفيه العمل الصالح.. جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم.. أني قبّلت امرأة لا تحلّ لي قال أشهدتّ العصر معنا.. الحديث.
🔸إذا ندم و عاد.. فالصلوات و الصّيام و كل عمل صالح مكفرات.. لأن القبلة محرم لغيره و ليس لذاته.. لأنها وسيلة للزّنا.. فالمكفرات كثيرة.. و المرأة هنا أميرة نفسها و تعرف أمور بيتها و مواقف الوالدين..
أعطيتها كل الأمور التي من شأنها أن تقف موقفا على ما تراه و يكون بالضوابط الشرعية... و العلم عند الله. "
ونقله جهدو محمد الأمين
يوم الجمعة 21 رمضان 1446
الموافق ل 21 مارس 2025 .
👍2
📌 فوائد ودرر منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢١ رمضان ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
ما هي البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية؟!
وكيف للعامي معرفتها وتمييزها عن السنة؟!
وكيف لطالب العلم ردّها؟! ..
الجواب:
"يُقسّم العلماء البدعة إلى بدعة إضافية، وبدعة حقيقية ..
١- البدعة الحقيقية: هي التي لا يُعرف لها أصل في الشرع، تأتي غالبا بعد استكمال الدين جميعا؛ كما قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم ..} الآية.
يأتي آخرون بشيء لا يُعرَف في هذا الدين الكامل؛ الذي أتمّه الله تعالى، إما من جهة المعتقد، أو في الفروع، أي في الأصول أو الفروع.
من جهة الأصول هناك كثير ممّن يسلك مسالك أهل الكلام المتأثرين بالفلاسفة، والمناطقة، فأخذ أهل الإسلام كتب اليونان الإغريق، وترجموها إلى العربية، مع تحذير من أئمة المسلمين السنيين بعدم دراسة علم الكلام؛ والدخول في علوم المناطقة .. لكن أبَوْا إلا سلوك ذلك، وإدراجها في العقائد، فكان أن ولّدوا عقائد فاسدة، سواء المعتزلة -وهم من أهل البدع-، أو من جهة الأشاعرة، أو الجهميّة، أو الكرّاميّة، وغيرهم .. كلهم أخذوا هذه القواعد، ولم يأخذوا من الكتاب والسنّة، وردّوا حديث الآحاد، ولم يعملوا به في العقائد، سواء مشهور، أو عزيز، أو غريب، بل عملوا بالعقل، والقواعد المنطقيّة العقليّة -عموما- في الغيبيات، والإلهيات، فنَفَوْا الصفات عن الله تعالى، وبعضهم نفى الصفات الاختيارية الفعليّة، وبعضهم أثبت سبع صفات دون الأخرى ..
كل هؤلاء أهل بدع، لأنهم أتَوا بجديد لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا على عهد صحابته، ولا عهد من بعدهم من القرون المفضّلة، (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ..) الحديث.
هذا من جهة الأصول، أما في الفروع فتجد البدعة أيضا، أضافوا لما أتمّه الله، واستدركوا على الشّرع، وحسّنوا بآرائهم كثيرا من العبادات، وأدرجوا فيها ما ليست منها؛ بدعوى أنهم يعبدون الله، ويقولون أن الله تعالى قال: {واعبدوا الله}، لكن يعبدونه بغير ما شرع، لا بما شرع، يضيفون إلى العبادات إضافات لم تكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- .. إنما هي مختلقة، لم يكن لها أي جذور، وهي بدعة حقيقية، سواء في الأصول أو في الفروع.
٢- أما البدعة الإضافية: فلها أصل مقرّر على وجه شرعي، هم وضعوها في غير الوجه الشرعي، وإن كان لها أصل.
الأذان مثلا؛ مشروع، لكن عند إخراج الميّت من الباب إلى المقبرة يؤذّن ..
تقول أن الأذان أصل شرعي، لكن له مَحالّه؛ عند دخول الوقت لإعلام الناس بدخوله، وإما يؤذّن للصلاة من غير إعلام، كالمرأة في البيت، أو إنسان يكون بعيدا عن المسجد، أو في بيته، أو غير ذلك .. يؤذّن، هذه مشروعة، وما عدا ذلك غير مشروع، إلا إذا جاء نص في الباب.
نعم إن لم يأتِ نص فنقول أنها بدعة إضافية، لها أصل، لكن لم تستعمل حسب الشرع، سواء من حيث الزمن، أو المكان، أو الهيئة ..
قراءة القرآن مأمور بها شرعا، والإنسان يتلوه، ويرتّله كما جاء في الآيات: {ورتّل القرآن ترتيلا}، {يتلونه حق تلاوته}، لكن الناس الآن يأتون بتلاوة بصوت مجتمع -على صوت واحد-، وهذا غير معروف في زمن الأولين، ولم يكن إلا بعد القرون المفضلّة، وحتى عند التلبية في الحج كانوا لا يجتمعون فيها على صوت واحد، قد تقع الموافقة لكن تختلف بعد ذلك ..
غالبا هذه البدع لها أربعه أسباب:
أولا: الجهل.
ثانيا: اتّباع الهوى.
ثالثا: اتّباع الآباء، والشيوخ، والتّعصب لهم من غير معرفة الدليل، ولا أن يكون الدليل صحيحا ..
رابعا: تقليد اليهود والنصارى.
هذه أسباب البدع الأربعة، لذا تجد خاصة النصارى يقرؤون الإنجيل بصوت واحد، وتجد أن الصوفيّة أخذوا هذا عنهم، فنقول أن أصلها -القراءة أو التلاوة- صحيح، لكن هيئتها هذه غير صحيحة، فمن هذه الحيثية لا يجوز، لأنه ليس هذا الذي شرعه الله في تلاوته ..
لا نفرّق بين بدعة حسنة وغير حسنة، فكلها غير حسنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (.. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) الحديث، جعل الكل بدعة.
وقالت عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه.
وفي الحديث الآخر: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، يعني باطل، حتى ولو ادّعى صاحبه أنه يتقرّب إلى الله به، فهو يأخذ به ذنبا لا أجرا، لأنه مردود عليه، وأحدث في شرع الله ما لا يرضاه الله تعالى، (إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا) ..
قد تأتي البدعة من حيث الزمان، أو المكان، مثلا التمر عند إدخال الميّت في قبره، كما قال ابن الحاج النّمري في المدخل؛ أن من البدع نشرا؛ الصدقات عند الدفن، وتجعلها عادة .. هذا من حيث الزمن، والمكان، نفس الشيء.
السؤال:
ما هي البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية؟!
وكيف للعامي معرفتها وتمييزها عن السنة؟!
وكيف لطالب العلم ردّها؟! ..
الجواب:
"يُقسّم العلماء البدعة إلى بدعة إضافية، وبدعة حقيقية ..
١- البدعة الحقيقية: هي التي لا يُعرف لها أصل في الشرع، تأتي غالبا بعد استكمال الدين جميعا؛ كما قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم ..} الآية.
يأتي آخرون بشيء لا يُعرَف في هذا الدين الكامل؛ الذي أتمّه الله تعالى، إما من جهة المعتقد، أو في الفروع، أي في الأصول أو الفروع.
من جهة الأصول هناك كثير ممّن يسلك مسالك أهل الكلام المتأثرين بالفلاسفة، والمناطقة، فأخذ أهل الإسلام كتب اليونان الإغريق، وترجموها إلى العربية، مع تحذير من أئمة المسلمين السنيين بعدم دراسة علم الكلام؛ والدخول في علوم المناطقة .. لكن أبَوْا إلا سلوك ذلك، وإدراجها في العقائد، فكان أن ولّدوا عقائد فاسدة، سواء المعتزلة -وهم من أهل البدع-، أو من جهة الأشاعرة، أو الجهميّة، أو الكرّاميّة، وغيرهم .. كلهم أخذوا هذه القواعد، ولم يأخذوا من الكتاب والسنّة، وردّوا حديث الآحاد، ولم يعملوا به في العقائد، سواء مشهور، أو عزيز، أو غريب، بل عملوا بالعقل، والقواعد المنطقيّة العقليّة -عموما- في الغيبيات، والإلهيات، فنَفَوْا الصفات عن الله تعالى، وبعضهم نفى الصفات الاختيارية الفعليّة، وبعضهم أثبت سبع صفات دون الأخرى ..
كل هؤلاء أهل بدع، لأنهم أتَوا بجديد لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا على عهد صحابته، ولا عهد من بعدهم من القرون المفضّلة، (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ..) الحديث.
هذا من جهة الأصول، أما في الفروع فتجد البدعة أيضا، أضافوا لما أتمّه الله، واستدركوا على الشّرع، وحسّنوا بآرائهم كثيرا من العبادات، وأدرجوا فيها ما ليست منها؛ بدعوى أنهم يعبدون الله، ويقولون أن الله تعالى قال: {واعبدوا الله}، لكن يعبدونه بغير ما شرع، لا بما شرع، يضيفون إلى العبادات إضافات لم تكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- .. إنما هي مختلقة، لم يكن لها أي جذور، وهي بدعة حقيقية، سواء في الأصول أو في الفروع.
٢- أما البدعة الإضافية: فلها أصل مقرّر على وجه شرعي، هم وضعوها في غير الوجه الشرعي، وإن كان لها أصل.
الأذان مثلا؛ مشروع، لكن عند إخراج الميّت من الباب إلى المقبرة يؤذّن ..
تقول أن الأذان أصل شرعي، لكن له مَحالّه؛ عند دخول الوقت لإعلام الناس بدخوله، وإما يؤذّن للصلاة من غير إعلام، كالمرأة في البيت، أو إنسان يكون بعيدا عن المسجد، أو في بيته، أو غير ذلك .. يؤذّن، هذه مشروعة، وما عدا ذلك غير مشروع، إلا إذا جاء نص في الباب.
نعم إن لم يأتِ نص فنقول أنها بدعة إضافية، لها أصل، لكن لم تستعمل حسب الشرع، سواء من حيث الزمن، أو المكان، أو الهيئة ..
قراءة القرآن مأمور بها شرعا، والإنسان يتلوه، ويرتّله كما جاء في الآيات: {ورتّل القرآن ترتيلا}، {يتلونه حق تلاوته}، لكن الناس الآن يأتون بتلاوة بصوت مجتمع -على صوت واحد-، وهذا غير معروف في زمن الأولين، ولم يكن إلا بعد القرون المفضلّة، وحتى عند التلبية في الحج كانوا لا يجتمعون فيها على صوت واحد، قد تقع الموافقة لكن تختلف بعد ذلك ..
غالبا هذه البدع لها أربعه أسباب:
أولا: الجهل.
ثانيا: اتّباع الهوى.
ثالثا: اتّباع الآباء، والشيوخ، والتّعصب لهم من غير معرفة الدليل، ولا أن يكون الدليل صحيحا ..
رابعا: تقليد اليهود والنصارى.
هذه أسباب البدع الأربعة، لذا تجد خاصة النصارى يقرؤون الإنجيل بصوت واحد، وتجد أن الصوفيّة أخذوا هذا عنهم، فنقول أن أصلها -القراءة أو التلاوة- صحيح، لكن هيئتها هذه غير صحيحة، فمن هذه الحيثية لا يجوز، لأنه ليس هذا الذي شرعه الله في تلاوته ..
لا نفرّق بين بدعة حسنة وغير حسنة، فكلها غير حسنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (.. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) الحديث، جعل الكل بدعة.
وقالت عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه.
وفي الحديث الآخر: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، يعني باطل، حتى ولو ادّعى صاحبه أنه يتقرّب إلى الله به، فهو يأخذ به ذنبا لا أجرا، لأنه مردود عليه، وأحدث في شرع الله ما لا يرضاه الله تعالى، (إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا) ..
قد تأتي البدعة من حيث الزمان، أو المكان، مثلا التمر عند إدخال الميّت في قبره، كما قال ابن الحاج النّمري في المدخل؛ أن من البدع نشرا؛ الصدقات عند الدفن، وتجعلها عادة .. هذا من حيث الزمن، والمكان، نفس الشيء.
إحداثات اليوم الثالث، والسابع، والأربعين .. من حيث الزمن، من أين لك هذا؟!
فيه دليل على الصدقة في اليوم الثالث، والسابع، والأربعين؟! لا.
فتكون بدعة إضافية.
الصدقة أصلها جائز، لكن لما يجعلها تتعلّق بزمن، أو مكان، أو هيئة معيّنة، أو يعقد عليها اعتقادا معيّنا .. فتُعدّ من البدع الإضافية، وهي من حيث الحكم كالأخرى، وكلّ بدعة ضلالة، مردودة على صاحبها.
الواجب على الإنسان أن ينكرها إذا لم يستطع تغييرها، وذلك أضعف الإيمان، أما إن أقرّ بها، ورضيها .. فهو مع هذا الأمر، يلحقه إثمه، لأنه رضيّه، ولا يجوز أن يرضى عن البدعة، بل يحاربها، لأن الإقرار بها إزالة للسنة، وإزالتها إرجاع للسنة مكانها، فهما ضدّان.
تقرّ في شهادتك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- متبوعك، أمتثل أمره، وأنتهي عن نهيه وزجره، ولا أقدّم عليه كائنا من كان، وأصدقه فيما أخبر، ثم تأتي بالبدعة التي نهانا عنها، وهو بريء منها، فلست صادقا في شهادة أن محمدا رسول الله.
يقول أشهد أن محمدا رسول الله؛ ثم يقرّ البدعة؛ فلم يُطع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؛ ثم يأتي القبور، ويطوف بها .. فيجب أن يراجع الشهادتين ..
خطورتها راجعة للشهادتين، إن لم تكن لك الشهادتان فهذه مشكلة.
هذه البدعة المفسّقة، أما المكفرة فأخطر، تخرج صاحبها من دائرة الإسلام الذي جاء بالتوحيد، وهؤلاء جاؤوا بما ينافيه، يعتقد في صاحب القبر خصائص الربوبية، ويطوف به، وعند القحط يذهبون إلى القبر ويدعونه لنزول الغيث، ويذبحون له .. ثم يأتيهم الغيث موافقة؛ فيقول جازما: استجيب لنا .. وهذا استدراج لهم.
هذه بدعة مكفرة، ذهبت الشهادتان، فيخرج من دائرة الإسلام، وهذا شرك أكبر، يجعلون إله من دون الله، وهو في نفسه حائر في قبره.
إذا رضي بما يفعلون قبل موته فهو من الطاغوت، ويجب أن ينكر ذلك، لكن غالبا المتصوفة لا ينكرون، وتجدهم يسجدون له، ولا يرضى عمّن لا يسجد له، ولما يموت يضعون له هذا .. فهم يعبدونه، ويتّخذونه إله، وهو طاغوت، وكلهم خارجون عن دائرة الإسلام، وهذه بدعة مكفّرة، وهذا طرأ على الإسلام طروءًا استدراكيا؛ يرفضه الإسلام من جذوره، والإسلام جاء ليُحارب هذا الأمر، ويجعل الوحدانية لله تعالى، وهؤلاء أحدثوا وأحدثوا ..
فلابدّ للناس من استفاقة، ووعي، ودعوة مؤصّلة، نافذة إلى القلوب، تخرج الناس من غفلتهم، وتظهر لهم البدع المكفرة، والمفسقة، والإضافية، والحقيقية ..
آثارها حقيقيّة .. فتجد مباركة مذاهب أهل الكلام، ومثل هذا لا ينكرونه، يُعرّفون الشهادة بـ: لا خالق ولا رب إلا الله، والأشاعرة وغيرهم يقولون نعتقد أنه خالق .. لكن يعتقدون الرازقية في الولي ..
عندنا أن هذا إثبات للربوبية فقط، أين العبادة والألوهية؟!
حتى أهل الجاهلية كانوا يقولون بهذا، {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} الآية.
هذا التحريف أضلّ به الأشاعرة كثيرا، ولما تقول أنهم مشركون، يذبحون لغير الله .. يقولون لا، فالشرك المنافي للتوحيد ما كان فيه اعتقاد كذا .. وتجدهم في إثبات الألوهية لا يثبتونها، ويدخلون في الخلاف مع المذاهب الفلسفية فقط في دائرة الربوبية، ونسوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، قال تعالى: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله}، والعبادة والألوهية هي عبادة الله وحده، من جهة العبد عبادة، ومن جهة المعبود ألوهية، سمّها ما شئت.
هم يثبتون الربوبية، ويشركون في الألوهية والعبادة، ووقعوا في بدع شتّى.
هؤلاء يحتاجون جهودا كثيرة لتنقية وتصفية هذه الأذهان المليئة بتراكمات، وترسّبات البدع، والضلالات في أنفسهم، يلزمهم تراكم الجهود، فطالب العلم يركّز على هذا، وعلى الدعوة إلى ما كان عليه الأئمة الفحول، والأنبياء من قبل، يركّزون على التوحيد، ويبقى إلى قيام الساعة، لأن أهل الشرك، والبدع باقون، اليهود، والنصارى، وغيرهم .. وعند المسلمين مظاهر شركية؛ عند المتصوفة، والشيعة .. وفي الباطن، واللّفظ .. موجود هذا.
يعتقدون معتقدات باطلة، أو باللّسان؛ يستغيثون بغير الله .. وهذه كلها بدع، تدخل في العقائد، والفقه ..
لذا حذّرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، وأمرنا بوجوب المحافظة على دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، نحتفظ بها سالمة من كل دخن ودرن، كما جاء في الآية: {إلا من أتى الله بقلب سليم}، يعني خالص من الشركيات والضلالات، وغيرها .. مما ينافي الدين، والتوحيد بدرجة أولى
لا نردّ أصل هذا من غير اقتران بفرعه أو وصفه، قد تقول يردّ الوصف ولا يردّ الأصل؛ لكن إذا خلا من الوصف تردّه ككل، لأنه لا ينفصل الوصف عن الأصل.
تقول القراءة الجماعية؛ تنزعها ككل، بوصفها بأصلها، وتقول أن القراءة غير الجماعية هي التي كانت الأصل الذي من الشرع، والوصف صار مختلطا بالأصل.
فيه دليل على الصدقة في اليوم الثالث، والسابع، والأربعين؟! لا.
فتكون بدعة إضافية.
الصدقة أصلها جائز، لكن لما يجعلها تتعلّق بزمن، أو مكان، أو هيئة معيّنة، أو يعقد عليها اعتقادا معيّنا .. فتُعدّ من البدع الإضافية، وهي من حيث الحكم كالأخرى، وكلّ بدعة ضلالة، مردودة على صاحبها.
الواجب على الإنسان أن ينكرها إذا لم يستطع تغييرها، وذلك أضعف الإيمان، أما إن أقرّ بها، ورضيها .. فهو مع هذا الأمر، يلحقه إثمه، لأنه رضيّه، ولا يجوز أن يرضى عن البدعة، بل يحاربها، لأن الإقرار بها إزالة للسنة، وإزالتها إرجاع للسنة مكانها، فهما ضدّان.
تقرّ في شهادتك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- متبوعك، أمتثل أمره، وأنتهي عن نهيه وزجره، ولا أقدّم عليه كائنا من كان، وأصدقه فيما أخبر، ثم تأتي بالبدعة التي نهانا عنها، وهو بريء منها، فلست صادقا في شهادة أن محمدا رسول الله.
يقول أشهد أن محمدا رسول الله؛ ثم يقرّ البدعة؛ فلم يُطع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؛ ثم يأتي القبور، ويطوف بها .. فيجب أن يراجع الشهادتين ..
خطورتها راجعة للشهادتين، إن لم تكن لك الشهادتان فهذه مشكلة.
هذه البدعة المفسّقة، أما المكفرة فأخطر، تخرج صاحبها من دائرة الإسلام الذي جاء بالتوحيد، وهؤلاء جاؤوا بما ينافيه، يعتقد في صاحب القبر خصائص الربوبية، ويطوف به، وعند القحط يذهبون إلى القبر ويدعونه لنزول الغيث، ويذبحون له .. ثم يأتيهم الغيث موافقة؛ فيقول جازما: استجيب لنا .. وهذا استدراج لهم.
هذه بدعة مكفرة، ذهبت الشهادتان، فيخرج من دائرة الإسلام، وهذا شرك أكبر، يجعلون إله من دون الله، وهو في نفسه حائر في قبره.
إذا رضي بما يفعلون قبل موته فهو من الطاغوت، ويجب أن ينكر ذلك، لكن غالبا المتصوفة لا ينكرون، وتجدهم يسجدون له، ولا يرضى عمّن لا يسجد له، ولما يموت يضعون له هذا .. فهم يعبدونه، ويتّخذونه إله، وهو طاغوت، وكلهم خارجون عن دائرة الإسلام، وهذه بدعة مكفّرة، وهذا طرأ على الإسلام طروءًا استدراكيا؛ يرفضه الإسلام من جذوره، والإسلام جاء ليُحارب هذا الأمر، ويجعل الوحدانية لله تعالى، وهؤلاء أحدثوا وأحدثوا ..
فلابدّ للناس من استفاقة، ووعي، ودعوة مؤصّلة، نافذة إلى القلوب، تخرج الناس من غفلتهم، وتظهر لهم البدع المكفرة، والمفسقة، والإضافية، والحقيقية ..
آثارها حقيقيّة .. فتجد مباركة مذاهب أهل الكلام، ومثل هذا لا ينكرونه، يُعرّفون الشهادة بـ: لا خالق ولا رب إلا الله، والأشاعرة وغيرهم يقولون نعتقد أنه خالق .. لكن يعتقدون الرازقية في الولي ..
عندنا أن هذا إثبات للربوبية فقط، أين العبادة والألوهية؟!
حتى أهل الجاهلية كانوا يقولون بهذا، {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} الآية.
هذا التحريف أضلّ به الأشاعرة كثيرا، ولما تقول أنهم مشركون، يذبحون لغير الله .. يقولون لا، فالشرك المنافي للتوحيد ما كان فيه اعتقاد كذا .. وتجدهم في إثبات الألوهية لا يثبتونها، ويدخلون في الخلاف مع المذاهب الفلسفية فقط في دائرة الربوبية، ونسوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، قال تعالى: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله}، والعبادة والألوهية هي عبادة الله وحده، من جهة العبد عبادة، ومن جهة المعبود ألوهية، سمّها ما شئت.
هم يثبتون الربوبية، ويشركون في الألوهية والعبادة، ووقعوا في بدع شتّى.
هؤلاء يحتاجون جهودا كثيرة لتنقية وتصفية هذه الأذهان المليئة بتراكمات، وترسّبات البدع، والضلالات في أنفسهم، يلزمهم تراكم الجهود، فطالب العلم يركّز على هذا، وعلى الدعوة إلى ما كان عليه الأئمة الفحول، والأنبياء من قبل، يركّزون على التوحيد، ويبقى إلى قيام الساعة، لأن أهل الشرك، والبدع باقون، اليهود، والنصارى، وغيرهم .. وعند المسلمين مظاهر شركية؛ عند المتصوفة، والشيعة .. وفي الباطن، واللّفظ .. موجود هذا.
يعتقدون معتقدات باطلة، أو باللّسان؛ يستغيثون بغير الله .. وهذه كلها بدع، تدخل في العقائد، والفقه ..
لذا حذّرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، وأمرنا بوجوب المحافظة على دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، نحتفظ بها سالمة من كل دخن ودرن، كما جاء في الآية: {إلا من أتى الله بقلب سليم}، يعني خالص من الشركيات والضلالات، وغيرها .. مما ينافي الدين، والتوحيد بدرجة أولى
لا نردّ أصل هذا من غير اقتران بفرعه أو وصفه، قد تقول يردّ الوصف ولا يردّ الأصل؛ لكن إذا خلا من الوصف تردّه ككل، لأنه لا ينفصل الوصف عن الأصل.
تقول القراءة الجماعية؛ تنزعها ككل، بوصفها بأصلها، وتقول أن القراءة غير الجماعية هي التي كانت الأصل الذي من الشرع، والوصف صار مختلطا بالأصل.
👍1
الصدقة كذلك؛ فتقول تنزع وصف الزمان والمكان، فيجب أن يكون الأصل ذلك موافقا للشرع، يعني تنزعها -الصدقة- في ذاك المكان، فلو تنزع الصدقه في ذاك المكان تبقى الصدقة الأصلية في غير ذلك، فنعتدّ بالأصل الذي شرعه المشرّع؛ دون أن يكون مختلطا بوصف باطل .."
✍️البدعــة تستلــزم محاذيــر فاســدة :•
👈🏻 فأَولاً : تستلزم تكذيب قول الله تعالىٰ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [ المائدة : 3 ] ؛ لأَنَّه إِذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينًا ؛ فمقتضاه أَنَّ الدِّين لم يكمل .
👈• ثانيًا : تستلزم القدح في الشَّريعة ، وأَنَّها ناقصة ؛ فأَكملها هٰذا المبتدع .
👈🏼• ثالثًا : تستلزم القدح في المسلمين الَّذين لم يأْتوا بها ؛ فكل من سبق هٰذه البدع من النَّاس دينهم ناقص ! وهٰذا خطير !!
👈• رابعًا : من لوازم هٰذه البدعة أَنَّ الغالب أَنَّ مَن اشتغل ببدعة ؛ انشغل عن سُنَّة ؛ كما قال بعض السَّلف : « ما أَحْدثَ قَومٌ بِدْعَةً ؛ إِلَّا هَدمُوا مِثْلَها مِنَ السُّنَّةِ » .
👈• خامسًا : أَنَّ هٰذه البدع توجب تفرُّق الأُمَّة ؛ لأَنَّ هٰؤلاء المبتدعة يعتقدون أَنَّهم هم أَصحاب الحقّ ؛ ومن سواهم علىٰ ضلال !! وأَهل الحقّ يقولون : أَنتم الَّذين علىٰ ضلال ! فتتفرق قلوبهم .فهٰذه مفاسد عظيمة ؛ كلها تترتب علىٰ البدعة من حيث هي بدعة ، مع أَنَّه يتَّصل بهٰذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدِّين .اهـ.
([ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلاَّمة:محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالىٰ - ( 2 / 316 ) دار ابن الجوزي ])
👈🏻 فأَولاً : تستلزم تكذيب قول الله تعالىٰ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [ المائدة : 3 ] ؛ لأَنَّه إِذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينًا ؛ فمقتضاه أَنَّ الدِّين لم يكمل .
👈• ثانيًا : تستلزم القدح في الشَّريعة ، وأَنَّها ناقصة ؛ فأَكملها هٰذا المبتدع .
👈🏼• ثالثًا : تستلزم القدح في المسلمين الَّذين لم يأْتوا بها ؛ فكل من سبق هٰذه البدع من النَّاس دينهم ناقص ! وهٰذا خطير !!
👈• رابعًا : من لوازم هٰذه البدعة أَنَّ الغالب أَنَّ مَن اشتغل ببدعة ؛ انشغل عن سُنَّة ؛ كما قال بعض السَّلف : « ما أَحْدثَ قَومٌ بِدْعَةً ؛ إِلَّا هَدمُوا مِثْلَها مِنَ السُّنَّةِ » .
👈• خامسًا : أَنَّ هٰذه البدع توجب تفرُّق الأُمَّة ؛ لأَنَّ هٰؤلاء المبتدعة يعتقدون أَنَّهم هم أَصحاب الحقّ ؛ ومن سواهم علىٰ ضلال !! وأَهل الحقّ يقولون : أَنتم الَّذين علىٰ ضلال ! فتتفرق قلوبهم .فهٰذه مفاسد عظيمة ؛ كلها تترتب علىٰ البدعة من حيث هي بدعة ، مع أَنَّه يتَّصل بهٰذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدِّين .اهـ.
([ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلاَّمة:محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالىٰ - ( 2 / 316 ) دار ابن الجوزي ])
💥 جديد الفتاوى الرّمضانيّة 💥
سأل محمد زرارقة فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، 22 رمضان.. عن إمام قرأ قول اللّه: ومن آياته الليل والنهار والشّمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون... كبّر وسجد في غير موضع السجود في الآية..
هل عليه سهو؟! وهل يلزم المأمومين متابعته وهل يشرع له التّسبيح ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" الذي أعلمه أنّ هذه الآيات من ذكر السّجود إلى غاية موضعه، هي كلّها محل للسجود، والأحسن أن يسجد في آخرها عند موضعه.. إن وصل في وسطها وسجد فسجوده صحيح.. لأنّها هي سنّة وليست بواجب.. وهو بسجوده في محل السجود لكن لم يقع في الأكمل.. فأرجو أن يصحّ سجوده.. ويتابع في ذلك. نعم. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.
سأل محمد زرارقة فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك، 22 رمضان.. عن إمام قرأ قول اللّه: ومن آياته الليل والنهار والشّمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون... كبّر وسجد في غير موضع السجود في الآية..
هل عليه سهو؟! وهل يلزم المأمومين متابعته وهل يشرع له التّسبيح ؟!
فكان مما أجاب به حفظه الله:
" الذي أعلمه أنّ هذه الآيات من ذكر السّجود إلى غاية موضعه، هي كلّها محل للسجود، والأحسن أن يسجد في آخرها عند موضعه.. إن وصل في وسطها وسجد فسجوده صحيح.. لأنّها هي سنّة وليست بواجب.. وهو بسجوده في محل السجود لكن لم يقع في الأكمل.. فأرجو أن يصحّ سجوده.. ويتابع في ذلك. نعم. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.
👍7
الإمام مالـــــــــك :
كل ما لَم يوافق الكتاب والسُّنة فاتركوه.
👇
[جامع بيان العلم وفضله، ٧٧٥/١]
كل ما لَم يوافق الكتاب والسُّنة فاتركوه.
👇
[جامع بيان العلم وفضله، ٧٧٥/١]
👍3
💥 جديد الفوائد 💥
سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه، الخامس عشر من رمضان 1446
شيخنا ذكرَ أحدهم أنه لا يَحسُن إطلاق لفظ المشرّع على النّبيّ صَلى الله عليهِ وسلم. لأن المشرّع هو الله وحده.. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مُبلّغ للشرع. فما صحة هذا القول ؟
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه:
هو لمّا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم مشرّع باعتبار أنّ كلامه وحي، وأنه يأتي بالوحي يبيّن للناس ما شرعه الله لهم و لكن في الحقيقة المشرع هو الله تعالى " إنِ الحكمُ إلا للّه " الآية.
التشريع هو الحكم.. يعني الحكم الشرعي؛ والحكم الشّرعيّ سواء في باب التوحيد أو باب العقيدة أو باب العمل أو باب الأخلاق أو غيرها ... كل من الله.. " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " الآية.
وفي قوله تعالى " إن الحكم إلا للهِ أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدّين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".. و آيات كثيرة في ذلك. ولكن فيه آيات آخر تبين أن الرجوع إلى كتاب اللّه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكونهما مصدرا التشريع.
إذا نظرت إلى القرآن فهو يحثّ على التّمسّك بالسنّة والرّجوع إليها.. قال تعالى: " فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله " أي المصدر الأصلي هو الله ،وهو المُصَدّر للأحكام ،ولكن المبلغ عن الله لا نعرفه إلا عن طريقه فهو لا يشرع وإنما يأتيه الوحي و يبلّغه عن الله فإن أطلق عنه لفظ التشريع أطلق عنه مجازا لا حقيقة.. لأن الله تعالى أمر بإتباعه وبسلوك طريقه..
قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله" " من يطع الرسول فقد أطاع الله.." هذه الآيات تدلّ أنّ النبيّ صلّى الّله عليهِ وسلّم إن قال شيء فإنه وحي.
أما الأمور الأخرى كالحروب والقضاء والأمور الدنيوية هذه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها برأيه لهذا لما سئل عن التأبير (التلقيح) فأمرهم أن يؤبروا فلم تحصل الثمرة.. فعادوا إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم ...
وفي القضاء يقضي لغير المستحِقّ فقال:".. وإِنكمْ تختصمُون إِلي، ولَعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بَعضٍ؛ فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قَضيت لَه بحَق أخيه فإِنما أقطع له قطعة من النار.." فالقضاء بحسب الأدلة التي أدلى بها كل واحد..
أما تعليم الناس الصلاة وتعليم الناس دينهم فهذا كلّه بالوحي.. جبريل يأتي يبيّن له كيف يصلّي وووو... فهو يبلّغ الناس شرعَ اللّه.
الأصل إطلاق لفظ المشرّع عن اللّه تعالى لأنه هو أصل التشريع.. لكن تجد علماء الأصول لما ينظرون لهذه المسائل يرون أنه إن نظر إليها في صورة مجردة فالمصدر الوحيد هو القرآن وإذا نظر إليه باعتبار ما دل عليه الكتاب دلّ على السنة و الإجماع و القياس فهذه راجعة إليه ولا تسمى تشريعا.. إنما نقول عموم ما نحصل به على الحكم الشرعي بالكتاب والسنة والإجماع والقياس..
" النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال لا تجتمع أمّتي على ضلالة " بمعنى الحكم المجمع عليه صحيح.. والقياس الصحيح.. إذا لم يختل أحد أركانه وإذا أمعنت النّظر وجدتّ أنّ هذه السّنّة والإجماع والقياس كلها راجعة إلى الكتاب، والكتاب هو الذي دلّ على السّنة كما ذكرت آيات السالفة.. وهو دل على الإجماع كما جاء في قوله " ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.. " الآية.
والقياس هو التمسّك بمعقول النص. معقول النّصّ في الكتاب والسّنّة والسنة راجعة إلى الكتاب.. فإذن المصدر الوحيد هو الكتاب والمشرع هو الله بهذا الإعتبار المشرع هو نعم.
المصدر الثاني بعد الكتاب هو السنة والسنة ينطق بها النّبي صلّى الله عليه وسلم لكنها وحي ألفاظها ليست قرآنا ولكن هي وحي.." إن هو إلا وحيٌ يوحى.. الآية.
من هذا القبيل التشريع ليس منه ولكن من الله تعالى.. لكن صدور الحكم الإلهي، بلسانه.. بخلاف الإجماع والقياس وغير ذلك.. "
ونقله من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحامدي
سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه، الخامس عشر من رمضان 1446
شيخنا ذكرَ أحدهم أنه لا يَحسُن إطلاق لفظ المشرّع على النّبيّ صَلى الله عليهِ وسلم. لأن المشرّع هو الله وحده.. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مُبلّغ للشرع. فما صحة هذا القول ؟
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه اللّه:
هو لمّا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم مشرّع باعتبار أنّ كلامه وحي، وأنه يأتي بالوحي يبيّن للناس ما شرعه الله لهم و لكن في الحقيقة المشرع هو الله تعالى " إنِ الحكمُ إلا للّه " الآية.
التشريع هو الحكم.. يعني الحكم الشرعي؛ والحكم الشّرعيّ سواء في باب التوحيد أو باب العقيدة أو باب العمل أو باب الأخلاق أو غيرها ... كل من الله.. " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " الآية.
وفي قوله تعالى " إن الحكم إلا للهِ أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدّين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".. و آيات كثيرة في ذلك. ولكن فيه آيات آخر تبين أن الرجوع إلى كتاب اللّه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكونهما مصدرا التشريع.
إذا نظرت إلى القرآن فهو يحثّ على التّمسّك بالسنّة والرّجوع إليها.. قال تعالى: " فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله " أي المصدر الأصلي هو الله ،وهو المُصَدّر للأحكام ،ولكن المبلغ عن الله لا نعرفه إلا عن طريقه فهو لا يشرع وإنما يأتيه الوحي و يبلّغه عن الله فإن أطلق عنه لفظ التشريع أطلق عنه مجازا لا حقيقة.. لأن الله تعالى أمر بإتباعه وبسلوك طريقه..
قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله" " من يطع الرسول فقد أطاع الله.." هذه الآيات تدلّ أنّ النبيّ صلّى الّله عليهِ وسلّم إن قال شيء فإنه وحي.
أما الأمور الأخرى كالحروب والقضاء والأمور الدنيوية هذه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها برأيه لهذا لما سئل عن التأبير (التلقيح) فأمرهم أن يؤبروا فلم تحصل الثمرة.. فعادوا إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم ...
وفي القضاء يقضي لغير المستحِقّ فقال:".. وإِنكمْ تختصمُون إِلي، ولَعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بَعضٍ؛ فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قَضيت لَه بحَق أخيه فإِنما أقطع له قطعة من النار.." فالقضاء بحسب الأدلة التي أدلى بها كل واحد..
أما تعليم الناس الصلاة وتعليم الناس دينهم فهذا كلّه بالوحي.. جبريل يأتي يبيّن له كيف يصلّي وووو... فهو يبلّغ الناس شرعَ اللّه.
الأصل إطلاق لفظ المشرّع عن اللّه تعالى لأنه هو أصل التشريع.. لكن تجد علماء الأصول لما ينظرون لهذه المسائل يرون أنه إن نظر إليها في صورة مجردة فالمصدر الوحيد هو القرآن وإذا نظر إليه باعتبار ما دل عليه الكتاب دلّ على السنة و الإجماع و القياس فهذه راجعة إليه ولا تسمى تشريعا.. إنما نقول عموم ما نحصل به على الحكم الشرعي بالكتاب والسنة والإجماع والقياس..
" النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال لا تجتمع أمّتي على ضلالة " بمعنى الحكم المجمع عليه صحيح.. والقياس الصحيح.. إذا لم يختل أحد أركانه وإذا أمعنت النّظر وجدتّ أنّ هذه السّنّة والإجماع والقياس كلها راجعة إلى الكتاب، والكتاب هو الذي دلّ على السّنة كما ذكرت آيات السالفة.. وهو دل على الإجماع كما جاء في قوله " ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.. " الآية.
والقياس هو التمسّك بمعقول النص. معقول النّصّ في الكتاب والسّنّة والسنة راجعة إلى الكتاب.. فإذن المصدر الوحيد هو الكتاب والمشرع هو الله بهذا الإعتبار المشرع هو نعم.
المصدر الثاني بعد الكتاب هو السنة والسنة ينطق بها النّبي صلّى الله عليه وسلم لكنها وحي ألفاظها ليست قرآنا ولكن هي وحي.." إن هو إلا وحيٌ يوحى.. الآية.
من هذا القبيل التشريع ليس منه ولكن من الله تعالى.. لكن صدور الحكم الإلهي، بلسانه.. بخلاف الإجماع والقياس وغير ذلك.. "
ونقله من مجلسه المبارك
أبو معاوية منير الحامدي
👍1
*📃|[ لا تطلب ليلة القدر لاجل دنيا-:*
📌 قال الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى :
*ليلةُ القدر تُرادُ للدِّين لا للدُّنيا، وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلمُ ليلةَ القدر ليطلب بها دُنياه، فليَتُبْ إلى الله من وقع له هذا الخاطرُ السيِّء، فإنَّ الله يقولُ في كتابه العزيز:*
*{مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}*
[سورة الشورى: 20]
*ولسنا ننكر على من يطلب الدنيا بأسبابها التي جعلها الله -تعالى-، وإنما ننكر على من يكون همُّه الدنيا دون الآخرة، حتى إنه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدنيا غافلًا عن الآخرة.*
*📕|[ آثار ابن باديس (٢/٣٢٩)]|*
📌 قال الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى :
*ليلةُ القدر تُرادُ للدِّين لا للدُّنيا، وكثيرٌ من العوامِّ يتمنَّى لو يعلمُ ليلةَ القدر ليطلب بها دُنياه، فليَتُبْ إلى الله من وقع له هذا الخاطرُ السيِّء، فإنَّ الله يقولُ في كتابه العزيز:*
*{مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}*
[سورة الشورى: 20]
*ولسنا ننكر على من يطلب الدنيا بأسبابها التي جعلها الله -تعالى-، وإنما ننكر على من يكون همُّه الدنيا دون الآخرة، حتى إنه يترصَّد ليلة القدر ليطلب فيها الدنيا غافلًا عن الآخرة.*
*📕|[ آثار ابن باديس (٢/٣٢٩)]|*
👍3
#جديد_مجالس_العلم_القبية
من مجلس فضيلة الشيخ محمّد علي فركوس حفظه الله
#السؤال:
▫️ جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.. كنا ناكل على عهد رسول الله ﷺ و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام. قال الترمذي صحيح حسن.
▫️وحديث آخر نهى الرجل أن يشرب واقفا .. سئل عن الأكل قال: هو أشرّ.
▫️وعن ابي هريرة قال رسول الله: لا يشربن أحد منكم قائما .. فمن نسي فل يستقيئ. فماهو وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟!
#الجواب:
▫️أولا العلماء يختلفون على أربعة أقوال في الشرب واقفا و يختلفون في الأكل القائما على قولين مشهورين.. وسبب الخلاف يرجع إلى هذه الآثار.
▫️ من تمسك بظاهرها قال لا يجوز الشرب قائما و من هذه الآثار حديث أنس ابن مالك و حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحج يشرب قائما قال: أتريد أن يشرب معك الهر. قال لا: قال شرب معك أشد منه، الشيطان. فأمره أن يستقيئ ولاشك أن مخالفة الشيطان واجبة و أمره أن يستقيئ لا يكون إلا عن زجر و الزجر أشد من النهي. لهذا قالوا لا يجوز الشرب قائما. وفي رواية أنس زجر النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما.
▫️هذه الأثار دلت انه لا يجوز الشرب قائما.. وتعارضها أحاديث أخرى، منها: حديث علي ابن طالب لما سمع أنه لا يجوز الشرب قائما أهذ إناء فيه ماء ثم قام فشرب قائما قال: هكذا رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلم يشرب قائما. هذا يدل على الجواز.. أي جواز الشرب قائما.. كذلك في حديث ابن عباس أنه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في زمزم، يشرب قائما.
▫️هذه الأحاديث الوادرة في هذا الباب صحّت عن النبي في البخاري و غيره.. تنازع فيها العلماء و في المسلك الذي سلكوه.. فالمسلك الذي سلكه بعضهم سلك مسلك الجمع و بعضهم سلك مسلك الترجيح و بعضهم حمله على صورة معيّنة واستبقى الأصل على ماهو عليه.. مسالكهم مختلفة.
▫️الذي سلك مسلك الجمع الأفضل أن يشرب الشارب قاعدا و إن شرب قائما فيجوز له. عمل بهذه الأحاديث التي فيها النّهي على أنها أولى و أفضل و هو ماذكره النووي و أما الأحاديث الأخرى.. فحملها على الجواز.
▫️الجمع بين القولين يظهر تهافته، لأن الجواز و الأفضلية تنافي الزجر و الأمر بالقيئ .. فلا يتركب الحكم و الحال هكذا لا يجتمعان لما فيه من اضطراب.. إذ كيف يزجره و يأمره أن يستقيئ ثم يقول يجوز الشرب قائما.
الذين سلكوا مسلك التّرجيح نظروا للأوامر و للأفعال قالوا أفعاله غير أقواله و نحن مأمورون بإتباع أقواله دون أفعاله التي خالفت.. بمعنى أن النهي هو القول و لكن الشرب قائما هو الفعل.. وقدّمنا القول على الفعل. هذا من جهة المتن ، أما من جهة الحكم قدّمنا النهي على الجواز و النهي يدل على ترتّب المفسدة.. ونقدم النهي في حالة التعارض، و إذا تعارضا نقدم النهي، لتضمّنه المفسدة و الجواز ليس فيه مفسدة.. لأنه يجوز الفعل ويجوز الترك.. لا يوجد مفسدة.. والآن في النهي مخالفة للشيطان حديث [ شرب من هو أخبث منه الشيطان ] ..
▫️قدمنا النهي لأن فيه مخالفة للشيطان و مخالفته واجبة و كان الترك أولى و لأن النبيّ صلى الله عليه و سلم يحتمل في فعله ثلاث إحتمالات:
#إحتمال_التقعيد؛ أصوليا. معناه العلماء يختلفون أصوليا هل خطاب اللّه يدخل فيه النّبيّ أو لا يدخل فيه.. إذا خاطب خطابا شرعيّا سواءً جاء من القرآن أو السنة هل يدخل فيه المخاطب أي من يبلّغ الناس فيأمره بذلك و هو مأمور و يلتزم به.. أم أنه خارج عن ذلك و يأمرهم هم فقط.. هذا خلاف أصولي. الجمهور على أن المبلّغ و هو النبي صلى اللّه عليه و سلم داخل في الخطاب و هو الصحيح.
#على_قول_القائلين أنه لا يدخل في الخطاب لا إشكال عندهم حديث علي و ابن عباس الذي رآه يشرب قائما و هو في زمزم لا إشكال لأن النبيّ خارج الخطاب.. و الأوامر لأمّته في هذه الأقوال من الناحية التأصيلية.. الصحيح كما قلت أنه يدخل في الخطاب.. و لكن هل فيه ميزة تميزه عن بقية الناس حتى لا يشمله الخطاب؛ ممكن مثلا حديث ما منكم من أحد إلا وُكل به قرين من الجنّ قالوا حتى أنت يارسول قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عنه فلا يأمرني إلا بخير.. اي القرين. يبقى معهم كلهم هؤلاء يأمرون الناس بالشر و الفساد و يوسوسون أيضا و لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم فلا يأمره إلا بالخير.. و لو شرب معه الشيطان يخرج من ذلك النّبيّ و لا يشرب معه. هذه حالة ثانية إن شئت.
#والحالة_الثالثة أن الجواز سابق للنّهي بمعنى أن الأشياء كانت على الجواز ثم يرد النهي لأن أصل الأشياء و الأعيان المنتفع بها على الإباحة خلق لكم مافي الارض جميعا أي كل هذه الأعيان على الجواز باستثناء ماحرمه الله.
من مجلس فضيلة الشيخ محمّد علي فركوس حفظه الله
#السؤال:
▫️ جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.. كنا ناكل على عهد رسول الله ﷺ و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام. قال الترمذي صحيح حسن.
▫️وحديث آخر نهى الرجل أن يشرب واقفا .. سئل عن الأكل قال: هو أشرّ.
▫️وعن ابي هريرة قال رسول الله: لا يشربن أحد منكم قائما .. فمن نسي فل يستقيئ. فماهو وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟!
#الجواب:
▫️أولا العلماء يختلفون على أربعة أقوال في الشرب واقفا و يختلفون في الأكل القائما على قولين مشهورين.. وسبب الخلاف يرجع إلى هذه الآثار.
▫️ من تمسك بظاهرها قال لا يجوز الشرب قائما و من هذه الآثار حديث أنس ابن مالك و حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحج يشرب قائما قال: أتريد أن يشرب معك الهر. قال لا: قال شرب معك أشد منه، الشيطان. فأمره أن يستقيئ ولاشك أن مخالفة الشيطان واجبة و أمره أن يستقيئ لا يكون إلا عن زجر و الزجر أشد من النهي. لهذا قالوا لا يجوز الشرب قائما. وفي رواية أنس زجر النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما.
▫️هذه الأثار دلت انه لا يجوز الشرب قائما.. وتعارضها أحاديث أخرى، منها: حديث علي ابن طالب لما سمع أنه لا يجوز الشرب قائما أهذ إناء فيه ماء ثم قام فشرب قائما قال: هكذا رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلم يشرب قائما. هذا يدل على الجواز.. أي جواز الشرب قائما.. كذلك في حديث ابن عباس أنه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في زمزم، يشرب قائما.
▫️هذه الأحاديث الوادرة في هذا الباب صحّت عن النبي في البخاري و غيره.. تنازع فيها العلماء و في المسلك الذي سلكوه.. فالمسلك الذي سلكه بعضهم سلك مسلك الجمع و بعضهم سلك مسلك الترجيح و بعضهم حمله على صورة معيّنة واستبقى الأصل على ماهو عليه.. مسالكهم مختلفة.
▫️الذي سلك مسلك الجمع الأفضل أن يشرب الشارب قاعدا و إن شرب قائما فيجوز له. عمل بهذه الأحاديث التي فيها النّهي على أنها أولى و أفضل و هو ماذكره النووي و أما الأحاديث الأخرى.. فحملها على الجواز.
▫️الجمع بين القولين يظهر تهافته، لأن الجواز و الأفضلية تنافي الزجر و الأمر بالقيئ .. فلا يتركب الحكم و الحال هكذا لا يجتمعان لما فيه من اضطراب.. إذ كيف يزجره و يأمره أن يستقيئ ثم يقول يجوز الشرب قائما.
الذين سلكوا مسلك التّرجيح نظروا للأوامر و للأفعال قالوا أفعاله غير أقواله و نحن مأمورون بإتباع أقواله دون أفعاله التي خالفت.. بمعنى أن النهي هو القول و لكن الشرب قائما هو الفعل.. وقدّمنا القول على الفعل. هذا من جهة المتن ، أما من جهة الحكم قدّمنا النهي على الجواز و النهي يدل على ترتّب المفسدة.. ونقدم النهي في حالة التعارض، و إذا تعارضا نقدم النهي، لتضمّنه المفسدة و الجواز ليس فيه مفسدة.. لأنه يجوز الفعل ويجوز الترك.. لا يوجد مفسدة.. والآن في النهي مخالفة للشيطان حديث [ شرب من هو أخبث منه الشيطان ] ..
▫️قدمنا النهي لأن فيه مخالفة للشيطان و مخالفته واجبة و كان الترك أولى و لأن النبيّ صلى الله عليه و سلم يحتمل في فعله ثلاث إحتمالات:
#إحتمال_التقعيد؛ أصوليا. معناه العلماء يختلفون أصوليا هل خطاب اللّه يدخل فيه النّبيّ أو لا يدخل فيه.. إذا خاطب خطابا شرعيّا سواءً جاء من القرآن أو السنة هل يدخل فيه المخاطب أي من يبلّغ الناس فيأمره بذلك و هو مأمور و يلتزم به.. أم أنه خارج عن ذلك و يأمرهم هم فقط.. هذا خلاف أصولي. الجمهور على أن المبلّغ و هو النبي صلى اللّه عليه و سلم داخل في الخطاب و هو الصحيح.
#على_قول_القائلين أنه لا يدخل في الخطاب لا إشكال عندهم حديث علي و ابن عباس الذي رآه يشرب قائما و هو في زمزم لا إشكال لأن النبيّ خارج الخطاب.. و الأوامر لأمّته في هذه الأقوال من الناحية التأصيلية.. الصحيح كما قلت أنه يدخل في الخطاب.. و لكن هل فيه ميزة تميزه عن بقية الناس حتى لا يشمله الخطاب؛ ممكن مثلا حديث ما منكم من أحد إلا وُكل به قرين من الجنّ قالوا حتى أنت يارسول قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عنه فلا يأمرني إلا بخير.. اي القرين. يبقى معهم كلهم هؤلاء يأمرون الناس بالشر و الفساد و يوسوسون أيضا و لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم فلا يأمره إلا بالخير.. و لو شرب معه الشيطان يخرج من ذلك النّبيّ و لا يشرب معه. هذه حالة ثانية إن شئت.
#والحالة_الثالثة أن الجواز سابق للنّهي بمعنى أن الأشياء كانت على الجواز ثم يرد النهي لأن أصل الأشياء و الأعيان المنتفع بها على الإباحة خلق لكم مافي الارض جميعا أي كل هذه الأعيان على الجواز باستثناء ماحرمه الله.
👍2
التحريم يأتي بالتدريج كالخمر و الربا وغيرها ، الجواز كان عقليا ثم يأتي النهي شرعيا أي المناهي تأتي تاليا و معنى أن النبي قد يفعل فعلا يحاكي فيه الجواز أو يطابق فيه الأصل ثم يرد من قوله منع فإذا كان كذلك النهي و المناهي في الشرب قائما كانت بعد.. أي مارآه علي ابن مالب يحتمل أن يكون قبل النّهي ثم جاء النّهي أما حديث ابن عباس رآه يشرب من زمزم قيل ليس له سبيل و هي معلّقة.. فشرب قائما. هذه للحاجة و الضرورة فلا يقاس عليها..
#تبين_لك أن وجود هذه الاحتمالات:
الأول هل يدخل في الخطاب.. و إن لم يدخل لاإشكال.. وإذا تقرر الدخول هل هذه من خصوصياته؟! الشرب قائما هذه محتملة و الأمر الآخر هذا الفعل قبل ورود النّهي أن يشرب قائما. إذا ورد هذا فلا تعارض فيما كان جائزا ثم جاء التنزيل و حرّمه كما في الكثير من الصّور التي وردت في القرآن.. كان مباحا ثم جاء النّهي فحرّمه ويحتمل في بعضها حالة الحاجة و الضرورة لا تستطيع إلا الشّرب قائما.
#مثلا تجد الحنفية معقلة و ممكن تشرب من يدك و تنحني و تشرب و هذا تشبّه بالقائم مادام ركبتيه مستقيمتين هو قائم و لو كان منحنيا مثل الشيخ العجوز المنحني هو قائم مادامت رجليه مستقيمتين يعني أنه يوجد انكسار اي فيه انحناء ولكن إذا استقامت ركبيته هو يعد قائما..
#هذه_فائدة_زائدة.. و الحاصل في الشرب فقط و انتهينا إلى أنه لا يجوز على الصحيح.. لتقديم النهي على الإباحة و تقديم النهي لكونه تاليا و ليس ناسخا للإباحة لأنها كانت عقلية و لا يترتب عليها النسخ و أما الإباحة الشرعية يلزمها نسخ.. والإعتراضات الأخرى أجبنا عنها.. هذا كله في مسألة الشرب القائما وأما الاكل قائما في يوم آخر.
#نقله الأخ جهدو محمد الأمين
مجلس يوم الجمعة ٢١ رمضان ١٤٤٦ الموافق ل 21 مارس 2025 .
#تبين_لك أن وجود هذه الاحتمالات:
الأول هل يدخل في الخطاب.. و إن لم يدخل لاإشكال.. وإذا تقرر الدخول هل هذه من خصوصياته؟! الشرب قائما هذه محتملة و الأمر الآخر هذا الفعل قبل ورود النّهي أن يشرب قائما. إذا ورد هذا فلا تعارض فيما كان جائزا ثم جاء التنزيل و حرّمه كما في الكثير من الصّور التي وردت في القرآن.. كان مباحا ثم جاء النّهي فحرّمه ويحتمل في بعضها حالة الحاجة و الضرورة لا تستطيع إلا الشّرب قائما.
#مثلا تجد الحنفية معقلة و ممكن تشرب من يدك و تنحني و تشرب و هذا تشبّه بالقائم مادام ركبتيه مستقيمتين هو قائم و لو كان منحنيا مثل الشيخ العجوز المنحني هو قائم مادامت رجليه مستقيمتين يعني أنه يوجد انكسار اي فيه انحناء ولكن إذا استقامت ركبيته هو يعد قائما..
#هذه_فائدة_زائدة.. و الحاصل في الشرب فقط و انتهينا إلى أنه لا يجوز على الصحيح.. لتقديم النهي على الإباحة و تقديم النهي لكونه تاليا و ليس ناسخا للإباحة لأنها كانت عقلية و لا يترتب عليها النسخ و أما الإباحة الشرعية يلزمها نسخ.. والإعتراضات الأخرى أجبنا عنها.. هذا كله في مسألة الشرب القائما وأما الاكل قائما في يوم آخر.
#نقله الأخ جهدو محمد الأمين
مجلس يوم الجمعة ٢١ رمضان ١٤٤٦ الموافق ل 21 مارس 2025 .
👍3
📌 فوائد منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
(بعد ذكر السائل كلاما للبشير الإبراهيمي -رحمه الله- (من آثاره) .. حول الاحتفال بالمولد النبوي ..)
كيف الردّ على المجيزين للاحتفال بالمولد؛ ويقولون أن ابن باديس الإبراهيمي -رحمهما الله- احتفلا؟! ..
الجواب:
"فيه محطات -إن شئت- للإجابة عن هذا السؤال ..
• أولا: اجتهادات المجتهدين ليست مصدرا من مصادر التشريع، التشريع هو الكتاب والسنة، وعلى نصوصهما وضوئهما يجتهد المجتهد.
• ثانيا: الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات هذه لابد لها من سند، أو نص؛ حتى نقضي بجوازها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدّد في ذلك الاحتفال بعيدين، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، هذا الأمر الثاني.
• لأن الاحتفالات إذا أُعطِي لها الطابع الشرعي؛ فهي من العبادات، كما هو الشأن بالنسبة للعيدين، هما من العبادات، ولا شك أننا لا نستطيع أن نشرّع عبادة إلا بنص.
• من جهة أخرى؛ لو كان هذا الاحتفال كما ذكر عموما القضايا التي يراها كل من أعضاء هذه الجمعية؛ يرونها جائزة، كإحياء ذكرى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيرته، وغير ذلك .. يكون الأصل مسبوقا بفعل السلف، وحيث أن السلف لم يحتفلوا بهذا؛ لا في القرون المفضّلة، ولا بعدها لم يحتفلوا بهذا المولد؛ فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع ذلك، إذ لو كان مشروعا لسبقونا إليه، إنما عُلِم ذلك بعد القرون المفضلة، وعند قوم كان ألصق بهذه الأعياد عيد النصارى؛ فالتمسوه من ذلك ..
لذلك ذكرنا أن البدعة تدور مع الأسباب الأربعة: الجهل، واتّباع الهوى، وتقليد الآباء، وتقليد اليهود والنصارى.
كثير من الناس يقعون في مثل هذا؛ ويحسّنون البدعة بالنظر إلى ما ذكره الشافعي -رحمه الله- من كونها تنقسم إلى بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة .. وهذه القسمة غير مُرتَضاة، أخذها -إن شئتم- من قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (نعم البدعة هي) على صلاة التراويح.
علما أنه يوجد فرق بين البدعة الشرعية؛ التي تَرِدُ في الشرع، والبدعة الدنيوية أو اللّغوية، فالبدعة اللغوية، أو الدنيوية؛ لا تُؤثّر، لأنها لا يُتعبّد بها؛ فضلا عن كونها بدعة من حيث هي جاءت محدثة؛ لكن لا تتعلّق بالدين.
صلاة الجماعة في التراويح فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى الليلة الأولى، والثانية، ولم يخرج الثالثة خشية أن تُفرَض عليهم، فهذه موجودة، وغاية ما في الأمر أن عمر -رضي الله عنه- لما رآهم يُصلونها أوزاعا وجماعات؛ جمعهم على إمام واحد، وقال: (نعم البدعة هي)، وليس المقصود البدعة المنبوذة أو المذمومة، لأنها موجودة شرعا، مقرّرة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعلها عمر والصحابة -رضي الله عنهم- متواجدون، ولم ينكر أحد، فكان إجماعا وحجّة، واستمر الإجماع والعمل على هذا ..
بقوله: (نعم البدعة هي) ظنّوا أن فيه بدعة حسنة، ومستحبّة، وسيّئة .. فاستحبّوا مثلا أن يصافح الرجل من عن يمينه وعن شماله بعد الصلاة، وعدّها النووي بدعة حسنة ومستحبّة، لأنه شافعي ..
الصحيح أن البدعة في الشّرع كلها سيئة، تستدرك على الشّرع كأنه تخلّف عن أحكام؛ وجاءت هذه الاجتهادات البدعيّة تستدرك؛ بعد أن جاءت النصوص تُبيّن أن شرع الله تعالى كامل تامّ؛ ليس فيه نقصان من جهة الأحكام، وما تخلّف منها فيه من القواعد التي بيّنها القرآن، فما وجدنا في كتاب الله وجدنا، وما لم نجده وجدنا أنه -القرآن- يرشد إلى السنّة، والإجماع، والقياس، ويحثّ على الاجتهاد، وهو النّظر بالقياس ونحوه؛ لإضافة بعض الفروع التي لم يَرِد الحكم فيها؛ وإلحاقها بالأصل المقرّر من الكتاب والسنة.
فالاجتهاد اعتبار، ومثل هذه الاعتبارات أجازها الشرع إذا كانت بشرطها.
إذًا؛ القول بهذا الكلام ليس صحيحا، وإلا فكل بدعة نختلق لها مزايا، وبعد ذلك نجيزها، مع أن الشرع أنكرها جميعا، لأنها تعمل على الاستدراك، وتضيف أمورا جديدة لم يأتِ بها الشرع.
كما حذّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها في قوله: (كل بدعة ضلالة).
- فـ (كلّ) تدلّ على جميع البدع؛ كثيرها وقليلها، جلّها ودقّها، وهي معدودة من المحرّمات، ومن محدثات الأمور.
- والتحذير جاء بقوله (إياكم ومحدثات الأمور)، كما يدلّ عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، فهل الاحتفال بالمولد هو من أمر الشرع؟! ليس كذلك.
- حتى ولو أتيت بكثير فوائد؛ يقال صحيحة؛ لكن ما لم يُحسّنه الشرع لا تحسين فيه، فالشّرع هو الذي يُحسّن ويُقبّح، وقد قبّح البدعة، ولو أتيت بكل محسّن فلا يتحسّن الشيء إذا لم يُحسّنه الشّرع.
وأيضا من حديث: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه، فيقال هذه لم يرِد فيها شيء، وهي من محدثات الأمور، حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، ولو كان الاحتفال بها مشروعا لسبقنا به الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعون، وغيرهم من أئمة الدين، ولم يقل أحد بهذا.
السؤال:
(بعد ذكر السائل كلاما للبشير الإبراهيمي -رحمه الله- (من آثاره) .. حول الاحتفال بالمولد النبوي ..)
كيف الردّ على المجيزين للاحتفال بالمولد؛ ويقولون أن ابن باديس الإبراهيمي -رحمهما الله- احتفلا؟! ..
الجواب:
"فيه محطات -إن شئت- للإجابة عن هذا السؤال ..
• أولا: اجتهادات المجتهدين ليست مصدرا من مصادر التشريع، التشريع هو الكتاب والسنة، وعلى نصوصهما وضوئهما يجتهد المجتهد.
• ثانيا: الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات هذه لابد لها من سند، أو نص؛ حتى نقضي بجوازها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدّد في ذلك الاحتفال بعيدين، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، هذا الأمر الثاني.
• لأن الاحتفالات إذا أُعطِي لها الطابع الشرعي؛ فهي من العبادات، كما هو الشأن بالنسبة للعيدين، هما من العبادات، ولا شك أننا لا نستطيع أن نشرّع عبادة إلا بنص.
• من جهة أخرى؛ لو كان هذا الاحتفال كما ذكر عموما القضايا التي يراها كل من أعضاء هذه الجمعية؛ يرونها جائزة، كإحياء ذكرى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيرته، وغير ذلك .. يكون الأصل مسبوقا بفعل السلف، وحيث أن السلف لم يحتفلوا بهذا؛ لا في القرون المفضّلة، ولا بعدها لم يحتفلوا بهذا المولد؛ فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع ذلك، إذ لو كان مشروعا لسبقونا إليه، إنما عُلِم ذلك بعد القرون المفضلة، وعند قوم كان ألصق بهذه الأعياد عيد النصارى؛ فالتمسوه من ذلك ..
لذلك ذكرنا أن البدعة تدور مع الأسباب الأربعة: الجهل، واتّباع الهوى، وتقليد الآباء، وتقليد اليهود والنصارى.
كثير من الناس يقعون في مثل هذا؛ ويحسّنون البدعة بالنظر إلى ما ذكره الشافعي -رحمه الله- من كونها تنقسم إلى بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة .. وهذه القسمة غير مُرتَضاة، أخذها -إن شئتم- من قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (نعم البدعة هي) على صلاة التراويح.
علما أنه يوجد فرق بين البدعة الشرعية؛ التي تَرِدُ في الشرع، والبدعة الدنيوية أو اللّغوية، فالبدعة اللغوية، أو الدنيوية؛ لا تُؤثّر، لأنها لا يُتعبّد بها؛ فضلا عن كونها بدعة من حيث هي جاءت محدثة؛ لكن لا تتعلّق بالدين.
صلاة الجماعة في التراويح فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى الليلة الأولى، والثانية، ولم يخرج الثالثة خشية أن تُفرَض عليهم، فهذه موجودة، وغاية ما في الأمر أن عمر -رضي الله عنه- لما رآهم يُصلونها أوزاعا وجماعات؛ جمعهم على إمام واحد، وقال: (نعم البدعة هي)، وليس المقصود البدعة المنبوذة أو المذمومة، لأنها موجودة شرعا، مقرّرة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعلها عمر والصحابة -رضي الله عنهم- متواجدون، ولم ينكر أحد، فكان إجماعا وحجّة، واستمر الإجماع والعمل على هذا ..
بقوله: (نعم البدعة هي) ظنّوا أن فيه بدعة حسنة، ومستحبّة، وسيّئة .. فاستحبّوا مثلا أن يصافح الرجل من عن يمينه وعن شماله بعد الصلاة، وعدّها النووي بدعة حسنة ومستحبّة، لأنه شافعي ..
الصحيح أن البدعة في الشّرع كلها سيئة، تستدرك على الشّرع كأنه تخلّف عن أحكام؛ وجاءت هذه الاجتهادات البدعيّة تستدرك؛ بعد أن جاءت النصوص تُبيّن أن شرع الله تعالى كامل تامّ؛ ليس فيه نقصان من جهة الأحكام، وما تخلّف منها فيه من القواعد التي بيّنها القرآن، فما وجدنا في كتاب الله وجدنا، وما لم نجده وجدنا أنه -القرآن- يرشد إلى السنّة، والإجماع، والقياس، ويحثّ على الاجتهاد، وهو النّظر بالقياس ونحوه؛ لإضافة بعض الفروع التي لم يَرِد الحكم فيها؛ وإلحاقها بالأصل المقرّر من الكتاب والسنة.
فالاجتهاد اعتبار، ومثل هذه الاعتبارات أجازها الشرع إذا كانت بشرطها.
إذًا؛ القول بهذا الكلام ليس صحيحا، وإلا فكل بدعة نختلق لها مزايا، وبعد ذلك نجيزها، مع أن الشرع أنكرها جميعا، لأنها تعمل على الاستدراك، وتضيف أمورا جديدة لم يأتِ بها الشرع.
كما حذّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها في قوله: (كل بدعة ضلالة).
- فـ (كلّ) تدلّ على جميع البدع؛ كثيرها وقليلها، جلّها ودقّها، وهي معدودة من المحرّمات، ومن محدثات الأمور.
- والتحذير جاء بقوله (إياكم ومحدثات الأمور)، كما يدلّ عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، فهل الاحتفال بالمولد هو من أمر الشرع؟! ليس كذلك.
- حتى ولو أتيت بكثير فوائد؛ يقال صحيحة؛ لكن ما لم يُحسّنه الشرع لا تحسين فيه، فالشّرع هو الذي يُحسّن ويُقبّح، وقد قبّح البدعة، ولو أتيت بكل محسّن فلا يتحسّن الشيء إذا لم يُحسّنه الشّرع.
وأيضا من حديث: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ)، أي مردود على صاحبه، فيقال هذه لم يرِد فيها شيء، وهي من محدثات الأمور، حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، ولو كان الاحتفال بها مشروعا لسبقنا به الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعون، وغيرهم من أئمة الدين، ولم يقل أحد بهذا.
فالقول أنه يوم يتذكّر سيرته، وأخلاقه، ويسير على سيرته، يدعو إلى طريقته .. نقول نعم، هذه التي تدعون إليها صحيحة؛ لكن من غير احتفال.
يدعو إلى الالتزام بها قولا، وفعلا، وسيرة، وسلوكا، وأخلاقا .. وكان -صلى الله عليه وسلم- خُلقه القرآن، وهو أمر بالأخلاق، والصدق، والأمانة، والعدل، والاستقامة، والاعتدال، وغيرها .. كلّها من أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجب أن نلتزمها، ونسلك طريقه في الدعوة والمعاملة.
ولا يشترط أن نخصّص يوما من العام نحتفل فيه مثلما يحتفل به النصارى بأنبيائهم -زعموا- وهم لم يرشدوهم إلى ذلك.
حاصله: لعلّ الخطأ في الاجتهاد؛ وهو قسمة البدعة إلى هذه الأقسام؛ وقع بها الناس في الخطأ، والصحيح أن كل بدعة ضلالة.
- يؤيّده قوله (كلّ بدعة ..)
- ويؤيده حديث عائشة -رضي الله عنها-، فما من عمل لا شاهد اعتبار له من الشرع إلا وهو مردود على صاحبه.
- وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، في أمر الدين لا يوجد احتفال بهذا، لم يحتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء الّذين سبقوا، ولم يأمر الصحابة بالاحتفال بمولده، فليس فيه ما يدلّ على جواز هذا، وليس من أمر ديننا.
هذا العذر الّذي يمكن أن نضيفه لعلماء الجمعية، ومهما على كعبهم، وسما علمهم؛ فهم مجتهدون، يصيبون ويخطئون، وربّما مقدمة خاطئة يبني عليها؛ فيصل إلى نتيجه خاطئة، خاصة إذا عوّل على القسمة هذه.
ونظرتهم لألّا يذهبوا إلى عيد ميلاد النصارى؛ فيجلبونهم للارتباط بالإسلام، وهذا ليس دعوى -على كلٍّ-، لكن قلت لعلّ هذا، وإلا فحكمه ظاهر.
الإنسان دائما معياره العودة إلى الرّعيل الأول، كيف كانوا؟!
هل كانوا يحتفلون؟!
لم يكن ذلك في وقتهم، ولا من أمرِهم، ولا دينا لهم، فلا يكون الآن دينا -كما قال مالك رحمه الله-، لأن الوحي انقطع بموت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
نشيد بالجمعية ليس معناه أنهم معصومون، مثلا نقول قال ابن باديس كذا .. لكن تجد في كتاب العقائد كثيرا من التعقيبات ذكرناها، وكثيرا من الأخطاء وجدناها أثناء الشرح، هي كثيرة باعتبار .. وحتى في مقالاته تعقّبنا هذا، وسيصدر -إن شاء الله- قريبا [فلسفة الجمعية للإبراهيمي]، جعلت فيه تعليقات وتعقيبات، بدءا بكلمة فلسفة، وفيه أمور نوافق فيها، وأمور كثيرة لا نوافق، وتُعدّ من الأخطاء والمؤاخذات عليه في هذا الباب، مع عدم إجحاف حقّه، واحترام مكانته ..
لكن الحق يُقال مهما كان، سواء علينا أو عليهم، فإن أخطأ فنبيّن، وإن أخطأنا نعود .. والأصل أن الناس لا يتبعون في الخطأ، وهكذا يكون العلم متكاملا، فلا نترك أمورا تدخل فيه بحُكم أن فلانا قال كذا .. لأنه مهما علا علمه فهو قاصر، والعلم الكامل لله تعالى، وما يُدركه الإنسان نقطة في بحر، لأن العلم كثير جدا، وقدرته محدودة على تحصيل كل ذلك.
اللغة العربية فقط؛ لا يستطيع الإنسان استحكامها؛ وهو من أهلها، فما بالك بالعلوم الأخرى؛ من علوم القرآن، والسنة، وعلم الرجال .. والعلم عند الله تعالى."
يدعو إلى الالتزام بها قولا، وفعلا، وسيرة، وسلوكا، وأخلاقا .. وكان -صلى الله عليه وسلم- خُلقه القرآن، وهو أمر بالأخلاق، والصدق، والأمانة، والعدل، والاستقامة، والاعتدال، وغيرها .. كلّها من أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجب أن نلتزمها، ونسلك طريقه في الدعوة والمعاملة.
ولا يشترط أن نخصّص يوما من العام نحتفل فيه مثلما يحتفل به النصارى بأنبيائهم -زعموا- وهم لم يرشدوهم إلى ذلك.
حاصله: لعلّ الخطأ في الاجتهاد؛ وهو قسمة البدعة إلى هذه الأقسام؛ وقع بها الناس في الخطأ، والصحيح أن كل بدعة ضلالة.
- يؤيّده قوله (كلّ بدعة ..)
- ويؤيده حديث عائشة -رضي الله عنها-، فما من عمل لا شاهد اعتبار له من الشرع إلا وهو مردود على صاحبه.
- وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، في أمر الدين لا يوجد احتفال بهذا، لم يحتفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأنبياء الّذين سبقوا، ولم يأمر الصحابة بالاحتفال بمولده، فليس فيه ما يدلّ على جواز هذا، وليس من أمر ديننا.
هذا العذر الّذي يمكن أن نضيفه لعلماء الجمعية، ومهما على كعبهم، وسما علمهم؛ فهم مجتهدون، يصيبون ويخطئون، وربّما مقدمة خاطئة يبني عليها؛ فيصل إلى نتيجه خاطئة، خاصة إذا عوّل على القسمة هذه.
ونظرتهم لألّا يذهبوا إلى عيد ميلاد النصارى؛ فيجلبونهم للارتباط بالإسلام، وهذا ليس دعوى -على كلٍّ-، لكن قلت لعلّ هذا، وإلا فحكمه ظاهر.
الإنسان دائما معياره العودة إلى الرّعيل الأول، كيف كانوا؟!
هل كانوا يحتفلون؟!
لم يكن ذلك في وقتهم، ولا من أمرِهم، ولا دينا لهم، فلا يكون الآن دينا -كما قال مالك رحمه الله-، لأن الوحي انقطع بموت النبي -صلى الله عليه وسلم-.
نشيد بالجمعية ليس معناه أنهم معصومون، مثلا نقول قال ابن باديس كذا .. لكن تجد في كتاب العقائد كثيرا من التعقيبات ذكرناها، وكثيرا من الأخطاء وجدناها أثناء الشرح، هي كثيرة باعتبار .. وحتى في مقالاته تعقّبنا هذا، وسيصدر -إن شاء الله- قريبا [فلسفة الجمعية للإبراهيمي]، جعلت فيه تعليقات وتعقيبات، بدءا بكلمة فلسفة، وفيه أمور نوافق فيها، وأمور كثيرة لا نوافق، وتُعدّ من الأخطاء والمؤاخذات عليه في هذا الباب، مع عدم إجحاف حقّه، واحترام مكانته ..
لكن الحق يُقال مهما كان، سواء علينا أو عليهم، فإن أخطأ فنبيّن، وإن أخطأنا نعود .. والأصل أن الناس لا يتبعون في الخطأ، وهكذا يكون العلم متكاملا، فلا نترك أمورا تدخل فيه بحُكم أن فلانا قال كذا .. لأنه مهما علا علمه فهو قاصر، والعلم الكامل لله تعالى، وما يُدركه الإنسان نقطة في بحر، لأن العلم كثير جدا، وقدرته محدودة على تحصيل كل ذلك.
اللغة العربية فقط؛ لا يستطيع الإنسان استحكامها؛ وهو من أهلها، فما بالك بالعلوم الأخرى؛ من علوم القرآن، والسنة، وعلم الرجال .. والعلم عند الله تعالى."
لفتوى رقم: ٧٤١
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات
في مسابقات رمضان
وحكمِ تخصيصها بالسابع والعشرين منه
السؤال:
ما حكمُ مسابقاتِ حفظِ القرآن والعلومِ الشرعية التي تُقامُ بالمساجد للطلبة؛ تشجيعًا لهم على مواصلة الطلب والحفظ؟ وما حكمُ تخصيصها بليلة السابع والعشرين مِنْ رمضان؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنَ المسابقات ـ في حدِّ ذاتها ـ على حِفْظِ القرآن الكريم ومعرفةِ معانيه وحفظِ الحديث النبويِّ ودراستِه، والفقهِ الإسلاميِّ وأصولِه، وغيرِها مِنَ العلوم النافعة؛ تقصُّدًا لمعرفة الصواب فيها مِنَ الخطإ في القضايا المطروحة في المسابقات، بل يُرَغَّبُ فيها، حيث تبعث المسابقاتُ العلميةُ في النَّفْسِ الهمَّةَ في البحث والتقصِّي في مسائله؛ نتيجةَ التنافس على الخير الذي تبعث عليه هذه المسابقاتُ، ويجوز ـ أيضًا على أرجحِ قولَيِ العلماء ـ بذلُ العِوَضِ الماليِّ فيها، وهو مذهبُ الحنفيةِ وَوَجْهٌ عند الحنابلة، واختاره ابنُ تيمية وابنُ القيِّم(١)؛ لأنَّ المُستثنَيات في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»(٢) إنما ذُكِرَ بَذْلُ العِوَضِ منها على سبيل التمثيل لِمَا فيها مِنْ معنى إعداد العُدَّة المادِّية في الجهاد، وهذا المعنى موجودٌ فيما هو أَوْلى منه وهو إعدادُ العُدَّة الإيمانية؛ ذلك لأنَّ الدِّين قِوامُه بالحُجَّة والجهاد؛ فإذا جازَتِ المراهنةُ والمسابقةُ على آلات الجهاد فهي في العلم أَوْلى بالجواز.
أمَّا عقدُ المسابقات القرآنية والعلمية في ليلة السابع والعشرين مِنْ رمضان وتوزيعُ الجوائز فيها على وجه الاحتفال، فلا يُشْرَعُ هذا التخصيصُ لمخالفته لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، عِلْمًا بأنَّ الاحتفالَ بليلة القدر مِنْ مُحْدَثات الأمور، وكُلُّ مُحْدَثةٍ بدعةٌ، وإنما المشروعُ إحياؤها بقراءة القرآن والصلاةِ والصدقة والدعاء، وغيرِ ذلك مِنْ أنواع العبادات المشروعة فيها؛ فالإكثارُ مِنَ العبادات فيها كسائر العَشر الأواخر؛ لأنه كان صلَّى الله عليه وسلَّم يُوقِظُ أهلَه ويَشُدُّ مِئْزَرَه ويُحيي ليلَه(٣)، وأكَّد ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٥)، وقد عَلَّمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عائشةَ رضي الله عنها أَنْ تدعوَ ـ إِنْ وافقَتْ ليلةَ القَدْر ـ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»(٦)، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ مارس ٢٠٠٧م
(١) انظر: «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٣)، «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (١٦٠)، «الفروسية» لابن القيِّم (٦٥).
(٢) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرِّهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» باب السَّبَق (٣٥٨٥)، وابنُ ماجه في «الجهاد» باب السَّبَق والرِّهان (٢٨٧٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه البَغَويُّ في «شرح السنَّة» (١٠/ ٣٩٣). وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦).
(٣) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «فضلِ ليلة القَدْر» باب العمل في العشر الأواخر مِنْ رمضان (٢٠٢٤)، ومسلمٌ في «الاعتكاف» (١١٧٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» بابٌ: تطوُّعُ قيامِ رمضانَ مِنَ الإيمان (٣٧)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٥٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ مَنْ صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ونيَّةً (١٩٠١)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه الترمذيُّ في «الدعوات» (٣٥١٣)، وابنُ ماجه في «الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٥٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه النوويُّ في «الأذكار» (٢٤٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٤٢٣).
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات
في مسابقات رمضان
وحكمِ تخصيصها بالسابع والعشرين منه
السؤال:
ما حكمُ مسابقاتِ حفظِ القرآن والعلومِ الشرعية التي تُقامُ بالمساجد للطلبة؛ تشجيعًا لهم على مواصلة الطلب والحفظ؟ وما حكمُ تخصيصها بليلة السابع والعشرين مِنْ رمضان؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنَ المسابقات ـ في حدِّ ذاتها ـ على حِفْظِ القرآن الكريم ومعرفةِ معانيه وحفظِ الحديث النبويِّ ودراستِه، والفقهِ الإسلاميِّ وأصولِه، وغيرِها مِنَ العلوم النافعة؛ تقصُّدًا لمعرفة الصواب فيها مِنَ الخطإ في القضايا المطروحة في المسابقات، بل يُرَغَّبُ فيها، حيث تبعث المسابقاتُ العلميةُ في النَّفْسِ الهمَّةَ في البحث والتقصِّي في مسائله؛ نتيجةَ التنافس على الخير الذي تبعث عليه هذه المسابقاتُ، ويجوز ـ أيضًا على أرجحِ قولَيِ العلماء ـ بذلُ العِوَضِ الماليِّ فيها، وهو مذهبُ الحنفيةِ وَوَجْهٌ عند الحنابلة، واختاره ابنُ تيمية وابنُ القيِّم(١)؛ لأنَّ المُستثنَيات في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»(٢) إنما ذُكِرَ بَذْلُ العِوَضِ منها على سبيل التمثيل لِمَا فيها مِنْ معنى إعداد العُدَّة المادِّية في الجهاد، وهذا المعنى موجودٌ فيما هو أَوْلى منه وهو إعدادُ العُدَّة الإيمانية؛ ذلك لأنَّ الدِّين قِوامُه بالحُجَّة والجهاد؛ فإذا جازَتِ المراهنةُ والمسابقةُ على آلات الجهاد فهي في العلم أَوْلى بالجواز.
أمَّا عقدُ المسابقات القرآنية والعلمية في ليلة السابع والعشرين مِنْ رمضان وتوزيعُ الجوائز فيها على وجه الاحتفال، فلا يُشْرَعُ هذا التخصيصُ لمخالفته لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، عِلْمًا بأنَّ الاحتفالَ بليلة القدر مِنْ مُحْدَثات الأمور، وكُلُّ مُحْدَثةٍ بدعةٌ، وإنما المشروعُ إحياؤها بقراءة القرآن والصلاةِ والصدقة والدعاء، وغيرِ ذلك مِنْ أنواع العبادات المشروعة فيها؛ فالإكثارُ مِنَ العبادات فيها كسائر العَشر الأواخر؛ لأنه كان صلَّى الله عليه وسلَّم يُوقِظُ أهلَه ويَشُدُّ مِئْزَرَه ويُحيي ليلَه(٣)، وأكَّد ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٥)، وقد عَلَّمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عائشةَ رضي الله عنها أَنْ تدعوَ ـ إِنْ وافقَتْ ليلةَ القَدْر ـ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»(٦)، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ مارس ٢٠٠٧م
(١) انظر: «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٣)، «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (١٦٠)، «الفروسية» لابن القيِّم (٦٥).
(٢) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرِّهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» باب السَّبَق (٣٥٨٥)، وابنُ ماجه في «الجهاد» باب السَّبَق والرِّهان (٢٨٧٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه البَغَويُّ في «شرح السنَّة» (١٠/ ٣٩٣). وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦).
(٣) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «فضلِ ليلة القَدْر» باب العمل في العشر الأواخر مِنْ رمضان (٢٠٢٤)، ومسلمٌ في «الاعتكاف» (١١٧٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» بابٌ: تطوُّعُ قيامِ رمضانَ مِنَ الإيمان (٣٧)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٥٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ مَنْ صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ونيَّةً (١٩٠١)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) أخرجه الترمذيُّ في «الدعوات» (٣٥١٣)، وابنُ ماجه في «الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٥٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه النوويُّ في «الأذكار» (٢٤٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٤٢٣).
روى الترمذي (2526) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وفي رواية الإمام أحمد (8030): وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ.
صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
ودعوة الصائم المستجابة تكون حال صيامه، إلى أن يشرع في الفطر، وليس بعد ذلك.
قال المناوي رحمه الله: "(والصائم حَتَّى) وَفِي رِوَايَة حِين (يفْطر) بِالْفِعْلِ، أَو يدْخل أَوَان فطره"
"التيسير شرح الجامع الصغير" (1/ 477).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى يكون محل هذه الدعوة: قبل الفطر أم في أثنائه أم بعده؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت؟
فأجاب: الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب؛ لأنه يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل، وأنه صائم، وكل هذه من أسباب الإجابة.
أما بعد الفطر: فإن النفس قد استراحت، وفرحت، وربما يحصل غفلة.
لكن ورد ذكر، إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه يكون بعد الإفطار: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا لا يكون إلا بعد الفطر.
وفي رواية الإمام أحمد (8030): وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ.
صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
ودعوة الصائم المستجابة تكون حال صيامه، إلى أن يشرع في الفطر، وليس بعد ذلك.
قال المناوي رحمه الله: "(والصائم حَتَّى) وَفِي رِوَايَة حِين (يفْطر) بِالْفِعْلِ، أَو يدْخل أَوَان فطره"
"التيسير شرح الجامع الصغير" (1/ 477).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى يكون محل هذه الدعوة: قبل الفطر أم في أثنائه أم بعده؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت؟
فأجاب: الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب؛ لأنه يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل، وأنه صائم، وكل هذه من أسباب الإجابة.
أما بعد الفطر: فإن النفس قد استراحت، وفرحت، وربما يحصل غفلة.
لكن ورد ذكر، إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه يكون بعد الإفطار: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا لا يكون إلا بعد الفطر.
إنَّ ليلتَكم هذه - سبعًا وعشرين - هي أرجى ليالي العشر في موافقة ليلة القدر، فاعمروها قدر استطاعتكم بالصَّلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والدُّعاء، متَّبعين هديَ نبيِّكم ﷺ؛ فإنَّ أولى الناس بشرف الليلة، وأوفرهم حظًّا فيها؛ هم أتباعُ سنتِه ﷺ.
#تغريد_العصيمي
#تغريد_العصيمي
👍2
🍂 ليس معي من العلم غير أني أعلم أني لست أعلم
العلامة محمد سعيد رسلان | درس ليلة 27 من رمضان 1446
العلامة محمد سعيد رسلان | درس ليلة 27 من رمضان 1446
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ)
الســؤال:
يستعمل الصوفيّة مصطلحات؛ كالسُّكْر، والهـُيام، والفناء، وغيرها ..
فما توجيهكم لاستعمال مثل هذه الألفاظ؟!
الجــواب:
"كثير من المسائل الخلافيّة؛ ذكرها ابن القيّم -رحمه الله-، والتي هي أسباب ليست حقيقية -في الأصل- لاختلاف العلماء، إنّما هي اختلافات محدثة، وذكر منها المصطلحات الحديثة، واستعمالها في شرح وبيان القرآن، بمعنى مصطلحات حديثة لم يعرفها السّلف الأوّلون، إنّما أحدثها قوم، وجاؤوا إلى آيات أنزلوها عليها؛ فخرجوا بتفسير آخر لم يعهده السلف، وقاموا بشرح بعض السّنن لم يعرفها السلف، وقالوا في غير ميدان العقيدة (في الفقه) أشياء تخالف ما كانت عليه السنّة ..
فأراد أن يُبيّن تقبيح هذه المصطلحات المحدثة؛ واستعمالها لأخذ المعاني من فحواها، وتفسير القرآن على ضوئها؛ فيقع في المهالك، وهذا شيء لم يشرعه الله.
ولم يَكْتفِ فقط بهذه المصطلحات؛ فأهل الكلام عندهم مصطلحات كثيرة في مسائل تتعلّق بما يسمّى ما وراء الطبيعة، والغيبيات، يذكرون الجوهر، وغيرها من المصطلحات المحدثة .. انطلاقا من تسميّة الفلاسفة والمناطقة اليونانيين، ثم أخذوها وعبّروا عنها بالعربية، واستعملوها، وأخرجوا لنا عديد العقائد، ولم يُكْتفى بهذا في الميدان العقدي ..
كذلك الصوفيّة الفلسفية؛ عندهم الفناء، والمسائل هذه، والقول بالرجعة التي اتّخذها الصوفيّة والهندوس؛ الّذين تأثّر بعض العلماء المسلمين بطريقتهم؛ ليسوا علماء بمفهوم سليم؛ إنّما للصوفيّة؛ كالحلّاج، وابن سبعين، وغيرهم .. أخذوا من الهندوسية؛ وخلطوا، وأخرجوا أمورا لا يشفع لها نص من الكتاب والسنّة، وليس عليها عمل السلف، حتى ذهبوا للقول بالرّجعة، بالنسبة لعلي من قبل، وقالوا أنه لم يمت مقتولا؛ بل رفعه الله .. كما يدّعي الشيعة السبئيّة، وقالوا أننا إذا آمنا أنه رفعه الله إليه؛ فما نسمعه من الرعد صوته، وغير ذلك ..
وبعده ينشرون مثل هذا المعتقد الفاسد؛ بناء على تأثرهم بهم -خاصة الجهة الشرقية القريبة من انتشار هذه العقائد الهندوسيّة- لذا قالوا بالرّجعة في الحياة، فإذا مات رجل صالح يخرج ويعود إلى الوجود في رجل صالح آخر، ويعود في الحياة وليس في الآخرة، وعمّموها على الأشخاص، وبعضهم قال بتناسخ الأرواح، وغير ذلك ..
أخذوا هذه المصطلحات؛ وجعلوها في الشريعة، واستنبطوا عقائد غاية في البطلان، وأفكارا غريبة عن الإسلام؛ بسبب هذا، ولا يقتصر الأمر في هذه المصطلحات على العقائد فقط، بل تجدها حتى في الفقه.
مثلا الشريعة في الأصل من الناحية الاصطلاحية عندما يتكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمر؛ لم يكن الاصطلاح هذا موجودا في عصره، إنما تكلّم باللغة، فالأصل أن كل ما يخرج من كلامه لبيان الشريعة فكلامه شرعيّ، يفهمه بالمعنى الشرعي، لكن هذا المعنى متضمّن لمعنى لغوي، فإذا غاب هذا المعنى أخذنا بالآخر ..
مثلا: قوله في الصلاة: (.. ولا تأتوها تَسْعَون .. وما فاتكم فأتمّوا ..) الحديث.
ذكر الإتمام، والإتمام هو ما أدركت مع الإمام في صلاته تجعله أول صلاتك، ثم لمّا يُسلّم تأتي بما بقي لك، وهذا هو الإتمام.
وجاء في حديث آخر (فاقضوا)، فذهب بعض الفقهاء إلى حمله على اصطلاح القضاء، فيجعل ما أدركه هو ما عليه الإمام، فإن كان الإمام في الركعة الثالثة فهي ركعته الثالثة، ولما ينتهي يقضي الأولى والثانية.
ثم اختلفوا في الأقوال والأفعال، وبعضهم حمل القضاء على الأفعال ..
إذا أمعنت النظر؛ وجدت أن هذه المصطلحات -القضاء والإتمام- جاءت في عصور الأئمة، والمصطلح لم يكن معروفا ذاك الوقت، إنما القضاء هو الإتمام، قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم ..}، أي أتممتم.
وقال: {فإذا قُضِيت الصلاة ..}، أي تمّت. وغيرها من الأدلة.
فمعنى الإتمام هو القضاء، ومعنى القضاء هو الإتمام، كمصطلح أصولي الإتمام غيره، وهذا من أسباب الخلاف؛ بسبب المصطلحات المحدثة.
أحببت أن أقول أنها ليست في العقائد فقط، وهي أخطر -بلا شك- في العقائد، فقد ترد في باب الفقه أيضا.
تارة بعض المذاهب لها مصطلحات خاصة، تريد استعمالها في بيان حكم معيّن مأخوذ من الكتاب والسنة؛ فتخرج إلى أمر لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنها محدثة، وبعده ينتهي الأمر إلى أحكام غير معروفة أصلا.
الحاصل: كما ذكرت أن هذه المصطلحات المحدثة؛ سواء من علم الكلام، أو من الجمع بين عقائد معيّنة، أو كان الشخص مجوسيا وأسلم؛ ولا تزال عنده رواسب، ويمزج العقيدة الإسلامية بهذه العقائد، ويُخرج مصطلحات جديدة، ويبدأ يتفنن فيها ..
يجعل درجات للأولياء، ثم يقول أنهم أفضل من الأنبياء، وهم يعلمون الحقيقة، والأنبياء يعلمون علم الشريعة، وعلم الحقيقة أفضل من علم الشريعة ..
الســؤال:
يستعمل الصوفيّة مصطلحات؛ كالسُّكْر، والهـُيام، والفناء، وغيرها ..
فما توجيهكم لاستعمال مثل هذه الألفاظ؟!
الجــواب:
"كثير من المسائل الخلافيّة؛ ذكرها ابن القيّم -رحمه الله-، والتي هي أسباب ليست حقيقية -في الأصل- لاختلاف العلماء، إنّما هي اختلافات محدثة، وذكر منها المصطلحات الحديثة، واستعمالها في شرح وبيان القرآن، بمعنى مصطلحات حديثة لم يعرفها السّلف الأوّلون، إنّما أحدثها قوم، وجاؤوا إلى آيات أنزلوها عليها؛ فخرجوا بتفسير آخر لم يعهده السلف، وقاموا بشرح بعض السّنن لم يعرفها السلف، وقالوا في غير ميدان العقيدة (في الفقه) أشياء تخالف ما كانت عليه السنّة ..
فأراد أن يُبيّن تقبيح هذه المصطلحات المحدثة؛ واستعمالها لأخذ المعاني من فحواها، وتفسير القرآن على ضوئها؛ فيقع في المهالك، وهذا شيء لم يشرعه الله.
ولم يَكْتفِ فقط بهذه المصطلحات؛ فأهل الكلام عندهم مصطلحات كثيرة في مسائل تتعلّق بما يسمّى ما وراء الطبيعة، والغيبيات، يذكرون الجوهر، وغيرها من المصطلحات المحدثة .. انطلاقا من تسميّة الفلاسفة والمناطقة اليونانيين، ثم أخذوها وعبّروا عنها بالعربية، واستعملوها، وأخرجوا لنا عديد العقائد، ولم يُكْتفى بهذا في الميدان العقدي ..
كذلك الصوفيّة الفلسفية؛ عندهم الفناء، والمسائل هذه، والقول بالرجعة التي اتّخذها الصوفيّة والهندوس؛ الّذين تأثّر بعض العلماء المسلمين بطريقتهم؛ ليسوا علماء بمفهوم سليم؛ إنّما للصوفيّة؛ كالحلّاج، وابن سبعين، وغيرهم .. أخذوا من الهندوسية؛ وخلطوا، وأخرجوا أمورا لا يشفع لها نص من الكتاب والسنّة، وليس عليها عمل السلف، حتى ذهبوا للقول بالرّجعة، بالنسبة لعلي من قبل، وقالوا أنه لم يمت مقتولا؛ بل رفعه الله .. كما يدّعي الشيعة السبئيّة، وقالوا أننا إذا آمنا أنه رفعه الله إليه؛ فما نسمعه من الرعد صوته، وغير ذلك ..
وبعده ينشرون مثل هذا المعتقد الفاسد؛ بناء على تأثرهم بهم -خاصة الجهة الشرقية القريبة من انتشار هذه العقائد الهندوسيّة- لذا قالوا بالرّجعة في الحياة، فإذا مات رجل صالح يخرج ويعود إلى الوجود في رجل صالح آخر، ويعود في الحياة وليس في الآخرة، وعمّموها على الأشخاص، وبعضهم قال بتناسخ الأرواح، وغير ذلك ..
أخذوا هذه المصطلحات؛ وجعلوها في الشريعة، واستنبطوا عقائد غاية في البطلان، وأفكارا غريبة عن الإسلام؛ بسبب هذا، ولا يقتصر الأمر في هذه المصطلحات على العقائد فقط، بل تجدها حتى في الفقه.
مثلا الشريعة في الأصل من الناحية الاصطلاحية عندما يتكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمر؛ لم يكن الاصطلاح هذا موجودا في عصره، إنما تكلّم باللغة، فالأصل أن كل ما يخرج من كلامه لبيان الشريعة فكلامه شرعيّ، يفهمه بالمعنى الشرعي، لكن هذا المعنى متضمّن لمعنى لغوي، فإذا غاب هذا المعنى أخذنا بالآخر ..
مثلا: قوله في الصلاة: (.. ولا تأتوها تَسْعَون .. وما فاتكم فأتمّوا ..) الحديث.
ذكر الإتمام، والإتمام هو ما أدركت مع الإمام في صلاته تجعله أول صلاتك، ثم لمّا يُسلّم تأتي بما بقي لك، وهذا هو الإتمام.
وجاء في حديث آخر (فاقضوا)، فذهب بعض الفقهاء إلى حمله على اصطلاح القضاء، فيجعل ما أدركه هو ما عليه الإمام، فإن كان الإمام في الركعة الثالثة فهي ركعته الثالثة، ولما ينتهي يقضي الأولى والثانية.
ثم اختلفوا في الأقوال والأفعال، وبعضهم حمل القضاء على الأفعال ..
إذا أمعنت النظر؛ وجدت أن هذه المصطلحات -القضاء والإتمام- جاءت في عصور الأئمة، والمصطلح لم يكن معروفا ذاك الوقت، إنما القضاء هو الإتمام، قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم ..}، أي أتممتم.
وقال: {فإذا قُضِيت الصلاة ..}، أي تمّت. وغيرها من الأدلة.
فمعنى الإتمام هو القضاء، ومعنى القضاء هو الإتمام، كمصطلح أصولي الإتمام غيره، وهذا من أسباب الخلاف؛ بسبب المصطلحات المحدثة.
أحببت أن أقول أنها ليست في العقائد فقط، وهي أخطر -بلا شك- في العقائد، فقد ترد في باب الفقه أيضا.
تارة بعض المذاهب لها مصطلحات خاصة، تريد استعمالها في بيان حكم معيّن مأخوذ من الكتاب والسنة؛ فتخرج إلى أمر لم يكن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنها محدثة، وبعده ينتهي الأمر إلى أحكام غير معروفة أصلا.
الحاصل: كما ذكرت أن هذه المصطلحات المحدثة؛ سواء من علم الكلام، أو من الجمع بين عقائد معيّنة، أو كان الشخص مجوسيا وأسلم؛ ولا تزال عنده رواسب، ويمزج العقيدة الإسلامية بهذه العقائد، ويُخرج مصطلحات جديدة، ويبدأ يتفنن فيها ..
يجعل درجات للأولياء، ثم يقول أنهم أفضل من الأنبياء، وهم يعلمون الحقيقة، والأنبياء يعلمون علم الشريعة، وعلم الحقيقة أفضل من علم الشريعة ..
👍1
كالصوفيّة، عندهم مقام الأولياء أفضل من مقام الأنبياء ..ثم يزيد حتى يصبح له خصائص الربوبية، وينجم عنه الشرك في العبادة، يتمسّحون به، ويطوفون بقبره، ويطلبون منه -دعاء المسألة- مع دعاء العبادة، وهذا الطواف على قبره دعاء عبادة، العبادة الشركية لا التوحيدية، يدعون الولي أن يرزقهم الولد، والمال، والنجدة من الديون، والغيث إذا أصابهم القحط ..
من أين لهم هذا؟!
من الشرارة الأولى، وزادت، ومن الغيض يأتي الفيض، قطرة ماء ثم ماء منهمر ..
والشيطان هذا هو مجاله؛ التلبيس، والتعميّة، والانحراف، والميل عن سواء السبيل.
والعلم عند الله."
من أين لهم هذا؟!
من الشرارة الأولى، وزادت، ومن الغيض يأتي الفيض، قطرة ماء ثم ماء منهمر ..
والشيطان هذا هو مجاله؛ التلبيس، والتعميّة، والانحراف، والميل عن سواء السبيل.
والعلم عند الله."