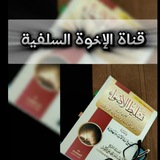(١) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٨١) باب الركعتين قبل الظهر، ومسلم (١/ ٣٣٠) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٨٢) باب الركعتين قبل الظهر، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٦٣)من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٩) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٨)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٣٢٦)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه الترمذي في «الصلاة» (٤١٥) باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وماله فيه من الفضل، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٥/ ٤٥٨).
(٥) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٧٩) باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، ومسلم (١/ ٣٢٨) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٧٧) باب المداومة على ركعتي الفجر، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٧٠).
(٧) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٨) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٥)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٢٦٥)من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٨) أخرجه مسلم (١/ ٣١١) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٨٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٩) «زاد المعاد» لابن القيم: (١/ ٣١٥).
(١٠) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (٨٦٤) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٤٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٤/ ١٧).
(١١) «المجموع للنووي»: (٤/ ٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٨٢) باب الركعتين قبل الظهر، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٦٣)من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٩) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٨)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٣٢٦)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه الترمذي في «الصلاة» (٤١٥) باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وماله فيه من الفضل، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٥/ ٤٥٨).
(٥) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٧٩) باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، ومسلم (١/ ٣٢٨) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٢٧٧) باب المداومة على ركعتي الفجر، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٧٠).
(٧) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٨) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٢٥)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٢٦٥)من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٨) أخرجه مسلم (١/ ٣١١) في «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٧٨٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٩) «زاد المعاد» لابن القيم: (١/ ٣١٥).
(١٠) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (٨٦٤) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٤٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٤/ ١٧).
(١١) «المجموع للنووي»: (٤/ ٣٠).
في وقت الشروعِ في صلاةِ الغائب على المفقودِ،
وابتداءِ عِدَّةِ زوجتِه
السؤال:
خرَجَ ثلاثةٌ مِنَ الصَّيَّادين ـ مِنْ حيِّنا ـ إلى البحرِ، فمات اثنانِ ونجا أحَدُهم، وذلك أنَّهم كانوا خرجوا إلى البحر ـ ليلًا ـ مسافةَ ٢٠كلم تقريبًا، وباتوا اللَّيلَ كُلَّه وهم يصطادون، وفي الصَّباح تَغيَّر الجوُّ فانقلب بهم الزَّورقُ، وكانوا مُتعَبِين جدًّا، فذلك الأخُ الَّذي نجا منهم وهو صاحبُ بُنيةٍ قويَّةٍ بَدَأ يسبح، فوجَدَ كُرَةَ شبكةٍ فتَعلَّق بها، وبقي عالقًا لمُدَّةِ ساعةٍ ونصفٍ، وقدَّر اللهُ أنَّ أصحابَ تلك الشَّبكةِ خرجوا إلى البحرِ لِاستخراجها، فلمَّا رأَوْه هابُوهُ ابتداءً لأنَّهم ظنُّوه جِنِّيًّا، ثمَّ اقتربوا منه وأنقذوه ـ ولله الحمدُ ـ، لكنَّ الاثنَيْن الآخَرَيْن لم يظهر لهما أثرٌ مِنْ ذلك الوقت، فعندما يُسأَلُ عُمَّالُ الحمايةِ المدنيَّةِ يقولون بحكم خِبرَتِهم: مستحيلٌ أَنْ يظهر لهما أثرٌ، لأنَّ عُمقَ البحرِ كبيرٌ في ذلك المكانِ، ويمنع عُمقُه خروجَهما منهُ غالبًا.
فزوجةُ أحَدِهما تسأل عن العِدَّةِ، لأنَّ هذا مِنَ المفقودين، فقد وجدت بعضَ أهلِ العلم يقولون: العبرةُ بِتَيقُّنِ موتِه، والبعضُ يقولون: نُرجِئُ الأمرَ ـ حتَّى في الغرقى ـ إلى أربعِ سَنَواتٍ، عملًا بأثرِ عُمَرَ رضي الله عنه، فنرجو مِنكم أَنْ تُفتُونا في هذه النَّازلةِ؟ وهل تكون صلاةُ الغائب عليهم ـ أيضًا ـ بعد أربعِ سِنينَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمفقودُ ـ باختصارٍ ـ هو: الغائبُ الَّذي انقطعَ خبرُه وَخَفِيَ على ذَوِيهِ أثرُه، أي: أنَّه لا يُعلَم ـ بعد البحثِ والتَّحرِّي ـ موضعُه ولا حياتُه أو موتُه؛ والمعلومُ شرعًا أنَّ الفقدانَ ـ في حدِّ ذاتهِ ـ لا يُؤثِّرُ في استصحابِ عقدِ الزَّواجِ، لذلك فإنَّ زوجةَ المفقودِ تبقى عَلَى نِكَاحِهِ، وتَستحِقُّ النَّفقةَ اتِّفاقًا، والمفقودُ الَّذِي ظاهرُ غَيْبَتِهِ الهلاكُ ـ كما هو شأنُ مَنْ كان في تلك المركبةِ، بحيث غلَبَ على ظنِّ النَّاجي منهم أنَّهما ماتا، ولا يُعلَمُ مصيرُهما ـ فإنَّ زوجةَ المفقودِ ـ في مِثلِ هذه الحالةِ ـ تتربَّص أربعَ سِنينَ، وتبدأُ مدَّةُ التَّربُّصِ مِنْ حينِ رفعِ الأمرِ إلى القاضي على الرَّاجحِ مِنْ أقوالِ العلماء، ومتى صدَرَ حكمُ القاضي بموتِ المفقودِ حكمًا فإنَّه يُصلَّى عليه صلاةَ الغائبِ، وتُقسَمُ تَرِكتُه على ورثَتِه، ولو لم تَنْقَضِ مدَّةُ التَّربُّصِ كاملةً، وتعتدُّ زوجتُه عِدَّةَ الوفاةِ أربعةَ أَشهُرٍ وعشرًا إلَّا أَنْ تكون حاملًا فبِوَضعِ الحمل، ومتى انتهتْ عِدَّتُها حلَّتْ للأزواجِ، ولا يتوقَّف أمرُها على طلاقِ وليِّ زوجها نيابةً عن المفقودِ(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٦ ربيعٍ الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤م
وابتداءِ عِدَّةِ زوجتِه
السؤال:
خرَجَ ثلاثةٌ مِنَ الصَّيَّادين ـ مِنْ حيِّنا ـ إلى البحرِ، فمات اثنانِ ونجا أحَدُهم، وذلك أنَّهم كانوا خرجوا إلى البحر ـ ليلًا ـ مسافةَ ٢٠كلم تقريبًا، وباتوا اللَّيلَ كُلَّه وهم يصطادون، وفي الصَّباح تَغيَّر الجوُّ فانقلب بهم الزَّورقُ، وكانوا مُتعَبِين جدًّا، فذلك الأخُ الَّذي نجا منهم وهو صاحبُ بُنيةٍ قويَّةٍ بَدَأ يسبح، فوجَدَ كُرَةَ شبكةٍ فتَعلَّق بها، وبقي عالقًا لمُدَّةِ ساعةٍ ونصفٍ، وقدَّر اللهُ أنَّ أصحابَ تلك الشَّبكةِ خرجوا إلى البحرِ لِاستخراجها، فلمَّا رأَوْه هابُوهُ ابتداءً لأنَّهم ظنُّوه جِنِّيًّا، ثمَّ اقتربوا منه وأنقذوه ـ ولله الحمدُ ـ، لكنَّ الاثنَيْن الآخَرَيْن لم يظهر لهما أثرٌ مِنْ ذلك الوقت، فعندما يُسأَلُ عُمَّالُ الحمايةِ المدنيَّةِ يقولون بحكم خِبرَتِهم: مستحيلٌ أَنْ يظهر لهما أثرٌ، لأنَّ عُمقَ البحرِ كبيرٌ في ذلك المكانِ، ويمنع عُمقُه خروجَهما منهُ غالبًا.
فزوجةُ أحَدِهما تسأل عن العِدَّةِ، لأنَّ هذا مِنَ المفقودين، فقد وجدت بعضَ أهلِ العلم يقولون: العبرةُ بِتَيقُّنِ موتِه، والبعضُ يقولون: نُرجِئُ الأمرَ ـ حتَّى في الغرقى ـ إلى أربعِ سَنَواتٍ، عملًا بأثرِ عُمَرَ رضي الله عنه، فنرجو مِنكم أَنْ تُفتُونا في هذه النَّازلةِ؟ وهل تكون صلاةُ الغائب عليهم ـ أيضًا ـ بعد أربعِ سِنينَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمفقودُ ـ باختصارٍ ـ هو: الغائبُ الَّذي انقطعَ خبرُه وَخَفِيَ على ذَوِيهِ أثرُه، أي: أنَّه لا يُعلَم ـ بعد البحثِ والتَّحرِّي ـ موضعُه ولا حياتُه أو موتُه؛ والمعلومُ شرعًا أنَّ الفقدانَ ـ في حدِّ ذاتهِ ـ لا يُؤثِّرُ في استصحابِ عقدِ الزَّواجِ، لذلك فإنَّ زوجةَ المفقودِ تبقى عَلَى نِكَاحِهِ، وتَستحِقُّ النَّفقةَ اتِّفاقًا، والمفقودُ الَّذِي ظاهرُ غَيْبَتِهِ الهلاكُ ـ كما هو شأنُ مَنْ كان في تلك المركبةِ، بحيث غلَبَ على ظنِّ النَّاجي منهم أنَّهما ماتا، ولا يُعلَمُ مصيرُهما ـ فإنَّ زوجةَ المفقودِ ـ في مِثلِ هذه الحالةِ ـ تتربَّص أربعَ سِنينَ، وتبدأُ مدَّةُ التَّربُّصِ مِنْ حينِ رفعِ الأمرِ إلى القاضي على الرَّاجحِ مِنْ أقوالِ العلماء، ومتى صدَرَ حكمُ القاضي بموتِ المفقودِ حكمًا فإنَّه يُصلَّى عليه صلاةَ الغائبِ، وتُقسَمُ تَرِكتُه على ورثَتِه، ولو لم تَنْقَضِ مدَّةُ التَّربُّصِ كاملةً، وتعتدُّ زوجتُه عِدَّةَ الوفاةِ أربعةَ أَشهُرٍ وعشرًا إلَّا أَنْ تكون حاملًا فبِوَضعِ الحمل، ومتى انتهتْ عِدَّتُها حلَّتْ للأزواجِ، ولا يتوقَّف أمرُها على طلاقِ وليِّ زوجها نيابةً عن المفقودِ(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٦ ربيعٍ الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤م
👍2
[ #الطّاعنون_في_العلماء_و_المخذّلون_يُهجرون_علی_حدٍّ_سواء]
قـال الشيخ محمّد علي فرڪوس حفظه الله :
"الطّاعنون في العلماء لا يُتَودّد إليهم فضلا عن أن يُصاحبون ، فيُجتنبون ويُهجرون ، وكذلك الذين لا يطعنون ولكن ليسوا واضحين في منهجهم، يُصاحبون الطّاعنين ويتوددون إليهم وو... فهؤلاء أهل التخذيل وهم أقرب إلی التّمييـعِ من المميّعة أنفسهم!
فهم يلعبون علی الحبلين كما يقال، يسكتون علی المنكرات، فإذا قمت وأنكرت صاحوا عليك! فهؤلاء هم أهل التّخذيل دائما، وهم المميّعون في الدّعوة زدشنم" اھ.
[صبيحة يوم الجمعة: ٢٤ رجب ١٤٤٦ھ]
قـال الشيخ محمّد علي فرڪوس حفظه الله :
"الطّاعنون في العلماء لا يُتَودّد إليهم فضلا عن أن يُصاحبون ، فيُجتنبون ويُهجرون ، وكذلك الذين لا يطعنون ولكن ليسوا واضحين في منهجهم، يُصاحبون الطّاعنين ويتوددون إليهم وو... فهؤلاء أهل التخذيل وهم أقرب إلی التّمييـعِ من المميّعة أنفسهم!
فهم يلعبون علی الحبلين كما يقال، يسكتون علی المنكرات، فإذا قمت وأنكرت صاحوا عليك! فهؤلاء هم أهل التّخذيل دائما، وهم المميّعون في الدّعوة زدشنم" اھ.
[صبيحة يوم الجمعة: ٢٤ رجب ١٤٤٦ھ]
👍3
📌 فوائد وتوجيهات منهجية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ١٤ رمضان ١٤٤٦ هـ)
السؤال:
للإمام الراتب سلطان، ما هي حدوده في الصور الآتية؟!:
إفتاء طالب علم من سأله داخل هذا المسجد ..
إجراء صلح بين اثنين بإذنه ودون حضوره .. تحديد القراءة في التراويح ..
الجواب:
"أولا: المعيار في ذلك؛ النّظر إلى مشروعية ذلك من الناحية الشرعية، هل هو مشروع ومُخَوّل له؟! أم هو حق للغير؟! ..
المسجد بُنِي للذِّكر وللصلاة، فيُصلي فيه، لكن أن يُكوّن جماعة أخرى؛ فلم يَرِد به الشرع، أما ذات الصلاة فيُصلّي، ولا يحتاج إذنا، لأنها مفروضة واجبة عليه، وبُنِيّت المساجد لأجل هذا، فيُؤدّي الصلاة، ولا يحتاج إذنا في ذلك، ويتوضّأ في محلّ الوضوء، ولا يحتاج إذن إمام راتب، ولا غيره ..
ولا يجوز أن توصَد أبواب المسجد في حقّه، بل تبقى مفتوحة.
لكن أن يتّخذ جماعة ثانية في المسجد؛ فهذا على خلاف بين أهل العلم في إجازة ذلك أو لا.
من رأى أنه يجوز استدلّ بالحديث الذي رواه الترمذي، لما دخل رجل المسجد؛ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه قد انصرفوا من الصلاة، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيّكم يتّجر على هذا؟! ..) الحديث، أو (من يتصدّق على هذا ..) الحديث.
والأصل فيه أنه عند دخوله لم يبحث عن جماعة، ولا طلب ذلك .. إنما كان هذا بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا دليل للحنابلة على جواز الجماعة الثانية، ولم يشترطوا إذن الإمام ..
والآخرون قالوا: أنه لابد من إذنه، وقالوا أن هذه ربّما حادثة عين لا عموم لها ..
والخلاف قائم في هذا الباب.
جماعة ثانية لا ينبغي أن تُقام إلا بإذنه، بخلاف الصلاة العادية الفردية.
١- هل يُفتي في المسجد بإذن الإمام أو بغير إذنه؟!
ننظر: إذا كان أهلا للفتوى، أو ينقلها من عالم للسائل، نفس السؤال المطروح يكرّره، ويضبطه، أو نحو ذلك .. فإذا كان كذلك، ولم يعقد مجلسا، ولا كرسيا .. إنّما سُئل فأجاب؛ فيجوز له ذلك، بل ويجب عليه أن يُبيّن الحكم الشرعي، خاصة إذا رآه صلّى صلاة غير صحيحة، أو صلّى إلى غير جهة القبلة .. فينصحه، أو يُنكر عليه، وهذه كلها لا تحتاج إلى إذن إمام، داخل المسجد أو خارجه ..
أما أن يعقد جلسة فتوى، أو كرسيا .. والناس تسأله، أو التدريس؛ فيحتاج إذن الإمام، لأنه أصبح أمرا منظّما، وقته معروف.
في هذه لابد من إذنه، إن وافق فبِها ونعمت، وإن منع فينظر إلى السبب، وهذا أمر آخر، لكن إن مُنِع يمتَنِع، ويجيب إن سُئل داخله أو خارجه؛ إما نقلا عن عالم، أو هو نفسه إن كان قادرا فيجيب ..
فرق بين الصلاة وحده وإقامة جماعة ثانية، وبين أن يُفتي أو يُنكر منكرا .. لا يحتاج إماما، وبين عقد مجلس للفتوى، والدروس ..
٢- الحالة الأخرى: يستأذن منه في عقد مجلس صلح داخل المسجد، ولا يُشترط أن يكون حاضرا، المهم أذِن له، فله عقد هذا المجلس داخل المسجد ..
٣- في تحديد القراءة:
المبدأ ذكرناه؛ في الأصل أن كل ما هو جائز شرعا لا يوجب علينا إمام أو غيره اختيارا، أو فعل شيء .. خاصة إذا كانت هذه القراءات عندنا سواء، أو أن هناك قراءة، أو رواية أحببتها، وهي أسهل وأضبط عندي ..
معروف مشروعية كل القراءات العشر، وكلها صحيحة، وتجوز، فلا يُلزمني إمام، ولا حاكم ..
إذا اشترط شرطا؛ حيث لا تتولّى المَهمّة إلا به؛ فهذا شرط.
مثلا: لتدخل مسابقة يُشترط هذا، وإلا لا تُقبَل؛ فهذا أمر.
أما أن تقرأ في البيت، أو غيره .. ويضع شرطا عامّا، وفي الصلاة يقول أنّه يُحافظ على الطابع المغربي، وغير ذلك .. فليس واجبا ..
تجده يُصلّي سادلا، ويقوم بالمخالفات .. ويقول حافظ على الطابع .. هذا فيما كان واجبا، ووافق الطابع.
هم يقولون نحن مالكية، ويخالفونه أصلا في العقيدة، والمسلك الأخلاقي، وغير ذلك .. ثم يقولون مغاربية مالكية .."
السؤال:
للإمام الراتب سلطان، ما هي حدوده في الصور الآتية؟!:
إفتاء طالب علم من سأله داخل هذا المسجد ..
إجراء صلح بين اثنين بإذنه ودون حضوره .. تحديد القراءة في التراويح ..
الجواب:
"أولا: المعيار في ذلك؛ النّظر إلى مشروعية ذلك من الناحية الشرعية، هل هو مشروع ومُخَوّل له؟! أم هو حق للغير؟! ..
المسجد بُنِي للذِّكر وللصلاة، فيُصلي فيه، لكن أن يُكوّن جماعة أخرى؛ فلم يَرِد به الشرع، أما ذات الصلاة فيُصلّي، ولا يحتاج إذنا، لأنها مفروضة واجبة عليه، وبُنِيّت المساجد لأجل هذا، فيُؤدّي الصلاة، ولا يحتاج إذنا في ذلك، ويتوضّأ في محلّ الوضوء، ولا يحتاج إذن إمام راتب، ولا غيره ..
ولا يجوز أن توصَد أبواب المسجد في حقّه، بل تبقى مفتوحة.
لكن أن يتّخذ جماعة ثانية في المسجد؛ فهذا على خلاف بين أهل العلم في إجازة ذلك أو لا.
من رأى أنه يجوز استدلّ بالحديث الذي رواه الترمذي، لما دخل رجل المسجد؛ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه قد انصرفوا من الصلاة، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيّكم يتّجر على هذا؟! ..) الحديث، أو (من يتصدّق على هذا ..) الحديث.
والأصل فيه أنه عند دخوله لم يبحث عن جماعة، ولا طلب ذلك .. إنما كان هذا بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا دليل للحنابلة على جواز الجماعة الثانية، ولم يشترطوا إذن الإمام ..
والآخرون قالوا: أنه لابد من إذنه، وقالوا أن هذه ربّما حادثة عين لا عموم لها ..
والخلاف قائم في هذا الباب.
جماعة ثانية لا ينبغي أن تُقام إلا بإذنه، بخلاف الصلاة العادية الفردية.
١- هل يُفتي في المسجد بإذن الإمام أو بغير إذنه؟!
ننظر: إذا كان أهلا للفتوى، أو ينقلها من عالم للسائل، نفس السؤال المطروح يكرّره، ويضبطه، أو نحو ذلك .. فإذا كان كذلك، ولم يعقد مجلسا، ولا كرسيا .. إنّما سُئل فأجاب؛ فيجوز له ذلك، بل ويجب عليه أن يُبيّن الحكم الشرعي، خاصة إذا رآه صلّى صلاة غير صحيحة، أو صلّى إلى غير جهة القبلة .. فينصحه، أو يُنكر عليه، وهذه كلها لا تحتاج إلى إذن إمام، داخل المسجد أو خارجه ..
أما أن يعقد جلسة فتوى، أو كرسيا .. والناس تسأله، أو التدريس؛ فيحتاج إذن الإمام، لأنه أصبح أمرا منظّما، وقته معروف.
في هذه لابد من إذنه، إن وافق فبِها ونعمت، وإن منع فينظر إلى السبب، وهذا أمر آخر، لكن إن مُنِع يمتَنِع، ويجيب إن سُئل داخله أو خارجه؛ إما نقلا عن عالم، أو هو نفسه إن كان قادرا فيجيب ..
فرق بين الصلاة وحده وإقامة جماعة ثانية، وبين أن يُفتي أو يُنكر منكرا .. لا يحتاج إماما، وبين عقد مجلس للفتوى، والدروس ..
٢- الحالة الأخرى: يستأذن منه في عقد مجلس صلح داخل المسجد، ولا يُشترط أن يكون حاضرا، المهم أذِن له، فله عقد هذا المجلس داخل المسجد ..
٣- في تحديد القراءة:
المبدأ ذكرناه؛ في الأصل أن كل ما هو جائز شرعا لا يوجب علينا إمام أو غيره اختيارا، أو فعل شيء .. خاصة إذا كانت هذه القراءات عندنا سواء، أو أن هناك قراءة، أو رواية أحببتها، وهي أسهل وأضبط عندي ..
معروف مشروعية كل القراءات العشر، وكلها صحيحة، وتجوز، فلا يُلزمني إمام، ولا حاكم ..
إذا اشترط شرطا؛ حيث لا تتولّى المَهمّة إلا به؛ فهذا شرط.
مثلا: لتدخل مسابقة يُشترط هذا، وإلا لا تُقبَل؛ فهذا أمر.
أما أن تقرأ في البيت، أو غيره .. ويضع شرطا عامّا، وفي الصلاة يقول أنّه يُحافظ على الطابع المغربي، وغير ذلك .. فليس واجبا ..
تجده يُصلّي سادلا، ويقوم بالمخالفات .. ويقول حافظ على الطابع .. هذا فيما كان واجبا، ووافق الطابع.
هم يقولون نحن مالكية، ويخالفونه أصلا في العقيدة، والمسلك الأخلاقي، وغير ذلك .. ثم يقولون مغاربية مالكية .."
👍6
*إحراز الأجر بتنويع الأعمال الصالحة في ليلة القدر ولا يقتصر فضلها على مجرد القيام !*:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: العمل، في ليلة القدر والصدقة، والصلاة، والزكاة.. أفضل من ألف شهر).
(الدر المنثور: ٨/ ٥٦٨)
قال ابن باديس: بيّن هذا الأثر- وفي معناه آثار كثيرة- أن خيرية ليلة القدر؛ راجعة إلى تفضيل الطاعة فيها، والعمل الصالح على غيرها من الليالي والأيام".
(آثار ابن باديس: ٢/ ٣٢٣)
وأخرج ابن جرير، عن عمرو بن قيس الملائي، في قوله: "ليلة القدر خير من ألف شهر".
قال: عمل فيها، خير من عمل في ألف شهر).
(الدر المنثور: ٨/ ٥٦٨)
.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: العمل، في ليلة القدر والصدقة، والصلاة، والزكاة.. أفضل من ألف شهر).
(الدر المنثور: ٨/ ٥٦٨)
قال ابن باديس: بيّن هذا الأثر- وفي معناه آثار كثيرة- أن خيرية ليلة القدر؛ راجعة إلى تفضيل الطاعة فيها، والعمل الصالح على غيرها من الليالي والأيام".
(آثار ابن باديس: ٢/ ٣٢٣)
وأخرج ابن جرير، عن عمرو بن قيس الملائي، في قوله: "ليلة القدر خير من ألف شهر".
قال: عمل فيها، خير من عمل في ألف شهر).
(الدر المنثور: ٨/ ٥٦٨)
.
👍5
"إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فهي أرجى من غيرها في أن تكون ليلة القدر." لطائف المعارف لابن رجب
قال ابن تيمية رحمه الله:
"إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، فهي أحرى أن تكون ليلة القدر بإذن الله."
قال بن باز رحمه الله في حديث المساء (239):
"قال بعض أهل العلم: إن كان في الأوتار ليلة الجمعة، كانت آكد وأقرب أن تكون ليلة القدر، لذا ينبغي لنا أن نعني بهذه الليالي، ولا سيما هذه الليلة، وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من الاجتهاد في الخير."
قال ابن تيمية رحمه الله:
"إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، فهي أحرى أن تكون ليلة القدر بإذن الله."
قال بن باز رحمه الله في حديث المساء (239):
"قال بعض أهل العلم: إن كان في الأوتار ليلة الجمعة، كانت آكد وأقرب أن تكون ليلة القدر، لذا ينبغي لنا أن نعني بهذه الليالي، ولا سيما هذه الليلة، وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من الاجتهاد في الخير."
👍7
💥 العلامة محمد علي فركوس :
السؤال :اقاموا صلاه التهجد بحجه انه هناك من اجازه من اهل العلم فانكر عليهم احدهم بشده فهل يشرع ان ينكر عليهم ؟
الجواب :
أولا النظر في تأسيس المسألة حتى يتضح المقام،
المسألة تدور على عدد ركعات الصلاة فهل النبي صلى الله عليه وسلم زاد و هل الصحابة زادوا، الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة في رمضان و لا في غيره.
و ورد عن ابن عباس أنه صلى ثلاث عشرة ركعة و قد جمعوا بين هذا و هذا فقالوا أنه إما تكون الركعتان راتبة العشاء أو راتبة الفجر. و من حيث السند فحديث عائشة رضي الله عنها أقوى فرجحوه أما حديث أنس أنه صلى عشرين ركعة فلا يثبت و قد ضعفه الألباني رحمه الله.
إذا تقرر هذا و أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا المنوال فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و أن الاقتصار على أحد عشر ركعة هو الراجح.
و الأفضل أن تصلى في رمضان في الثلث الأول من الليل للأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمعهم في الثلث الأول من ليل رمضان و بقيت هي السنة الفعلية إلي يومنا هذا و الأمة لا تجتمع على ضلالة. و إن صلاها مع الإمام فله أجر قيام ليلة تامة كما في الحديث. و ان كانوا قد اختلفوا على مذاهب فهذا هو الراجح كما تقدم.
سبب الخلاف هو ورود العدد هل ورد في الحكم أم في متعلقه؟ مثال ورود العدد د في الحكم كحديث ولوغ الكلب فهنا جاء العدد سبع غسلات فمعناه أن يقتصر على سبع غسلات.
و مثال ورود العدد على متعلق الحكم كحديث « خمس من الفواسق يقتلن في الحل و الحرم » فلما كان العدد تعلق بمتعلق الحكم و هو الفسق و الضرر جاز قتل كل ما كان فيه ضرر و هذه الخمس جاءت على سبيل التمثيل و بالتالي يوسع مجرى الحكم.
في مسألتنا العدد جاء في الركعات كما جاء في كفارة الحج « تلك عشرة كاملة » و ما ورد على الحكم لا يزاد عليه.
💥مجلس 22 رمضان 1443 بالقبة.
السؤال :اقاموا صلاه التهجد بحجه انه هناك من اجازه من اهل العلم فانكر عليهم احدهم بشده فهل يشرع ان ينكر عليهم ؟
الجواب :
أولا النظر في تأسيس المسألة حتى يتضح المقام،
المسألة تدور على عدد ركعات الصلاة فهل النبي صلى الله عليه وسلم زاد و هل الصحابة زادوا، الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة في رمضان و لا في غيره.
و ورد عن ابن عباس أنه صلى ثلاث عشرة ركعة و قد جمعوا بين هذا و هذا فقالوا أنه إما تكون الركعتان راتبة العشاء أو راتبة الفجر. و من حيث السند فحديث عائشة رضي الله عنها أقوى فرجحوه أما حديث أنس أنه صلى عشرين ركعة فلا يثبت و قد ضعفه الألباني رحمه الله.
إذا تقرر هذا و أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا المنوال فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و أن الاقتصار على أحد عشر ركعة هو الراجح.
و الأفضل أن تصلى في رمضان في الثلث الأول من الليل للأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمعهم في الثلث الأول من ليل رمضان و بقيت هي السنة الفعلية إلي يومنا هذا و الأمة لا تجتمع على ضلالة. و إن صلاها مع الإمام فله أجر قيام ليلة تامة كما في الحديث. و ان كانوا قد اختلفوا على مذاهب فهذا هو الراجح كما تقدم.
سبب الخلاف هو ورود العدد هل ورد في الحكم أم في متعلقه؟ مثال ورود العدد د في الحكم كحديث ولوغ الكلب فهنا جاء العدد سبع غسلات فمعناه أن يقتصر على سبع غسلات.
و مثال ورود العدد على متعلق الحكم كحديث « خمس من الفواسق يقتلن في الحل و الحرم » فلما كان العدد تعلق بمتعلق الحكم و هو الفسق و الضرر جاز قتل كل ما كان فيه ضرر و هذه الخمس جاءت على سبيل التمثيل و بالتالي يوسع مجرى الحكم.
في مسألتنا العدد جاء في الركعات كما جاء في كفارة الحج « تلك عشرة كاملة » و ما ورد على الحكم لا يزاد عليه.
💥مجلس 22 رمضان 1443 بالقبة.
👍6
قال العلامة ابن باز رحمه الله:
ليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله فيها القرآن، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال سبحانه في أول سورة الدخان: {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)}.
وقال سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) }.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق على صحته. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القران وغير ذلك من وجوه الخير.
وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها. وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده. فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر».
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائماً، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيماناً واحتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم: يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها» . وقالت: «كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» . وكان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام غالبا، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت «يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكان السلف بعدهم، يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير.
فالمشروع للمسلمين في كل مكان أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وبسلف هذه الأمة الأخيار، فيحيوا هذه الليالي بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والعبادة إيمانا واحتسابا حتى يفوزوا بمغفرة الذنوب، وحط الأوزار والعتق من النار. فضلا منه سبحانه وجودا وكرما. وقد دل الكتاب والسنة أن هذا الوعد العظيم مما يحصل باجتناب الكبائر. كما قال سبحانه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض المسلمين قد يجتهد في رمضان ويتوب إلى الله سبحانه مما سلف من ذنوبه، ثم بعد خروج رمضان يعود إلى أعماله السيئة وفي ذلك خطر عظيم.
فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يعزم عزماً صادقاً على الاستمرار في طاعة الله وترك المعاصي، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)}.
ليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله فيها القرآن، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال سبحانه في أول سورة الدخان: {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)}.
وقال سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) }.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق على صحته. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القران وغير ذلك من وجوه الخير.
وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها. وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده. فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر».
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائماً، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيماناً واحتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم: يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها» . وقالت: «كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» . وكان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام غالبا، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت «يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكان السلف بعدهم، يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير.
فالمشروع للمسلمين في كل مكان أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وبسلف هذه الأمة الأخيار، فيحيوا هذه الليالي بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والعبادة إيمانا واحتسابا حتى يفوزوا بمغفرة الذنوب، وحط الأوزار والعتق من النار. فضلا منه سبحانه وجودا وكرما. وقد دل الكتاب والسنة أن هذا الوعد العظيم مما يحصل باجتناب الكبائر. كما قال سبحانه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض المسلمين قد يجتهد في رمضان ويتوب إلى الله سبحانه مما سلف من ذنوبه، ثم بعد خروج رمضان يعود إلى أعماله السيئة وفي ذلك خطر عظيم.
فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يعزم عزماً صادقاً على الاستمرار في طاعة الله وترك المعاصي، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)}.
👍1
ومعنى الآية أن الذين اعترفوا بأن ربهم الله وآمنوا به وأخلصوا له العبادة واستقاموا على ذلك تبشرهم الملائكة عند الموت بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن مصيرهم الجنة من أجل إيمانهم به سبحانه واستقامتهم على طاعته وترك معصيته، وإخلاص العبادة له سبحانه، والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب الثبات على الحق، والاستقامة عليه، والحذر من الإصرار على معاصي الله عز وجل.
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)}
فنسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين في هذه الليالي وغيرها لما يحبه ويرضاه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. انتهى مجموع الفتاوى (15/ 425).
([1]) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).
([2]) أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).
([3]) أخرجه البخاري (2020)، ومسلم (1169)
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)}
فنسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين في هذه الليالي وغيرها لما يحبه ويرضاه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. انتهى مجموع الفتاوى (15/ 425).
([1]) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).
([2]) أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).
([3]) أخرجه البخاري (2020)، ومسلم (1169)
👍2
قال العيني رحمه الله:
"إنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف، لا نهيا للصوام عن السواك" انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (11/ 13).
قال ابن القيم، رحمه الله، بعد حكاية الخلاف في ذلك:
"وفصلُ النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطِّيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال ومُوجِباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طِيبُ ذلك الخُلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم.
وحيثُ أخبر بأن ذلك "حين يَخْلُف" و"حين يُمْسُون"؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طِيبُها زائدًا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهةً للعباد، فَرُبَّ مكروهٍ عند الناس محبوبٍ عند الله تعالى، وبالعكس؛ فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد، وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة.
وقد يَقْوَى العملُ ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مُشاهَدٌ بالبصر والبصيرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وقوّةً في البدن، وسَعَةً في الرزق، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سَوادًا في الوجه، وظلمةً في القلب، وَوَهَنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبِغْضَةً في قلوب الخلق".
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "ما عمل رجل عملًا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إنْ خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ".
وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إنَّ الرجل الطّيِّب البَرَّ لتشمُّ منه رائحة طيبة وإن لم يَمَسَّ طِيبًا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشمُّ لا هذا، ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب". انتهى، من "الوابل الصيب" (66-68).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: " يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ؛ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
فأجاب: يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فلا بأس به.
مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) " انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/121
"إنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف، لا نهيا للصوام عن السواك" انتهى من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (11/ 13).
قال ابن القيم، رحمه الله، بعد حكاية الخلاف في ذلك:
"وفصلُ النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطِّيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال ومُوجِباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طِيبُ ذلك الخُلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم.
وحيثُ أخبر بأن ذلك "حين يَخْلُف" و"حين يُمْسُون"؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طِيبُها زائدًا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهةً للعباد، فَرُبَّ مكروهٍ عند الناس محبوبٍ عند الله تعالى، وبالعكس؛ فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد، وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة.
وقد يَقْوَى العملُ ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مُشاهَدٌ بالبصر والبصيرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وقوّةً في البدن، وسَعَةً في الرزق، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سَوادًا في الوجه، وظلمةً في القلب، وَوَهَنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبِغْضَةً في قلوب الخلق".
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "ما عمل رجل عملًا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إنْ خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ".
وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إنَّ الرجل الطّيِّب البَرَّ لتشمُّ منه رائحة طيبة وإن لم يَمَسَّ طِيبًا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهواء لا يشمُّ لا هذا، ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب". انتهى، من "الوابل الصيب" (66-68).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: " يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ؛ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
فأجاب: يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه؛ فلا بأس به.
مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) " انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/121
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا [يعني : جهة المشرق] ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا [يعني : جهة المغرب]، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ : فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) رواه البخاري (1954) ، ومسلم (1100) .
قال النووي : "يَنْقَضِي الصَّوْمُ وَيَتِمُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ " .
انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/ 304) .
وقال ابن عبد البر: " وَالنَّهَارُ الَّذِي يَجِبُ صِيَامُهُ : مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، عَلَى هَذَا إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى من "التمهيد" (10/62).
والمقصود بالغروب : غياب كامل قرص الشمس واختفاؤه ، ولا عبرة بالحمرة الباقية في الأفق ، فحيث غاب كامل القرص ، فقد حل الفطر .
قال الحافظ ابن رجب: " هذا الحديث يدل على أن مجرد غيبوبة القرص ، يدخل به وقت صلاة المغرب ، كما يفطر الصائم بذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم: حكاه ابن المنذر وغيره.
قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار" انتهى من "فتح الباري" (4/352) بتصرف يسير.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا غاب قرص الشمس : حينئذ يفطر الصائم ، ويزول وقت النهي ، ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام" .
انتهى من "شرح عمدة الفقه" (ص: 169).
وقال النووي: " وَلَا نَظَرَ بَعْدَ تَكَامُلِ الْغُرُوبِ إلَى بَقَاءِ شُعَاعِهَا ، بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا [يعني : صلاة المغرب] مَعَ بَقَائِهِ " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (3/29) .
قال النووي : "يَنْقَضِي الصَّوْمُ وَيَتِمُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ " .
انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/ 304) .
وقال ابن عبد البر: " وَالنَّهَارُ الَّذِي يَجِبُ صِيَامُهُ : مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، عَلَى هَذَا إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى من "التمهيد" (10/62).
والمقصود بالغروب : غياب كامل قرص الشمس واختفاؤه ، ولا عبرة بالحمرة الباقية في الأفق ، فحيث غاب كامل القرص ، فقد حل الفطر .
قال الحافظ ابن رجب: " هذا الحديث يدل على أن مجرد غيبوبة القرص ، يدخل به وقت صلاة المغرب ، كما يفطر الصائم بذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم: حكاه ابن المنذر وغيره.
قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار" انتهى من "فتح الباري" (4/352) بتصرف يسير.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا غاب قرص الشمس : حينئذ يفطر الصائم ، ويزول وقت النهي ، ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام" .
انتهى من "شرح عمدة الفقه" (ص: 169).
وقال النووي: " وَلَا نَظَرَ بَعْدَ تَكَامُلِ الْغُرُوبِ إلَى بَقَاءِ شُعَاعِهَا ، بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا [يعني : صلاة المغرب] مَعَ بَقَائِهِ " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (3/29) .
قال النووي : " وأمَّا في العمران وقُلل الجبال : فالاعتبار بأن لا يُرى شيءٌ مِنْ شُعَاعِهَا عَلَى الْجُدَرَانِ وَقُلَلِ الْجِبَالِ ، وَيُقْبِلُ الظَّلَّامُ مِنْ الْمَشْرِقِ " انتهى من " المجموع " (3/29).
[ قلَّة الْجَبَل : هِي الْقطعَة تستدير فِي أَعْلَاهُ ، ينظر: " جمهرة اللغة" (1/164) ] .
وقال في " الفواكه الدواني" (1/168) : " مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ : غُرُوبُ الشَّمْسِ ، إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَكُونُ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ ، أَوْ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ.
وَأَمَّا مَنْ يَكُونُ خَلْفَ الْجِبَالِ : فَلَا يُعَوِّلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا يُعَوِّلُ عَلَى إقْبَالِ الظُّلْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا ظَهَرَتْ ، كَانَ دَلِيلًا عَلَى مَغِيبِهَا ، فَيُصَلِّي وَيُفْطِرُ " انتهى
وقال ابن دقيق العيد : " وَالْأَمَاكِنُ تَخْتَلِفُ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا فِيهِ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ قُرْصِ الشَّمْسِ : لَمْ يَكْتَفِ بِغَيْبُوبَةِ الْقُرْصِ عَنْ الْأَعْيُنِ ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى غُرُوبِهَا بِطُلُوعِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ" انتهى من "إحكام الأحكام " (1/166).
وقال الحطَّاب : " وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ : إذَا غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ ، بِمَوْضِعٍ لَا جِبَالَ فِيهِ ، فَأَمَّا مَوْضِعٌ تَغْرُبُ فِيهِ خَلْفَ جِبَالٍ ، فَيُنْظَرُ إلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الظُّلْمَةُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ" انتهى من "مواهب الجليل" (1/392) .
ويدل لهذا الحديث السابق : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا [ أي جهة المشرق] ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا [أي : جهة المغرب] ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ : فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) .
قال القرطبي: " أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها ؛ إذ لا يُقِبل الليل إلا إذا أدبر النهار ، ولا يُدبر النهار إلا إذا غربت الشمس ، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ، ويُشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك : فيحل الإفطار" انتهى من "إكمال المعلم" (4/35) .
وقال النووي : " قَالَ الْعُلَمَاءُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا ، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ ، بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/ 209) .
وقال ابن دقيق العيد : " الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارُ مُتَلَازِمَانِ ، أَعْنِي : إقْبَالَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النَّهَارِ.
وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ لِلْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَيُسْتَدَلُّ بِالظَّاهِرِ عَلَى الْخَفِيِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ مَا يَسْتُرُ الْبَصَرَ عَنْ إدْرَاكِ الْغُرُوبِ ، وَكَانَ الْمَشْرِقُ بَارِزًا ظَاهِرًا ، فَيُسْتَدَلُّ بِطُلُوعِ اللَّيْلِ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ" انتهى من "إحكام الأحكام" (2/ 27).
[ قلَّة الْجَبَل : هِي الْقطعَة تستدير فِي أَعْلَاهُ ، ينظر: " جمهرة اللغة" (1/164) ] .
وقال في " الفواكه الدواني" (1/168) : " مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ : غُرُوبُ الشَّمْسِ ، إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَكُونُ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ ، أَوْ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ.
وَأَمَّا مَنْ يَكُونُ خَلْفَ الْجِبَالِ : فَلَا يُعَوِّلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا يُعَوِّلُ عَلَى إقْبَالِ الظُّلْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا ظَهَرَتْ ، كَانَ دَلِيلًا عَلَى مَغِيبِهَا ، فَيُصَلِّي وَيُفْطِرُ " انتهى
وقال ابن دقيق العيد : " وَالْأَمَاكِنُ تَخْتَلِفُ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا فِيهِ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ قُرْصِ الشَّمْسِ : لَمْ يَكْتَفِ بِغَيْبُوبَةِ الْقُرْصِ عَنْ الْأَعْيُنِ ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى غُرُوبِهَا بِطُلُوعِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ" انتهى من "إحكام الأحكام " (1/166).
وقال الحطَّاب : " وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ : إذَا غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ ، بِمَوْضِعٍ لَا جِبَالَ فِيهِ ، فَأَمَّا مَوْضِعٌ تَغْرُبُ فِيهِ خَلْفَ جِبَالٍ ، فَيُنْظَرُ إلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الظُّلْمَةُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ" انتهى من "مواهب الجليل" (1/392) .
ويدل لهذا الحديث السابق : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا [ أي جهة المشرق] ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا [أي : جهة المغرب] ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ : فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) .
قال القرطبي: " أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها ؛ إذ لا يُقِبل الليل إلا إذا أدبر النهار ، ولا يُدبر النهار إلا إذا غربت الشمس ، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ، ويُشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك : فيحل الإفطار" انتهى من "إكمال المعلم" (4/35) .
وقال النووي : " قَالَ الْعُلَمَاءُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا ، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ ، بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/ 209) .
وقال ابن دقيق العيد : " الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارُ مُتَلَازِمَانِ ، أَعْنِي : إقْبَالَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النَّهَارِ.
وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ لِلْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَيُسْتَدَلُّ بِالظَّاهِرِ عَلَى الْخَفِيِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ مَا يَسْتُرُ الْبَصَرَ عَنْ إدْرَاكِ الْغُرُوبِ ، وَكَانَ الْمَشْرِقُ بَارِزًا ظَاهِرًا ، فَيُسْتَدَلُّ بِطُلُوعِ اللَّيْلِ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ" انتهى من "إحكام الأحكام" (2/ 27).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وسن تعجيل فطر أي : المبادرة به إذا غربت الشمس ، فالمعتبر غروب الشمس ، لا الأذان ، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم ، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير ، فلو غربت الشمس ، وأنت تشاهدها ، والناس لم يؤذنوا بعد ، فلك أن تفطر ، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ، فليس لك أن تفطر ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .
ولا يضر بقاء النور القوي ، فبعض الناس يقول : نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا ، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس ، وسن الفطر .
ودليل سنية المبادرة : قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير .
فإن قال قائل : هل لي أن أفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت ، فهل لي أن أفطر ؟
فالجواب : نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ثم طلعت الشمس ) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/267) .
" وسن تعجيل فطر أي : المبادرة به إذا غربت الشمس ، فالمعتبر غروب الشمس ، لا الأذان ، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم ، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير ، فلو غربت الشمس ، وأنت تشاهدها ، والناس لم يؤذنوا بعد ، فلك أن تفطر ، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ، فليس لك أن تفطر ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .
ولا يضر بقاء النور القوي ، فبعض الناس يقول : نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا ، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس ، وسن الفطر .
ودليل سنية المبادرة : قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير .
فإن قال قائل : هل لي أن أفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت ، فهل لي أن أفطر ؟
فالجواب : نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ثم طلعت الشمس ) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/267) .
سؤال الأخ محمد زرارقة وفقه الله:
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعمركم.
كيف يمكن التوفيق بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن ترك إظهار الترحّم على أهل البدع هي سُنّةُ كثيرٍ من السلف" [الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨]، وبين قول الشيخ ربيع المدخلي -ختم الله له ولكم بالحسنى- عندما سُئل عن حكم الترحم على أهل البدع، فأجاب: "أمّا الترحم على أهل البدع، فإنّه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح، ومنهم أحمد بن حنبل، ودلّ على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سُنّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينازع في هذا جاهل ضال".
وقد بحثت في المقالات المفيدة التي كتبتموها فلم أجد الإشارة إلى الترحم على أهل البدع، مثل:
- التعامل مع إمام مبتدع.
- صفة المبتدع.
- ضوابط الاستفادة من كتب المبتدعة.
- ضوابط هجر المبتدع.
- الجواب عن الاعتراضِ على حُكمِ المُتلبِّسِ بالبدعةِ.
- الجواب عن الاعتراض على استحقاق المبتدع للولاء مِنْ وجهٍ والبراء مِنْ وجه.
فأفيدونا جزاكم الله خيرًا، وفتح الله عليكم.
جواب الشيخ فركوس حفظه الله:
أولا فيه المبتدع الذي بدعته مفسقة والمبتدع الذي بدعته مكفرة، والفرق بينهما أن الذي بدعته مفسقة لا يزال في حظيرة الإسلام وأما الذي بدعته مكفرة فيخرج من حضيرة الإسلام، فبدعة الشرك الأكبر الذي يعتقده القبوريون والذين يعتقدون في أئمتهم أنهم أحياء وفيهم بعض خصوصيات الربوبية فهؤلاء غير هؤلاء، فمن كان في دائرة الإسلام يترحم عليه [حق المسلم على المسلم ست]الحديث.
الترحم على المسلمين سواء أهل المعاصي أو أهل البدع ممن هم في البدعة المفسقة، يبقى أن المبتدع الذي بدعته مفسقة إن كان الحاكم أو الوجهاء أو أهل الفضل والعلم فيمن يرون من قتل نفسه بمعصية أو فعل أمرا كريها يجوز أن يمتنعوا عن الصلاة عليه وعن الترحم عليه من باب النكاية ومن أمثاله حتى يرتدعوا ولا يأخذوا أموال الناس بالباطل فهؤلاء يجوز الترحم عليهم والصلاة عليهم [صلوا على ميتكم] وكذلك لأهل الفضل والعلم ألا يفعلوا ذلك للتقليص من بدعهم ويعلم الناس حالهم وأنهم لا يستقيموا على بدعهم، ممكن حمل كلام ابن تيمية على هذا المعنى أو من باب إظهار أنهم أحدثوا في الدين ومن كان متبعهم يعزف عنهم ويعدل الى طريق السنة، لا ينكر في الأصل وله الترحم قصد الإبعاد وليس قصد الجواز كما هو الشأن في عامة المسلمين وحتى يعرف الناس ما كان عليه.
منقول
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعمركم.
كيف يمكن التوفيق بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن ترك إظهار الترحّم على أهل البدع هي سُنّةُ كثيرٍ من السلف" [الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨]، وبين قول الشيخ ربيع المدخلي -ختم الله له ولكم بالحسنى- عندما سُئل عن حكم الترحم على أهل البدع، فأجاب: "أمّا الترحم على أهل البدع، فإنّه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح، ومنهم أحمد بن حنبل، ودلّ على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سُنّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينازع في هذا جاهل ضال".
وقد بحثت في المقالات المفيدة التي كتبتموها فلم أجد الإشارة إلى الترحم على أهل البدع، مثل:
- التعامل مع إمام مبتدع.
- صفة المبتدع.
- ضوابط الاستفادة من كتب المبتدعة.
- ضوابط هجر المبتدع.
- الجواب عن الاعتراضِ على حُكمِ المُتلبِّسِ بالبدعةِ.
- الجواب عن الاعتراض على استحقاق المبتدع للولاء مِنْ وجهٍ والبراء مِنْ وجه.
فأفيدونا جزاكم الله خيرًا، وفتح الله عليكم.
جواب الشيخ فركوس حفظه الله:
أولا فيه المبتدع الذي بدعته مفسقة والمبتدع الذي بدعته مكفرة، والفرق بينهما أن الذي بدعته مفسقة لا يزال في حظيرة الإسلام وأما الذي بدعته مكفرة فيخرج من حضيرة الإسلام، فبدعة الشرك الأكبر الذي يعتقده القبوريون والذين يعتقدون في أئمتهم أنهم أحياء وفيهم بعض خصوصيات الربوبية فهؤلاء غير هؤلاء، فمن كان في دائرة الإسلام يترحم عليه [حق المسلم على المسلم ست]الحديث.
الترحم على المسلمين سواء أهل المعاصي أو أهل البدع ممن هم في البدعة المفسقة، يبقى أن المبتدع الذي بدعته مفسقة إن كان الحاكم أو الوجهاء أو أهل الفضل والعلم فيمن يرون من قتل نفسه بمعصية أو فعل أمرا كريها يجوز أن يمتنعوا عن الصلاة عليه وعن الترحم عليه من باب النكاية ومن أمثاله حتى يرتدعوا ولا يأخذوا أموال الناس بالباطل فهؤلاء يجوز الترحم عليهم والصلاة عليهم [صلوا على ميتكم] وكذلك لأهل الفضل والعلم ألا يفعلوا ذلك للتقليص من بدعهم ويعلم الناس حالهم وأنهم لا يستقيموا على بدعهم، ممكن حمل كلام ابن تيمية على هذا المعنى أو من باب إظهار أنهم أحدثوا في الدين ومن كان متبعهم يعزف عنهم ويعدل الى طريق السنة، لا ينكر في الأصل وله الترحم قصد الإبعاد وليس قصد الجواز كما هو الشأن في عامة المسلمين وحتى يعرف الناس ما كان عليه.
منقول
👍6