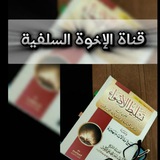نصرة غزة لا يكون بخراب الأردن ومصر، ولا بإثارة الفتنة فيهما لمزيد من سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وضياع أموالهم واحتلال أوطانهم وقتل أبنائهم وهدم بيوتهم على رؤوسهم، ولا بالتهجم على جيشيهما ورجال الأمن فيهما، فهذا لا يفيد أهل غزة بشيء، ولا يعود على المسلمين بخير.
فلا يستغفلنكم أعداؤكم وأنتم لا تشعرون، فتخربون بيوتكم بأيديكم.
انصروا أهل غزة بما يعود عليهم بالنفع حقيقة
أسأل الله أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرحمهم برحمته، ويكفر عنهم ذنوبهم، وينتقم من أعدائهم كلهم.
كتبه الشيخ علي الرملي وفقه الله
فلا يستغفلنكم أعداؤكم وأنتم لا تشعرون، فتخربون بيوتكم بأيديكم.
انصروا أهل غزة بما يعود عليهم بالنفع حقيقة
أسأل الله أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرحمهم برحمته، ويكفر عنهم ذنوبهم، وينتقم من أعدائهم كلهم.
كتبه الشيخ علي الرملي وفقه الله
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
إذا رَأيْتَ نَفْسَك مُتَحَيِّرًا فَالْزَم الاستِغفار، فإنّ الاستغفار مِمّا يَفتَحِ الله بِهِ على العبد .📚شرح الكافية الشافية:١٨٨/٣.
إذا رَأيْتَ نَفْسَك مُتَحَيِّرًا فَالْزَم الاستِغفار، فإنّ الاستغفار مِمّا يَفتَحِ الله بِهِ على العبد .📚شرح الكافية الشافية:١٨٨/٣.
فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله من مجالسه المختلفة:
🖋 حُكْمُ شِرَاءِ الْأَضَاحِي مِنَ الْمُؤَسَّسَاتِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا
📜 السُّؤَال:
أَعْمَلُ فِي مُؤَسَّسَةٍ تَقُومُ بِشِرَاءِ الْأَضَاحِي لِلْعُمَّالِ، وَالثَّمَنُ مِنْ 5 إِلَى 6 (أَيْ: بَيْنَ خَمْسَةٍ إلى سِتَّةِ مْلْيون سنتيم)، يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَلَا يَرَى الْأُضْحِيَةَ حَتَّى يَوْمِ الْعِيدِ، وَهِيَ مُسْتَوْرَدَةٌ، وَالْعَقْدُ يَنْتَهِي غَدًا. هَلْ هَذَا جَائِزٌ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللهُ:
يَجُوزُ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْبَائِعِ السِّلْعَةَ الَّتِي بِهَا أَوْصَافٌ مَخْصُوصَةٌ، مِثْلَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا عُيُوبٌ، أَوْ تَكُونُ فِي سِنٍّ مُعَيَّنَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِك، فَإِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ، يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ جَائِزًا لَا لَازِمًا، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا: فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَلْتَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِهِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ السِّلْعَةِ وَتَأْخِيرُ الْمَالِ، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْأَصْنَافِ الرِّبَوِيَّة، لَوْ كَانَ مِنَ الْأَصْنَافِ الرِّبَوِيَّةِ، لَقُلْنَا لَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ رَآهَا وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ، انْقَلَبَ الْعَقْدُ إِلَى لَازِمٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ جَائِزًا، وَهَذَا يُسَمَّى «خِيَارَ الرُّؤْيَةِ». وَفِيهِ أَيْضًا خِيَارُ الْعَيْبِ، وَخِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، خِيَارُ الْعَيْبِ، خِيَارُ التَّدْلِيسِ) إِذَا وُجِدَتْ، يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، فَإِذَا اسْتَحْكَمَ الْعَقْدُ لَزِمَ الْوَفَاءُ.
وَلَكِنْ مَعَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، إِذَا أَعْطَيْتَهُمُ الْمَالَ دُونَ أَن تَرَاهَا، فَلَمَّا يَأْتِي وَقْتُ التَّسْلِيمِ، يَقُولُونَ لَكَ: «هَذِهِ شَاتُكَ»، فَلَمَّا تُذْبَحُ وَتَرَاهَا، يَقُولُونَ: «ذَهَبَتْ أَمْوَالُك وَلَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهَا»، أَيْ: أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِالْخِيَارِ، وَأَنْتَ تُعْطِيهِمُ الْمَالَ وَلَا تَسْتَطِيعُ اسْتِرْدَادَهُ، وَهَذَا يُفْضِي إِلَى النِّزَاعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ وَكُلُّ عَقْدٍ يُفْضِي إِلَى النِّزَاعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ، يَنْبَغِي تَرْكُهُ.
بِمَعْنًى: لَوْ أَنَّ وَاحِدًا قَالَ لَهُ: «احْضِرْ لِي سِلْعَةً مِنَ الْخَارِجِ»، فَقَالَ: «نَعَمْ، مَا هِيَ الْمُوَاصَفَاتُ؟» فَقَالَ: «احْضِرْ لِي لَوْزًا صِفَتُهُ أَنَّهُ مُقَشَّرٌ»، وَخِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَالَ: «احْضِرْ لِي سَيَّارَةً»، فَقَالَ: «مَا هِيَ مُوَاصَفَاتُهَا؟» فَقَالَ: «مِقْوَدُهَا كَذَا وَكَذَا...»، إِلَخْ. فَإِذَا لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الْمُوَاصَفَاتِ، يَتَّصِلُ بِهِ وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ هَذَا الشَّرْطَ، أَوْ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحَقِّقَ لَهُ الشَّرْطَ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا، يُلْغَى الْعَقْدُ، وَيَسْتَرِدُّ مَالَهُ، وَيَسْتَرِدُّ سَيَّارَتَهُ أَوْ لَوْزَهُ، أَمَّا إِنْ وَفَّرَ لَهُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْبَلَ بِهَذَا الْعَقْدِ، أَيْ: أَنَّ الْعَقْدَ يَصْبِحُ لَازِمًا بَعْدَ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الْخِيَارِ.
كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، فِيهِ أَضَاحٍ نَطَحَتْ غَيْرَهَا، وَفِيهِ... وَإِلَخْ. وَلَكِنْ لَمَّا تَرَاهَا أَنْتَ، تَجِدُ فِيهَا أُمُورًا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ نَطَحَتْ غَيْرَهَا، أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنَ السِّنِّ الْمَطْلُوبِ، أَوْ فِيهَا عَيْبٌ، فَتَقُولُ لَهُ: «لَيْسَتْ هَذِهِ الَّتِي طَلَبْتُهَا»، فَيَقُولُ لَكَ: «خُذْهَا وَلَا نَرُدُّ لَكَ مَالَكَ». إِنْ حَصَلَ هَكَذَا وَكَانَ غَدًا الْعِيدُ، سَتَغْضَبُ وَتَرُدُّ غَضَبَكَ عَلَى أَهْلِكَ... لَنْ تَجِدَ لَهُ حَلًّا؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي اشْتَرَتْ لَا تَخْسَرُ، تَقُولُ: «أَنَا جَعَلْتُ لَكُمْ إِعَانَةً، فَلَا أَخْسَرُ، إِنَّمَا رُدُّوا لِي أَمْوَالِي وَانْتَهَى».
إِذَنْ، فِيهِ حُكْمٌ بِالْجَوَازِ، مِنَ الْجَائِزِ إِلَى اللَّزُومِ عِنْدَمَا يَنْتَفِي الْخِيَارُ، فَيَصْبِحُ الْعَقْدُ لَازِمًا، عِنْدَ انْتِفَاءِ الْخِيَارِ، أَيْ: أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهَا، فِي هَذِهِ الْحَالِ يَصْبِحُ الْعَقْدُ لَازِمًا، وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ الْوَفَاءُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [الْمَائِدَةِ: 1].
🖋 حُكْمُ شِرَاءِ الْأَضَاحِي مِنَ الْمُؤَسَّسَاتِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا
📜 السُّؤَال:
أَعْمَلُ فِي مُؤَسَّسَةٍ تَقُومُ بِشِرَاءِ الْأَضَاحِي لِلْعُمَّالِ، وَالثَّمَنُ مِنْ 5 إِلَى 6 (أَيْ: بَيْنَ خَمْسَةٍ إلى سِتَّةِ مْلْيون سنتيم)، يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَلَا يَرَى الْأُضْحِيَةَ حَتَّى يَوْمِ الْعِيدِ، وَهِيَ مُسْتَوْرَدَةٌ، وَالْعَقْدُ يَنْتَهِي غَدًا. هَلْ هَذَا جَائِزٌ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللهُ:
يَجُوزُ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْبَائِعِ السِّلْعَةَ الَّتِي بِهَا أَوْصَافٌ مَخْصُوصَةٌ، مِثْلَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا عُيُوبٌ، أَوْ تَكُونُ فِي سِنٍّ مُعَيَّنَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِك، فَإِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ، يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ جَائِزًا لَا لَازِمًا، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا: فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَلْتَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِهِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ السِّلْعَةِ وَتَأْخِيرُ الْمَالِ، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْأَصْنَافِ الرِّبَوِيَّة، لَوْ كَانَ مِنَ الْأَصْنَافِ الرِّبَوِيَّةِ، لَقُلْنَا لَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ رَآهَا وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ، انْقَلَبَ الْعَقْدُ إِلَى لَازِمٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ جَائِزًا، وَهَذَا يُسَمَّى «خِيَارَ الرُّؤْيَةِ». وَفِيهِ أَيْضًا خِيَارُ الْعَيْبِ، وَخِيَارُ التَّدْلِيسِ، وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، خِيَارُ الْعَيْبِ، خِيَارُ التَّدْلِيسِ) إِذَا وُجِدَتْ، يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، فَإِذَا اسْتَحْكَمَ الْعَقْدُ لَزِمَ الْوَفَاءُ.
وَلَكِنْ مَعَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، إِذَا أَعْطَيْتَهُمُ الْمَالَ دُونَ أَن تَرَاهَا، فَلَمَّا يَأْتِي وَقْتُ التَّسْلِيمِ، يَقُولُونَ لَكَ: «هَذِهِ شَاتُكَ»، فَلَمَّا تُذْبَحُ وَتَرَاهَا، يَقُولُونَ: «ذَهَبَتْ أَمْوَالُك وَلَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهَا»، أَيْ: أَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِالْخِيَارِ، وَأَنْتَ تُعْطِيهِمُ الْمَالَ وَلَا تَسْتَطِيعُ اسْتِرْدَادَهُ، وَهَذَا يُفْضِي إِلَى النِّزَاعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ وَكُلُّ عَقْدٍ يُفْضِي إِلَى النِّزَاعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ، يَنْبَغِي تَرْكُهُ.
بِمَعْنًى: لَوْ أَنَّ وَاحِدًا قَالَ لَهُ: «احْضِرْ لِي سِلْعَةً مِنَ الْخَارِجِ»، فَقَالَ: «نَعَمْ، مَا هِيَ الْمُوَاصَفَاتُ؟» فَقَالَ: «احْضِرْ لِي لَوْزًا صِفَتُهُ أَنَّهُ مُقَشَّرٌ»، وَخِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَالَ: «احْضِرْ لِي سَيَّارَةً»، فَقَالَ: «مَا هِيَ مُوَاصَفَاتُهَا؟» فَقَالَ: «مِقْوَدُهَا كَذَا وَكَذَا...»، إِلَخْ. فَإِذَا لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الْمُوَاصَفَاتِ، يَتَّصِلُ بِهِ وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ هَذَا الشَّرْطَ، أَوْ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحَقِّقَ لَهُ الشَّرْطَ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا، يُلْغَى الْعَقْدُ، وَيَسْتَرِدُّ مَالَهُ، وَيَسْتَرِدُّ سَيَّارَتَهُ أَوْ لَوْزَهُ، أَمَّا إِنْ وَفَّرَ لَهُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْبَلَ بِهَذَا الْعَقْدِ، أَيْ: أَنَّ الْعَقْدَ يَصْبِحُ لَازِمًا بَعْدَ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الْخِيَارِ.
كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، فِيهِ أَضَاحٍ نَطَحَتْ غَيْرَهَا، وَفِيهِ... وَإِلَخْ. وَلَكِنْ لَمَّا تَرَاهَا أَنْتَ، تَجِدُ فِيهَا أُمُورًا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ نَطَحَتْ غَيْرَهَا، أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنَ السِّنِّ الْمَطْلُوبِ، أَوْ فِيهَا عَيْبٌ، فَتَقُولُ لَهُ: «لَيْسَتْ هَذِهِ الَّتِي طَلَبْتُهَا»، فَيَقُولُ لَكَ: «خُذْهَا وَلَا نَرُدُّ لَكَ مَالَكَ». إِنْ حَصَلَ هَكَذَا وَكَانَ غَدًا الْعِيدُ، سَتَغْضَبُ وَتَرُدُّ غَضَبَكَ عَلَى أَهْلِكَ... لَنْ تَجِدَ لَهُ حَلًّا؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي اشْتَرَتْ لَا تَخْسَرُ، تَقُولُ: «أَنَا جَعَلْتُ لَكُمْ إِعَانَةً، فَلَا أَخْسَرُ، إِنَّمَا رُدُّوا لِي أَمْوَالِي وَانْتَهَى».
إِذَنْ، فِيهِ حُكْمٌ بِالْجَوَازِ، مِنَ الْجَائِزِ إِلَى اللَّزُومِ عِنْدَمَا يَنْتَفِي الْخِيَارُ، فَيَصْبِحُ الْعَقْدُ لَازِمًا، عِنْدَ انْتِفَاءِ الْخِيَارِ، أَيْ: أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهَا، فِي هَذِهِ الْحَالِ يَصْبِحُ الْعَقْدُ لَازِمًا، وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ الْوَفَاءُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [الْمَائِدَةِ: 1].
وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الصَّحِيحَةُ، وَلَكِنَّكَ سَتَتَعَامَلُ مَعَ نَاسٍ يُهِمُّهُمُ الْمَالُ، فَإِنْ قَدَّمْتَ لَهُ الْمَالَ لَنْ يَرُدَّهُ لَكَ، وَلَيْسَ يَتَحَاكَمُ إِلَى الشَّرْعِ وَيَقُولُ: «هَذِهِ عَوْرَاءُ أَوْ عَرْجَاءُ»، إِلَخْ. هَذَا سَيَقُولُ لَكَ: «أَنَا لَا أَبْقَى أَخْتَارُ لَكَ، خُذْهَا وَانْتَهَى». فَكَيْفَ تَأْتِي أَنْتَ بِهَا لِلْبَيْتِ وَهِيَ لَا تُجْزِئُ؟ ثُمَّ تَتَقَوقَعُ وَتَصِيرُ مِثْلَ هَذَا الْأَخِ... الْمَشَاكِلُ تَأْتِي هَكَذَا الْإِنْسَانُ يَتَبَصَّرُ بِهَا ابْتِدَاءً.
إِذَا رَأَيْتَهَا، انْتَهَى، نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَرَاهَا إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُسَلِّمُونَهَا لَكَ، نَحْنُ إِنْ رَأَيْنَاهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عُيُوبٌ، انْتَهَى، لَا مُشْكِلَ، وَلَكِنَّكَ لَا تَرَاهَا، ثُمَّ يَوْمَ الْعِيدِ قَدْ تَجِدُ فِيهَا عَيْبًا... فَأَنْتَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْهَبَ مَعَ هَذَا وَتَجْعَلَ عَلَيْهَا عَلَامَةً، لَكِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَكَ، إِذَنْ، تَجْتَنِبُ هَذَا وَتَزِيدُ مَالًا وَتَشْتَرِي...؟!
📜سَائِل: هَلْ فِي هَذَا غَرَرٌ؟
🎙 الشَّيْخ:
لَيْسَ فِيهِ غَرَرٌ، إِنَّمَا فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. الْغَرَرُ أَنْ يَقُولَ لَكَ: «قَدْ تَجِدُهَا سَلِيمَةً وَقَدْ تَجِدُهَا مَرِيضَةً». أَمَّا هَذَا فَيَقُولُ لَكَ: «إِنَّهَا سَلِيمَةٌ ابْتِدَاءً»، وَلَكِنْ يَبْقَى لَكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ...
📜 الْفَتْوَى رَقْمُ 05 📍 مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ :الإثنين 8 شوال 1446 هـ الموافق لـ 07 أبريل 2025 م
🔍الصِّنْفُ:فَتَاوَى الْأُضْحِيَةِ وَالْعِيدِ
إِذَا رَأَيْتَهَا، انْتَهَى، نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَرَاهَا إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُسَلِّمُونَهَا لَكَ، نَحْنُ إِنْ رَأَيْنَاهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عُيُوبٌ، انْتَهَى، لَا مُشْكِلَ، وَلَكِنَّكَ لَا تَرَاهَا، ثُمَّ يَوْمَ الْعِيدِ قَدْ تَجِدُ فِيهَا عَيْبًا... فَأَنْتَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْهَبَ مَعَ هَذَا وَتَجْعَلَ عَلَيْهَا عَلَامَةً، لَكِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَكَ، إِذَنْ، تَجْتَنِبُ هَذَا وَتَزِيدُ مَالًا وَتَشْتَرِي...؟!
📜سَائِل: هَلْ فِي هَذَا غَرَرٌ؟
🎙 الشَّيْخ:
لَيْسَ فِيهِ غَرَرٌ، إِنَّمَا فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. الْغَرَرُ أَنْ يَقُولَ لَكَ: «قَدْ تَجِدُهَا سَلِيمَةً وَقَدْ تَجِدُهَا مَرِيضَةً». أَمَّا هَذَا فَيَقُولُ لَكَ: «إِنَّهَا سَلِيمَةٌ ابْتِدَاءً»، وَلَكِنْ يَبْقَى لَكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ...
📜 الْفَتْوَى رَقْمُ 05 📍 مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ :الإثنين 8 شوال 1446 هـ الموافق لـ 07 أبريل 2025 م
🔍الصِّنْفُ:فَتَاوَى الْأُضْحِيَةِ وَالْعِيدِ
مسألة فقهية تعلموها ✍👇🏻
ما حكم البول في المُغتسل #الدوش 🚿
قال : اﻹمام ابن القيم رحمه الله
لَوْ كَانَ الْمَكَان مُبَلَّطًا لَا يَسْتَقِرّ فِيهِ الْبَوْل - بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور #الْفُقَهَاء
المصدر : من 📗 تهذيب السنن
جزء ( 1 ) صفحة ( 118 )
______
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام ❓
الجواب :
نعم _ يجوز لهُ ذلك مع التحفُظ من رشاش البول ويُشرع لهُ أن يصُّبَ عليهِ ماءً ليذهب مُباشرةً إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان "
المصدر : من 📔فتاوى اللجنة الدائمة
جزء ( 5 ) صفحة ( 102 )
___
وسُئل : الفقيه ابن عثيمين رحمه الله
هل التبول في #البانيو أثناء الإستحمام يدخل في حديث النهي عن أن يبول الشّخص في مكان استحمامه _ لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل ❓
فأجاب : لا __ لا يدخُل لأنهُ إذا بالَ فسوف يريق عليه الماء - ثم يزول البول - لكن لا يستحم حتى :
👈🏻يزيل البول بإراقة الماء عليه
المصدر : من 📘 لقاء الباب المفتوح
رقم : -- ( 4026 ) ●
ما حكم البول في المُغتسل #الدوش 🚿
قال : اﻹمام ابن القيم رحمه الله
لَوْ كَانَ الْمَكَان مُبَلَّطًا لَا يَسْتَقِرّ فِيهِ الْبَوْل - بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور #الْفُقَهَاء
المصدر : من 📗 تهذيب السنن
جزء ( 1 ) صفحة ( 118 )
______
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام ❓
الجواب :
نعم _ يجوز لهُ ذلك مع التحفُظ من رشاش البول ويُشرع لهُ أن يصُّبَ عليهِ ماءً ليذهب مُباشرةً إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان "
المصدر : من 📔فتاوى اللجنة الدائمة
جزء ( 5 ) صفحة ( 102 )
___
وسُئل : الفقيه ابن عثيمين رحمه الله
هل التبول في #البانيو أثناء الإستحمام يدخل في حديث النهي عن أن يبول الشّخص في مكان استحمامه _ لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل ❓
فأجاب : لا __ لا يدخُل لأنهُ إذا بالَ فسوف يريق عليه الماء - ثم يزول البول - لكن لا يستحم حتى :
👈🏻يزيل البول بإراقة الماء عليه
المصدر : من 📘 لقاء الباب المفتوح
رقم : -- ( 4026 ) ●
. #ســـــــائل_يقــــــــــــول_ ☟
*أريد أن أزوج ابنتي من طالب علم غير ميسور الحال لكن بنتي لا ترغب تريد رجلًا ميسور الحال ؟*
🗯ــ ⬇ *_الجــ↶ـــواب_* ⬇ ــ🗯
📜 الله أعلم أين البركة، وأين الخير، فقد يبارك الله لها في هذا الطالب الصالح ولو كان فقيرًا، فالله عز وجل ما سيضيعه، والقضية لو تزوجتي من هذا الغني القضية قليل زبيب ولوز وحليب وعصير وفستان، أيش القضية ؟!! هذا يحفظ لك دينكِ الله يباركِ فيكِ ويحفظكِ ويهديكِ، انظري إلى مصلحتكِ في دينكِ، هذا أنفع لكِ وخير لكِ، إن يسر الله لك برجل صالح ميسور الحال لا مانع، لكن إذا كان الأمر أن تتوقفي عن الزواج حتى يأتي الثري ما أنت بذكية ولا حريصة على المصلحة، فنحن نقول لكِ إذا يسر الله بالرجل الصالح فأمور الدنيا سهلة، سييسرها الله عز وجل : ﴿…وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ… ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
نسأل الله أن يختار لكِ ما فيه الخير.
▪▪▪
ـــ 📖 *_أجـــاب ؏ـنــه_* 📖 ــــ
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى
*أريد أن أزوج ابنتي من طالب علم غير ميسور الحال لكن بنتي لا ترغب تريد رجلًا ميسور الحال ؟*
🗯ــ ⬇ *_الجــ↶ـــواب_* ⬇ ــ🗯
📜 الله أعلم أين البركة، وأين الخير، فقد يبارك الله لها في هذا الطالب الصالح ولو كان فقيرًا، فالله عز وجل ما سيضيعه، والقضية لو تزوجتي من هذا الغني القضية قليل زبيب ولوز وحليب وعصير وفستان، أيش القضية ؟!! هذا يحفظ لك دينكِ الله يباركِ فيكِ ويحفظكِ ويهديكِ، انظري إلى مصلحتكِ في دينكِ، هذا أنفع لكِ وخير لكِ، إن يسر الله لك برجل صالح ميسور الحال لا مانع، لكن إذا كان الأمر أن تتوقفي عن الزواج حتى يأتي الثري ما أنت بذكية ولا حريصة على المصلحة، فنحن نقول لكِ إذا يسر الله بالرجل الصالح فأمور الدنيا سهلة، سييسرها الله عز وجل : ﴿…وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ… ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
نسأل الله أن يختار لكِ ما فيه الخير.
▪▪▪
ـــ 📖 *_أجـــاب ؏ـنــه_* 📖 ــــ
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى
ساعة استجابة، لا تنسوا الدعاء لانفسكم ولكل من يعز عليكم، ولبلادنا وجيشنا وعالمنا أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويحقق لنا كل ما نتمنى
في حكمِ عبارةِ: «فلان لا تخفى عليه خافيةٌ» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1406
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1406
الفتوى رقم: ١٤٠٦
الصنف: فتاوى متنوعة ـ ألفاظ في الميزان
في حكمِ عبارةِ: «فلان لا تخفى عليه خافيةٌ»
السؤال:
يعبِّر البعضُ ـ عند ذِكرِ علمِ أحَدِ العلماء وسَعَةِ اطِّلاعِه وتَضلُّعِه، أو إحاطةِ الأمير أو الوالي الحازمِ علمًا بكُلِّ تفاصيلِ مُلكِه وإمارتِه وناحِيَتِه ـ بقولهم إنَّه: «لا تخفى عليه خافيةٌ» أو نحوها؛ فهل يُعَدُّ ذلك مِنَ الغُلُوِّ ومِنَ العبارات المُستقبَحةِ الَّتي ينبغي اجتنابُها في حقِّ المخلوقِ لكونها خاصَّةً بالله أم في الأمر سَعَةٌ؟ أفيدونا، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فعبارةُ: «لا تخفى عليه خافيةٌ» ـ عند إطلاقِها عن أيِّ قيدٍ ـ ينصرف الذِّهنُ عند سماعها إلى الله تعالى، لعدمِ وجودِ أيِّ قرينةٍ تدلُّ أنَّ المعنيَّ بذلك هو العلمُ النِّسبيُّ لا العلمُ المُطلَقُ؛ فإذا أُطلِقَتْ على غيرِ الله دون قيدٍ كانت باطلةً وكانت إمَّا خطأً لفظيًّا أو غُلُوًّا مِنْ قائلِها لأنَّها لا تليق إلَّا بالله سبحانه؛ ذلك لأنَّ الموصوفَ بِصِفةِ العلمِ المُطلَقِ إنَّما هو اللهُ تعالى العليمُ بكُلِّ ما في هذا الكونِ، الَّذي لا يخفى عليه شيءٌ ولا تَخْفى عليه خافِيَةٌ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥﴾ [آل عِمران]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ١٢﴾ [الطَّلاق]، وقال تعالى: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ٧﴾ [طه]، وقال تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدَۢا ٢٨﴾ [الجن]، وغيرها مِنَ الآيات.
وعليه، فلا يصحُّ إطلاقُ هذه العبارةِ دون قيدٍ إلَّا في حقِّ الله تعالى؛ ولا شكَّ أنَّ المبالغةَ في الإطراء بنفيِ الجهلِ مُطلَقًا غُلُوٌّ في المدحِ مُستهجَنٌ لا يُنصَحُ به، لكونه يُفضي إلى ما يُنافي التَّوحيدَ، بتسويةِ غير اللهِ بالله فيما هو مِنْ خصائصِ الله.
أمَّا إذا كان في سياق المُتحدِّثِ ذِكرٌ لبعض العلومِ والمَعارفِ أو لأمورٍ جزئيَّةٍ ـ أَلَمَّ بها الموصوفُ أو ضَبَطَها ـ ثمَّ أَردفَ ذلك بعبارةِ: «لا تخفى منها عليه خافيةٌ» أو «أحاط بهذا الشَّيءِ علمًا» ممَّا تُمكِنُ فيه الإحاطةُ، للدَّلالة على سَعَةِ علمِه بها واطِّلاعه عليها وإحاطتِه بها لكونها تدخل في مجالات تخصُّصه وهو عليمٌ بها وقد بلَغَ فيها مَبْلَغًا، أو ذِكرِ إحاطةِ الأميرِ أو الوالي الحازمِ علمًا بمُلكِه وإمارتِه كما وصَفَ الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ الخليفةَ العبَّاسيَّ النَّاصرَ لدِينِ الله بأنَّه: «لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ أحوال رعيَّتِه كِبارِهم وصِغارِهم، وأصحابُ أخبارِه في أقطار البلاد يُوصِلون إليه أحوالَ الملوكِ الظَّاهرةَ والباطنةَ حتَّى يُشاهِدَ جميعَ البلادِ دفعةً واحدةً»(١)؛ فلا أرى في ذلك مانعًا بالشَّرط المذكور، لوجود القرينةِ السِّياقيَّةِ أو اللَّفظيَّةِ المقيِّدةِ في قوله: «منها» أو «بها» ونحوِ ذلك، الأمرُ الَّذي لا ينصرف الذِّهنُ معه إلى العلم المُطلَقِ الَّذي يختصُّ به اللهُ عند سماعِها؛ وإنَّما ينصرفُ إلى وصف المُتحدَّثِ عنه بالعلمِ النِّسبيِّ المُقيَّد؛ ذلك لأنَّ عِلمَ البشر ـ مهما عَلَا وسَمَا ـ محدودُ الأُفُقِ وضيِّقُ الجوانبِ، وقُدْرةُ الإنسانِ على الإحاطةِ محدودةٌ ـ أيضًا ـ قاصرةٌ على بعضِ المعلوماتِ أو شِقصٍ كبيرٍ منها، فالمرءُ يسعى دائمًا ـ ولو في مادَّةِ اختصاصه ـ إلى الاستزادةِ ممَّا أعطاهُ اللهُ مِنَ العلم، ولا يُحصِّل منه ـ ولو بالعكوف المُستمِرِّ وإنفاقِ جميعِ وقتِه ـ سوى على النَّزرِ اليسير، لأنَّ العلمَ غزيرٌ وكثيرٌ لا يحيط به أحَدٌ، وكما قِيلَ: «العلمُ إذا أعطَيْتَه كُلَّك أعطاك بعضَه، وإِنْ أعطَيْتَه بعضَك فاتَكَ كُلُّه»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رمضان ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مـارس ٢٠٢٥م
(١) «تاريخ الإسلام ووفَيَات المَشاهير والأعلام» للذَّهبي (٤٥/ ٨٦).
(٢) ورَدَ عن جملةٍ مِنَ الأعلام، وورَدَتْ جملةٌ حسنةٌ عن النَّظَّام؛ فعن محمَّدِ بنِ يزيدَ المُبرِّد: نا عَمْرُو بنُ بحرٍ [الجاحظ] قال: سَمِعْتُ إبراهيمَ بنَ سيَّارٍ النَّظَّامَ يقول: «العلمُ شيءٌ لا يُعطيك بعضَه حتَّى تُعطِيَه كُلَّك، وأنتَ ـ إذا أعطَيْتَه كُلَّك ـ مِنْ إعطائه البعضَ على خطرٍ» [«الفقيه والمتفقِّه» (٢/ ٢٠٤) و«تاريخ بغداد» (٦/ ٩٧) كلاهما للخطيب البغدادي].
الصنف: فتاوى متنوعة ـ ألفاظ في الميزان
في حكمِ عبارةِ: «فلان لا تخفى عليه خافيةٌ»
السؤال:
يعبِّر البعضُ ـ عند ذِكرِ علمِ أحَدِ العلماء وسَعَةِ اطِّلاعِه وتَضلُّعِه، أو إحاطةِ الأمير أو الوالي الحازمِ علمًا بكُلِّ تفاصيلِ مُلكِه وإمارتِه وناحِيَتِه ـ بقولهم إنَّه: «لا تخفى عليه خافيةٌ» أو نحوها؛ فهل يُعَدُّ ذلك مِنَ الغُلُوِّ ومِنَ العبارات المُستقبَحةِ الَّتي ينبغي اجتنابُها في حقِّ المخلوقِ لكونها خاصَّةً بالله أم في الأمر سَعَةٌ؟ أفيدونا، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فعبارةُ: «لا تخفى عليه خافيةٌ» ـ عند إطلاقِها عن أيِّ قيدٍ ـ ينصرف الذِّهنُ عند سماعها إلى الله تعالى، لعدمِ وجودِ أيِّ قرينةٍ تدلُّ أنَّ المعنيَّ بذلك هو العلمُ النِّسبيُّ لا العلمُ المُطلَقُ؛ فإذا أُطلِقَتْ على غيرِ الله دون قيدٍ كانت باطلةً وكانت إمَّا خطأً لفظيًّا أو غُلُوًّا مِنْ قائلِها لأنَّها لا تليق إلَّا بالله سبحانه؛ ذلك لأنَّ الموصوفَ بِصِفةِ العلمِ المُطلَقِ إنَّما هو اللهُ تعالى العليمُ بكُلِّ ما في هذا الكونِ، الَّذي لا يخفى عليه شيءٌ ولا تَخْفى عليه خافِيَةٌ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥﴾ [آل عِمران]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ١٢﴾ [الطَّلاق]، وقال تعالى: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ٧﴾ [طه]، وقال تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدَۢا ٢٨﴾ [الجن]، وغيرها مِنَ الآيات.
وعليه، فلا يصحُّ إطلاقُ هذه العبارةِ دون قيدٍ إلَّا في حقِّ الله تعالى؛ ولا شكَّ أنَّ المبالغةَ في الإطراء بنفيِ الجهلِ مُطلَقًا غُلُوٌّ في المدحِ مُستهجَنٌ لا يُنصَحُ به، لكونه يُفضي إلى ما يُنافي التَّوحيدَ، بتسويةِ غير اللهِ بالله فيما هو مِنْ خصائصِ الله.
أمَّا إذا كان في سياق المُتحدِّثِ ذِكرٌ لبعض العلومِ والمَعارفِ أو لأمورٍ جزئيَّةٍ ـ أَلَمَّ بها الموصوفُ أو ضَبَطَها ـ ثمَّ أَردفَ ذلك بعبارةِ: «لا تخفى منها عليه خافيةٌ» أو «أحاط بهذا الشَّيءِ علمًا» ممَّا تُمكِنُ فيه الإحاطةُ، للدَّلالة على سَعَةِ علمِه بها واطِّلاعه عليها وإحاطتِه بها لكونها تدخل في مجالات تخصُّصه وهو عليمٌ بها وقد بلَغَ فيها مَبْلَغًا، أو ذِكرِ إحاطةِ الأميرِ أو الوالي الحازمِ علمًا بمُلكِه وإمارتِه كما وصَفَ الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ الخليفةَ العبَّاسيَّ النَّاصرَ لدِينِ الله بأنَّه: «لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ أحوال رعيَّتِه كِبارِهم وصِغارِهم، وأصحابُ أخبارِه في أقطار البلاد يُوصِلون إليه أحوالَ الملوكِ الظَّاهرةَ والباطنةَ حتَّى يُشاهِدَ جميعَ البلادِ دفعةً واحدةً»(١)؛ فلا أرى في ذلك مانعًا بالشَّرط المذكور، لوجود القرينةِ السِّياقيَّةِ أو اللَّفظيَّةِ المقيِّدةِ في قوله: «منها» أو «بها» ونحوِ ذلك، الأمرُ الَّذي لا ينصرف الذِّهنُ معه إلى العلم المُطلَقِ الَّذي يختصُّ به اللهُ عند سماعِها؛ وإنَّما ينصرفُ إلى وصف المُتحدَّثِ عنه بالعلمِ النِّسبيِّ المُقيَّد؛ ذلك لأنَّ عِلمَ البشر ـ مهما عَلَا وسَمَا ـ محدودُ الأُفُقِ وضيِّقُ الجوانبِ، وقُدْرةُ الإنسانِ على الإحاطةِ محدودةٌ ـ أيضًا ـ قاصرةٌ على بعضِ المعلوماتِ أو شِقصٍ كبيرٍ منها، فالمرءُ يسعى دائمًا ـ ولو في مادَّةِ اختصاصه ـ إلى الاستزادةِ ممَّا أعطاهُ اللهُ مِنَ العلم، ولا يُحصِّل منه ـ ولو بالعكوف المُستمِرِّ وإنفاقِ جميعِ وقتِه ـ سوى على النَّزرِ اليسير، لأنَّ العلمَ غزيرٌ وكثيرٌ لا يحيط به أحَدٌ، وكما قِيلَ: «العلمُ إذا أعطَيْتَه كُلَّك أعطاك بعضَه، وإِنْ أعطَيْتَه بعضَك فاتَكَ كُلُّه»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رمضان ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مـارس ٢٠٢٥م
(١) «تاريخ الإسلام ووفَيَات المَشاهير والأعلام» للذَّهبي (٤٥/ ٨٦).
(٢) ورَدَ عن جملةٍ مِنَ الأعلام، وورَدَتْ جملةٌ حسنةٌ عن النَّظَّام؛ فعن محمَّدِ بنِ يزيدَ المُبرِّد: نا عَمْرُو بنُ بحرٍ [الجاحظ] قال: سَمِعْتُ إبراهيمَ بنَ سيَّارٍ النَّظَّامَ يقول: «العلمُ شيءٌ لا يُعطيك بعضَه حتَّى تُعطِيَه كُلَّك، وأنتَ ـ إذا أعطَيْتَه كُلَّك ـ مِنْ إعطائه البعضَ على خطرٍ» [«الفقيه والمتفقِّه» (٢/ ٢٠٤) و«تاريخ بغداد» (٦/ ٩٧) كلاهما للخطيب البغدادي].
#جديد_الفتاوى_القبية🖋 كيفية التعامل مع مستقيم جديد فيه ميول جنسية للرجال
📜 نص السؤال:
أَحَدُ العَوَامِ مِنَ الشَّبَابِ فِي مَنْطِقَتِنَا بَعْدَ مُخَالَطَةِ الإِخْوَةِ السَّلَفِيِّينَ بَدَأَتْ تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الاسْتِقَامَةِ وَيَحْضُرُ حِلَقَ القُرْآنِ، لَكِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ مَيْلًا لِلرِّجَالِ وَيَتَكَلَّمُ عَلَى وَسَائِطِ التَّوَاصُلِ بِكَلامٍ فَاحِشٍ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ الإِخْوَةُ لِيَنْصَحُوهُ، لَكِنْ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ وَأَضَرَّ بِسُمْعَةِ الإِخْوَةِ فِي المَنْطِقَةِ، فَهَجَرَهُ بَعْضُ الإِخْوَةِ وَلَكِنْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَهْجُرُوهُ، فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ عَلَى صَوَابٍ، وَمَا نَصِيحَتُكُمْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَهُ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللَّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَـإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ» (1)، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، أَيْ السَّيِّئَاتِ وَأَصْحَابَ السَّيِّئَاتِ؛ لِأَنَّ السَّيِّئَةَ لَا تَقُومُ وَحْدَهَا بَلْ تَقُومُ مَعَ فَاعِلِهَا، وَالْبِدَعُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
وَقَالَ ﷺ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا» (2)، وَقَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (3)؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.
فَإِذَا وَقَعَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَعَاصِي:
- فَدَفَعَتْهُ نَفْسُهُ لِذَلِكَ، فَكَانَ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ لَازِمًا وَفِي الْحَالِ، مَعَ الْإِقْلَاعِ عَنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَعَدَمِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى بَقِيَّةِ السَّيِّئَاتِ الْأُخْرَى إِنْ وُجِدَتْ، ثُمَّ اسْتِتْبَاعُهَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70].
أَمَّا إِذَا نُوصِحَ وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّبَرُّؤِ مِنْهُ؛ كَيْ لَا يَكُونَ رَاضِيًا بِمَا يَفْعَلُ، لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، فالَّذِي يَسْكُتُ وَلَا يَنْصَحُهُ فَهُوَ رَاضٍ بِشَكْلٍ أَوْ بِآخَرَ.
لِذَا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ هَذَا الرِّضَا، بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِنْكَارِ وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهُ وَيَجْتَنِبَ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ بِأَلَّا يَسْكُتَ عَنْهَا، فَلَا يَقَعُ فِي مِثْلِ عَمَلِهِ.
لِذَا قَالَ ﷺ: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَأَنْكَرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا» (4).
أَمَّا التَّبَرُّؤُ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ: كَيْ لَا يَلْحَقَهُ وَلِكَيْ لَا يُوضَعَ هَؤُلَاءِ السَّلَفِيُّونَ عَلَى طَبَقٍ وَاحِدَةٍ.
- لِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 214-216].
فالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرِيقَ الثَّانِيَ هُمْ عَلَى صَوَابٍ، وَأَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ ينقص فِي مَوْقِفِهِمْ هَذَا التَّبَرُّؤُ وَالِابْتِعَادُ عَنْهُ، وَقَبْلَ التَّبَرُّؤِ النَّصِيحَةُ الْمُسَدَّدَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى تَبَرَّءُوا مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
📜 نص السؤال:
أَحَدُ العَوَامِ مِنَ الشَّبَابِ فِي مَنْطِقَتِنَا بَعْدَ مُخَالَطَةِ الإِخْوَةِ السَّلَفِيِّينَ بَدَأَتْ تَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الاسْتِقَامَةِ وَيَحْضُرُ حِلَقَ القُرْآنِ، لَكِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ مَيْلًا لِلرِّجَالِ وَيَتَكَلَّمُ عَلَى وَسَائِطِ التَّوَاصُلِ بِكَلامٍ فَاحِشٍ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ الإِخْوَةُ لِيَنْصَحُوهُ، لَكِنْ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ وَأَضَرَّ بِسُمْعَةِ الإِخْوَةِ فِي المَنْطِقَةِ، فَهَجَرَهُ بَعْضُ الإِخْوَةِ وَلَكِنْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَهْجُرُوهُ، فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ عَلَى صَوَابٍ، وَمَا نَصِيحَتُكُمْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَهُ؟
🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس حَفِظَهُ اللَّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَـإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ» (1)، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، أَيْ السَّيِّئَاتِ وَأَصْحَابَ السَّيِّئَاتِ؛ لِأَنَّ السَّيِّئَةَ لَا تَقُومُ وَحْدَهَا بَلْ تَقُومُ مَعَ فَاعِلِهَا، وَالْبِدَعُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
وَقَالَ ﷺ: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا» (2)، وَقَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (3)؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.
فَإِذَا وَقَعَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَعَاصِي:
- فَدَفَعَتْهُ نَفْسُهُ لِذَلِكَ، فَكَانَ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ لَازِمًا وَفِي الْحَالِ، مَعَ الْإِقْلَاعِ عَنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَعَدَمِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى بَقِيَّةِ السَّيِّئَاتِ الْأُخْرَى إِنْ وُجِدَتْ، ثُمَّ اسْتِتْبَاعُهَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70].
أَمَّا إِذَا نُوصِحَ وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّبَرُّؤِ مِنْهُ؛ كَيْ لَا يَكُونَ رَاضِيًا بِمَا يَفْعَلُ، لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، فالَّذِي يَسْكُتُ وَلَا يَنْصَحُهُ فَهُوَ رَاضٍ بِشَكْلٍ أَوْ بِآخَرَ.
لِذَا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ هَذَا الرِّضَا، بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِنْكَارِ وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهُ وَيَجْتَنِبَ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ بِأَلَّا يَسْكُتَ عَنْهَا، فَلَا يَقَعُ فِي مِثْلِ عَمَلِهِ.
لِذَا قَالَ ﷺ: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَأَنْكَرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا» (4).
أَمَّا التَّبَرُّؤُ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ: كَيْ لَا يَلْحَقَهُ وَلِكَيْ لَا يُوضَعَ هَؤُلَاءِ السَّلَفِيُّونَ عَلَى طَبَقٍ وَاحِدَةٍ.
- لِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 214-216].
فالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرِيقَ الثَّانِيَ هُمْ عَلَى صَوَابٍ، وَأَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ ينقص فِي مَوْقِفِهِمْ هَذَا التَّبَرُّؤُ وَالِابْتِعَادُ عَنْهُ، وَقَبْلَ التَّبَرُّؤِ النَّصِيحَةُ الْمُسَدَّدَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى تَبَرَّءُوا مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
سئل فضيلة الشيخ فركوس
هل صاحب سلسل البول الدائم يلزمه الوضوء بعد الاذان وليس قبله.. ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
هذا راجع لحديث حمنة بنت جحش حين قال النبي صلى الله عليه و سلم توضئي عند كل صلاة.. وقد كانت مستحاضة... فيه من قدر وفيه من لم يقدر..
الذي قدر قال توضئي عند وقت كل صلاة.. ولا يهمّك ما يخرج منك بعد الوضوء.
ومن لم يقدر قال توضئي عند كل صلاة ولا يلزم أن يكون قد دخل الوقت، لكن إذا جاء وقت الصّلاة، تتوضأ ثم تصلّي ..
والذي يجتمع فيه القولان هو دخول الوقت.. بمعنى إذا دخل الوقت تتوضأ ثم لا يهمّ أن يخرج منها شيء ..
أنا أقول حتى نخرج من هذا، يمكن له أن يستنجي في بيته ويذهب للمسجد ويتوضأ، ولا يلزم من ذلك دخول الخلاء.. ولا يضره خروج شيء بعد ذلك لهذه العلة.. المرض. والعلم عند اللّه.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.
هل صاحب سلسل البول الدائم يلزمه الوضوء بعد الاذان وليس قبله.. ؟!
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
هذا راجع لحديث حمنة بنت جحش حين قال النبي صلى الله عليه و سلم توضئي عند كل صلاة.. وقد كانت مستحاضة... فيه من قدر وفيه من لم يقدر..
الذي قدر قال توضئي عند وقت كل صلاة.. ولا يهمّك ما يخرج منك بعد الوضوء.
ومن لم يقدر قال توضئي عند كل صلاة ولا يلزم أن يكون قد دخل الوقت، لكن إذا جاء وقت الصّلاة، تتوضأ ثم تصلّي ..
والذي يجتمع فيه القولان هو دخول الوقت.. بمعنى إذا دخل الوقت تتوضأ ثم لا يهمّ أن يخرج منها شيء ..
أنا أقول حتى نخرج من هذا، يمكن له أن يستنجي في بيته ويذهب للمسجد ويتوضأ، ولا يلزم من ذلك دخول الخلاء.. ولا يضره خروج شيء بعد ذلك لهذه العلة.. المرض. والعلم عند اللّه.
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ، فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله.
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86) : " وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية .
والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى .
واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - .
واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .
وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .
قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86) : " وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية .
والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى .
واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - .
واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .
وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .
قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .