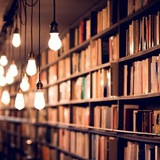التوسعة على العيال يوم عاشوراء ..!
وأما التوسعة فيه على العيال؛ فقال حربٌ: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئا.
وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة" فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه، أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته.
قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرا.
وقول حرب أن أحمد لم يره شيئا إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح إسناده.
وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء. وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال العقيلي: هو غير محفوظ. وقد روي عن عمر من قوله، وفي إسناده مجهول لا يعرف.
[لطائف المعارف (ص/103) لابن رجب]
وأما التوسعة فيه على العيال؛ فقال حربٌ: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئا.
وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة" فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه، أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته.
قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرا.
وقول حرب أن أحمد لم يره شيئا إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح إسناده.
وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء. وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال العقيلي: هو غير محفوظ. وقد روي عن عمر من قوله، وفي إسناده مجهول لا يعرف.
[لطائف المعارف (ص/103) لابن رجب]
[ عاشوراء ]
وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم.
[لطائف المعارف (ص/103) لابن رجب]
وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم.
[لطائف المعارف (ص/103) لابن رجب]
الشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه حيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا ولا من هم؟.
ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه .
والعبد لا يزال يقع في شدائد وکرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله.
وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله ﷺ: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة).
وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذُكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله.
[بيان فضل علم السلف (ص/75) لابن رجب]
ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه .
والعبد لا يزال يقع في شدائد وکرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله.
وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله ﷺ: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة).
وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذُكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله.
[بيان فضل علم السلف (ص/75) لابن رجب]
قال الله تعالى: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}
قال الحسن: إِذَا رَأَيتَ الرَّجلَ يُنافسكَ في الدُّنْيَا فنافِسْهُ في الآخرةِ.
وقال وُهَيبُ بنُ الوَرْدِ: إِن استطعتَ أَن لَا يسبقَكَ إِلَى الله أَحدٌ فافعلْ.
وقالَ محمدُ بنُ يوسف الأصبهاني العابدُ: لو أَنَّ رجلاً سَمِعَ برجلٍ أو عَرفَ رجلًا أطوعَ للَّه منهُ فَانصدعَ قلبُهُ لم يكن ذلكَ بِعجبٍ.
[مجموع الرسائل (90/1) لابن رجب]
قال الحسن: إِذَا رَأَيتَ الرَّجلَ يُنافسكَ في الدُّنْيَا فنافِسْهُ في الآخرةِ.
وقال وُهَيبُ بنُ الوَرْدِ: إِن استطعتَ أَن لَا يسبقَكَ إِلَى الله أَحدٌ فافعلْ.
وقالَ محمدُ بنُ يوسف الأصبهاني العابدُ: لو أَنَّ رجلاً سَمِعَ برجلٍ أو عَرفَ رجلًا أطوعَ للَّه منهُ فَانصدعَ قلبُهُ لم يكن ذلكَ بِعجبٍ.
[مجموع الرسائل (90/1) لابن رجب]
ويقال أيضاً لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي ولا إنسان، وما فيه إنسانية.
[مجموع الرسائل (777/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (777/2) لابن رجب]
ويكفي المُذنِب ما فاتَه في حال اشتغاله بالذُّنوب من الأعمَالِ الصالحةِ التي كان يُمكنه تحصيل الدَّرَجات بها.
[مجموع الرسائل (797/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (797/2) لابن رجب]
فإن الذنوب يتبعها ولابد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد وظلمة القلب وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة، ويفوت بها من حلاوة الطاعات وأنوار الإيمان وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف ما لا يوازي الذَّرة منه جميع لذات الدُّنْيَا، فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك وتفوته الحياة الطيبة فينعكس قصده بارتكاب المعصية.
[مجموع الرسائل (800/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (800/2) لابن رجب]
في الطاعات من اللذة والسرور والابتهاج والطمأنينة وقرة العين أمرٌ ثابتٌ بالنصوص المستفيضة وهو مشهور محسوس يدركه بالذوق والوجد من حصل له، ولا يمكن التعبير بالكلام عن حقيقته، والآثار عن السَّلف والمشايخ العارفين في هذا الباب كثيرةٌ موجودة.
[مجموع الرسائل (801/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (801/2) لابن رجب]
قال الله تعالى في أهل الطاعة: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}.
قال الحسن وغيره من السَّلف: "لنرزقنه عبادةً يجد حلاوتها في قلبه".
ومن فسرها بالقناعة= فهو صحيح أيضًا، من أنواع الحياة الطيبة الرضى بالمعيشة، فإن الرضى كما قال عبد الواحد بن زيد: "جنة الدُّنْيَا ومستراح العابدين".
[مجموع الرسائل (801/2) لابن رجب]
قال الحسن وغيره من السَّلف: "لنرزقنه عبادةً يجد حلاوتها في قلبه".
ومن فسرها بالقناعة= فهو صحيح أيضًا، من أنواع الحياة الطيبة الرضى بالمعيشة، فإن الرضى كما قال عبد الواحد بن زيد: "جنة الدُّنْيَا ومستراح العابدين".
[مجموع الرسائل (801/2) لابن رجب]
قال ابن المبارك وغيره: "مساكين أهل الدُّنْيَا خرجوا عنها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله"..
والمعاصي تقطع هذه المواد وتغلق أبواب هذه الجنة المعجلة وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب عز وجل وعن مواهبه السنية الخاصة بأهل التقوى.
[مجموع الرسائل (802/2) لابن رجب]
والمعاصي تقطع هذه المواد وتغلق أبواب هذه الجنة المعجلة وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب عز وجل وعن مواهبه السنية الخاصة بأهل التقوى.
[مجموع الرسائل (802/2) لابن رجب]
عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا) وشبك أصابعه.
هذا التشبيك من النبي ﷺ في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة، لم يكن عبثا؛ فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان، كان ذلك تشبيها بالقول، ثم أوضحه بالفعل، فشبك أصابعه بعضها في بعض؛ ليتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقوله، ويزداد بيانا وظهورا.
ويفهم من تشبيكه: أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح، وأخوة الإيمان.
وهذا كقوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر) خرجاه في الصحيحين.
وفي رواية: (المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر).
[فتح الباري (419/3) لابن رجب]
هذا التشبيك من النبي ﷺ في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة، لم يكن عبثا؛ فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان، كان ذلك تشبيها بالقول، ثم أوضحه بالفعل، فشبك أصابعه بعضها في بعض؛ ليتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقوله، ويزداد بيانا وظهورا.
ويفهم من تشبيكه: أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح، وأخوة الإيمان.
وهذا كقوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر) خرجاه في الصحيحين.
وفي رواية: (المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر).
[فتح الباري (419/3) لابن رجب]
قال بعض السّلف:
ترك دانق ممّا يكرهه الله أحبّ إليّ من خمسمائة حجّة.
كفّ الجوارح عن المحرّمات أفضل من التطوّع بالحجّ وغيره، وهو أشقّ على النفوس.
[لطائف المعارف (ص/439) لابن رجب]
ترك دانق ممّا يكرهه الله أحبّ إليّ من خمسمائة حجّة.
كفّ الجوارح عن المحرّمات أفضل من التطوّع بالحجّ وغيره، وهو أشقّ على النفوس.
[لطائف المعارف (ص/439) لابن رجب]
سلوا الله الثّبات على الطّاعات إلى الممات،
وتعوّذوا به من تقلّب القلوب،
ومن الحور بعد الكور.
ما أوحش ذلّ المعصية بعد عزّ الطّاعة!
[لطائف المعارف (ص/393) لابن رجب]
وتعوّذوا به من تقلّب القلوب،
ومن الحور بعد الكور.
ما أوحش ذلّ المعصية بعد عزّ الطّاعة!
[لطائف المعارف (ص/393) لابن رجب]
"قُلْ: آمَنْتُ باللَّهِ، ثم اسْتَقِمْ"
الاستقامة: هي سلوكُ الصِّراط المستقيم، وهو الدِّينُ القيِّم من غير تعريج عنه يَمنةً ولا يَسرةً، ويشمل ذلك فعلَ الطَّاعات كلّها، الظاهرة والباطنة، وتركَ المنهيات كُلِّها كذلك، فصارت هذه الوصيةُ جامعةً لخصال الدِّين كُلِّها.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/475) لابن رجب]
الاستقامة: هي سلوكُ الصِّراط المستقيم، وهو الدِّينُ القيِّم من غير تعريج عنه يَمنةً ولا يَسرةً، ويشمل ذلك فعلَ الطَّاعات كلّها، الظاهرة والباطنة، وتركَ المنهيات كُلِّها كذلك، فصارت هذه الوصيةُ جامعةً لخصال الدِّين كُلِّها.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/475) لابن رجب]
{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا}
الذين قالوا: ربنا الله كثير، ولكن أهل الاستقامة قليل.
[مجموع الرسائل (339/1) لابن رجب]
الذين قالوا: ربنا الله كثير، ولكن أهل الاستقامة قليل.
[مجموع الرسائل (339/1) لابن رجب]
وحاصل الأمر ما قاله قتادة وغيره من السَّلف: "إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إِلَيْهِ، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم".
[مجموع الرسائل (803/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (803/2) لابن رجب]
ما أمر الله به عباده فهو من عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم؛ فإن نفس الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله وخشيته وذكره وشكره هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامها، فلا صلاح للنفوس ولا قرة للعيون ولا طمأنينة ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها في الدُّنْيَا عَلَى الحقيقة إلا بذلك، فحاجتها إِلَى ذلك أعظم من حاجة الأبدان إِلَى الطعام والشراب والنفس بكثير، فإنَّه حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحق الَّذِي لا إله إلا هو، ومتى فقد ذلك هلك وفسد ولم يصلحه بعد ذلك شيء البتة، وكذلك ما حرمه الله عَلَى عباده هو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم، ولهذا حرَّم عليهم ما يصدهم عن ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر وبين أنَّه يصد عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهما، وكذلك سائر ما حرَّمه الله فإنَّه مضرة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم.
[مجموع الرسائل (803/2) لابن رجب]
[مجموع الرسائل (803/2) لابن رجب]
روى الثوري، عن أبي حيان التيمي سعيد بن حيان، عن رجل قال: كان يقال: العُلَمَاء ثلاثة: فعالمٌ بالله ليس عالماً بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله، وعالمٌ بالله عَالِمٌ بأمر الله.
فالعالم بالله وبأوامر الله: الَّذِي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالمٍ بأمر الله: الَّذِي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالمٍ بالله: الَّذِي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل.
[مجموع الرسائل (808/2) لابن رجب]
فالعالم بالله وبأوامر الله: الَّذِي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالمٍ بأمر الله: الَّذِي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالمٍ بالله: الَّذِي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل.
[مجموع الرسائل (808/2) لابن رجب]
«واعلم أنَّ في الصَّبر على ما تكره خيراً كثيراً»
يعني: أنَّ ما أصاب العبدَ مِنَ المصائب المؤلمةِ المكتوبة عليه إذا صبر عليها، كان له في الصبر خيرٌ كثير..
والتقدير الماضي يُعين العبد على أنْ ترضى نفسُه بما أصابه، فمن استطاع أنْ يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإنْ لم يستطع الرِّضا، فإنَّ في الصَّبر على المكروه خيراً كثيراً.
فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب:
إحداهما: أنْ يرضى بذلك، وهذه درجةٌ عاليةٌ رفيعة جداً، قال الله عز وجل: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}.
قال علقمة: هي المصيبة تصيبُ الرَّجلَ، فيعلم أنَّها من عند الله، فيسلِّمُ لها ويرضى..
وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنَّه غير متَّهم في قضائه، وتارةً يُلاحظون ثوابَ الرِّضا بالقضاء، فيُنسيهم ألم المقتضي به، وتارةً يُلاحظون عظمةَ المبتلي وجلالَه وكمالَه، فيستغرقون في مشاهدة ذلك، حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصلُ إليه خواصُّ أهل المعرفة والمحبَّةِ..
والدرجة الثانية: أنْ يصبرَ على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرِّضا بالقضاء فالرِّضا فضلٌ مندوبٌ إليه مستحب، والصبرُ واجبٌ على المؤمن حتمٌ، وفي الصَّبر خيرٌ كثيرٌ، فإنَّ الله أمرَ به، ووعدَ عليه جزيلَ الأجر. قال الله عز وجل: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}، وقال: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}..
والفرق بين الرضا والصبر:
أنَّ الصَّبر: كفُّ النَّفس وحبسُها عن التسخط مع وجود الألم، وتمنِّي زوال ذلك، وكفُّ الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع.
والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمنِّي زوال ذلك المؤلم، وإنْ وجدَ الإحساسُ بالألم، لكن الرضا يخفِّفُه لما يباشر القلبَ من رَوح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرِّضا، فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/454) لابن رجب]
يعني: أنَّ ما أصاب العبدَ مِنَ المصائب المؤلمةِ المكتوبة عليه إذا صبر عليها، كان له في الصبر خيرٌ كثير..
والتقدير الماضي يُعين العبد على أنْ ترضى نفسُه بما أصابه، فمن استطاع أنْ يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإنْ لم يستطع الرِّضا، فإنَّ في الصَّبر على المكروه خيراً كثيراً.
فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب:
إحداهما: أنْ يرضى بذلك، وهذه درجةٌ عاليةٌ رفيعة جداً، قال الله عز وجل: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}.
قال علقمة: هي المصيبة تصيبُ الرَّجلَ، فيعلم أنَّها من عند الله، فيسلِّمُ لها ويرضى..
وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنَّه غير متَّهم في قضائه، وتارةً يُلاحظون ثوابَ الرِّضا بالقضاء، فيُنسيهم ألم المقتضي به، وتارةً يُلاحظون عظمةَ المبتلي وجلالَه وكمالَه، فيستغرقون في مشاهدة ذلك، حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصلُ إليه خواصُّ أهل المعرفة والمحبَّةِ..
والدرجة الثانية: أنْ يصبرَ على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرِّضا بالقضاء فالرِّضا فضلٌ مندوبٌ إليه مستحب، والصبرُ واجبٌ على المؤمن حتمٌ، وفي الصَّبر خيرٌ كثيرٌ، فإنَّ الله أمرَ به، ووعدَ عليه جزيلَ الأجر. قال الله عز وجل: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}، وقال: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}..
والفرق بين الرضا والصبر:
أنَّ الصَّبر: كفُّ النَّفس وحبسُها عن التسخط مع وجود الألم، وتمنِّي زوال ذلك، وكفُّ الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع.
والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمنِّي زوال ذلك المؤلم، وإنْ وجدَ الإحساسُ بالألم، لكن الرضا يخفِّفُه لما يباشر القلبَ من رَوح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرِّضا، فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية.
[جامع العلوم والحِكَم (ص/454) لابن رجب]