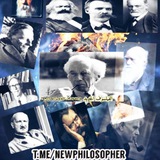Forwarded from ألبير كامو Albert Camus
يتمثل دور مارت كحلقة الوصل بين شخصيتين حيث تعترفُ لميرسو بأنَّها كانت عشيقة لزغرو من هنا تتحول جملة من المسائل الحياتية والوجودية مثل السعادة والحياة والموت والانتحار إلى ثيمات أساسية في الرواية.
ضرورة الاندماج في الحياة ارادة السعادة
ينطلق كامو من مفهوم جديد لشرح العلاقة القائمة بين الإنسان والحياة. ويورد ذكر مفهوم إرادة السعادة على لسان شخصية زغرو حيث يتنبى الكاتب تقنية الحوار المطول لعرض رأيين متقابلين. الأول يمثله زغرو الذي صار كسيحا وملازما للفراش واضعا مسدساً؛ لأن الانتحار بالنسبة إليه أحد خياراته. والثاني هو ما يعبر عنه مرسو بسلوكياته العبثية. إذ يتفهم المتلقي بأنَّ زغرو شخصية واقعية ولا يعيش في أوهام كما لا ينكر دور المال في توفير حياة سعيدة للإنسان لكن لا يجد علاقة سببية بين الحالتين امتلاك المال والسعادة. ويعتقدُ بأن العنصر الأساسي في معادلة السعادة هو اكتساب الوقت. ويجب أن يخدم المال أيضا هذا التوجه.
زيادة على ذلك يصرح زغرو بأنه لا يريد اختصار حياتهِ ولو حرم من البصر ويديه أيضاً وهذا لا يمنعه من التفكير بالانتحار كأن الحياة والموت متجاوران. وتتخلص فلسفة زغرو للحياة في ثلاث كلمات العمل والألم والحب. هذه الأفكار تأتي متسقة مع ما يسرده الراوي عن انطباع ميرسو لشخصية زغرو إذ يجده محاطاً بالكتب فهو لا يتكلم إلا بعد التفكير، أيضاً تعطي مارت تصوراً عن عشيقها السابق تصف إياه بالمرح والقارىء.
وينتهي اللقاء المغلف بغلالة فكرية وفلسفية بين الاثنين ومن ثُم يعود بنا الراوي إلى شقة مرسو حيثُ يأخذ البراميلي باهتمام السارد إذ يصف الأخير بأنّه أصم ونصف أخرس تتركه أُخته وحيدًا عندما يعارض وجود صديقها في الشقة. ومن جديد ينصرف الراوي إلى مرسو وينقلُ خبر قتله لزغرو، ومن هنا تتخذ الأحداث منحى جديداً كما تتغير البنية المكانية حيث ينتقل مرسو إلى براغ. غير أن مرسو لا يتخلى عن سلوكه العبثي. بل يصوره الراوي في أشد حالاته عدميةً. وما يشعر به هو الحنين إلى مدن مليئة بالشمس والنساء. لذلك يعود إلى الجزائر إذ يبدأُ فصلا جديدا من حياة مرسو. وهو يستعيد مضامين كلام زغرو عن إرادة السعادة.
2
ضرورة الاندماج في الحياة ارادة السعادة
ينطلق كامو من مفهوم جديد لشرح العلاقة القائمة بين الإنسان والحياة. ويورد ذكر مفهوم إرادة السعادة على لسان شخصية زغرو حيث يتنبى الكاتب تقنية الحوار المطول لعرض رأيين متقابلين. الأول يمثله زغرو الذي صار كسيحا وملازما للفراش واضعا مسدساً؛ لأن الانتحار بالنسبة إليه أحد خياراته. والثاني هو ما يعبر عنه مرسو بسلوكياته العبثية. إذ يتفهم المتلقي بأنَّ زغرو شخصية واقعية ولا يعيش في أوهام كما لا ينكر دور المال في توفير حياة سعيدة للإنسان لكن لا يجد علاقة سببية بين الحالتين امتلاك المال والسعادة. ويعتقدُ بأن العنصر الأساسي في معادلة السعادة هو اكتساب الوقت. ويجب أن يخدم المال أيضا هذا التوجه.
زيادة على ذلك يصرح زغرو بأنه لا يريد اختصار حياتهِ ولو حرم من البصر ويديه أيضاً وهذا لا يمنعه من التفكير بالانتحار كأن الحياة والموت متجاوران. وتتخلص فلسفة زغرو للحياة في ثلاث كلمات العمل والألم والحب. هذه الأفكار تأتي متسقة مع ما يسرده الراوي عن انطباع ميرسو لشخصية زغرو إذ يجده محاطاً بالكتب فهو لا يتكلم إلا بعد التفكير، أيضاً تعطي مارت تصوراً عن عشيقها السابق تصف إياه بالمرح والقارىء.
وينتهي اللقاء المغلف بغلالة فكرية وفلسفية بين الاثنين ومن ثُم يعود بنا الراوي إلى شقة مرسو حيثُ يأخذ البراميلي باهتمام السارد إذ يصف الأخير بأنّه أصم ونصف أخرس تتركه أُخته وحيدًا عندما يعارض وجود صديقها في الشقة. ومن جديد ينصرف الراوي إلى مرسو وينقلُ خبر قتله لزغرو، ومن هنا تتخذ الأحداث منحى جديداً كما تتغير البنية المكانية حيث ينتقل مرسو إلى براغ. غير أن مرسو لا يتخلى عن سلوكه العبثي. بل يصوره الراوي في أشد حالاته عدميةً. وما يشعر به هو الحنين إلى مدن مليئة بالشمس والنساء. لذلك يعود إلى الجزائر إذ يبدأُ فصلا جديدا من حياة مرسو. وهو يستعيد مضامين كلام زغرو عن إرادة السعادة.
2
Forwarded from ألبير كامو Albert Camus
الموت في الصومعة
بعد عودته إلى الجزائر يؤثث لحياة خاصة به ويختار منزله في الطبيعة بين الأشجار تشاركه في «البيت أمام العالم» مجموعة من صديقاته لكن لا تطول إقامته في هذا المكان، بل يتجه إلى قرية في الضواحي ويصبح وحيداً. وهو عندما يصاب بالمرض يتصور بأن الحياة لا تتغير بغيابه، كما أن لوسيان حبيبته ستكون مصممة على التمتع بأيامها بل تُعطي حنانها ومشاعرها الدافئة لشخص آخر. لا تنظم حبكة متماسكة بناء هذا العمل الروائي حتى الجريمة التي يرتكبها مرسو لا يتحول إلى خيط يجمع أجزاء الرواية. ولعلك تجد تفسير ذلك الأمر في الموضوع الذي تدور عليه الرواية إذ تهيمن أسئلة وجودية على مساحة هذا العمل. فالرسالة التي أراد الكاتب أن يوصلها هي أن الموت لا يبرر الهروب من الحياة، فبذلك يخالف كامو، أفلاطون، فالأخير يقول إن الحياة تأمل في الموت بينما الحياة لدى بطل كامو هي بحث عن السعادة في اليقظات الصباحية حتى لو تكرر هذا البحث بصورته السيزيفية فعليك أن لا تتوقف... هذا ما تفهمه من رواية "الموت السعيد".
3
بعد عودته إلى الجزائر يؤثث لحياة خاصة به ويختار منزله في الطبيعة بين الأشجار تشاركه في «البيت أمام العالم» مجموعة من صديقاته لكن لا تطول إقامته في هذا المكان، بل يتجه إلى قرية في الضواحي ويصبح وحيداً. وهو عندما يصاب بالمرض يتصور بأن الحياة لا تتغير بغيابه، كما أن لوسيان حبيبته ستكون مصممة على التمتع بأيامها بل تُعطي حنانها ومشاعرها الدافئة لشخص آخر. لا تنظم حبكة متماسكة بناء هذا العمل الروائي حتى الجريمة التي يرتكبها مرسو لا يتحول إلى خيط يجمع أجزاء الرواية. ولعلك تجد تفسير ذلك الأمر في الموضوع الذي تدور عليه الرواية إذ تهيمن أسئلة وجودية على مساحة هذا العمل. فالرسالة التي أراد الكاتب أن يوصلها هي أن الموت لا يبرر الهروب من الحياة، فبذلك يخالف كامو، أفلاطون، فالأخير يقول إن الحياة تأمل في الموت بينما الحياة لدى بطل كامو هي بحث عن السعادة في اليقظات الصباحية حتى لو تكرر هذا البحث بصورته السيزيفية فعليك أن لا تتوقف... هذا ما تفهمه من رواية "الموت السعيد".
3
لمحات من الفلسفة اليابانية القديمة
حارث زهير الحكاك
الشعب الياباني، كأي شعب عريق، يتمتع بخلفية حضارية كبيرة، من أهم ركائزها فلسفة خاصة بهم أطلق عليها حكمائهم الأقدمون أسم ( الزن) . وهي تمثل عندهم نوع من الإرتباط الروحي مع معطيات المحيط، ويتضمن هذا الأرتباط عدد من الأسس والتعليمات والتدريب الذهني والعملي على ممارستها في مواجهة الألغاز الذهنية التي تواجههم والمطبات التفكيرية وعواقبها، وكيفية تبسيط حلولها بأعتبارها متوارثة من الذهن نفسه. إن تبادل الآراء في هذا الإرتباط الروحي بين الطالب والأستاذ يكون عادة مليء بمكامن كثيرة ذات أعماق تفكيرية لا نستطيع نحن العرب أو الغربيون تصوره بالأخص فيما يتعلق بالخداع البراق في الروح أو فكرة أنت صاحب الذهن. لفد ثمن فلاسفة العالم مثل الفيلسوف الأمريكي- البريطاني آلن واتس بعض مفردات الفلسفة اليابانية القديمة، وقيموا فيها الكثير خصوصا فيما يتعلق بأهمية الهدوء والسكون والإنتظار لأختراق حاجز النفس الأدائي، وترتيب أحاسيس أصل الخوف والقلق، وأستقبال وأستخدام تفريغ الذهن الآني لطرد وتطهير أعمق الأخاديد العقلية.
إن فهم (الزن) يُزهر معنى كلمة (الآن) والإحساس بالزمن العفيف لمن يفطنه على كونه بما تعرفه كحدث إرادي يزمن الحياة ولا يوقتها. ولقد أطلق اليابانيون على هذا أسم الحس القطبي، وهذا مطلوب للإستفادة على الأقل من ما يحتضنه أوائل المصدقين بالأمور المرتبطة بتدوين أحتفال الوجود. وهو في هذه الحالة ولادة أي مخلوق، وهي طبعا تحدث هنا وهناك، على شكل أرتباطا متداولا بين الناس ونضوجا نابعا ومنظورا من نفسه. فالفلسفة اليابانية تقول أن أي فرد يستطيع أن يحس أن الكون يولد وينضج تعريفيا في كل وقت، الآن ودائما وفي كل أعصابه وأحاسيسه لأنها في ذلك، للحظة ما، متوازنة وبطريقة غير حسابية.
تعود بعض جوانب الفلسفة اليابانية إلى التعاليم البوذية، خصوصا فيما يتعلق بالإلحاح في تقييم حاجات الإنسان في الحياة، وما يصاحب هذا الإلحاح من قلق الإنسان بمبدأ الحاجة التي هي أصلا من أستنباط العقل نفسه. وهنا يجب القول أنه على الناس أن يعلموا بأن هذه الطريقة الفذة من الإحساس العميق في النفس، قد ولدت في شعوب معينة لأنها كانت مطلوبة في هيكلة مجتمعاتهما وبعيدة عن الطريق المستخدم في الغرب للتعرف على جوانب الحياة، وطبعا يكون هذا المنظور بعين الإنسان الساكن في الغرب
فاليابانيون يمررون إلى أطفالهم وأجيالهم قصصا فيها الكثير من الحكمة والفلسفة اليابانية من أجل تدريبهم على فهم الحياة ولتنسيقها وعادة ما تكون بإطار مسلي أما مكتوبة أو مسموعة، وتكون أصلا نابعة من الأديان القديمة وتأثيرها في تسوية تراكيب ومفاهيم مجتمعات الإنسان، ومبنية في نفس الوقت على نوع خاص من التصور للإنسان الذي يعيش في مجتمعات الغرب والشرق الأوسط، خصوصا في بعض السلوكيات التي يقوم بها ذلك الإنسان في الحياة بسبب بعض الأمور والحوادث الموقظة للفراغ الذهني مثل المرض والقلق النفسي والكآبة وقلة النوم. وبما أن الفرد في مثل هذا النوع من الإجماع الشعبي لا يملك قابلية التصور لماهية المرض، فقد أنعكس هذا فيما نتخيل على أحترام كبير لقوة الحياة وكيفية التعامل بين الناس. أدناه أربع قصص طريفة مليئة بالحكمة يحكيها اليابانيون لأطفالهم :-
الحكاية الأولى: كان رجلان يمشيان على ضفة نهر هدير سريع ألجريان فرأيا رجلا آخر متعلقا بغصن من شجرة مطلة على النهر، بعد قليل أنكسر الغصن وسقط الرجل في الماء وراح يتقلب بين التيار السريع وأمواجه المتلاطمة إلى أن تمكن من التعلق بإحدى الصخور البارزة وتسلق عليها، فذهب إليه الرجلان وسأله أحدهما :- ماذا دهاك يا رجل، ألم تكن خائفا من هذه المجازفة. فأجابه الرجل وكان من هيئته وملابسه طالبا في أحد المعابد اليابانية القريبة:- كلا لم أكن خائفا، لأن النهر وأنا غير مفصولين كما يقال، والذي حدث كان مداعبة بيني وبينه بإنشداد تفكيري زائدا بعض الشيء، فعلاقتي معه علاقة أبدية مبنية على الإحترام المتبادل والإقتناع بأهمية كل واحد منا لهذه الطبيعة الخلابة. وهكذا يا صغار يكون أحترام الطبيعة بحسناتها وسيئاتها من أحترامنا لأنفسنا، لأننا جزءا منها.
1
حارث زهير الحكاك
الشعب الياباني، كأي شعب عريق، يتمتع بخلفية حضارية كبيرة، من أهم ركائزها فلسفة خاصة بهم أطلق عليها حكمائهم الأقدمون أسم ( الزن) . وهي تمثل عندهم نوع من الإرتباط الروحي مع معطيات المحيط، ويتضمن هذا الأرتباط عدد من الأسس والتعليمات والتدريب الذهني والعملي على ممارستها في مواجهة الألغاز الذهنية التي تواجههم والمطبات التفكيرية وعواقبها، وكيفية تبسيط حلولها بأعتبارها متوارثة من الذهن نفسه. إن تبادل الآراء في هذا الإرتباط الروحي بين الطالب والأستاذ يكون عادة مليء بمكامن كثيرة ذات أعماق تفكيرية لا نستطيع نحن العرب أو الغربيون تصوره بالأخص فيما يتعلق بالخداع البراق في الروح أو فكرة أنت صاحب الذهن. لفد ثمن فلاسفة العالم مثل الفيلسوف الأمريكي- البريطاني آلن واتس بعض مفردات الفلسفة اليابانية القديمة، وقيموا فيها الكثير خصوصا فيما يتعلق بأهمية الهدوء والسكون والإنتظار لأختراق حاجز النفس الأدائي، وترتيب أحاسيس أصل الخوف والقلق، وأستقبال وأستخدام تفريغ الذهن الآني لطرد وتطهير أعمق الأخاديد العقلية.
إن فهم (الزن) يُزهر معنى كلمة (الآن) والإحساس بالزمن العفيف لمن يفطنه على كونه بما تعرفه كحدث إرادي يزمن الحياة ولا يوقتها. ولقد أطلق اليابانيون على هذا أسم الحس القطبي، وهذا مطلوب للإستفادة على الأقل من ما يحتضنه أوائل المصدقين بالأمور المرتبطة بتدوين أحتفال الوجود. وهو في هذه الحالة ولادة أي مخلوق، وهي طبعا تحدث هنا وهناك، على شكل أرتباطا متداولا بين الناس ونضوجا نابعا ومنظورا من نفسه. فالفلسفة اليابانية تقول أن أي فرد يستطيع أن يحس أن الكون يولد وينضج تعريفيا في كل وقت، الآن ودائما وفي كل أعصابه وأحاسيسه لأنها في ذلك، للحظة ما، متوازنة وبطريقة غير حسابية.
تعود بعض جوانب الفلسفة اليابانية إلى التعاليم البوذية، خصوصا فيما يتعلق بالإلحاح في تقييم حاجات الإنسان في الحياة، وما يصاحب هذا الإلحاح من قلق الإنسان بمبدأ الحاجة التي هي أصلا من أستنباط العقل نفسه. وهنا يجب القول أنه على الناس أن يعلموا بأن هذه الطريقة الفذة من الإحساس العميق في النفس، قد ولدت في شعوب معينة لأنها كانت مطلوبة في هيكلة مجتمعاتهما وبعيدة عن الطريق المستخدم في الغرب للتعرف على جوانب الحياة، وطبعا يكون هذا المنظور بعين الإنسان الساكن في الغرب
فاليابانيون يمررون إلى أطفالهم وأجيالهم قصصا فيها الكثير من الحكمة والفلسفة اليابانية من أجل تدريبهم على فهم الحياة ولتنسيقها وعادة ما تكون بإطار مسلي أما مكتوبة أو مسموعة، وتكون أصلا نابعة من الأديان القديمة وتأثيرها في تسوية تراكيب ومفاهيم مجتمعات الإنسان، ومبنية في نفس الوقت على نوع خاص من التصور للإنسان الذي يعيش في مجتمعات الغرب والشرق الأوسط، خصوصا في بعض السلوكيات التي يقوم بها ذلك الإنسان في الحياة بسبب بعض الأمور والحوادث الموقظة للفراغ الذهني مثل المرض والقلق النفسي والكآبة وقلة النوم. وبما أن الفرد في مثل هذا النوع من الإجماع الشعبي لا يملك قابلية التصور لماهية المرض، فقد أنعكس هذا فيما نتخيل على أحترام كبير لقوة الحياة وكيفية التعامل بين الناس. أدناه أربع قصص طريفة مليئة بالحكمة يحكيها اليابانيون لأطفالهم :-
الحكاية الأولى: كان رجلان يمشيان على ضفة نهر هدير سريع ألجريان فرأيا رجلا آخر متعلقا بغصن من شجرة مطلة على النهر، بعد قليل أنكسر الغصن وسقط الرجل في الماء وراح يتقلب بين التيار السريع وأمواجه المتلاطمة إلى أن تمكن من التعلق بإحدى الصخور البارزة وتسلق عليها، فذهب إليه الرجلان وسأله أحدهما :- ماذا دهاك يا رجل، ألم تكن خائفا من هذه المجازفة. فأجابه الرجل وكان من هيئته وملابسه طالبا في أحد المعابد اليابانية القريبة:- كلا لم أكن خائفا، لأن النهر وأنا غير مفصولين كما يقال، والذي حدث كان مداعبة بيني وبينه بإنشداد تفكيري زائدا بعض الشيء، فعلاقتي معه علاقة أبدية مبنية على الإحترام المتبادل والإقتناع بأهمية كل واحد منا لهذه الطبيعة الخلابة. وهكذا يا صغار يكون أحترام الطبيعة بحسناتها وسيئاتها من أحترامنا لأنفسنا، لأننا جزءا منها.
1
👍1
الحكاية الثانية: كان لرجل في واحدة من القرى فرسا جميلة ذات شهرة في قريته وفي القرى المجاورة، وكان يداريها ويرعاها ويعطيها العلف الجيد والمسكن النظيف الأمين لأنه كان يخاف عليها. في إحدى المغربيات قفزت الفرس من فوق سور المزرعة وأنطلقت هاربة ولم تعد. فأجتمع سكان القرية عنده ليواسوه على ضياع فرسه وسألوه إن كان يشعر بالأسى والحزن عليها، فأجابهم: (ربما) وسكت. بعد أيام عادت الفرس ومعها عدد من الخيول البرية. فأجتمع أهل القرية عنده بعدما أنتشر هذا الخبر ليهنئوه على عودة فرسه وما جلبت معها، وسألوه إن كان يشعر بالسعادة بهذا الحظ الكبير، فأجابهم : (ربما) وسكت. بعد يومين قرر أبن هذا الرجل أن يدرب أحد الخيول البرية التي جاءت مع الفرس، فسقط من عليه وأنكسرت ساقه، فأجتمعت القرية عنده لمواساته وسألوه إن كان هذا الحادث سيولد عنده شعور بالألم، فأجابهم: (ربما) وسكت. بعد عدة أيام جاء إلى القرية عدد من ضباط الجيش لتجنيد شباب القرية، فأخذوا كل الشباب وتركوا أبن الرجل بسبب كسر رجله، فسألوه أهل القرية هل هذا سيولد عنده بعض الشعور والإحساس بالراحة والطمأنينة والسكينة؟، فأجابهم: (ربما) وسكت. وهكذا يا صغار لا يعلم أحدكم ما هو جيد له في أي حال، لأن أي فرد هو بذاته ليس سيء أو جيد من نظرة الإنسان المتأمل الصريح، أو غير المصدق بوجود نوع واحد من الشعور بالنفس.
الحكاية الثالثة: في زمن ما عرض تنفيذ أحد المشاريع المعمارية للتنافس بين المقاولين، ففاز به أحدهم. كان من ضمن المشروع بناء صالة كبيرة ذات ثمانية أضلاع، يرتكز سقفها على ثمانية أعمدة حديدية بطول 5 أمتار، واحد في كل زاوية من زوايا الصالة ، وعمود حديدي أسمك من الباقين وبطول 8 أمتار في الوسط ليحمل السقف. بأنتهاء بناء الجدران والأعمدة الثمانية، جاء العمال ليلا ليخبروا المعمار بأن منافسه الذي خسر العقد قد جاء ومعه عدد من العمال وقطعوا قطعة مقدارها 2 متر من العمود الأوسط، وأتلفوه. ولا يدرون بماذا سيعملون غدا صباحا. فأجابهم المقاول تعالوا غدا حسب الموعد ولا تبالوا بشيء. في الصباح أمرهم المقاول بتثبيت العمود في مكانه، ولما فعلوا ذلك وجدوه مطابقا تماما للثمانية أمتار المطلوبة، ففرحوا وأستفسروا هل كانوا على خطأ في ظنهم ،فأجابهم المقاول كلا، ولكنني توقعت أن يقوم ذلك المقاول بقطع 2 متر من العمود وعليه كنت أنا قد طلبت العمود من الشركة المصنعة له أن يكون بطول 10 أمتار، فتم البناء حسب ما هو مطلوب وفي الوقت المحدد له في العقد. من هذا أيها الصغار نتعلم أهمية التفاني في العمل وأحترام الإتفاقات التي تعقد بين الناس، ولا نكترث لمن يريد إعاقة نفوسنا عن الشعور بالسعادة والرضا.
الحكاية الرابعة. جاء إلى أحد الحكماء إثنان من أحسن صانعي السيوف اليابانية، ليحتكما عنده عن صناعتهما، ومن الذي يصنع أمضى وأحسن سيف. فأخذهما إلى نهير صغير ولكنه جاري بسرعة. فاخذ أول سيف وغرز مقدمته بالطين وجعل حافته الحادة معاكسة لتيار الماء، ثم ابتعد خطوة عنه ووضع على سطح الماء قطعة من الورق طافية على الماء الذي أخذها بسرعة ,وضربها بحافة السيف فأنقطعت إلى قطعتين. ثم أخذ السيف الثاني وأعاد الكرة عليه، ولكن هذه المرة أخذ تيار الماء الورقة وأبتعد بها عن حافة السيف وبقيت سليمة. فقال لهما الحكيم أرأيتم ما حدث ؟ أن الغاية تبطل الوسيلة، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث بالمستقبل، وعليكما أن تجودا بعملكما لإراحة النفس والضمير وليس للأعتزاز بكلمة (الأنا).
2
الفيلسوف الجديد
الحكاية الثالثة: في زمن ما عرض تنفيذ أحد المشاريع المعمارية للتنافس بين المقاولين، ففاز به أحدهم. كان من ضمن المشروع بناء صالة كبيرة ذات ثمانية أضلاع، يرتكز سقفها على ثمانية أعمدة حديدية بطول 5 أمتار، واحد في كل زاوية من زوايا الصالة ، وعمود حديدي أسمك من الباقين وبطول 8 أمتار في الوسط ليحمل السقف. بأنتهاء بناء الجدران والأعمدة الثمانية، جاء العمال ليلا ليخبروا المعمار بأن منافسه الذي خسر العقد قد جاء ومعه عدد من العمال وقطعوا قطعة مقدارها 2 متر من العمود الأوسط، وأتلفوه. ولا يدرون بماذا سيعملون غدا صباحا. فأجابهم المقاول تعالوا غدا حسب الموعد ولا تبالوا بشيء. في الصباح أمرهم المقاول بتثبيت العمود في مكانه، ولما فعلوا ذلك وجدوه مطابقا تماما للثمانية أمتار المطلوبة، ففرحوا وأستفسروا هل كانوا على خطأ في ظنهم ،فأجابهم المقاول كلا، ولكنني توقعت أن يقوم ذلك المقاول بقطع 2 متر من العمود وعليه كنت أنا قد طلبت العمود من الشركة المصنعة له أن يكون بطول 10 أمتار، فتم البناء حسب ما هو مطلوب وفي الوقت المحدد له في العقد. من هذا أيها الصغار نتعلم أهمية التفاني في العمل وأحترام الإتفاقات التي تعقد بين الناس، ولا نكترث لمن يريد إعاقة نفوسنا عن الشعور بالسعادة والرضا.
الحكاية الرابعة. جاء إلى أحد الحكماء إثنان من أحسن صانعي السيوف اليابانية، ليحتكما عنده عن صناعتهما، ومن الذي يصنع أمضى وأحسن سيف. فأخذهما إلى نهير صغير ولكنه جاري بسرعة. فاخذ أول سيف وغرز مقدمته بالطين وجعل حافته الحادة معاكسة لتيار الماء، ثم ابتعد خطوة عنه ووضع على سطح الماء قطعة من الورق طافية على الماء الذي أخذها بسرعة ,وضربها بحافة السيف فأنقطعت إلى قطعتين. ثم أخذ السيف الثاني وأعاد الكرة عليه، ولكن هذه المرة أخذ تيار الماء الورقة وأبتعد بها عن حافة السيف وبقيت سليمة. فقال لهما الحكيم أرأيتم ما حدث ؟ أن الغاية تبطل الوسيلة، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث بالمستقبل، وعليكما أن تجودا بعملكما لإراحة النفس والضمير وليس للأعتزاز بكلمة (الأنا).
2
الفيلسوف الجديد
👍1
العدميــة بيــن المعــري وشـــوبنهاور فكــرة خــلاص
د. عماد الدين الجبوري
عندما اتخذ مؤسس الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت مبدأ الشك لليقين، كان الإمام الفيلسوف أبو حامد الغزالي قد سبقه فى ذلك بعدة قرون، وكذلك كانت أسبقية ابن خلدون على كارل ماركس فى علم الاجتماع. وإذا كان دانتي قد اقتبس فكرة “الكوميديا الإلهية” من كتاب المعري “رسالة الغفران” بعد ترجمتها إلى اللغة اللاتينية، فإن الأخير كان أيضاً سباقاً بطرح “العدمية” قبل شوبنهاور والفلسفة الوجودية عموماً وبزمن بعيد.
ولقد فضلنا المقارنة هنا بين أبي العلاء المعري “973-1057” والفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور “1788-1860”، دون سارتر وغيره، لأن القاسم المشترك فيما بينهما هو التشاؤم من جهة. وتقارب نوع ما للوضع الفردي حياتياً من جهة أخرى. وسوف نعتمد بشكل عام على ديوان “اللزوميات”، وعلى كتاب “العالم كإرادة وفكرة” الترجمة الإنكليزية. وقبل أن نحلل العدمية بين هذين الكبيرين، علينا أن نعلم بأن تشاؤمية المعري كانت أسبابها: أنه فقد بصره بعدما أُصابه الجدري وهو في سن الرابعة من عمره.
وقطع دراسته فى كبرى مكتبات طرابلس الشام بعد وفاة أبيه المفاجئ ، وكذلك ترك دراسته فى بغداد عندما سمع بمرض أمه، ثم خبر وفاتها وهو في طريق العودة إليها. علاوة على الاضطراب السياسي والحزبي بين الحمدانيين والفاطميين، والنزاعات الحربية مع الروم البيزنطيين. أما بالنسبة إلى شوبنهاور فإن أباه قد مات منتحراً عام 1805، وسلوكية أمه معه لم تكن بالموقع الحسن، حيث كانت من أروع من نبغ فى عصرها بكتابة القصة، وترفض أن يعلو شأنها الأدبي أى شخص حتى لو كان وحيدها آرثر.
فكانت تقسو عليه وتجافيه، خصوصاً بعدما أخبرها الشاعر الكبير غوته بعظمة عقلية ابنها في المستقبل. فضلاً على ذلك سلسلة الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية التى كانت تسود أوربا على مدى عقدين من الزمن.
وهكذا طغت الصفة التشاؤمية على عقلية وتفكير المعري وشوبنهاور، إذ جمعتهما حالة متقاربة الشبه رغم الفارق بين ظرفي الزمان والمكان والوضع العائلي والتناحر السياسي ورحى الحروب الطاحنة.
لذا أمسيا ينظران إلى العالم والطبيعة والمجتمع والفرد من زاوية كالحة لا تطاق. ما الخير والسعادة عندهما إلا أمور سلبية سرعان ما تأتي سرعان ما تزول، لأن الحياة ملؤها التعب ليس فيها سكينة طوال الامتداد الزمني، والوجود كله شر. وفي هذا يقول المعري:
ألا إنما الدنيا نحوسٍ لأهلها
فما من زمانٍ أنتَ فيه سعيد
أو
نزول كما زال آباؤنا
ويبقى الزمان على ما ترى ...
ويرى شوبنهاور بأن في “كل فرد حوض من الألم لا محيص عنه”، وحتى إذا فرضنا جدلاً بأن هذا الألم له نهاية، فإنه سوف “يحل مكانه على الفور عناء آخراً” وليس لدينا من ذلك لا مفر ولا محيص.
إذن فإن القاعدة الحقيقية للبشرية جمعاء داخل هذا العالم هو الألم المستديم، وإذا تساءلنا علام كل هذا التشاؤم الدامس؟ يأتينا الجواب من المعري:
فى العدمِ كنا وَحُكمُ الله أوجدنا
ثم اتفقنا على ثانٍ من العدمِ
أو
-نمرُ سراعاً بين عدمينِ مالنا
لباثُ كإنا عابرون على جسرِ
1
د. عماد الدين الجبوري
عندما اتخذ مؤسس الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت مبدأ الشك لليقين، كان الإمام الفيلسوف أبو حامد الغزالي قد سبقه فى ذلك بعدة قرون، وكذلك كانت أسبقية ابن خلدون على كارل ماركس فى علم الاجتماع. وإذا كان دانتي قد اقتبس فكرة “الكوميديا الإلهية” من كتاب المعري “رسالة الغفران” بعد ترجمتها إلى اللغة اللاتينية، فإن الأخير كان أيضاً سباقاً بطرح “العدمية” قبل شوبنهاور والفلسفة الوجودية عموماً وبزمن بعيد.
ولقد فضلنا المقارنة هنا بين أبي العلاء المعري “973-1057” والفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور “1788-1860”، دون سارتر وغيره، لأن القاسم المشترك فيما بينهما هو التشاؤم من جهة. وتقارب نوع ما للوضع الفردي حياتياً من جهة أخرى. وسوف نعتمد بشكل عام على ديوان “اللزوميات”، وعلى كتاب “العالم كإرادة وفكرة” الترجمة الإنكليزية. وقبل أن نحلل العدمية بين هذين الكبيرين، علينا أن نعلم بأن تشاؤمية المعري كانت أسبابها: أنه فقد بصره بعدما أُصابه الجدري وهو في سن الرابعة من عمره.
وقطع دراسته فى كبرى مكتبات طرابلس الشام بعد وفاة أبيه المفاجئ ، وكذلك ترك دراسته فى بغداد عندما سمع بمرض أمه، ثم خبر وفاتها وهو في طريق العودة إليها. علاوة على الاضطراب السياسي والحزبي بين الحمدانيين والفاطميين، والنزاعات الحربية مع الروم البيزنطيين. أما بالنسبة إلى شوبنهاور فإن أباه قد مات منتحراً عام 1805، وسلوكية أمه معه لم تكن بالموقع الحسن، حيث كانت من أروع من نبغ فى عصرها بكتابة القصة، وترفض أن يعلو شأنها الأدبي أى شخص حتى لو كان وحيدها آرثر.
فكانت تقسو عليه وتجافيه، خصوصاً بعدما أخبرها الشاعر الكبير غوته بعظمة عقلية ابنها في المستقبل. فضلاً على ذلك سلسلة الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية التى كانت تسود أوربا على مدى عقدين من الزمن.
وهكذا طغت الصفة التشاؤمية على عقلية وتفكير المعري وشوبنهاور، إذ جمعتهما حالة متقاربة الشبه رغم الفارق بين ظرفي الزمان والمكان والوضع العائلي والتناحر السياسي ورحى الحروب الطاحنة.
لذا أمسيا ينظران إلى العالم والطبيعة والمجتمع والفرد من زاوية كالحة لا تطاق. ما الخير والسعادة عندهما إلا أمور سلبية سرعان ما تأتي سرعان ما تزول، لأن الحياة ملؤها التعب ليس فيها سكينة طوال الامتداد الزمني، والوجود كله شر. وفي هذا يقول المعري:
ألا إنما الدنيا نحوسٍ لأهلها
فما من زمانٍ أنتَ فيه سعيد
أو
نزول كما زال آباؤنا
ويبقى الزمان على ما ترى ...
ويرى شوبنهاور بأن في “كل فرد حوض من الألم لا محيص عنه”، وحتى إذا فرضنا جدلاً بأن هذا الألم له نهاية، فإنه سوف “يحل مكانه على الفور عناء آخراً” وليس لدينا من ذلك لا مفر ولا محيص.
إذن فإن القاعدة الحقيقية للبشرية جمعاء داخل هذا العالم هو الألم المستديم، وإذا تساءلنا علام كل هذا التشاؤم الدامس؟ يأتينا الجواب من المعري:
فى العدمِ كنا وَحُكمُ الله أوجدنا
ثم اتفقنا على ثانٍ من العدمِ
أو
-نمرُ سراعاً بين عدمينِ مالنا
لباثُ كإنا عابرون على جسرِ
1
وينص شوبنهاور أيضاً على أن “الحياة تتأرجح كالبندول إلى الأمام والخلف بين الألم والسأم”، وفى كلتا الحالتين لا خير فى هذا العالم سوى حياة بائسة عافرة.
العقل
رغم أن المعري وشبونهور يعتبران فيلسوفين مثاليين، إلا أن المعري كونه شاعر أولاَ، لذا فإنه يمتلك ذبذبة غير مستقرة تجاه العقل، عكس شوبنهاور الذى يمتلك فكراً فلسفياً مستقراً، فإذا كان الأخير قد وضع العقل بعد الإرادة منزلة، فإن المعري نراه تارة ينظر إلى العقل على أنه المرشد الصحيح لأصول المعرفة حيث يقول:
إذا تفكرتَ فكراً لا يمازجهُ
فساد عقلٍ صحيحٍ هانَ ما صعبا
أو
ولو صفا العقل ألقى الثقلَ حاملُه
عنه ولم ترَ في الهيجاء معترِكا
وتارة أخرى يمجده أيما تمجيد ويعلو من شأن قدرته حتى يصل به إلى درجة النبوة فى عالم الغيب، وعلينا أن نشاوره وحده:
أيها الغر إن خُصصتَ بعقلٍ
فاسألنهُ فكل عقلٍ نبي
أو
فشاور العقل واترك غيره هدراً
فالعقل خير مشير ضمه النادي ...
ولكن فجأةً يعود ويحط من شأنه وقدرته ويساوي بين منزلة العالِم والجاهل:
وما العلماء والجهال إلا
قريب حين تنظر من قريبِ ...
هي ذي تذبذبات المعري، ولا غرابة فى ذلك لكونه شاعراً وتغلبه روح التوصية. علاوة على أنه صاحب عاهة مستديمة:
فاحذر ولا تدع الأمور مضاعة
وانظر بقلبِ مفكرٍ متبصرِ
أما شوبنهاور فالعقل عنده الأساس في البحث عن الحقيقة ويهاجم الفلسفة المادية متسائلاً: كيف نفسر العقل بأنه مادة ما دمنا لا نعلم المادة إلا بواسطة العقل؟ ..ثم لا يمكن أن نستدل عن كنه الحقيقة بالبحث عن المادة ذاتها وثم ننتقل إلى التفكير والعكس هو الصحيح عنده، حيث “أننا لن نصل إلى طبيعة الأشياء الحقيقية إذا بدأنا السير من الخارج”. لذلك أوجب معرفة طبيعة عقولنا أولاً، ثم ننظر إلى العالم الخارجي ثانياً.
وهنا يفسر لنا شوبنهاور لماذا يعتبر العقل أقل أهمية من الإرادة. وحسب تصوره، أن “أغبى إنسان ينقلب إلى مرهف الذكاء إذا ما كانت المسألة المطروحة عليه للبحث تمس رغباته مساً قريباً.
وإذا حاولنا أن نجعل العقل محل “الإرادة” فهذا خطأ يجب علينا تجنبه. لأن العقل “قد أنتجته الطبيعة ليخدم إرادة الفرد”. كما وأن شخصية الفرد تشكلها إرادته لا عقله، كون أن الإرادة “هي العنصر الوحيد الدائم الثابت”. فالعالم والطبيعة والإنسان عنصرهم الحقيقي هي الإرادة.
إذا أردنا أن نشير إلى الفارق هنا بين المعري وشوبنهاور، فإن الأول لم يتأثر بفكر فلسفي معين، ولم يبن فلسفته على أنقاض من سبقه أو يضعها مقابل من عاصره. أعني أن مبدأه في العقل نابع من إحساسه الفكري الممزوج بالروح الشعرية، بينما الثاني فقد شيد مبدأه فى العقل مقابل فكرة مواطنه عمانوئيل كانت “الشيء فى ذاته”. ومعاصره جورج هيجل في “الفكر وحدة عضوية”.
حكمة الموت
إن المعري وشوبنهاور ينظران إلى الموت بأنه نعيم، حيث يقطع عنا عناء الألم، بل إنه راحة أبدية ورقاد يستريح فيه الإنسان حسب قول المعري:
ضجعة الموت رقدة يستريح -
الجسم فيها والعيش مثل السهادِ
أو
موتٌ يسير معه راحةٌ
خيرٌ من اليسرِ وطول البقاء
ويذهب بعدميته بُعداً تشاؤمياً حاداً عندما يتمنى أن ينقطع النسل ويموت حتى الطفل الرضيع، ويرى العدم نعمة:
فليت وليداً ماتَ ساعة وضعهِ
ولم يرتضع من أمهِ النفساء
أو
وأرحتُ أولادي فهم في نعمة
العدمِ التي فضلت نعيمَ العاجلِ
2
العقل
رغم أن المعري وشبونهور يعتبران فيلسوفين مثاليين، إلا أن المعري كونه شاعر أولاَ، لذا فإنه يمتلك ذبذبة غير مستقرة تجاه العقل، عكس شوبنهاور الذى يمتلك فكراً فلسفياً مستقراً، فإذا كان الأخير قد وضع العقل بعد الإرادة منزلة، فإن المعري نراه تارة ينظر إلى العقل على أنه المرشد الصحيح لأصول المعرفة حيث يقول:
إذا تفكرتَ فكراً لا يمازجهُ
فساد عقلٍ صحيحٍ هانَ ما صعبا
أو
ولو صفا العقل ألقى الثقلَ حاملُه
عنه ولم ترَ في الهيجاء معترِكا
وتارة أخرى يمجده أيما تمجيد ويعلو من شأن قدرته حتى يصل به إلى درجة النبوة فى عالم الغيب، وعلينا أن نشاوره وحده:
أيها الغر إن خُصصتَ بعقلٍ
فاسألنهُ فكل عقلٍ نبي
أو
فشاور العقل واترك غيره هدراً
فالعقل خير مشير ضمه النادي ...
ولكن فجأةً يعود ويحط من شأنه وقدرته ويساوي بين منزلة العالِم والجاهل:
وما العلماء والجهال إلا
قريب حين تنظر من قريبِ ...
هي ذي تذبذبات المعري، ولا غرابة فى ذلك لكونه شاعراً وتغلبه روح التوصية. علاوة على أنه صاحب عاهة مستديمة:
فاحذر ولا تدع الأمور مضاعة
وانظر بقلبِ مفكرٍ متبصرِ
أما شوبنهاور فالعقل عنده الأساس في البحث عن الحقيقة ويهاجم الفلسفة المادية متسائلاً: كيف نفسر العقل بأنه مادة ما دمنا لا نعلم المادة إلا بواسطة العقل؟ ..ثم لا يمكن أن نستدل عن كنه الحقيقة بالبحث عن المادة ذاتها وثم ننتقل إلى التفكير والعكس هو الصحيح عنده، حيث “أننا لن نصل إلى طبيعة الأشياء الحقيقية إذا بدأنا السير من الخارج”. لذلك أوجب معرفة طبيعة عقولنا أولاً، ثم ننظر إلى العالم الخارجي ثانياً.
وهنا يفسر لنا شوبنهاور لماذا يعتبر العقل أقل أهمية من الإرادة. وحسب تصوره، أن “أغبى إنسان ينقلب إلى مرهف الذكاء إذا ما كانت المسألة المطروحة عليه للبحث تمس رغباته مساً قريباً.
وإذا حاولنا أن نجعل العقل محل “الإرادة” فهذا خطأ يجب علينا تجنبه. لأن العقل “قد أنتجته الطبيعة ليخدم إرادة الفرد”. كما وأن شخصية الفرد تشكلها إرادته لا عقله، كون أن الإرادة “هي العنصر الوحيد الدائم الثابت”. فالعالم والطبيعة والإنسان عنصرهم الحقيقي هي الإرادة.
إذا أردنا أن نشير إلى الفارق هنا بين المعري وشوبنهاور، فإن الأول لم يتأثر بفكر فلسفي معين، ولم يبن فلسفته على أنقاض من سبقه أو يضعها مقابل من عاصره. أعني أن مبدأه في العقل نابع من إحساسه الفكري الممزوج بالروح الشعرية، بينما الثاني فقد شيد مبدأه فى العقل مقابل فكرة مواطنه عمانوئيل كانت “الشيء فى ذاته”. ومعاصره جورج هيجل في “الفكر وحدة عضوية”.
حكمة الموت
إن المعري وشوبنهاور ينظران إلى الموت بأنه نعيم، حيث يقطع عنا عناء الألم، بل إنه راحة أبدية ورقاد يستريح فيه الإنسان حسب قول المعري:
ضجعة الموت رقدة يستريح -
الجسم فيها والعيش مثل السهادِ
أو
موتٌ يسير معه راحةٌ
خيرٌ من اليسرِ وطول البقاء
ويذهب بعدميته بُعداً تشاؤمياً حاداً عندما يتمنى أن ينقطع النسل ويموت حتى الطفل الرضيع، ويرى العدم نعمة:
فليت وليداً ماتَ ساعة وضعهِ
ولم يرتضع من أمهِ النفساء
أو
وأرحتُ أولادي فهم في نعمة
العدمِ التي فضلت نعيمَ العاجلِ
2
ورغم أن شوبنهاور يعتبر الموت مروعاً مفزعاً لكنه أعظم النِعم البشرية، حيث أن حب الحياة مسألة باطلة كاذبة ويجب مقاومة إرادة النسل، إذ “أن إشباع الغريزة الجنسية هو الذي يستوجب المنع لأنه أقوى ما يثبت شهوة الحياة”.
إن هذه السوداوية المضنية إنما تعكس الوضع السلبي الذى عاناه المتشائمان المعري وشوبنهاور حياتياً واجتماعياً. فقد بقيا وحيدين دون أهل ولا أصدقاء، أو لنقل رفضا الزواج والخلان وفضلا الانطواء عن المحيط الذى لم يعزلهم.
الخلود
يذهب الفيلسوفان في هذا المجال بالامتداد التشاؤمي عن أمور الدنيا وما يتعلق بأمر الخلود، فالمعري، وكما معروف لنا، يخضع إلى الشحنات النفسية التي تجتاح جوانحه. فإن كانت سلبية كفر الدين والآخرين، وإن كانت إيجابية تعيده إلى ركن الإيمان. ومع ذلك نجده فى كلتا الحالتين ينفي وجود حياة بعد الموت:
حياةٌ ثم موتٌ ثم بعثٌ
حديثُ خرافةٍ يا أم عمرو
أو
-أرى هذيانا طال من كل أمة
يضمنه ايجازها وشروحها
وأوصال جسم للتراب ما لها
ولم يدر دار أين تذهب روحها ؟
ثم يخبرنا بأنه سيرحل عن هذا العالم المادي، ولكن إلى أين؟ لا يعلم! ولذلك يطالبنا بأن لا نرجو منه عودة:
سأرحل عن وشيك ولست بعالم ٍ
على أي أمرٍ لا ابالك أقدم
أو
أترجون أن أعود إليكم
لا ترجوا فإنني لا أعودُ
ولجسمي إلى التراب هبوطُ
ولروحي إلى الهواء صعودُ
إنها فعلاً حيرة مستعصية عند شاعرنا المعري، وليس له منها من محيص حيث لا يوجد من يسأله فيخبره عما سمع ورأى فى مماته:
فهل قامَ من جدثً ٍميتٍ
فيخبر عن مسمعٍ أو رأى؟
ثم:
هل فازَ بالجنةِ عمالها؟
وهل ثوى في النارِ نوبخت؟
أما شوبنهاور فيشير إلى أن “الإنسان بعد أن كون من آلامه وعذابه فكرة الجحيم رأى أن لم يبق لديه شيء يكون منه الجنة إلا الملل”. وحسب تصوره فإن الإنسان منذ نعومة أظافره يحس ويلتمس بمرارة هذا العالم الكريه المملوء شراً.
وبما أن شوبنهاور قد آمن بفكرة “النيرفانا” أو تناسخ الأرواح وفق العقيدة البوذية، والمعري يرفض هذه الفكرة.
لذا فإنه أكثر وضحاً من شوبنهاور في هذا الشأن، حيث يؤمن بقدرة الله المطلقة بإحياء الموتى وحشر الخلق:
وقدرة الله حق ليس يعجزها
حشرٌ خلقٍ ولا بعث لأجسادِ
أو
-ومتى شاء الذى صورنا
أشعر الميت نشوراً فنشر
3
إن هذه السوداوية المضنية إنما تعكس الوضع السلبي الذى عاناه المتشائمان المعري وشوبنهاور حياتياً واجتماعياً. فقد بقيا وحيدين دون أهل ولا أصدقاء، أو لنقل رفضا الزواج والخلان وفضلا الانطواء عن المحيط الذى لم يعزلهم.
الخلود
يذهب الفيلسوفان في هذا المجال بالامتداد التشاؤمي عن أمور الدنيا وما يتعلق بأمر الخلود، فالمعري، وكما معروف لنا، يخضع إلى الشحنات النفسية التي تجتاح جوانحه. فإن كانت سلبية كفر الدين والآخرين، وإن كانت إيجابية تعيده إلى ركن الإيمان. ومع ذلك نجده فى كلتا الحالتين ينفي وجود حياة بعد الموت:
حياةٌ ثم موتٌ ثم بعثٌ
حديثُ خرافةٍ يا أم عمرو
أو
-أرى هذيانا طال من كل أمة
يضمنه ايجازها وشروحها
وأوصال جسم للتراب ما لها
ولم يدر دار أين تذهب روحها ؟
ثم يخبرنا بأنه سيرحل عن هذا العالم المادي، ولكن إلى أين؟ لا يعلم! ولذلك يطالبنا بأن لا نرجو منه عودة:
سأرحل عن وشيك ولست بعالم ٍ
على أي أمرٍ لا ابالك أقدم
أو
أترجون أن أعود إليكم
لا ترجوا فإنني لا أعودُ
ولجسمي إلى التراب هبوطُ
ولروحي إلى الهواء صعودُ
إنها فعلاً حيرة مستعصية عند شاعرنا المعري، وليس له منها من محيص حيث لا يوجد من يسأله فيخبره عما سمع ورأى فى مماته:
فهل قامَ من جدثً ٍميتٍ
فيخبر عن مسمعٍ أو رأى؟
ثم:
هل فازَ بالجنةِ عمالها؟
وهل ثوى في النارِ نوبخت؟
أما شوبنهاور فيشير إلى أن “الإنسان بعد أن كون من آلامه وعذابه فكرة الجحيم رأى أن لم يبق لديه شيء يكون منه الجنة إلا الملل”. وحسب تصوره فإن الإنسان منذ نعومة أظافره يحس ويلتمس بمرارة هذا العالم الكريه المملوء شراً.
وبما أن شوبنهاور قد آمن بفكرة “النيرفانا” أو تناسخ الأرواح وفق العقيدة البوذية، والمعري يرفض هذه الفكرة.
لذا فإنه أكثر وضحاً من شوبنهاور في هذا الشأن، حيث يؤمن بقدرة الله المطلقة بإحياء الموتى وحشر الخلق:
وقدرة الله حق ليس يعجزها
حشرٌ خلقٍ ولا بعث لأجسادِ
أو
-ومتى شاء الذى صورنا
أشعر الميت نشوراً فنشر
3
مجموعة قنوات قد يهمكم محتواها..
كتب في علم النفس
@Psychologybookss
مقالات في علم النفس والشخصية
@psychoanalysis_2021
للكتب والمصادر الفلسفية
@philosophybookss
باروخ سبينوزا
@spinoza_2021
نيتشه
@Nietzsche1
كامو
@Camus_Al
شوبنهاور - سيوران
@Schopenhauer_Cioran
كافكا
@kafka2022
دوستويفسكي
@Dostoyevsky_Kafka
https://www.tg-me.com/Ali_AlWardi
كتب في علم النفس
@Psychologybookss
مقالات في علم النفس والشخصية
@psychoanalysis_2021
للكتب والمصادر الفلسفية
@philosophybookss
باروخ سبينوزا
@spinoza_2021
نيتشه
@Nietzsche1
كامو
@Camus_Al
شوبنهاور - سيوران
@Schopenhauer_Cioran
كافكا
@kafka2022
دوستويفسكي
@Dostoyevsky_Kafka
https://www.tg-me.com/Ali_AlWardi
Telegram
الدكتور علي الوردي
الدكتور علي الوردي أعظم من حلل الشخصية العراقية وفصلها تفصيلاً دقيقاً.
👎1
كانط: نقد العقل الخالص (الأفكار الأساسية للكتاب)
محمد الهلالي
إن هدف إيمانويل كانط Emmanuel Kant (1724-1804) من تأليف كتابه Critique de la raison pure (تمت ترجمة هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان "نقد العقل المحض"، ترجمة غانم هنا، مراجعة فتحي المسكيني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2013، وترجمه موسى وهبة تحت عنوان "نقد العقل الخالص"، مركز الإنماء القومي، بيروت) هو تحديد ما يمكنُ للإنسان معرفته. عاش كانط في قرن تميز بتقديس العلم، لذلك ارتأى أن يُنقذ الفلسفة. وعملية إنقاذ الفلسفة لن تتم إلا بفحص حدود العقل.
يشرح كانط في كتابه "نقد العقل المحض" السبب الذي يجعل الفلسفة لا تستطيع أن تتجاوز حدود التجربة بتحقيق نفس درجة اليقين التي يحققها المنطق والرياضيات والفيزياء.
إن "نقد العقل المحض" جعل كانط يضع الذات في مركز المعرفة، متوخيا اكتشاف إمكانات العقل بالاستفادة من تجربة الرياضيات والفيزياء، من خلال دراسة الكيفية التي جعلت هذين العلمين يحصلان على يقينيات "قبلية"، اي يقينيات تم التوصل إليها قبل إجراء أية تجربة.
كان الفلاسفة السابقون على كانط يرون ان الموضوع هو واقع معطى يخضع له العقل. رفض كانط هذا المنظور. وفرض منهجا جديدا يُحدّدُ الموضوع حسب ما يقتضيه العقل. لقد استبدل كانط الواقعية (التي تقول إن الواقع يوجد في استقلال عن الوعي) بالمثالية (التي تقول إن الواقع يبنيه العقل، وبالتالي فالواقع بناء ناتج عن العقل ولا يوجد في استقلال عنه).
إن موقف كانط هذا، أي القاضي بجعل الواقع ثمرة للعقل هو ما يُعتبرُ ثورة في الفلسفة (تعادل أهميتها أهمية الثورة الكوبرنيكية في مجال الفلك): فكما ان كوبرنيكوس اكتشف بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس، قام كانط بجعل الذات هي مركز نظرية المعرفة، وليس الموضوع.
يؤكد موقف كانط (القائل بأن الذات هي مركز المعرفة وليس الموضوع الذي تدرسه) أن العقل يتدخل بطريقة فعالة في إعداد وتكوين المعرفة: أي أن العقل هو الذي يشكل الواقع.
وهكذا فالمعرفة التي تحصل عليها الذات حول الموضوع تابعة لملكة الذات الخاصة بإنجاز فعل المعرفة. (يقول كانط: "لا نعرف من الأشياء معرفة قبلية، إلا ما نضعه نحن فيها").
يبينُ كتاب "نقد العقل المحض" لكانط أن الواقع منظم ومرتب بواسطة الفكر. وهو بذلك يوضح وجود "أطر كونية ضرورية"، يستعملها العقل البشري لمعرفة العالم.
ويميز كانط في الملكة التي تنجز المعرفة ما بين:
- القدرة على استقبال المعلومة (أي القدرة على استقبال المعطيات الحسية الخارجية (sensibilité)، والتي ترجمت ترجمة رديئة من خلال كلمة "الحساسية").
- الفهم: وهو الاشتغال بالمفاهيم.
وعلى سبيل التوضيح: هناك موضوع معين، يتم استقبال معلومات عنه من خلال "القدرة على استقبال المعلومة"، ثم يتم التفكير فيه من خلال المفاهيم (التي يضمها الفهم).
وتشتغل القدرة على استقبال المعلومة من جهة، والفهم من جهة أخرى اعتمادا على أطرٍ قبلية:
1
محمد الهلالي
إن هدف إيمانويل كانط Emmanuel Kant (1724-1804) من تأليف كتابه Critique de la raison pure (تمت ترجمة هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان "نقد العقل المحض"، ترجمة غانم هنا، مراجعة فتحي المسكيني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2013، وترجمه موسى وهبة تحت عنوان "نقد العقل الخالص"، مركز الإنماء القومي، بيروت) هو تحديد ما يمكنُ للإنسان معرفته. عاش كانط في قرن تميز بتقديس العلم، لذلك ارتأى أن يُنقذ الفلسفة. وعملية إنقاذ الفلسفة لن تتم إلا بفحص حدود العقل.
يشرح كانط في كتابه "نقد العقل المحض" السبب الذي يجعل الفلسفة لا تستطيع أن تتجاوز حدود التجربة بتحقيق نفس درجة اليقين التي يحققها المنطق والرياضيات والفيزياء.
إن "نقد العقل المحض" جعل كانط يضع الذات في مركز المعرفة، متوخيا اكتشاف إمكانات العقل بالاستفادة من تجربة الرياضيات والفيزياء، من خلال دراسة الكيفية التي جعلت هذين العلمين يحصلان على يقينيات "قبلية"، اي يقينيات تم التوصل إليها قبل إجراء أية تجربة.
كان الفلاسفة السابقون على كانط يرون ان الموضوع هو واقع معطى يخضع له العقل. رفض كانط هذا المنظور. وفرض منهجا جديدا يُحدّدُ الموضوع حسب ما يقتضيه العقل. لقد استبدل كانط الواقعية (التي تقول إن الواقع يوجد في استقلال عن الوعي) بالمثالية (التي تقول إن الواقع يبنيه العقل، وبالتالي فالواقع بناء ناتج عن العقل ولا يوجد في استقلال عنه).
إن موقف كانط هذا، أي القاضي بجعل الواقع ثمرة للعقل هو ما يُعتبرُ ثورة في الفلسفة (تعادل أهميتها أهمية الثورة الكوبرنيكية في مجال الفلك): فكما ان كوبرنيكوس اكتشف بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس، قام كانط بجعل الذات هي مركز نظرية المعرفة، وليس الموضوع.
يؤكد موقف كانط (القائل بأن الذات هي مركز المعرفة وليس الموضوع الذي تدرسه) أن العقل يتدخل بطريقة فعالة في إعداد وتكوين المعرفة: أي أن العقل هو الذي يشكل الواقع.
وهكذا فالمعرفة التي تحصل عليها الذات حول الموضوع تابعة لملكة الذات الخاصة بإنجاز فعل المعرفة. (يقول كانط: "لا نعرف من الأشياء معرفة قبلية، إلا ما نضعه نحن فيها").
يبينُ كتاب "نقد العقل المحض" لكانط أن الواقع منظم ومرتب بواسطة الفكر. وهو بذلك يوضح وجود "أطر كونية ضرورية"، يستعملها العقل البشري لمعرفة العالم.
ويميز كانط في الملكة التي تنجز المعرفة ما بين:
- القدرة على استقبال المعلومة (أي القدرة على استقبال المعطيات الحسية الخارجية (sensibilité)، والتي ترجمت ترجمة رديئة من خلال كلمة "الحساسية").
- الفهم: وهو الاشتغال بالمفاهيم.
وعلى سبيل التوضيح: هناك موضوع معين، يتم استقبال معلومات عنه من خلال "القدرة على استقبال المعلومة"، ثم يتم التفكير فيه من خلال المفاهيم (التي يضمها الفهم).
وتشتغل القدرة على استقبال المعلومة من جهة، والفهم من جهة أخرى اعتمادا على أطرٍ قبلية:
1
بالنسبة للقدرة على استقبال المعلومة هناك إطاران هما المكان والزمان. وذلك لأن الذات تدرك دوما الأشياء في المكان، وتدرك حالاتها النفسية في الزمان.
- أما أطر الفهم فهي المقولات، أي الصيغ التي تمكن العقل الإنساني من إدراك الأشياء، وهذه المقولات تسمى أيضا المفاهيم الخالصة. ومهمتها الأساسية هي ترتيب المعطيات المتنوعة التي يتم الحصول عليها.
ولما تحاول هذه المفاهيمُ الخالصة أن تعرف المطلق، أي ما يوجد خارج العالم الحسي: تشكل ما يسميه كانط بالعقل. ومن بين الأفكار المكونة للعقل (كما يعرفه كانط):
- الروح باعتبارها جوهرا موجودا في ذاته.
- الله باعتباره جوهر الجواهر وسبب الأسباب
- العالم كوحدة كلية.
ولكن بما أن المقولات (المفاهيم الخالصة) تستمد محتواها من "القدرة على استقبال المعلومة"، فإن العقل عاجز عن التحرر منها.
إن كتاب "نقد العقل المحض" يعيد النظر في الميتافيزيقا. وبما أن الميتافيزيقا (أو العقل التأملي) تولّدتْ عن تجاوز التجربة للفهم، فإنها تبدو كاستعداد طبيعي للعقل. لكن أفكار العقل لا تصلح إلا لضبط سعي الفكر نحو المطلق، أي أنها توجه فقط الجهد الإنساني في مجال المعرفة بمنعه من أن يحقق إشباعا ذاتيا بيُسر كبير.
وبما أن كلّ مَعرفة تتطلب التنسيق بين القدرة على استعمال المعلومة والفهم، وبما أن "القدرة على استقبال المعلومة" لا يمكنها أن تكون ثقافية، فإن المقولات (المفاهيم الخالصة) لا يمكنها أن تُطبّق إلا على التجربة، أي لا يمكن لتلك المقولات أن تستعمل خارج مجال التجربة، فكل معرفة تم استخلاصها من الفهم الخالص، ومن العقل الخالص لا يمكن أن تكون حسب كانط إلا وهما. وهذا يعني أن الحقيقة لا توجد إلا في التجربة. وهذا يقود إلى الاستنتاج التالي: لا يمكن للميتافيزيقا أن تكون علما بالأشياء في ذاتها. يرفض كانط اعتبار الميتافيزيقا علما. فالميتافيزيقا لا تسمح للإنسان بإثبات أي شيء بخصوص الروح، والله، والعالم. والسبب في ذلك هو أنها لا تقدم يقينا برجة يقين المنطق والرياضيات والفيزياء.
2
الفيلسوف الجديد
- أما أطر الفهم فهي المقولات، أي الصيغ التي تمكن العقل الإنساني من إدراك الأشياء، وهذه المقولات تسمى أيضا المفاهيم الخالصة. ومهمتها الأساسية هي ترتيب المعطيات المتنوعة التي يتم الحصول عليها.
ولما تحاول هذه المفاهيمُ الخالصة أن تعرف المطلق، أي ما يوجد خارج العالم الحسي: تشكل ما يسميه كانط بالعقل. ومن بين الأفكار المكونة للعقل (كما يعرفه كانط):
- الروح باعتبارها جوهرا موجودا في ذاته.
- الله باعتباره جوهر الجواهر وسبب الأسباب
- العالم كوحدة كلية.
ولكن بما أن المقولات (المفاهيم الخالصة) تستمد محتواها من "القدرة على استقبال المعلومة"، فإن العقل عاجز عن التحرر منها.
إن كتاب "نقد العقل المحض" يعيد النظر في الميتافيزيقا. وبما أن الميتافيزيقا (أو العقل التأملي) تولّدتْ عن تجاوز التجربة للفهم، فإنها تبدو كاستعداد طبيعي للعقل. لكن أفكار العقل لا تصلح إلا لضبط سعي الفكر نحو المطلق، أي أنها توجه فقط الجهد الإنساني في مجال المعرفة بمنعه من أن يحقق إشباعا ذاتيا بيُسر كبير.
وبما أن كلّ مَعرفة تتطلب التنسيق بين القدرة على استعمال المعلومة والفهم، وبما أن "القدرة على استقبال المعلومة" لا يمكنها أن تكون ثقافية، فإن المقولات (المفاهيم الخالصة) لا يمكنها أن تُطبّق إلا على التجربة، أي لا يمكن لتلك المقولات أن تستعمل خارج مجال التجربة، فكل معرفة تم استخلاصها من الفهم الخالص، ومن العقل الخالص لا يمكن أن تكون حسب كانط إلا وهما. وهذا يعني أن الحقيقة لا توجد إلا في التجربة. وهذا يقود إلى الاستنتاج التالي: لا يمكن للميتافيزيقا أن تكون علما بالأشياء في ذاتها. يرفض كانط اعتبار الميتافيزيقا علما. فالميتافيزيقا لا تسمح للإنسان بإثبات أي شيء بخصوص الروح، والله، والعالم. والسبب في ذلك هو أنها لا تقدم يقينا برجة يقين المنطق والرياضيات والفيزياء.
2
الفيلسوف الجديد
الفلسفة تلتفت إلى المؤلف
وا أسفاه، ها هو العقل يهوي إلى حضيض اليأس،
والبصر تلفُّه العتمة،
عندما تُضخِّم عواصف الحياة من وزن هموم الدنيا،
ينسى العقل نوره الباطن، ويؤخذ بالظلام الخارجي،
هذا الرجل كان يومًا طليقًا متجهًا إلى السماء بخشوعٍ وولوع،
يتأمل الشمس القرمزية والصفاء البارد للقمر،
كان فلكيًّا يعكف على متابعة الكواكب في أفلاكها،
هذا الرجل كان يَنْشد معرفة مصدر العواصف التي تعزِفُ وتثير البحار؛
الروح التي تحرك العالم،
السبب الذي يجعل الشمس تنتقل من الشرق المُشعِّ إلى الغرب المائي،
كان ينشُد معرفة السبب الذي يجعل ساعات الربيع معتدلةً تَزِين الأرض
بالزهور، ومَن الذي يفعم الخريف بالعناقيد المكتنزة عند اكتمال العام،
ها هو العقل الذي كان يبحثُ ويستكشف أسرار الطبيعة الخفية،
يَرزَح في قلب الظلام،
عنقه مكبَّلٌ بالأغلال الثقيلة،
مرغمًا تحت وطأتها أن يتأمل التراب الحقير.
ومضت تقول: «غير أن الوقت وقت علاجٍ لا وقت شكوى»، ثم حدَّقت بملء عينيها قائلةً: «ألست أنت مَن أرضعته يومًا من لَبَني وأطعمته من طعامي إلى أن بلغ أشدَّه؟ لقد منحتُك أسلحةً كفيلةً بأن تحميك وتَذُود عنك ولكنك ألقيت بها بعيدًا؟ ألا تعرفني؟ لماذا أنت صامت؟ هل أصمتك الخجل أم أسكتك الذهول؟ كنت أودُّ أن يكون الخجل، ولكن الذهول فيما أرى هو الذي يَتَملَّكك.»
عندما وَجَدتني صامتًا، بل مبلسًا غير قادرٍ على النطق، وضعت يدها برفقٍ على صدري وقالت: «لا خطر، إنه يعاني من شيءٍ من النسيان، ذلك المرض الشائع في العقول الضالة، لقد نسي نفسه برهةً وسوف يتذكَّرُها بسهولةٍ إذا ما تَعرَّف عليَّ، ولكي أمهِّد له ذلك سأُبدِّد بعضًا من ضباب الهموم الدنيوية التي تغشِّي على عينيه.»
قالت ذلك ثم جمعت طرف ردائها وجفَّفت عينيَّ المُغرورقتين.
بوئيثيوس
عزاء الفلسفة
وا أسفاه، ها هو العقل يهوي إلى حضيض اليأس،
والبصر تلفُّه العتمة،
عندما تُضخِّم عواصف الحياة من وزن هموم الدنيا،
ينسى العقل نوره الباطن، ويؤخذ بالظلام الخارجي،
هذا الرجل كان يومًا طليقًا متجهًا إلى السماء بخشوعٍ وولوع،
يتأمل الشمس القرمزية والصفاء البارد للقمر،
كان فلكيًّا يعكف على متابعة الكواكب في أفلاكها،
هذا الرجل كان يَنْشد معرفة مصدر العواصف التي تعزِفُ وتثير البحار؛
الروح التي تحرك العالم،
السبب الذي يجعل الشمس تنتقل من الشرق المُشعِّ إلى الغرب المائي،
كان ينشُد معرفة السبب الذي يجعل ساعات الربيع معتدلةً تَزِين الأرض
بالزهور، ومَن الذي يفعم الخريف بالعناقيد المكتنزة عند اكتمال العام،
ها هو العقل الذي كان يبحثُ ويستكشف أسرار الطبيعة الخفية،
يَرزَح في قلب الظلام،
عنقه مكبَّلٌ بالأغلال الثقيلة،
مرغمًا تحت وطأتها أن يتأمل التراب الحقير.
ومضت تقول: «غير أن الوقت وقت علاجٍ لا وقت شكوى»، ثم حدَّقت بملء عينيها قائلةً: «ألست أنت مَن أرضعته يومًا من لَبَني وأطعمته من طعامي إلى أن بلغ أشدَّه؟ لقد منحتُك أسلحةً كفيلةً بأن تحميك وتَذُود عنك ولكنك ألقيت بها بعيدًا؟ ألا تعرفني؟ لماذا أنت صامت؟ هل أصمتك الخجل أم أسكتك الذهول؟ كنت أودُّ أن يكون الخجل، ولكن الذهول فيما أرى هو الذي يَتَملَّكك.»
عندما وَجَدتني صامتًا، بل مبلسًا غير قادرٍ على النطق، وضعت يدها برفقٍ على صدري وقالت: «لا خطر، إنه يعاني من شيءٍ من النسيان، ذلك المرض الشائع في العقول الضالة، لقد نسي نفسه برهةً وسوف يتذكَّرُها بسهولةٍ إذا ما تَعرَّف عليَّ، ولكي أمهِّد له ذلك سأُبدِّد بعضًا من ضباب الهموم الدنيوية التي تغشِّي على عينيه.»
قالت ذلك ثم جمعت طرف ردائها وجفَّفت عينيَّ المُغرورقتين.
بوئيثيوس
عزاء الفلسفة
العوامل الخارجية للآراء والمعتقدات:
غوستاف لوبون
(١) التلقين
أكثر آرائنا ومعتقداتنا؛ سياسية كانت أم دينية أم اجتماعية، نتيجة التلقين، قال (جيمس): «إن التلقين عبارة عن القوة التي تؤثر بها الأفكار في المعتقدات والسير.» وعندي أن هذا التعريف غير صحيح، فالتلقين هو بالحقيقة كناية عن قوة الإقناع ليس بالأفكار وحدها، بل بأي عامل آخر؛ كالتوكيد والنفوذ … إلخ، ولو نظرنا إلى الأفكار دون غيرها لرأيناها ذات تأثير ضعيف.
وللتلقين مناهج كثيرة نعد منها البيئة، والكتب، والجرائد، والخطب، والعمل الشخصي … إلخ، والكلام من أكثر هذه المناهج تأثيرًا، وتوكيد الكلام يزيده قوة ونفوذًا.
وشدة التلقين تختلف باختلاف العوامل، فهذه الشدة تبتدئ من التأثير الضئيل للبائع الذي يحاول أن يحملنا على ابتياع شيء من سلعه، وتنتهي إلى التأثير الذي يؤثر به المُنَوِّم في المصاب بمرض الأعصاب حيث يجعله سليب الإرادة، وفي عالم السياسة يكون الزعيم ذو النفوذ العظيم هو المنوم.
وتكون نتائج التلقين بحسب حالة الملقَّن النفسية، فالملقَّن يصبح بتأثير أحد المحرضات — كالحقد والحب — التي تضيِّق دائرة شعوره أكثر انفعالًا؛ فيسهل تحويل آرائه.
ولا يتخلص أولو الفضل من سلطان التلقين، فلقد بيَّن (جول لوميتر) في محاضرته عن (فينيلون) أن هذا الحَبْر الشهير أصبح مقودًا من (مدام كويون) ذات المرض العصبي بعد أن اتخذته مرشدًا لها؛ إذ استطاعت أن تقنعه بصحة آرائها في المذهب الصوفي الداعي إلى عدم المبالاة بالنجاة الأبدية وبالأعمال، وقد بلغ تأثيرها فيه مبلغًا جعله يعرض ذلك المذهب على مؤتمر من الأساقفة برئاسة (بوسويه) الذي لم يلبث أن اكتشف تلقين (مدام كويون) للحَبْر المشار إليه، فقال: «أنصاع مبهوتًا من رؤيتي امرأة ذات بصيرة محدودة، قليلة الفضل، كثيرة الوهم، تؤثِّر في رجل ذي روح عالية!» غير أن الذين يطلعون على التاريخ الحديث لا يعتريهم الدهش كما اعترى (بوسويه)؛ لأن كثيرًا من الحوادث كمسألة (هومبرت)، ومسألة (دوبري دولا ماهيري) … إلخ، أثبتت لهم أن عددًا كبيرًا من الصيارفة الماهرين والمحامين القديرين والقادة المدبرين تركوا ثروتهم بين أيدي أناس محتالين معدودين من الرُقاة المشعوذين.
1
غوستاف لوبون
(١) التلقين
أكثر آرائنا ومعتقداتنا؛ سياسية كانت أم دينية أم اجتماعية، نتيجة التلقين، قال (جيمس): «إن التلقين عبارة عن القوة التي تؤثر بها الأفكار في المعتقدات والسير.» وعندي أن هذا التعريف غير صحيح، فالتلقين هو بالحقيقة كناية عن قوة الإقناع ليس بالأفكار وحدها، بل بأي عامل آخر؛ كالتوكيد والنفوذ … إلخ، ولو نظرنا إلى الأفكار دون غيرها لرأيناها ذات تأثير ضعيف.
وللتلقين مناهج كثيرة نعد منها البيئة، والكتب، والجرائد، والخطب، والعمل الشخصي … إلخ، والكلام من أكثر هذه المناهج تأثيرًا، وتوكيد الكلام يزيده قوة ونفوذًا.
وشدة التلقين تختلف باختلاف العوامل، فهذه الشدة تبتدئ من التأثير الضئيل للبائع الذي يحاول أن يحملنا على ابتياع شيء من سلعه، وتنتهي إلى التأثير الذي يؤثر به المُنَوِّم في المصاب بمرض الأعصاب حيث يجعله سليب الإرادة، وفي عالم السياسة يكون الزعيم ذو النفوذ العظيم هو المنوم.
وتكون نتائج التلقين بحسب حالة الملقَّن النفسية، فالملقَّن يصبح بتأثير أحد المحرضات — كالحقد والحب — التي تضيِّق دائرة شعوره أكثر انفعالًا؛ فيسهل تحويل آرائه.
ولا يتخلص أولو الفضل من سلطان التلقين، فلقد بيَّن (جول لوميتر) في محاضرته عن (فينيلون) أن هذا الحَبْر الشهير أصبح مقودًا من (مدام كويون) ذات المرض العصبي بعد أن اتخذته مرشدًا لها؛ إذ استطاعت أن تقنعه بصحة آرائها في المذهب الصوفي الداعي إلى عدم المبالاة بالنجاة الأبدية وبالأعمال، وقد بلغ تأثيرها فيه مبلغًا جعله يعرض ذلك المذهب على مؤتمر من الأساقفة برئاسة (بوسويه) الذي لم يلبث أن اكتشف تلقين (مدام كويون) للحَبْر المشار إليه، فقال: «أنصاع مبهوتًا من رؤيتي امرأة ذات بصيرة محدودة، قليلة الفضل، كثيرة الوهم، تؤثِّر في رجل ذي روح عالية!» غير أن الذين يطلعون على التاريخ الحديث لا يعتريهم الدهش كما اعترى (بوسويه)؛ لأن كثيرًا من الحوادث كمسألة (هومبرت)، ومسألة (دوبري دولا ماهيري) … إلخ، أثبتت لهم أن عددًا كبيرًا من الصيارفة الماهرين والمحامين القديرين والقادة المدبرين تركوا ثروتهم بين أيدي أناس محتالين معدودين من الرُقاة المشعوذين.
1
👍1
وما الشعوذة سوى نوع من التلقين، والإنسان يعاني أمرها كما يعاني الطير شعوذة الثعبان، ومما لا ريب فيه أن بعض الناس النادرين يؤثرون في الحيوان بما يتخذونه من ضروب الرقية، كما يشاهد ذلك مربو الحيوانات، وما أكثر الجرائم التي اقتُرفت بفعل الشعوذة والرقية! فما لقيت كونتة (تارنوسكا) صعوبة في جعل عشاقها يقتلون رجالًا كثيرًا، وقد أصبحت من النفوذ والتأثير بحيث كان يجب تبديل فرسانها وحَرَسِ سجنها تبديلًا مستمرًّا.
ويوجد شبه بين الأمثلة المذكورة وبين أعمال الوسطاء أو الدراويش الذي يلقنون من يحيط بهم فيجعلونهم يعتقدون أمورًا لا أساس لها، على هذا الوجه ذهب كثير من مشاهير العلماء ضحية تلقين الوسيطة المشهورة المسماة (أوزابيا) كما سأبين ذلك في فصل آخر.
وبما أن شأن الجماعات يزيد بالتدريج وكان التلقين هو المؤثر فيها، فإن نفوذ الزعماء يعظم يومًا فيومًا، وما الحكومات الشعبية إلا حكومات بعض زعماء يتجلى استبدادهم في كل آنٍ؛ لأن الزعماء هم الذين يأمرون بالاعتصابات، ويُكرِهون الوزراء على إطاعتهم، ويسببون وضع قوانين عقيمة مخالفة للعقل والصواب.
قدرة الزعماء على التلقين كبيرة جدًّا، وبها يرغمون الجموع على الخضوع والانقياد، فلقد بيَّن مدير شركة (أورليان) في عيد هذه الشركة السنوي أن موظفيها اعتصبوا في زمان اضطر فيه إلى التسليم بجميع مطاليبهم، ثم قال: «إن سبب هذا الاعتصاب هو بضعة محرضين التجأوا في تحريضهم إلى إقامة الوعيد والسب والشتم مكان الدليل والبرهان.» ولو كان عند ذلك المدير اطلاع كافٍ على سنن النفس لعلم أن إبطال تلقين أولئك المحركين يتم بإخراجهم من الشركة، فالتلقين لا يقاوم إلا بالتلقين، ولا يؤدي الإذعان لما يقترحه الزعماء سوى زيادة نفوذهم.
2
ويوجد شبه بين الأمثلة المذكورة وبين أعمال الوسطاء أو الدراويش الذي يلقنون من يحيط بهم فيجعلونهم يعتقدون أمورًا لا أساس لها، على هذا الوجه ذهب كثير من مشاهير العلماء ضحية تلقين الوسيطة المشهورة المسماة (أوزابيا) كما سأبين ذلك في فصل آخر.
وبما أن شأن الجماعات يزيد بالتدريج وكان التلقين هو المؤثر فيها، فإن نفوذ الزعماء يعظم يومًا فيومًا، وما الحكومات الشعبية إلا حكومات بعض زعماء يتجلى استبدادهم في كل آنٍ؛ لأن الزعماء هم الذين يأمرون بالاعتصابات، ويُكرِهون الوزراء على إطاعتهم، ويسببون وضع قوانين عقيمة مخالفة للعقل والصواب.
قدرة الزعماء على التلقين كبيرة جدًّا، وبها يرغمون الجموع على الخضوع والانقياد، فلقد بيَّن مدير شركة (أورليان) في عيد هذه الشركة السنوي أن موظفيها اعتصبوا في زمان اضطر فيه إلى التسليم بجميع مطاليبهم، ثم قال: «إن سبب هذا الاعتصاب هو بضعة محرضين التجأوا في تحريضهم إلى إقامة الوعيد والسب والشتم مكان الدليل والبرهان.» ولو كان عند ذلك المدير اطلاع كافٍ على سنن النفس لعلم أن إبطال تلقين أولئك المحركين يتم بإخراجهم من الشركة، فالتلقين لا يقاوم إلا بالتلقين، ولا يؤدي الإذعان لما يقترحه الزعماء سوى زيادة نفوذهم.
2
(٢) الانطباعات الأولى
الانطباعات الأولى هي أول ما يشعر به المرء عند مصاقبته أول مرة ما جهله سابقًا من رجل، أو حادثة، أو شيء آخر، وحيث إن التدقيق في الأمر متعب شاق فإن الناس يكتفون على العموم بالانطباعات الأولى.
والانطباعات في بعض عناصر الحياة الاجتماعية تسير أحيانًا هي والبرهان، ولكن يوجد عناصر أخرى تظل فيها انطباعاتنا الأولى وحدها دليلًا، ونعد من هذه العناصر الفنون والآداب على الخصوص، ولمَّا كانت الانطباعات تابعة لمشاعر متبدلة فإن ما تولِّده في النفوس من صور وآراء يتحول بسهولة، وهذا هو سر اختلافها باختلاف الأزمنة والأشخاص والشعوب، فالانطباعات الأولى التي تورثها الأشياء نفسها في أمير إقطاعي أو أسقف من أشياع (كالفين) أو رجل متعلم أو عامي أو عالم لا تكون واحدة، وأما مسائل العلم التي لا تأثير للعاطفة فيها فإنه قلما يشاهد فيها مثل هذا الاختلاف، وعلة ذلك كون أقوالنا ومبادئنا فيها لا تتم بتأثير الانطباعات الأولى.
وأحيانًا تزول الانطباعات الأولى بغتةً بتأثير انطباعات أخرى مناقضة لها، ولكنها قد تكون قوية لا تتلاشى إلا شيئًا فشيئًا بفعل البلى والدثور.
ويقتضي اعتبار الانطباعات الأولى دلائل مبهمة، وعلائم غير صحيحة يجب نقدها، والبحث عن حقيقتها على الدوام، وإلا فإن عدم تمحيصها — كما يفعل الناس في الغالب — يؤدي إلى وقوع المرء في الضلال مدة حياته؛ ذلك لأنه ليس لها دعامة تستند إليها سوى العواطف والكراهة الغريزية التي لا يرشدها أي عقل، ولأن مبادئنا في العدل والظلم، والخير والشر، والصواب والخطأ، تقوم في أكثر الأحيان على هذه الأسس الواهية.
3
الانطباعات الأولى هي أول ما يشعر به المرء عند مصاقبته أول مرة ما جهله سابقًا من رجل، أو حادثة، أو شيء آخر، وحيث إن التدقيق في الأمر متعب شاق فإن الناس يكتفون على العموم بالانطباعات الأولى.
والانطباعات في بعض عناصر الحياة الاجتماعية تسير أحيانًا هي والبرهان، ولكن يوجد عناصر أخرى تظل فيها انطباعاتنا الأولى وحدها دليلًا، ونعد من هذه العناصر الفنون والآداب على الخصوص، ولمَّا كانت الانطباعات تابعة لمشاعر متبدلة فإن ما تولِّده في النفوس من صور وآراء يتحول بسهولة، وهذا هو سر اختلافها باختلاف الأزمنة والأشخاص والشعوب، فالانطباعات الأولى التي تورثها الأشياء نفسها في أمير إقطاعي أو أسقف من أشياع (كالفين) أو رجل متعلم أو عامي أو عالم لا تكون واحدة، وأما مسائل العلم التي لا تأثير للعاطفة فيها فإنه قلما يشاهد فيها مثل هذا الاختلاف، وعلة ذلك كون أقوالنا ومبادئنا فيها لا تتم بتأثير الانطباعات الأولى.
وأحيانًا تزول الانطباعات الأولى بغتةً بتأثير انطباعات أخرى مناقضة لها، ولكنها قد تكون قوية لا تتلاشى إلا شيئًا فشيئًا بفعل البلى والدثور.
ويقتضي اعتبار الانطباعات الأولى دلائل مبهمة، وعلائم غير صحيحة يجب نقدها، والبحث عن حقيقتها على الدوام، وإلا فإن عدم تمحيصها — كما يفعل الناس في الغالب — يؤدي إلى وقوع المرء في الضلال مدة حياته؛ ذلك لأنه ليس لها دعامة تستند إليها سوى العواطف والكراهة الغريزية التي لا يرشدها أي عقل، ولأن مبادئنا في العدل والظلم، والخير والشر، والصواب والخطأ، تقوم في أكثر الأحيان على هذه الأسس الواهية.
3
(٣) الاحتياج إلى التفسير
الاحتياج إلى التفسير كالاحتياج إلى الاعتقاد يلازم الإنسان من المهد إلى اللحد، وقد ساعد على تكوين الآلهة، ويساعد على ظهور عدد غير قليل من الآراء، ويسهل قضاؤه، فأبسط الأجوبة تكفيه، وهذه السهولة هي مصدر كثير من الأغلاط.
وبما أن روح البشر مولعة بالقضايا القاطعة فإنها تحافظ على آرائها الباطلة الصادرة عن الاحتياج إلى التفسير زمنًا طويلًا، معتبرة كل من يحارب هذه الآراء عدوًّا مقلقًا للراحة، والمحذور الأساسي للآراء القائمة على تفاسير باطلة هو أن الإنسان بعد أن يعدها جازمة لا يسعى في البحث عن غيرها، فلقد أوجب جهلنا جهل أنفسنا تأخر العلوم قرونًا كثيرة، وتضييق دائرتها في الوقت الحاضر.
والتعطش إلى التفسير يتناول على الدوام أمورًا لا تُدرَك، فالنفس تسلم بأن «المشتري» هو الذي يرسل الرعد والصواعق عوضًا عن أن تعترف بأنها تجهل العلل التي تسببها، والعلم نفسه بدلًا من أن يقر بجهله بعض المواضيع فإنه يكتفي في الغالب بمثل هذا التفسير لإيضاحها.
4
الاحتياج إلى التفسير كالاحتياج إلى الاعتقاد يلازم الإنسان من المهد إلى اللحد، وقد ساعد على تكوين الآلهة، ويساعد على ظهور عدد غير قليل من الآراء، ويسهل قضاؤه، فأبسط الأجوبة تكفيه، وهذه السهولة هي مصدر كثير من الأغلاط.
وبما أن روح البشر مولعة بالقضايا القاطعة فإنها تحافظ على آرائها الباطلة الصادرة عن الاحتياج إلى التفسير زمنًا طويلًا، معتبرة كل من يحارب هذه الآراء عدوًّا مقلقًا للراحة، والمحذور الأساسي للآراء القائمة على تفاسير باطلة هو أن الإنسان بعد أن يعدها جازمة لا يسعى في البحث عن غيرها، فلقد أوجب جهلنا جهل أنفسنا تأخر العلوم قرونًا كثيرة، وتضييق دائرتها في الوقت الحاضر.
والتعطش إلى التفسير يتناول على الدوام أمورًا لا تُدرَك، فالنفس تسلم بأن «المشتري» هو الذي يرسل الرعد والصواعق عوضًا عن أن تعترف بأنها تجهل العلل التي تسببها، والعلم نفسه بدلًا من أن يقر بجهله بعض المواضيع فإنه يكتفي في الغالب بمثل هذا التفسير لإيضاحها.
4
(٤) الألفاظ والصيغ والصور
الألفاظ والصيغ من أكثر العوامل توليدًا للآراء والمعتقدات، وهي لما فيها من قدرة رهيبة قد أوجبت هلاك أناس أكثر من الذين قتلتهم المدافع، وما في الألفاظ من قدرة فناشئ عن أنها توقظ في المرء مشاعر دالة عليها، وقد بيَّنت في مؤلفات أخرى ما لها من الشأن في أمور السياسة.١
إن قوة الصيغ عظيمة في المجالس، فبها يحرك رجال السياسة مشاعر السامعين، ولم يلبث رئيس الوزارة الفرنسوية الموسيو (كليمانسو) أن سقط بغتةً بتأثير لفظ واحد أيقظ في أعضاء البرلمان مشاعر الخزي التي تكونت أيام حادثة «فاشودا»، وكذلك خلفه فإنه سقط للعلة نفسها، وللفظين الآتيين اللذين تلوكهما أفواه المشتغلين بالسياسة مثل ذلك التأثير، وهما: التمول والصلعكة.
وقد تبلغ الألفاظ في فعلها مبالغًا تؤثر أحيانًا في أكثر الرجال تأملًا، وعندما تكون النفس إزاء حادثة يتعذر اكتناهها فإنها تكتفي بإيجاد صيغة، فلما جهل العلماء أسرار الحياة وعجزوا عن بيان السبب في تحول حبة البلوط إلى سنديانة، وعن بيان الكيفية التي تتطور بها ذوات الحياة اكتفوا بصيغ تقوم مقام التفسير والإيضاح.
والألفاظ توقظ في المرء صورًا نفسية، ولكن الصور المرسومة أجلب للإنسان، وإني ذكرت في كتابي المسمى «روح السياسة» مقدار ما أوجبته الإعلانات المصورة من تأثير كبير في الانتخابات الأخيرة التي وقعت في إنكلترا، وقد أدرك أرباب الصناعة والطباعة هذا الأمر فتفننوا في استعمال الإعلانات المصورة ترويجًا لسلعهم.
وولاة الأمور أنفسهم قد اطلعوا على شأن الصور في تكوين الآراء، فبعدما قلَّ الاكتتاب الاختياري في كتائب الفرسان فكَّر منذ بضع سنين أحد رجال الحرب الواقفين على سنن النفس في تعليق إعلانات مصورة تمثل فرسانًا نشطين يقومون بأنواع التمرينات، وعلى رأس الإعلانات أشير إلى الفوائد التي ينالها المتطوعون، وقد كانت نتيجة ذلك أن استغنت أكثر الكتائب فكفَّت عن قبول اكتتابات جديدة.
5
الألفاظ والصيغ من أكثر العوامل توليدًا للآراء والمعتقدات، وهي لما فيها من قدرة رهيبة قد أوجبت هلاك أناس أكثر من الذين قتلتهم المدافع، وما في الألفاظ من قدرة فناشئ عن أنها توقظ في المرء مشاعر دالة عليها، وقد بيَّنت في مؤلفات أخرى ما لها من الشأن في أمور السياسة.١
إن قوة الصيغ عظيمة في المجالس، فبها يحرك رجال السياسة مشاعر السامعين، ولم يلبث رئيس الوزارة الفرنسوية الموسيو (كليمانسو) أن سقط بغتةً بتأثير لفظ واحد أيقظ في أعضاء البرلمان مشاعر الخزي التي تكونت أيام حادثة «فاشودا»، وكذلك خلفه فإنه سقط للعلة نفسها، وللفظين الآتيين اللذين تلوكهما أفواه المشتغلين بالسياسة مثل ذلك التأثير، وهما: التمول والصلعكة.
وقد تبلغ الألفاظ في فعلها مبالغًا تؤثر أحيانًا في أكثر الرجال تأملًا، وعندما تكون النفس إزاء حادثة يتعذر اكتناهها فإنها تكتفي بإيجاد صيغة، فلما جهل العلماء أسرار الحياة وعجزوا عن بيان السبب في تحول حبة البلوط إلى سنديانة، وعن بيان الكيفية التي تتطور بها ذوات الحياة اكتفوا بصيغ تقوم مقام التفسير والإيضاح.
والألفاظ توقظ في المرء صورًا نفسية، ولكن الصور المرسومة أجلب للإنسان، وإني ذكرت في كتابي المسمى «روح السياسة» مقدار ما أوجبته الإعلانات المصورة من تأثير كبير في الانتخابات الأخيرة التي وقعت في إنكلترا، وقد أدرك أرباب الصناعة والطباعة هذا الأمر فتفننوا في استعمال الإعلانات المصورة ترويجًا لسلعهم.
وولاة الأمور أنفسهم قد اطلعوا على شأن الصور في تكوين الآراء، فبعدما قلَّ الاكتتاب الاختياري في كتائب الفرسان فكَّر منذ بضع سنين أحد رجال الحرب الواقفين على سنن النفس في تعليق إعلانات مصورة تمثل فرسانًا نشطين يقومون بأنواع التمرينات، وعلى رأس الإعلانات أشير إلى الفوائد التي ينالها المتطوعون، وقد كانت نتيجة ذلك أن استغنت أكثر الكتائب فكفَّت عن قبول اكتتابات جديدة.
5
(٥) الأوهام
تكتنفنا الأوهام منذ عهد الطفولة حتى الموت، فنحن لا نعيش إلا بالأوهام، ولا نتبع سوى الأوهام، وبأوهام الحب والحقد والحرص والفخر نحافظ على قوة السير والحركة فينا غافلين عن قسوة المصير.
والأوهام العقلية هي قليلة بالنسبة إلى الأوهام العاطفية، وإذا كانت تنمو فذلك لأننا نود على الدوام أن نشرح بالعقل مشاعر هي في الغالب مطمورة في دياجير اللاشعور، ويحملنا الوهم العاطفي أحيانًا على الاعتقاد بأننا نحب أناسًا وأشياء لا يهمنا بالحقيقة أمرها، ويجعلنا هذا الوهم نعتقد أيضًا دوام مشاعر لا بد من اختفائها بفعل تطورنا الشخصي.
بهذه الأوهام نحيا، وهي التي تزوق لنا الطريق المؤدية إلى الفناء الأبدي، ولا نأسف على كونه يندر تحليلها، فالعقل لا يحللها من غير أن يقضي على بواعث الحركة فينا، والعوامل التي تشل الإرادة تكثر عند البحث عن علل الإرادة، وحينئذ يغوص المرء في بحر من التناقض والتردد. كتبت مدام (دوستائيل): «إن الاطلاع على كل شيء، وإدراك كل شيء يؤديان إلى التذبذب»، فلو وُجد ذكاء له ما نعزوه إلى الآلهة من قدرة على إدراك الحال والمستقبل في لحظة واحدة لما اهتم بأي أمر، ولبطلت بواعث سيره إلى الأبد.
يظهر لنا بعد بيان ما تقدم أن الوهم هو ركن حياة الأفراد والشعوب الحقيقي، وأنه هو الذي يمكن أن يُعتمد عليه وحده، ومع ذلك فإن كتب الفلسفة تغفل عنه أحيانًا.
6
تكتنفنا الأوهام منذ عهد الطفولة حتى الموت، فنحن لا نعيش إلا بالأوهام، ولا نتبع سوى الأوهام، وبأوهام الحب والحقد والحرص والفخر نحافظ على قوة السير والحركة فينا غافلين عن قسوة المصير.
والأوهام العقلية هي قليلة بالنسبة إلى الأوهام العاطفية، وإذا كانت تنمو فذلك لأننا نود على الدوام أن نشرح بالعقل مشاعر هي في الغالب مطمورة في دياجير اللاشعور، ويحملنا الوهم العاطفي أحيانًا على الاعتقاد بأننا نحب أناسًا وأشياء لا يهمنا بالحقيقة أمرها، ويجعلنا هذا الوهم نعتقد أيضًا دوام مشاعر لا بد من اختفائها بفعل تطورنا الشخصي.
بهذه الأوهام نحيا، وهي التي تزوق لنا الطريق المؤدية إلى الفناء الأبدي، ولا نأسف على كونه يندر تحليلها، فالعقل لا يحللها من غير أن يقضي على بواعث الحركة فينا، والعوامل التي تشل الإرادة تكثر عند البحث عن علل الإرادة، وحينئذ يغوص المرء في بحر من التناقض والتردد. كتبت مدام (دوستائيل): «إن الاطلاع على كل شيء، وإدراك كل شيء يؤديان إلى التذبذب»، فلو وُجد ذكاء له ما نعزوه إلى الآلهة من قدرة على إدراك الحال والمستقبل في لحظة واحدة لما اهتم بأي أمر، ولبطلت بواعث سيره إلى الأبد.
يظهر لنا بعد بيان ما تقدم أن الوهم هو ركن حياة الأفراد والشعوب الحقيقي، وأنه هو الذي يمكن أن يُعتمد عليه وحده، ومع ذلك فإن كتب الفلسفة تغفل عنه أحيانًا.
6
(٦) الضرورة
يوجد فوق أهواء المشترعين الذين لا يفتأون يسنُّون القوانين في سبيل إصلاح المجتمع سيد قاهر؛ أعني: الضرورة، فالضرورة — وهي لا تبالي بتأملاتنا — تمثل القدر القديم الذي كانت الآلهة نفسها مكرهة على الخضوع له.
والاختلاف بين أوامر المشترعين العمي وبين الضرورة المسيطرة على الأشياء يزيد كل يوم، ومع ذلك الاختلاف نرى أن المجتمع الفرنسوي يعيش على رغم قوانينه لا بقوانينه.
والمشترعون لظنهم أنهم قادرون على عمل كل شيء لا يبقى ما هو غير ممكن في نظرهم، فيكفي عندهم أن يكون الشيء سديدًا ليكون ممكنًا، ولكن الضرورة لا تلبث أن تُبدِّد بيدها الحديدية جميع أوهامهم وخيالاتهم، ونرى في التدابير القاسية التي أملتها الضرورة في أستراليا ضد الاعتصابات المهددة لحياة تلك البلاد والمؤدية إلى خرابها مثالًا بارزًا على ذلك، والغريب في هذه المسألة هو أن أعضاء الوزارة الأسترالية كانوا من الاشتراكيين المتطرفين.
هوامش
(١) قالت جريدة الطان في عددها الصادر في ٢٩ كانون الثاني سنة ١٩١١ ما يأتي:
لقد أجاد الدكتور (غوستاف لوبون) — في كتابه الذي بحث فيه عن روح السياسة والاجتماع بحثًا عميقًا — عندما أشار بحذقه النادر وبصيرته الثاقبة إلى تأثير الألفاظ السحري في الجماعات والمجالس نيابية أم غير نيابية، فقد أتى مجلسنا النيابي بعمل يؤيد صحة نظره؛ إذ إن هذا المجلس أصبح منذ بضعة أيام مسحورًا من لائحة «اللامركزية».
7
الفيلسوف الجديد
يوجد فوق أهواء المشترعين الذين لا يفتأون يسنُّون القوانين في سبيل إصلاح المجتمع سيد قاهر؛ أعني: الضرورة، فالضرورة — وهي لا تبالي بتأملاتنا — تمثل القدر القديم الذي كانت الآلهة نفسها مكرهة على الخضوع له.
والاختلاف بين أوامر المشترعين العمي وبين الضرورة المسيطرة على الأشياء يزيد كل يوم، ومع ذلك الاختلاف نرى أن المجتمع الفرنسوي يعيش على رغم قوانينه لا بقوانينه.
والمشترعون لظنهم أنهم قادرون على عمل كل شيء لا يبقى ما هو غير ممكن في نظرهم، فيكفي عندهم أن يكون الشيء سديدًا ليكون ممكنًا، ولكن الضرورة لا تلبث أن تُبدِّد بيدها الحديدية جميع أوهامهم وخيالاتهم، ونرى في التدابير القاسية التي أملتها الضرورة في أستراليا ضد الاعتصابات المهددة لحياة تلك البلاد والمؤدية إلى خرابها مثالًا بارزًا على ذلك، والغريب في هذه المسألة هو أن أعضاء الوزارة الأسترالية كانوا من الاشتراكيين المتطرفين.
هوامش
(١) قالت جريدة الطان في عددها الصادر في ٢٩ كانون الثاني سنة ١٩١١ ما يأتي:
لقد أجاد الدكتور (غوستاف لوبون) — في كتابه الذي بحث فيه عن روح السياسة والاجتماع بحثًا عميقًا — عندما أشار بحذقه النادر وبصيرته الثاقبة إلى تأثير الألفاظ السحري في الجماعات والمجالس نيابية أم غير نيابية، فقد أتى مجلسنا النيابي بعمل يؤيد صحة نظره؛ إذ إن هذا المجلس أصبح منذ بضعة أيام مسحورًا من لائحة «اللامركزية».
7
الفيلسوف الجديد
اعتَذَر سقراط لبيرديكَّاس المقدوني عن عدم تلبية الدعوة لزيارته قائلًا: «حتى لا أموتَ أَسوأَ مِيتةٍ؛ أن أَتقبَّل معروفًا لن أكون قادرًا على ردِّه.»
التأملات
التأملات
اعتاد سقراط أن يُطلِق على الاعتقادات الشائعة اسم «بعبع»؛ أشياء تُخيف بها الأطفال.
التأملات
التأملات