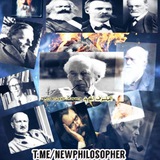ثَمَّةَ أربعةُ أدواءٍ أساسيةٍ تُصيب العقل المُوجِّه كن على حذرٍ دائمٍ منها كلما صادَفتَها، وقل في كل حالةٍ: «هذه الفكرة لا لزوم لها.» «هذه قد تُضعف وشائج المجتمع.» «هذا الذي تهمُّ بقوله لا يُعبِّر عن قناعتك الحقيقية.» (أن تقول ما لا تقتنع به هو قمة التناقُض). أما الرابع فهو عندما تُبكِّت نفسَك على أي شيء؛ فهذا دليلٌ على أن الجزء الأكثر ألوهةً فيك قد خَضعَ واستسلم للجزء الأدنى والفاني — أي الجسد — ولذَّاتِه العنيفة.
التأملات
التأملات
عِش الحياةَ على أفضلِ نحوٍ ممكن. بوُسعِ الروح أن تفعل ذلك إذا كانت غير مكترثةٍ بالأشياء غير الفارقة indifferent. وستكون غيرَ مكترثةٍ بهذه الأشياء إذا نظرت إليها ككلٍّ وإلى كلٍّ منها على حدة، وتَذكَّرَت أنْ لا شيء من هذه الأشياء يُصدِر حكمًا عن نفسه أو يَفرِض نفسه علينا؛ فالأشياء ذاتُها خاملة. وإنما نحن الذين نُنتِج الأحكام عنها ونَطبَعها في عقولنا. وإنَّ بِوُسعِنا ألَّا نَطبَعها على الإطلاق، وأن نمحُو في الحال أي حكمٍ تَصادَف انطباعُه. تَذكَّرْ أيضًا أن انتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يَدومَ إلَّا لحظةً قصيرةً ثم تنتهي الحياة. وما الصعب في ذلك على أية حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقةً مع الطبيعة فتقبَّلها وستَجِدها سهلةً يسيرة، وإذا كانت ضد الطبيعة فابحث عما هو متفقٌ مع طبيعتك واسعَ في طلبه حتى لو لم يأتِ معه بمجد؛ فمن حق كل إنسانٍ أن يلتمس ما هو خيرٌ له.
التأملات
التأملات
فلانٌ يحتقرني؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل حريصًا على ألا يَبدُر مني أي لفظٍ أو فعلٍ يستوجب الازدراء. سيكرهني فلانٌ؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل رفيقًا حسن النية تجاه الجميع، ومستعدًّا لأن أُظهِر فلانًا هذا على خطئه؛ لا بتأنيبٍ ولا بتصنُّع التسامُح، بل بنبالةٍ وإخلاصٍ حقيقيَّين، مثل فوكيون العظيم (ما لم يكن مُتهكِّمًا في قوله).١٩ هكذا ينبغي أن يكون ضميرنا الباطن، الذي تراه أعينُ الآلهة: ينبغي أن ترانا الآلهةُ غير ساخطِين ولا شاكِين. وماذا يَضيرُك إذا كنتَ الآن تَفعلُ ما تُسيغُه طبيعتُك وما يفي بالغرضِ الحاضرِ لطبيعة العالم — إنسانًا أُسنِد إليه تحقيقُ الخيرِ العامِّ على هذا النحوِ أو ذاك؟
التأملات
التأملات
ما أَشدَّ كذبه وتصنُّعَه ذلك الذي يقول: «لقد عَقدتُ النية على أن أكون مخلصًا لكَ.» ماذا تفعل أيها الرجل، وما الداعي لهذه المُقدِّمات؟ الأفعال سوف تكشف كل شيء. الإخلاص ينبغي أن يكون مكتوبًا على جبينك، متجليًا في نغمة صوتك وبريق عينَيك، تمامًا كما يقرأ المحبوب كل شيء في أَعيُن مُحبِّيه. للصلاح والإخلاص شميمٌ نافذٌ لا يُخطِئه العابر. أمَّا تكلُّف الإخلاص فأَشبَه بالخِنجر. لا شيء أكثر شَينًا من صداقة الذئاب. فبُعدًا لها. الرجل الصالح والطيِّب والخيِّر تَنضَح نظرته بهذه الصفات كلها ولا تُخطِئه العين.
التأملات
التأملات
روسكين
دين الجمال
نقولا فياض
كان والد روسكين تاجر خمور، ولكنه كان يتعشق الطبيعة، ويحب الأدب والتصوير، ويميل إلى الأسفار، وقد ترك لابنه ثروة واسعة، مع هذا الغرام الفطري بالطبيعة والجمال. على أن الجمال لم يكن يتجلى له بادئ ذي بدء إلا من خلال الضباب الضارب قبابه في كل ناحية من لندن. ولما خرج منها إلى الأرباض أخذ يتعرف إلى جمال الأشياء فيما كانت تقع عليه عيناه من المروج الخضراء وبساتين الكرز والتوت، ومناظر تلك الثمار السحرية المتعددة الألوان، وعناقيد اللآلئ المخبَّأة بين الأوراق، فكان الفتى روسكين يرى فيها فردوسه الأرضي، ويقضي عندها الساعات الطوال سابحًا في بحر الخيال بين التأملات والأحلام.
وكانت أمُّه من المتزمتات لا تني في أداء مهمتها كزوج وكأم، حتى رضيت أن ترافقه إلى أوكسفورد الغريبة عنها؛ لتكون على مقربة منه تسهر عليه وتُقصي عنه الألم ما أمكن، والأخطار ما استطاعت، وإن أدى ذلك إلى إضعاف بنيته، أو سد أبواب اللباقة والمهارة في وجهه. وكانت تُعنى بتعليمه العهدين القديم والجديد، فترعرع في النعمة والترف، لا يعرف ما هو الهم، ولا يفهم معنى للحسد أو الطمع، ولا تقرع أذنيه كلمة لوم أو جدل، فكان السلام والطاعة والإيمان الإطار الذي يكتنف حياته؛ فنما الذوق فيه بعيدًا عن المؤثرات الخارجية.
وكان أبوه يقوده في ساعات الفراغ إلى الأنقاض والمعابد والقصور التي يمر بها في أسفاره العديدة، فيملأ منه السمع والبصر بالأناشيد والأشعار والصور، فزار إسكتلندة في الخامسة من عمره، وباريس في السادسة، وشهد تتويج شارل العاشر، ووقف في ساحة واترلو، وعاد إلى إنكلترا وهو يكتب ذكريات ويخط رسومًا، فيصف المدارس والكنائس، وموسيقى أوكسفورد وقبر شكسبير، ومعملًا للدبابيس في برمنكهام، وينظم الشعر في العاشرة، ويجمع الحجارة النادرة في الأودية، ويراقب الأنوار ويقيس الأبعاد. وكل ما كان يستشفه بفكره الثاقب كان يتعشقه بقلب خلي بِكر ظمآن. وكان يهتم بالأشياء أكثر من اهتمامه بالأحياء، ولا سيما ما اتصل منها بالجمال، وفيها ما فيها من أسباب اللذة أو الألم، فتراه مثلًا مشغولًا بالصور المعلقة على جدران البيت الذي يزوره عن أهل البيت أنفسهم.
وأول ما تعرف إلى الجمال كان عندما رأى في الأفق غيومًا صافية كالبلور، وقد صبغتها شمس المساء بلونها الوردي، فما كان الفردوس المفقود بأجمل منها في عينيه!
وأصبحت تأملاته في الطبيعة لا للتسلية، بل نوعًا من دعوة قدسية نحو المثل الأعلى. فصار تاريخ حياته منذ ذلك الحين تاريخ اجتماعه إلى الطبيعة في سفراته المتعددة كل عام، والتي لم يكن يأتيها حبًّا بالاستجمام فحسب، بل كان يذهب إليها كما يذهب إلى الله الذي يفتح للشباب أبواب الفرح!
ولم يكن يستطيع وصفها وتعريفها، فكان يقول: «أي نوع من الشعور البشري هذا الإحساس الذي يُحَب فيه الحجر للحجر والغيم للغيم؟ إن القرد يحب القرد لأنه قرد، وتُحَب شجرة الجوز لثمرها، ولكن الحجر لا يُحَب لأنه حجر. أما أنا فقد كانت لي الحجارة خبزًا.»
ولكي يرى هذه الحجارة عن كثب كان يصرف الأشهر الطوال في سويسرا وإيطاليا. وأحبَّ أن يُقيم في «شافونكين»، إلا أن تزاحم السياح منعه، ففكر في شراء قمة «برازون»، ولكن الفلاحين تعجبوا كيف تُشرى مثل هذه الأرض الصخرية القاحلة؛ فظنوا أن هناك كنزًا وما زالوا عليه حتى أبعدوه.
وما كاد يرفع عينيه عن كتبه حتى وقعتا على فتاة قلبه وعمره ١٧ سنة. وكانت إسبانية المولد، باريسية التربية، كاثوليكية المذهب، فلم يرُقْ لأمه البروتستانتية هذا الحب، وما زالت به حتى حملته على نسيانها مستعينة بالأسفار بين فرنسا وروما وجبال الألب.
1
دين الجمال
نقولا فياض
كان والد روسكين تاجر خمور، ولكنه كان يتعشق الطبيعة، ويحب الأدب والتصوير، ويميل إلى الأسفار، وقد ترك لابنه ثروة واسعة، مع هذا الغرام الفطري بالطبيعة والجمال. على أن الجمال لم يكن يتجلى له بادئ ذي بدء إلا من خلال الضباب الضارب قبابه في كل ناحية من لندن. ولما خرج منها إلى الأرباض أخذ يتعرف إلى جمال الأشياء فيما كانت تقع عليه عيناه من المروج الخضراء وبساتين الكرز والتوت، ومناظر تلك الثمار السحرية المتعددة الألوان، وعناقيد اللآلئ المخبَّأة بين الأوراق، فكان الفتى روسكين يرى فيها فردوسه الأرضي، ويقضي عندها الساعات الطوال سابحًا في بحر الخيال بين التأملات والأحلام.
وكانت أمُّه من المتزمتات لا تني في أداء مهمتها كزوج وكأم، حتى رضيت أن ترافقه إلى أوكسفورد الغريبة عنها؛ لتكون على مقربة منه تسهر عليه وتُقصي عنه الألم ما أمكن، والأخطار ما استطاعت، وإن أدى ذلك إلى إضعاف بنيته، أو سد أبواب اللباقة والمهارة في وجهه. وكانت تُعنى بتعليمه العهدين القديم والجديد، فترعرع في النعمة والترف، لا يعرف ما هو الهم، ولا يفهم معنى للحسد أو الطمع، ولا تقرع أذنيه كلمة لوم أو جدل، فكان السلام والطاعة والإيمان الإطار الذي يكتنف حياته؛ فنما الذوق فيه بعيدًا عن المؤثرات الخارجية.
وكان أبوه يقوده في ساعات الفراغ إلى الأنقاض والمعابد والقصور التي يمر بها في أسفاره العديدة، فيملأ منه السمع والبصر بالأناشيد والأشعار والصور، فزار إسكتلندة في الخامسة من عمره، وباريس في السادسة، وشهد تتويج شارل العاشر، ووقف في ساحة واترلو، وعاد إلى إنكلترا وهو يكتب ذكريات ويخط رسومًا، فيصف المدارس والكنائس، وموسيقى أوكسفورد وقبر شكسبير، ومعملًا للدبابيس في برمنكهام، وينظم الشعر في العاشرة، ويجمع الحجارة النادرة في الأودية، ويراقب الأنوار ويقيس الأبعاد. وكل ما كان يستشفه بفكره الثاقب كان يتعشقه بقلب خلي بِكر ظمآن. وكان يهتم بالأشياء أكثر من اهتمامه بالأحياء، ولا سيما ما اتصل منها بالجمال، وفيها ما فيها من أسباب اللذة أو الألم، فتراه مثلًا مشغولًا بالصور المعلقة على جدران البيت الذي يزوره عن أهل البيت أنفسهم.
وأول ما تعرف إلى الجمال كان عندما رأى في الأفق غيومًا صافية كالبلور، وقد صبغتها شمس المساء بلونها الوردي، فما كان الفردوس المفقود بأجمل منها في عينيه!
وأصبحت تأملاته في الطبيعة لا للتسلية، بل نوعًا من دعوة قدسية نحو المثل الأعلى. فصار تاريخ حياته منذ ذلك الحين تاريخ اجتماعه إلى الطبيعة في سفراته المتعددة كل عام، والتي لم يكن يأتيها حبًّا بالاستجمام فحسب، بل كان يذهب إليها كما يذهب إلى الله الذي يفتح للشباب أبواب الفرح!
ولم يكن يستطيع وصفها وتعريفها، فكان يقول: «أي نوع من الشعور البشري هذا الإحساس الذي يُحَب فيه الحجر للحجر والغيم للغيم؟ إن القرد يحب القرد لأنه قرد، وتُحَب شجرة الجوز لثمرها، ولكن الحجر لا يُحَب لأنه حجر. أما أنا فقد كانت لي الحجارة خبزًا.»
ولكي يرى هذه الحجارة عن كثب كان يصرف الأشهر الطوال في سويسرا وإيطاليا. وأحبَّ أن يُقيم في «شافونكين»، إلا أن تزاحم السياح منعه، ففكر في شراء قمة «برازون»، ولكن الفلاحين تعجبوا كيف تُشرى مثل هذه الأرض الصخرية القاحلة؛ فظنوا أن هناك كنزًا وما زالوا عليه حتى أبعدوه.
وما كاد يرفع عينيه عن كتبه حتى وقعتا على فتاة قلبه وعمره ١٧ سنة. وكانت إسبانية المولد، باريسية التربية، كاثوليكية المذهب، فلم يرُقْ لأمه البروتستانتية هذا الحب، وما زالت به حتى حملته على نسيانها مستعينة بالأسفار بين فرنسا وروما وجبال الألب.
1
وكان حبه للطبيعة ككل حب؛ أي مزيجًا من الفرح والكآبة، واللذة والألم، فإذا مر يومًا بمكان تبدَّل العهد به فرآه على غير ما عرفه من قبل؛ لوجود ميناء جديدة مثلًا، أو سكة حديد، أو أبنية لتنشيط السياحة، شعر بجرح في فؤاده كأنما هي حبيبته قد أُهينت، وصاح بمواطنيه: «إنكم احتقرتم الطبيعة وكل ما تُثير فينا مناظرها من نبيل الشعور. إن الثوار في فرنسا جعلوا الكنائس حرائس للخيل، وأنتم حولتم إلى ميادين سباق كلَّ معابد الأرض؛ أي الجبال التي يمكن فيها عبادة الله بأحسن ما يُعبد، وأقصى أمانيكم أن تمروا في السكة الحديدية من أمام هذه المعابد، وتأكلوا على مذابحها.»
هذا الإغراق في حب الطبيعة كان يلهيه عن كل ما حوله، وكثيرًا ما بقي أيامًا يجهل الجديد من الأحداث في بلاده، وهكذا سقطت الخرطوم وقُتل غوردون باشا، ولم يعرف بهذا ولا ذاك.
وتزوج سنة ١٨٤٨، ثم طلق زوجته بعد ست سنوات، ولم تخبُ نار الحماسة فيه يومًا، ولا تحول نظره في الآفاق المشعة التي علِق بها فؤاده.
•••
هذا الرجل السابح في الخيال كان في الوقت عينه رجل عمل، وبذلك يختلف عن غيره من النقاد والشعراء الذين يكتفون بالوصف والغزل دون أن يفكروا بالإصلاح العملي، فكان كلما أرسل فكرة أو أخرج كتابًا ينزل بنفسه إلى المعركة؛ ليرى ما صارت إليه فكرته، وليُدافع عنها. وقد نادى بتربية الذوق وتنمية روح الفن في الجماعات فلم يُسمع نداؤه؛ فقدم نفسه لإعطاء دروس ليلية في الرسم مدة أربع سنوات، وأنشأ بماله متحفًا للفن على رابية تطل على المروج الخضراء، ثم عُيِّن أستاذًا في أوكسفورد، فأراد أن يقرن العلم بالعمل؛ فأقام فيها متحفًا ووهب المدرسة مالًا، وتطوَّع طوال ثلاث عشرة سنة لعبادة الجمال، والتبشير به.
ولما أدخلوا في التدريس علم التشريح استقال؛ لأن التشريح في نظره بشاعة، فضلًا عن قلة فائدته، بدليل أن كثيرًا من العلماء كانوا في غِنًى عنه، وأن النحاتين اليونان كانوا يجهلون التشريح.
ولكن ما الفائدة من المجامع العلمية وما يُقدَّم فيها من أمثلة للجمال ما دام العالم مملوءًا بالبشاعة، وما دام رجال القرى يتركون الأعمال التي تُقوي عضلات الجسم، ويتزاحمون في المدن لخدمة الآلة، وقد أصبحوا مثلها في أيدي رؤسائهم؟ ما الفائدة من المتاحف ما دامت أجمل مناظر الطبيعة تتوارى خلف البنايات الحديثة والمصانع التي تخنق خضرة الدمن، وتُسوِّد بالدخان وجه السماء؟ إن دخان المعامل كالبَرَص يأكل المباني ويهين المدن ويُفسد المناظر. البلد الغني بلد بشع، والآلة تحط من مقام الإنسان.
هو يريد أن تكون أراضي إنكلترا جميلة هادئة، لا أدوات بخار ولا سكك حديد ولا أناس لا إرادة لهم ولا تفكير. هو لا يطلب الحرية، بل المساواة في الخضوع للشرائع والقوانين، وإذا احتيج إلى التنقل من مكان إلى آخر فليكن ذلك براحة وأمان، دون التعرض لأخطار السرعة وغير ذلك. هو يطلب كثيرًا من الأزهار وكثيرًا من الشعر والموسيقى.
حُلم من الأحلام ساوره أيام قامت ثورة الكومون في فرنسا، وأراد أن يحقق ما بشر به، فجاء باللآلئ للمتاحف، وبالخبز للأكواخ، ودفعه حبه للزراعة إلى منح بعض أراضيه للشيوعيين؛ ليُجربوا آراءهم في استثمارها على شرط أن يحتفظوا بآرائه فيما يختص بجمال الأشياء، غير أن التجربة لم تنجح، ولم تُسفر إلا عن خلْق بعض المقاهي وأندية اللهو.
لقد أراد هذا المجدِّد الرجعي أن يعود بعصره القهقرى، بترك الآلة والبخار واعتماد اليد والمغزل، ونفَس الإنسان الحي؛ فعم هذا العمل بين النساء، وأصبح من العادات السائدة أن يُهدى للعروس نسيج روسكين، واستُغنِي عن الآلة أينما أمكن أن يقوم العمل اليدوي مقامها؛ تمرينًا وتقوية للعضلات. ولم يكن كبعض القسس الذين يعظون الفقراء ويتنعمون بمآكل الأغنياء، بل أجرى على نفسه ما سنَّه من الخضوع لشرائع الجمال، وقام بتجفيف الأراضي على ضفاف بحيرة كونيستون، غير آبهٍ بالنفقات ليلهي الفلاحين عن المدينة، وبنى جسرًا صغيرًا على البحيرة بمعونة بعض تلامذته، وتعلم النجارة والدهان؛ فهو من هذا القبيل يُشبه تولستوي الذي قال عنه: إنه من أعظم رجال العصر.
2
هذا الإغراق في حب الطبيعة كان يلهيه عن كل ما حوله، وكثيرًا ما بقي أيامًا يجهل الجديد من الأحداث في بلاده، وهكذا سقطت الخرطوم وقُتل غوردون باشا، ولم يعرف بهذا ولا ذاك.
وتزوج سنة ١٨٤٨، ثم طلق زوجته بعد ست سنوات، ولم تخبُ نار الحماسة فيه يومًا، ولا تحول نظره في الآفاق المشعة التي علِق بها فؤاده.
•••
هذا الرجل السابح في الخيال كان في الوقت عينه رجل عمل، وبذلك يختلف عن غيره من النقاد والشعراء الذين يكتفون بالوصف والغزل دون أن يفكروا بالإصلاح العملي، فكان كلما أرسل فكرة أو أخرج كتابًا ينزل بنفسه إلى المعركة؛ ليرى ما صارت إليه فكرته، وليُدافع عنها. وقد نادى بتربية الذوق وتنمية روح الفن في الجماعات فلم يُسمع نداؤه؛ فقدم نفسه لإعطاء دروس ليلية في الرسم مدة أربع سنوات، وأنشأ بماله متحفًا للفن على رابية تطل على المروج الخضراء، ثم عُيِّن أستاذًا في أوكسفورد، فأراد أن يقرن العلم بالعمل؛ فأقام فيها متحفًا ووهب المدرسة مالًا، وتطوَّع طوال ثلاث عشرة سنة لعبادة الجمال، والتبشير به.
ولما أدخلوا في التدريس علم التشريح استقال؛ لأن التشريح في نظره بشاعة، فضلًا عن قلة فائدته، بدليل أن كثيرًا من العلماء كانوا في غِنًى عنه، وأن النحاتين اليونان كانوا يجهلون التشريح.
ولكن ما الفائدة من المجامع العلمية وما يُقدَّم فيها من أمثلة للجمال ما دام العالم مملوءًا بالبشاعة، وما دام رجال القرى يتركون الأعمال التي تُقوي عضلات الجسم، ويتزاحمون في المدن لخدمة الآلة، وقد أصبحوا مثلها في أيدي رؤسائهم؟ ما الفائدة من المتاحف ما دامت أجمل مناظر الطبيعة تتوارى خلف البنايات الحديثة والمصانع التي تخنق خضرة الدمن، وتُسوِّد بالدخان وجه السماء؟ إن دخان المعامل كالبَرَص يأكل المباني ويهين المدن ويُفسد المناظر. البلد الغني بلد بشع، والآلة تحط من مقام الإنسان.
هو يريد أن تكون أراضي إنكلترا جميلة هادئة، لا أدوات بخار ولا سكك حديد ولا أناس لا إرادة لهم ولا تفكير. هو لا يطلب الحرية، بل المساواة في الخضوع للشرائع والقوانين، وإذا احتيج إلى التنقل من مكان إلى آخر فليكن ذلك براحة وأمان، دون التعرض لأخطار السرعة وغير ذلك. هو يطلب كثيرًا من الأزهار وكثيرًا من الشعر والموسيقى.
حُلم من الأحلام ساوره أيام قامت ثورة الكومون في فرنسا، وأراد أن يحقق ما بشر به، فجاء باللآلئ للمتاحف، وبالخبز للأكواخ، ودفعه حبه للزراعة إلى منح بعض أراضيه للشيوعيين؛ ليُجربوا آراءهم في استثمارها على شرط أن يحتفظوا بآرائه فيما يختص بجمال الأشياء، غير أن التجربة لم تنجح، ولم تُسفر إلا عن خلْق بعض المقاهي وأندية اللهو.
لقد أراد هذا المجدِّد الرجعي أن يعود بعصره القهقرى، بترك الآلة والبخار واعتماد اليد والمغزل، ونفَس الإنسان الحي؛ فعم هذا العمل بين النساء، وأصبح من العادات السائدة أن يُهدى للعروس نسيج روسكين، واستُغنِي عن الآلة أينما أمكن أن يقوم العمل اليدوي مقامها؛ تمرينًا وتقوية للعضلات. ولم يكن كبعض القسس الذين يعظون الفقراء ويتنعمون بمآكل الأغنياء، بل أجرى على نفسه ما سنَّه من الخضوع لشرائع الجمال، وقام بتجفيف الأراضي على ضفاف بحيرة كونيستون، غير آبهٍ بالنفقات ليلهي الفلاحين عن المدينة، وبنى جسرًا صغيرًا على البحيرة بمعونة بعض تلامذته، وتعلم النجارة والدهان؛ فهو من هذا القبيل يُشبه تولستوي الذي قال عنه: إنه من أعظم رجال العصر.
2
👍1
وأنشأ في البرية مكتبة جامعة كان يحمل إليها الكتب على ظهور البغال احتجاجًا على المدينة وسكك الحديد. وكانت بعض العائلات تقوم بترتيب هذه الكتب وإرسالها لمن يريد مطالعتها خدمة له، وإعجابًا به، فلا ناشر ولا وسيط، بل هي الأيدي نفسها التي كانت تنظم الكتب كانت تنسخها وتكتب المقالات عن مذهب المعلم وتحفر له الرسوم. وكان يقول: في وسعي أن أربح من كتبي ما شئت إذا رشوت النقاد في المجلات والجرائد، ودفعت نصف ما أربح للمكاتب ولمن يلصق الإعلانات، وسايرت أسقف بتربوروف.
وقد أفلح في مشروعه؛ فإن كتابًا من كتبه «المصابيح السبعة للبناء» ربح ٧٥ ألف فرنك، وكتابًا آخر عنوانه «السمسم والزنابق» يُباع منه كل عام ٣ آلاف نسخة.
وكان المتحف الوطني لسنة ١٨٤٥ فقيرًا خاليًا من التحف الثمينة، فرفع صوته مطالبًا بالعناية به، فأغناه بألواح من أشهر الفنانين مما لا تجده حتى في اللوفر. ولما ظهر كتابه «حجارة فينيسيا» وكتابه الآخر «المصابيح السبعة» تغير البناء الإنكليزي واكتسب مسحة جديدة جميلة. وفي سنة ١٨٥٤ شهر الحرب على «سراي البلور» منتقدًا هذا البناء القائم على الحديد والزجاج وما يقتضي من النفقات، وطلب تأليف لجنة لحماية البناء الحجري؛ فكان له ما أراد. وأدرك الناس ما في جانب هذا الرجل من الحق، وأن مناظر الطبيعة منبع غِنًى، فأصبحوا إذا أرادوا مد سكة حديد في مكان ما يستعينون برأي أصحاب الفن، فلا يُقدمون على تشويه جمال تلك البقعة. ولم تلقَ دعايته للألبسة القديمة والأعياد الرمزية آذانًا صماء. والغريب أن الذي يمر اليوم بمدرسة البنات في «شلسا» أول أيار يرى المعبد والدار مزدانة بالأزهار مهداة من كل أنحاء إنكلترا. فتنتخب الطالبات ملكة أيار من بينهن فتمر تحت قبة من الأغصان المتعانقة، ووراءها ملكة العام الماضي، ثم تعتلي العرش بين صفين، وتمر الطالبات من أمامها يتقبلن الهدايا من يديها، وكلها مؤلفات روسكين.
•••
لم يفهم الناس روسكين فرموه بالتعصب والكبرياء والتناقض، وجعلوا إخلاصه استبدادًا، وكرمه الحاتمي محبة ذات؛ ذلك لأنه كان صريحًا إلى أبعد حدود الصراحة، لا يبالي برضاء الناس أو غضبهم. قال له أحدهم يومًا: إني معجب بما تكتب، فأجابه: وما يهمني إعجابك، أتُراك استفدت شيئًا مما أكتب؟ وجاءه وفد من طلاب غلاسكو يرشحونه لرئاسة جمعيتهم فسألوه: هل هو مع دزرائيلي أو غلادستون؟ فأجابهم: وماذا يهمكم دزرائيلي أو غلادستون؟ أنتم طلاب علم، وما عليكم أن تهتموا بالسياسة أكثر من اهتمامكم بمطاردة الفئران، ولو أنكم قرأتم عشرة أسطر لي لأدركتم أنني لا أسأل عن غلادستون أو دزرائيلي، ولكني أكره التحزب السياسي كرهي للشيطان. وأنا، مع كارليل، لله وللملك.
ولم يسلم هو نفسه من نقداته اللاذعة، وكم رجع عن خطأ سابق! وكان صارمًا في انتقاده كتبه. وكان إنسانيًّا بكل ما في هذه الكلمة من معاني الإنسانية؛ فساعد الفقير والعامل، وبدد ثروته البالغة خمسة ملايين في جواهر للمتاحف وخبز للأكواخ.
وكان إلى ذلك خطيبًا ساحرًا. انظر إليه وهو يصعد إلى المنبر في أوكسفورد وقد ضاق النادي بالحاضرين وهجر التلامذة صفوفهم ليسمعوا، وامتلأت النوافذ والشرفات، وتعذر إقفال الأبواب لازدحام الناس، والنساء كالرجال عددًا، وبينهن أمريكانيات عبرن الأطلسي لسماع ذاك الذي يُسميه كارليل «روسكين الأثيري». وما كاد يطل عليهم حتى علا الهتاف من كل جانب، ووقف الناس على رءوس أرجلهم ليروا تلك القامة المديدة، والشعر الطويل، والعينين المتغيرتين كالأمواج، والفم المتحرك كالقوس عندما ينطلق عنه السهم، والسحنة الجامعة في ملامحها بين الحماسة والهزء والتأمل، حتى إذا أنصت القوم حيَّاهم بابتسامة، وأخرج بين يديه أشياء مختلفة من حجارة ومعادن وصور ونقود وما شاكل، يستشهد بها في عرض حديثه، ثم يبدأ بالكلام بهدوء كأنه قس يتلو صفحة من التوراة، ويرتفع صوته شيئًا فشيئًا فيترك أوراقه جانبًا، ويُجيل بصره في الجمهور وقد ملك عليهم مشاعرهم.
3
وقد أفلح في مشروعه؛ فإن كتابًا من كتبه «المصابيح السبعة للبناء» ربح ٧٥ ألف فرنك، وكتابًا آخر عنوانه «السمسم والزنابق» يُباع منه كل عام ٣ آلاف نسخة.
وكان المتحف الوطني لسنة ١٨٤٥ فقيرًا خاليًا من التحف الثمينة، فرفع صوته مطالبًا بالعناية به، فأغناه بألواح من أشهر الفنانين مما لا تجده حتى في اللوفر. ولما ظهر كتابه «حجارة فينيسيا» وكتابه الآخر «المصابيح السبعة» تغير البناء الإنكليزي واكتسب مسحة جديدة جميلة. وفي سنة ١٨٥٤ شهر الحرب على «سراي البلور» منتقدًا هذا البناء القائم على الحديد والزجاج وما يقتضي من النفقات، وطلب تأليف لجنة لحماية البناء الحجري؛ فكان له ما أراد. وأدرك الناس ما في جانب هذا الرجل من الحق، وأن مناظر الطبيعة منبع غِنًى، فأصبحوا إذا أرادوا مد سكة حديد في مكان ما يستعينون برأي أصحاب الفن، فلا يُقدمون على تشويه جمال تلك البقعة. ولم تلقَ دعايته للألبسة القديمة والأعياد الرمزية آذانًا صماء. والغريب أن الذي يمر اليوم بمدرسة البنات في «شلسا» أول أيار يرى المعبد والدار مزدانة بالأزهار مهداة من كل أنحاء إنكلترا. فتنتخب الطالبات ملكة أيار من بينهن فتمر تحت قبة من الأغصان المتعانقة، ووراءها ملكة العام الماضي، ثم تعتلي العرش بين صفين، وتمر الطالبات من أمامها يتقبلن الهدايا من يديها، وكلها مؤلفات روسكين.
•••
لم يفهم الناس روسكين فرموه بالتعصب والكبرياء والتناقض، وجعلوا إخلاصه استبدادًا، وكرمه الحاتمي محبة ذات؛ ذلك لأنه كان صريحًا إلى أبعد حدود الصراحة، لا يبالي برضاء الناس أو غضبهم. قال له أحدهم يومًا: إني معجب بما تكتب، فأجابه: وما يهمني إعجابك، أتُراك استفدت شيئًا مما أكتب؟ وجاءه وفد من طلاب غلاسكو يرشحونه لرئاسة جمعيتهم فسألوه: هل هو مع دزرائيلي أو غلادستون؟ فأجابهم: وماذا يهمكم دزرائيلي أو غلادستون؟ أنتم طلاب علم، وما عليكم أن تهتموا بالسياسة أكثر من اهتمامكم بمطاردة الفئران، ولو أنكم قرأتم عشرة أسطر لي لأدركتم أنني لا أسأل عن غلادستون أو دزرائيلي، ولكني أكره التحزب السياسي كرهي للشيطان. وأنا، مع كارليل، لله وللملك.
ولم يسلم هو نفسه من نقداته اللاذعة، وكم رجع عن خطأ سابق! وكان صارمًا في انتقاده كتبه. وكان إنسانيًّا بكل ما في هذه الكلمة من معاني الإنسانية؛ فساعد الفقير والعامل، وبدد ثروته البالغة خمسة ملايين في جواهر للمتاحف وخبز للأكواخ.
وكان إلى ذلك خطيبًا ساحرًا. انظر إليه وهو يصعد إلى المنبر في أوكسفورد وقد ضاق النادي بالحاضرين وهجر التلامذة صفوفهم ليسمعوا، وامتلأت النوافذ والشرفات، وتعذر إقفال الأبواب لازدحام الناس، والنساء كالرجال عددًا، وبينهن أمريكانيات عبرن الأطلسي لسماع ذاك الذي يُسميه كارليل «روسكين الأثيري». وما كاد يطل عليهم حتى علا الهتاف من كل جانب، ووقف الناس على رءوس أرجلهم ليروا تلك القامة المديدة، والشعر الطويل، والعينين المتغيرتين كالأمواج، والفم المتحرك كالقوس عندما ينطلق عنه السهم، والسحنة الجامعة في ملامحها بين الحماسة والهزء والتأمل، حتى إذا أنصت القوم حيَّاهم بابتسامة، وأخرج بين يديه أشياء مختلفة من حجارة ومعادن وصور ونقود وما شاكل، يستشهد بها في عرض حديثه، ثم يبدأ بالكلام بهدوء كأنه قس يتلو صفحة من التوراة، ويرتفع صوته شيئًا فشيئًا فيترك أوراقه جانبًا، ويُجيل بصره في الجمهور وقد ملك عليهم مشاعرهم.
3
وكان محاميًا فصار نبيًّا. أغريزة أم علم أم دهاء أم عبقرية؟ لا يعرفون، ولكنهم يصغون إليه وقد طرحوا الورق والقلم، وأعرضوا عن تدوين ما يسمعون، ومشوا وراءه في الطريق الملتوية التي يقودهم فيها، وفي كل منعطف وادٍ جديد وأفق جديد. وما هي إلا لحظات وإذا بهم يرتفعون معه ارتفاعًا مستمرًّا حتى يصلوا إلى القمة التي تُشرف على العالم.
هذا الساحر العظيم كانت له أسطورته كالأبطال. يُقال: إنه دخل يومًا مخزن مجوهرات فعرفه البائع، فأقبل عليه يعرض كل ما عنده من الحجارة الكريمة، طالبًا إليه أن يكشف عن أسرارها، وتألبت من حوله فتيات المحل والسيدات الشاريات، فوقف بينهن وتكلم، تكلم بعلم الزعنفة الذي يسلب الأمواج درها، وسحر الجنية التي تحرس الدر: هذا الياقوت الأحمر وردة فارسية، لون الفرح والحب والحياة على الأرض، الزهرة التي استُخدم برعمها لإناء العطر الذي سكبت منه المجدلية على قدمي المخلص، وهذا اللازورد مثل الفرح والحب في السماء، لا تفرق عن الياقوت إلا بلونها الأزرق، وهذه اللؤلؤة خضوع الضياء، رمز الصبر، لون الحمامة التي تبشر بتراجع المياه، والمرغريت زهرة اللؤلؤ، والأقحوان رمز التواضع، ولكنها غالية الثمن؛ لأن التواضع يفتح أبواب الفردوس المطعمة جدرانه بالزبرجد.
وقصَّ عليهن ولادة هذه الأحجار في أعماق الأرض والبحار، ثم التفت إليهن يقول ما معناه: «هل من المعقول أن نحب هذه الحجارة ونكرمها؟ نعم، على شرط أن تكون هي التي نحب لا ذواتنا. إن عبادة الحجر الأسود الهابط من السماء لا تبعد كثيرًا عن الحكمة التي هي عبادة السماء نفسها. وليس من الجنون أن نفكر في أن الحجارة ترى، بل الجنون إذا فكرنا أن العيون لا ترى. ليس من الجنون أن نفكر أن اليوم الذي تُجمع فيه الجواهر تكون حجر الزاوية لجدران الهيكل، ولكن من الجنون أن نظن أن يوم انهيار الهيكل تذهب الأرواح هباء ولا تبقى روحانية ما فوق الأنقاض.»
«نعم، أيتها السيدات الجميلات، أحببن الجواهر واعتنين بها، ولكن أحببن نفوسكن أكثر، واعتنين بها ليوم يجمع السيد جواهره.»
وكانت السيدات يُصغين بخشوع ووهن إلى هذه الأقوال التي لم يسمعنها من أفواه من يرقص معهن في ساعات اللهو والسرور.
هكذا تريد الأسطورة أن يُلقي المعلم تعاليمه لا في المدارس والمعاهد فقط، بل على الطرق أيضًا.
إن فضل روسكين أنه أيقظ الأفكار، ولفت نحو الجماعات أنظار الأدباء والفنانين، وساعد بتعاليمه في أوكسفورد على نشر الفلسفة والفن؛ لأنه لا يكفي أن يكون في الناس فنانون، بل يجب أن يوجد من يتذوقهم ويقرأهم ويشجعهم. وكان بعد كارليل أول من نادى بالإخاء ومساعدة العمال بوضع حد أدنى للأجرة، والضمان ضد البطالة. وهو مع ذلك عدو الاشتراكية، ويعتبر المساواة وهمًا؛ لأن دونها أهوال المطامع التي لا تُحد، والكبرياء التي لا تُرد.
غير أن أتباعه ومريديه توسعوا في تفسير أفكاره، حتى إن بعض النساء نشرن جريدة فوضوية بعنوان «المشعل»، ولكن هذا المشعل ما عتم أن انطفأ في الضباب اللندني؛ لأن الفكرة الواقعية غالبة في الإنكليز. وهذا وليم موريس الشاعر المزوق مات مؤخرًا عن نصف مليون من الجنيهات تركها لورثته الأقربين دون أن يستفيد منها أحد من العامة.
4
هذا الساحر العظيم كانت له أسطورته كالأبطال. يُقال: إنه دخل يومًا مخزن مجوهرات فعرفه البائع، فأقبل عليه يعرض كل ما عنده من الحجارة الكريمة، طالبًا إليه أن يكشف عن أسرارها، وتألبت من حوله فتيات المحل والسيدات الشاريات، فوقف بينهن وتكلم، تكلم بعلم الزعنفة الذي يسلب الأمواج درها، وسحر الجنية التي تحرس الدر: هذا الياقوت الأحمر وردة فارسية، لون الفرح والحب والحياة على الأرض، الزهرة التي استُخدم برعمها لإناء العطر الذي سكبت منه المجدلية على قدمي المخلص، وهذا اللازورد مثل الفرح والحب في السماء، لا تفرق عن الياقوت إلا بلونها الأزرق، وهذه اللؤلؤة خضوع الضياء، رمز الصبر، لون الحمامة التي تبشر بتراجع المياه، والمرغريت زهرة اللؤلؤ، والأقحوان رمز التواضع، ولكنها غالية الثمن؛ لأن التواضع يفتح أبواب الفردوس المطعمة جدرانه بالزبرجد.
وقصَّ عليهن ولادة هذه الأحجار في أعماق الأرض والبحار، ثم التفت إليهن يقول ما معناه: «هل من المعقول أن نحب هذه الحجارة ونكرمها؟ نعم، على شرط أن تكون هي التي نحب لا ذواتنا. إن عبادة الحجر الأسود الهابط من السماء لا تبعد كثيرًا عن الحكمة التي هي عبادة السماء نفسها. وليس من الجنون أن نفكر في أن الحجارة ترى، بل الجنون إذا فكرنا أن العيون لا ترى. ليس من الجنون أن نفكر أن اليوم الذي تُجمع فيه الجواهر تكون حجر الزاوية لجدران الهيكل، ولكن من الجنون أن نظن أن يوم انهيار الهيكل تذهب الأرواح هباء ولا تبقى روحانية ما فوق الأنقاض.»
«نعم، أيتها السيدات الجميلات، أحببن الجواهر واعتنين بها، ولكن أحببن نفوسكن أكثر، واعتنين بها ليوم يجمع السيد جواهره.»
وكانت السيدات يُصغين بخشوع ووهن إلى هذه الأقوال التي لم يسمعنها من أفواه من يرقص معهن في ساعات اللهو والسرور.
هكذا تريد الأسطورة أن يُلقي المعلم تعاليمه لا في المدارس والمعاهد فقط، بل على الطرق أيضًا.
إن فضل روسكين أنه أيقظ الأفكار، ولفت نحو الجماعات أنظار الأدباء والفنانين، وساعد بتعاليمه في أوكسفورد على نشر الفلسفة والفن؛ لأنه لا يكفي أن يكون في الناس فنانون، بل يجب أن يوجد من يتذوقهم ويقرأهم ويشجعهم. وكان بعد كارليل أول من نادى بالإخاء ومساعدة العمال بوضع حد أدنى للأجرة، والضمان ضد البطالة. وهو مع ذلك عدو الاشتراكية، ويعتبر المساواة وهمًا؛ لأن دونها أهوال المطامع التي لا تُحد، والكبرياء التي لا تُرد.
غير أن أتباعه ومريديه توسعوا في تفسير أفكاره، حتى إن بعض النساء نشرن جريدة فوضوية بعنوان «المشعل»، ولكن هذا المشعل ما عتم أن انطفأ في الضباب اللندني؛ لأن الفكرة الواقعية غالبة في الإنكليز. وهذا وليم موريس الشاعر المزوق مات مؤخرًا عن نصف مليون من الجنيهات تركها لورثته الأقربين دون أن يستفيد منها أحد من العامة.
4
لقد نظر روسكين إلى الطبيعة بعاطفة محب للفن مؤمن به، فلم يرَ منها سوى مظاهرها الغرارة. وإن الإنسان، عندما يفكر بهذه المأساة الأزلية الغامضة الأسرار التي تمر بنا على مسرح الحياة، وهذه الحرب الدائمة التي لا هوادة فيها ونتيجتها أبدًا انتصار القوي وانهزام الضعف، وهذه المذبحة التي تُولد وتموت فيها مواكب الناس بعد تهاويل الحياة وشقاء التقلبات، لأمْيَل إلى تشاؤم داروِن الطبيعي منه إلى تفاؤل روسكين السماوي. إن داروِن وروسكين على طرفي نقيض في فهم الإنسان والطبيعة؛ ولهذا كان روسكين يكره داروِن.
إن عبادة الجمال طريق لعبادة الله، وهذه النظرة إلى الجمال كانت تلائم — كما يقول تين — إنكليز ذلك العهد المحافظين المتزمتين، فكان روسكين يشعر بالحنين إلى العصور الماضية، عصور الحرارة والإيمان، ويُثني على معابد الطراز القوطي في فرنسا وإنكلترا؛ لأنها تمثل تلك العصور، وكان يُعجب بالقدامى من أهل الفن؛ لطهارة الشعور فيهم. وفي رأيه أن التقهقر في الفن بدأ من عهد رفائيل؛ فقد كان الفن من قبل وسيلة لإظهار الدين، فصار الدين وسيلة لإظهار الفن. وبلغ به التعصب في هذا الباب أنه لو استطاع لأحرق جميع النساء العاريات لروبنسن وجوردانس؛ ولهذا سماه بعضهم «توركمادا جمال».
ويطول بي الشرح لو أردت تعداد كل ما فكر به روسكين أو قاله أو عمله. ومن عادة الناس أن يستهزئوا بالخارجين على التقاليد والعادات، وينعتوهم بالمتهوسين، غير أن ذلك لا يمنعهم غالبًا من أن يتبعوهم مأخوذين بحرارة القلب والإيمان والكلام، وعلى هذا الوجه قاد روسكين الرأي العام. وفي هذيانه الشعري المُبعثر في ثمانين مجلدًا كان يشعر بأخطار الحالة الاجتماعية، ويرى ما في حرب الطبقات والديمقراطية من الأسباب المؤذنة بانهيار المدنية. وجاءت ثورة الكومون في باريس وحرق باريس بعد الحصار «وقد ساهم بسخاء في إنعاشها» فثبَّتت روسكين في مخاوفه، على أن تفاؤله السماوي لم يُفارقه يومًا؛ ولهذا ظل رسول أُلفة وسلام بين الطبقات.
•••
هكذا كان حب الطبيعة الألف والياء في حياة روسكين، فظهرت آثاره في قسمات وجهه، وتجعدات جبينه، وأملى عليه كل حرف من كلماته، ووجه كل خطوة من خطواته، وأجرى كل معين من أفكاره. وكان له النور الذي يُضيء، والنار التي تعطي الحرارة وتُطهر؛ فأقصاه عن صغائر البغضاء وعن عذاب الحب، وأطلقه في ميادين الأبحاث العلمية؛ لأن العلم وحده يساعد على الدخول على الطبيعة في هيكل أسرارها.
ولا عجب إذا اعتبره الناس رجل أسطورة وهو الذي حارب وحده عالمًا بأسره، لا من أجل الحقيقة التي لها أنبياؤها، ولا من أجل العدالة التي لها رسلها، ولا من أجل الدين الذي له شهداؤه، بل من أجل ما هو فوق هذه الأشياء، وربما اجتمعت كلها فيه: الجمال.
5
الفيلسوف الجديد
إن عبادة الجمال طريق لعبادة الله، وهذه النظرة إلى الجمال كانت تلائم — كما يقول تين — إنكليز ذلك العهد المحافظين المتزمتين، فكان روسكين يشعر بالحنين إلى العصور الماضية، عصور الحرارة والإيمان، ويُثني على معابد الطراز القوطي في فرنسا وإنكلترا؛ لأنها تمثل تلك العصور، وكان يُعجب بالقدامى من أهل الفن؛ لطهارة الشعور فيهم. وفي رأيه أن التقهقر في الفن بدأ من عهد رفائيل؛ فقد كان الفن من قبل وسيلة لإظهار الدين، فصار الدين وسيلة لإظهار الفن. وبلغ به التعصب في هذا الباب أنه لو استطاع لأحرق جميع النساء العاريات لروبنسن وجوردانس؛ ولهذا سماه بعضهم «توركمادا جمال».
ويطول بي الشرح لو أردت تعداد كل ما فكر به روسكين أو قاله أو عمله. ومن عادة الناس أن يستهزئوا بالخارجين على التقاليد والعادات، وينعتوهم بالمتهوسين، غير أن ذلك لا يمنعهم غالبًا من أن يتبعوهم مأخوذين بحرارة القلب والإيمان والكلام، وعلى هذا الوجه قاد روسكين الرأي العام. وفي هذيانه الشعري المُبعثر في ثمانين مجلدًا كان يشعر بأخطار الحالة الاجتماعية، ويرى ما في حرب الطبقات والديمقراطية من الأسباب المؤذنة بانهيار المدنية. وجاءت ثورة الكومون في باريس وحرق باريس بعد الحصار «وقد ساهم بسخاء في إنعاشها» فثبَّتت روسكين في مخاوفه، على أن تفاؤله السماوي لم يُفارقه يومًا؛ ولهذا ظل رسول أُلفة وسلام بين الطبقات.
•••
هكذا كان حب الطبيعة الألف والياء في حياة روسكين، فظهرت آثاره في قسمات وجهه، وتجعدات جبينه، وأملى عليه كل حرف من كلماته، ووجه كل خطوة من خطواته، وأجرى كل معين من أفكاره. وكان له النور الذي يُضيء، والنار التي تعطي الحرارة وتُطهر؛ فأقصاه عن صغائر البغضاء وعن عذاب الحب، وأطلقه في ميادين الأبحاث العلمية؛ لأن العلم وحده يساعد على الدخول على الطبيعة في هيكل أسرارها.
ولا عجب إذا اعتبره الناس رجل أسطورة وهو الذي حارب وحده عالمًا بأسره، لا من أجل الحقيقة التي لها أنبياؤها، ولا من أجل العدالة التي لها رسلها، ولا من أجل الدين الذي له شهداؤه، بل من أجل ما هو فوق هذه الأشياء، وربما اجتمعت كلها فيه: الجمال.
5
الفيلسوف الجديد
كوندياك ١٧١٥–١٧٨٠
يوسف كرم
(١) حياته ومصنفاته
قسيس لم يزاول مهام الكهنوت قط، وإنما قرأ الفلاسفة المحدثين، وخالط معاصرية منهم، واعتنق مذهب لوك، فكان زعيم الحسية في وطنه، عرض هذه الحسية في كتاب «محاولة في أصل المعارف الإنسانية» (١٧٤٦) وأتبعه بآخر عنوانه (كتاب المذاهب) (١٧٤٩) نقد فيه مذاهب ديكارت ومالبرانش وسبينوزا وليبنتز وغيرهم من المعتمدين على العقل وحده، فلا يهتدون إلى الحق، بل لا يتفقون فيما بينهم، فالامتداد عند ديكارت جوهر، وعند سبينوزا عرض، وعند لبينتز معنى متناقض، ثم نشر كتابه المعروف «في الإحساسات» (١٧٥٤) يفصل فيه الكتاب الأول، وألحق به كتاب «الحيوان» (١٧٥٥) يبين فيه نشوء قوى الحيوان والفرق بينه وبين الإنسان، وفي ١٧٦٨ انتخب عضوًا بالأكاديمية الفرنسية خلفاً لقسيس آخر، والواقع أن أسلوبه رشيق وضاح، وبعد وفاته نشر له كتاب في «المنطق» لا على الطريقة المدرسية، ولكنه عبارة عن ملاحظة ونصائح في تدبير الفكر، وكتاب في «لغة الحساب» لم يتمكن من إتمامه، وكان يقصد به الي بيان الطريقة التي يمكن بها صوغ جميع العلوم، ومنها الأخلاق والميتافيزيقا، بمثل ما للرياضيات من دقة.
(٢) مذهبه
يذهب كوندياك في الحسية إلى أبعد من لوك، فإنه يقصر التجربة على الإحساس الظاهري، ويستغني عن «التفكير» كمصدر أصيل للمعرفة، فيدعي أن أي إحساس ظاهري يكفي لتوليد جميع القوى النفسية، ولبيان ذلك يفترض (في كتاب الإحساس) تمثالًا حيًّا داخل تمثال من رخام، ويقول إذا كسرنا الرخام في موضع الأنف أتحنا للتمثال الحي القدرة على استخدام حاسة الشم، وهي الحاسة المعتبرة أدنى الحواس، فعند أول إحساس يوجد شيء واحد في شعور التمثال، هو رائحة وردة مثلًا، ويكون شعوره كله هذه الرائحة، أو أية رائحة أخرى تعرض له، ومتى كان له إحساس واحد ليس غير، كان هذا هو الانتباه، ولا ينقطع الإحساس بالرائحة بانقطاع التأثير، ولكنه يبقى، وبقاؤه هذا مع حدوث رائحة جديدة هو الذاكرة، وإذا وجه التمثال انتباهه إلى الإحساس الحاضر والإحساس الماضي جميعًا، كان هذا الانتباه المزدوج المقارنة أو المضاهاة، وإذا أدرك بهذه المضاهاة المشابهات والفوارق، كان الحكم الموجب والحكم السالب، وإذا تكررت المضاهاة وتكرر الحكم كان الاستدلال، وإذا أحس التمثال إحساسًا مؤلمًا فتذكر إحساسًا لاذًّا، كان لهذه الذكرى قوة أعظم وكانت المخيلة، وتلك هي القوى العقلية، أما القوى الإرادية فتتولد من الإحساس باللذة والألم؛ ذلك بأنه إذا تذكر التمثال رائحة لذيذة وهو منفعل بإحساس مؤلم، كان هذا التذكر حاجة، ونشأ عنه ميل هو الاشتهاء، وإذا تسلَّط الاشتهاء كان الهوى، وهكذا يتولد الحب والبغض والرجاء والخوف، ومتى حصل التمثال على موضوع شهوته كان الرضا، وإذا ما ولدت فيه تجربة الرضا عادة الحكم بأنه لن يصادف عقبة في سبيل شهوته تولدت الإرادة، فما الإرادة إلا شهوة مصحوبة بفكرة أن الموضوع المشتهى هو في مقدورنا.
على أن التمثال، وقد حصل على جميع قواه، لا يعلم أن العالم الخارجي موجود، بل لا يعلم أن جسمه موجود، من حيث إن إحساساته انفعالات ذاتية ليس غير، فكيف يصل إلى إدراك المقادير والمسافات؟ وكيف يدرك أن شيئًا موجودًا خارجًا عنه؟ هاتان مسألتان يجب التمييز بينهما، والفحص عن كل واحدة على حدة، وهما موضوع القسم الثاني والقسم الثالث من كتاب الإحساسات، فعن المسألة الأولى يقر كوندياك رأي لوك أن الأكمه الذي يستعيد البصر لا يميز لفوره بين كرة وبين مكعب كان يعرفهما باللمس، إذ أن اللمس هو الذي يدرك الأشكال أولًا، ويدركها البصر بفضل علاقاته باللمس، ثم لا تعود به حاجة إلى تذكر الإحساسات اللمسية التي كانت مساعدة له، خلافًا لما يذهب إليه باركلي، وعن المسألة الثانية قال كوندياك في الطبعة الأولى لكتاب الإحساسات إن معرفة «الخارجية» ترجع إلى تقارن الإحساسات اللمسية، مثل أن يحس التمثال في آنٍ واحد حرارة في إحدى الذراعين وبرودة في الأخرى وألمًا في الرأس، وعاد فقال — في الطبعة الثانية (١٧٧٨) — إن إحساسات لمسية بمثل هذا الغموض يمكن أن تتقارن دون أن تتخارج، وإن فكرة الخارجية تنشأ من المقاومة التي نصادفها في حركتنا وبذلك نضيف جسمنا إلى أنفسنا ونميز بينه وبين سائر الأجسام، ولما كان اللمس يدرك القرب والبعد، فإن اختلاف احساسات الروائح والأصوات والألوان في القوة يوحي إلى التمثال بأن هذه الاحساسات ليست مجرد أحوال باطنة، ولكنها صادرة عن أشياء خارجية، وبذلك نرجع أحكام الخارجية إلى إحساسات ليس غير.
1
يوسف كرم
(١) حياته ومصنفاته
قسيس لم يزاول مهام الكهنوت قط، وإنما قرأ الفلاسفة المحدثين، وخالط معاصرية منهم، واعتنق مذهب لوك، فكان زعيم الحسية في وطنه، عرض هذه الحسية في كتاب «محاولة في أصل المعارف الإنسانية» (١٧٤٦) وأتبعه بآخر عنوانه (كتاب المذاهب) (١٧٤٩) نقد فيه مذاهب ديكارت ومالبرانش وسبينوزا وليبنتز وغيرهم من المعتمدين على العقل وحده، فلا يهتدون إلى الحق، بل لا يتفقون فيما بينهم، فالامتداد عند ديكارت جوهر، وعند سبينوزا عرض، وعند لبينتز معنى متناقض، ثم نشر كتابه المعروف «في الإحساسات» (١٧٥٤) يفصل فيه الكتاب الأول، وألحق به كتاب «الحيوان» (١٧٥٥) يبين فيه نشوء قوى الحيوان والفرق بينه وبين الإنسان، وفي ١٧٦٨ انتخب عضوًا بالأكاديمية الفرنسية خلفاً لقسيس آخر، والواقع أن أسلوبه رشيق وضاح، وبعد وفاته نشر له كتاب في «المنطق» لا على الطريقة المدرسية، ولكنه عبارة عن ملاحظة ونصائح في تدبير الفكر، وكتاب في «لغة الحساب» لم يتمكن من إتمامه، وكان يقصد به الي بيان الطريقة التي يمكن بها صوغ جميع العلوم، ومنها الأخلاق والميتافيزيقا، بمثل ما للرياضيات من دقة.
(٢) مذهبه
يذهب كوندياك في الحسية إلى أبعد من لوك، فإنه يقصر التجربة على الإحساس الظاهري، ويستغني عن «التفكير» كمصدر أصيل للمعرفة، فيدعي أن أي إحساس ظاهري يكفي لتوليد جميع القوى النفسية، ولبيان ذلك يفترض (في كتاب الإحساس) تمثالًا حيًّا داخل تمثال من رخام، ويقول إذا كسرنا الرخام في موضع الأنف أتحنا للتمثال الحي القدرة على استخدام حاسة الشم، وهي الحاسة المعتبرة أدنى الحواس، فعند أول إحساس يوجد شيء واحد في شعور التمثال، هو رائحة وردة مثلًا، ويكون شعوره كله هذه الرائحة، أو أية رائحة أخرى تعرض له، ومتى كان له إحساس واحد ليس غير، كان هذا هو الانتباه، ولا ينقطع الإحساس بالرائحة بانقطاع التأثير، ولكنه يبقى، وبقاؤه هذا مع حدوث رائحة جديدة هو الذاكرة، وإذا وجه التمثال انتباهه إلى الإحساس الحاضر والإحساس الماضي جميعًا، كان هذا الانتباه المزدوج المقارنة أو المضاهاة، وإذا أدرك بهذه المضاهاة المشابهات والفوارق، كان الحكم الموجب والحكم السالب، وإذا تكررت المضاهاة وتكرر الحكم كان الاستدلال، وإذا أحس التمثال إحساسًا مؤلمًا فتذكر إحساسًا لاذًّا، كان لهذه الذكرى قوة أعظم وكانت المخيلة، وتلك هي القوى العقلية، أما القوى الإرادية فتتولد من الإحساس باللذة والألم؛ ذلك بأنه إذا تذكر التمثال رائحة لذيذة وهو منفعل بإحساس مؤلم، كان هذا التذكر حاجة، ونشأ عنه ميل هو الاشتهاء، وإذا تسلَّط الاشتهاء كان الهوى، وهكذا يتولد الحب والبغض والرجاء والخوف، ومتى حصل التمثال على موضوع شهوته كان الرضا، وإذا ما ولدت فيه تجربة الرضا عادة الحكم بأنه لن يصادف عقبة في سبيل شهوته تولدت الإرادة، فما الإرادة إلا شهوة مصحوبة بفكرة أن الموضوع المشتهى هو في مقدورنا.
على أن التمثال، وقد حصل على جميع قواه، لا يعلم أن العالم الخارجي موجود، بل لا يعلم أن جسمه موجود، من حيث إن إحساساته انفعالات ذاتية ليس غير، فكيف يصل إلى إدراك المقادير والمسافات؟ وكيف يدرك أن شيئًا موجودًا خارجًا عنه؟ هاتان مسألتان يجب التمييز بينهما، والفحص عن كل واحدة على حدة، وهما موضوع القسم الثاني والقسم الثالث من كتاب الإحساسات، فعن المسألة الأولى يقر كوندياك رأي لوك أن الأكمه الذي يستعيد البصر لا يميز لفوره بين كرة وبين مكعب كان يعرفهما باللمس، إذ أن اللمس هو الذي يدرك الأشكال أولًا، ويدركها البصر بفضل علاقاته باللمس، ثم لا تعود به حاجة إلى تذكر الإحساسات اللمسية التي كانت مساعدة له، خلافًا لما يذهب إليه باركلي، وعن المسألة الثانية قال كوندياك في الطبعة الأولى لكتاب الإحساسات إن معرفة «الخارجية» ترجع إلى تقارن الإحساسات اللمسية، مثل أن يحس التمثال في آنٍ واحد حرارة في إحدى الذراعين وبرودة في الأخرى وألمًا في الرأس، وعاد فقال — في الطبعة الثانية (١٧٧٨) — إن إحساسات لمسية بمثل هذا الغموض يمكن أن تتقارن دون أن تتخارج، وإن فكرة الخارجية تنشأ من المقاومة التي نصادفها في حركتنا وبذلك نضيف جسمنا إلى أنفسنا ونميز بينه وبين سائر الأجسام، ولما كان اللمس يدرك القرب والبعد، فإن اختلاف احساسات الروائح والأصوات والألوان في القوة يوحي إلى التمثال بأن هذه الاحساسات ليست مجرد أحوال باطنة، ولكنها صادرة عن أشياء خارجية، وبذلك نرجع أحكام الخارجية إلى إحساسات ليس غير.
1
👍1
وللتمثال المقصور على الشم كما تقدم القدرة على تجريد المعاني وتعميمها، فإنه إذ يميز بين الحالات التي يمر بها يحصل على معنى العدد، وإذ يعلم أنه يستطيع ألَّا يبقي الرائحة التي هو إياها وأن يعود ما كان، يحصل على معنى الممكن، وإذ يدرك تعاقب الإحساسات يحصل على معنى الزمان، وإذ يتذكر جملة الإحساسات التي ينفعل بها يحصل على معنى الشخصية وأما المعنى الكلي فهو جزء من المعنى الجزئي، ولا حقيقة له إلا في الذهن، وما هذه الحقيقة إلا لفظ أو اسم، ليس في الطبيعة ماهيات وأنواع وأجناس، وإنما تعبر الألفاظ الكلية عن وجهات نظر الذهن حين يدرك ما بين الأشياء من مشابهات وفوارق، ومتى لم يكن في الطبيعة ماهيات كان الحد لغوًا ووجب الاستعاضة عنه بالتحليل: «معانينا إما بسيطة أو مركبة، البسيطة لا تحد ولكن التحليل يكشف لنا عن أصلها وطريقة اكتسابها، والمعاني المركبة لا تعلم إلى بالتحليل؛ لأنه هو وحده الذي يبين لنا عناصرها»، ومتى لم تكن المعاني المجردة إلا ألفاظًا، لم يكن هناك سوى وسيلة واحدة لتخيلها: تلك هي إجادة وضع اللغة؛ فإنه إذا لم يكن لدينا أسماء لم يكن لدينا معانٍ مجردة، فلم يكن لدينا معاني أجناس وأنواع، فلم نستطع الاستدلال، ففن الاستدلال يرجع كله إلى أحكام الكلام، وليس الاستدلال تأديًا من الكلي إلى الجزئي ولكنه «حساب» يتأدَّآ من الشيء إلى الشيء نفسه بتغير الإشارات الدالة، ومثله الأعلى استدلال الجبر الذي ترجع إليه سائر أنواع الاستدلال، (وهذا معناه رد القضية إلى معادلة، وتتصل هذه المحاولة بمحاولات ريمون لول وليبنتز وأصحاب المنطق الرياضي فيما بعد).
وهكذا بدل أن يفسر كوندياك الأفعال بالقوى، والانفعالات بالميول، يجعل الميول تصدر عن الانفعالات، ويجعل القوى عادات الأفعال، وما يسمى غريزة ثمرة التجربة الشخصية، أو عادة ولدها التفكير، أو «عادة خلت من التفكير الذي ولدها»، ولما كان أفراد النوع الواحد تحس نفس الحاجة فتعمل لنفس الغاية بنفس الأعضاء، كانت للنوع نفس العادات أو الغرائز، وكانت جميع المعاني وجميع قوى النفس «إحساسات محولة».
بيد أن كوندياك لم يكن ماديًّا؛ فإنه إذ يعتبر الإحساس ظاهرة أصيلة، يرى في الظواهر الجسمية التي يجعلها الماديون علة له مجرد «مناسبات» لظهوره، وهو يعارض لوك معارضة صريحة في افتراضه أن مادة معينة قد تكون حاصلة على قوة التفكير، فيقول إن المفكر يجب أن يكون واحدًا، وليس للمادة وحدة ولكنها كثرة، ويعترف للإنسان بنفس روحية عاقلة خالدة، ويضعه فوق الحيوان لأنه يميز الحق، ويحس الجمال، ويخلق الفنون والعلوم، ويدرك مبادئ الأخلاق، ويصعد إلى الله، ولكن كوندياك يذهب مذهب بعض مفكري العصر الوسيط ويقول: إن الحسية حال الإنسان بعد خطيئة آدم، وإن آدم كان قبل خطيئته يعقل بدون وساطة الحواس لأن النفس الإنسانية عاقلة بذاتها، وستعود إلى التعقل في الحياة الآجلة، وهو يدلل على خلود النفس بأنها خلقية وأنها لا تلقى في الحياة العاجلة ما يناسب أفعالها من ثواب وعقاب، ويدلل على وجود الله بدليل العلة الفاعلية، ودليل العلة الغائية، وسواء أكان مخلصًا في هذا القسم من أقواله أم لم يكن، فقد كان أثره الخاص إذاعة المذهب الحسي في وقت اشتدت فيه الحملة الفلسفية على الدين.
2
الفيلسوف الجديد
وهكذا بدل أن يفسر كوندياك الأفعال بالقوى، والانفعالات بالميول، يجعل الميول تصدر عن الانفعالات، ويجعل القوى عادات الأفعال، وما يسمى غريزة ثمرة التجربة الشخصية، أو عادة ولدها التفكير، أو «عادة خلت من التفكير الذي ولدها»، ولما كان أفراد النوع الواحد تحس نفس الحاجة فتعمل لنفس الغاية بنفس الأعضاء، كانت للنوع نفس العادات أو الغرائز، وكانت جميع المعاني وجميع قوى النفس «إحساسات محولة».
بيد أن كوندياك لم يكن ماديًّا؛ فإنه إذ يعتبر الإحساس ظاهرة أصيلة، يرى في الظواهر الجسمية التي يجعلها الماديون علة له مجرد «مناسبات» لظهوره، وهو يعارض لوك معارضة صريحة في افتراضه أن مادة معينة قد تكون حاصلة على قوة التفكير، فيقول إن المفكر يجب أن يكون واحدًا، وليس للمادة وحدة ولكنها كثرة، ويعترف للإنسان بنفس روحية عاقلة خالدة، ويضعه فوق الحيوان لأنه يميز الحق، ويحس الجمال، ويخلق الفنون والعلوم، ويدرك مبادئ الأخلاق، ويصعد إلى الله، ولكن كوندياك يذهب مذهب بعض مفكري العصر الوسيط ويقول: إن الحسية حال الإنسان بعد خطيئة آدم، وإن آدم كان قبل خطيئته يعقل بدون وساطة الحواس لأن النفس الإنسانية عاقلة بذاتها، وستعود إلى التعقل في الحياة الآجلة، وهو يدلل على خلود النفس بأنها خلقية وأنها لا تلقى في الحياة العاجلة ما يناسب أفعالها من ثواب وعقاب، ويدلل على وجود الله بدليل العلة الفاعلية، ودليل العلة الغائية، وسواء أكان مخلصًا في هذا القسم من أقواله أم لم يكن، فقد كان أثره الخاص إذاعة المذهب الحسي في وقت اشتدت فيه الحملة الفلسفية على الدين.
2
الفيلسوف الجديد
Forwarded from شوبنهاور - سيوران
▪مدخل لفلسفة شوبنهاور
هشام عبده
في طفولتنا وصبانا المبكر عندما كنا نتأمل مستقبلنا ،كنا مثل أطفال في مسرح قبل أن ترفع الستارة ،نجلس بروح عالية وبلهفة ننتظر بدء المسرحية ،وكأنها رحمة أننا لا نعرف حقيقة ما سيحدث ،يمكننا حدسه ،هناك أوقات يبدو فيها الأطفال كالسجناء الأبرياء ،مدانون ،لا للموت بل للحياة ،ولأن الجميع غير واعي لمعنى جملهم وكلامهم عموما ،على الرغم من كل هذا ،كل شاب يرغب للوصول إلى الشيخوخة ،بكلمات أخرى ،حالة من الحياة التي عنها يمكن أن يقال "هي سيئة اليوم وستكون أسوأ في الغد ،وهكذا حتى أسوأ الجميع" .
إذا حاولت أن تتخيل بأقرب ما تستطيع ،ما كمية البؤس ،العذاب ،والمعاناة لكل نوع تشرق عليه الشمس في دورتها ،وقتها ستعترف بأنها ستكون أفضل إذا ،على الأرض كما على القمر ،مرة أخرى أنت قد تنظر للحياة كحادث غير مريح ،يمتص الهدوء السعيد للعدم ،وعلى كل حال ،حتى لو فكرت أن أشياء قد سارت معك بإحتمال جيد طيلة حياتك ،الواضح أنك ستشعر إجمالا أن الحياة هي إحباط باطل ، احتيال !
إستطاع شوبنهاور أن يرى في الفرد وجهين : "تمثلا وإرادة ، إذ أن التمثل أو التصور يعني إذا نظرنا إليه من الخارج، أما الإرادة إذا نظرنا إليه من الداخل ،وهذه النظرة يمكن أن ينظر بها كل فرد إلى نفسه على حدة، ولا يستطيع أن يشعر بها شعوراً واضحاً إلا في نفسه فحسب .
إذن تسعى فلسفة "شوبنهاور" إلى خلاص الإنسان وذلك بدرجتين : الخلاص بالفن؛ أي تأمل الكون والحياة تأملاً نزيهاً خالياً من الغرض أو شوائب المادة، ثم الخلاص بالزهد الذي يسحق الإرادة مصدر الشرور في هذا العالم.
ويتساءل شوبنهاور عما إذا كان العالم يسير أصلاً على نظام معين مرسوم منذ البدايات في معزل عن تدخله هو - أي الإنسان نفسه - يجيب قائلاً : "إن هذا الإنسان يسير تبعاً لقانون هو - مبدأ العلة الكافية - ، ذلك أن كل امتثالاتنا وتصوراتنا مرتبة في ما بينها وبين بعض على نحو من شأنه أن يجعل الواحد منها مرتبطاً بالآخر، ولاشيء منها يقوم مستقلاً بنفسه أو منفصلاً عن غيره ،وهذا الإرتباط لدى شوبنهاور، إرتباط منتظم تستطيع أن تعينه قبل التجربة بصفته مركزاً في طبيعة الذات، أما بالنسبة إلى الإرادة، التي تشكل أساس القاعدة الثانية لوجود هذا العالم ، فإن شوبنهاور من أجل الوصول إلى ربطها بالامتثال يقوم بقفزة أساسية من الذات بإعتبارها عقلاً يفكر ويتصور تبعاً لمبدأ العلة الكافية إلى الموضوع بإعتباره الإرادة التي هي - في نظره، الجوهر الباطن والسر الأعظم لهذا الوجود، وما الوجود في الواقع إلا التحقق الموضوعي للإرادة .
وبالنسبة إلى شوبنهاور فإن الإرادة تختلف، من حيث إنها شيء في ذاته، عن تجلياتها في الظواهر، ومن طريق المكان والزمان تميز الإرادة نفسها في موضوعات متنوعة في أماكن مختلفة وفي لحظات مختلفة، لكنها كلها ترتبط مع ذلك وفقاً لقوانين العلية.
1
هشام عبده
في طفولتنا وصبانا المبكر عندما كنا نتأمل مستقبلنا ،كنا مثل أطفال في مسرح قبل أن ترفع الستارة ،نجلس بروح عالية وبلهفة ننتظر بدء المسرحية ،وكأنها رحمة أننا لا نعرف حقيقة ما سيحدث ،يمكننا حدسه ،هناك أوقات يبدو فيها الأطفال كالسجناء الأبرياء ،مدانون ،لا للموت بل للحياة ،ولأن الجميع غير واعي لمعنى جملهم وكلامهم عموما ،على الرغم من كل هذا ،كل شاب يرغب للوصول إلى الشيخوخة ،بكلمات أخرى ،حالة من الحياة التي عنها يمكن أن يقال "هي سيئة اليوم وستكون أسوأ في الغد ،وهكذا حتى أسوأ الجميع" .
إذا حاولت أن تتخيل بأقرب ما تستطيع ،ما كمية البؤس ،العذاب ،والمعاناة لكل نوع تشرق عليه الشمس في دورتها ،وقتها ستعترف بأنها ستكون أفضل إذا ،على الأرض كما على القمر ،مرة أخرى أنت قد تنظر للحياة كحادث غير مريح ،يمتص الهدوء السعيد للعدم ،وعلى كل حال ،حتى لو فكرت أن أشياء قد سارت معك بإحتمال جيد طيلة حياتك ،الواضح أنك ستشعر إجمالا أن الحياة هي إحباط باطل ، احتيال !
إستطاع شوبنهاور أن يرى في الفرد وجهين : "تمثلا وإرادة ، إذ أن التمثل أو التصور يعني إذا نظرنا إليه من الخارج، أما الإرادة إذا نظرنا إليه من الداخل ،وهذه النظرة يمكن أن ينظر بها كل فرد إلى نفسه على حدة، ولا يستطيع أن يشعر بها شعوراً واضحاً إلا في نفسه فحسب .
إذن تسعى فلسفة "شوبنهاور" إلى خلاص الإنسان وذلك بدرجتين : الخلاص بالفن؛ أي تأمل الكون والحياة تأملاً نزيهاً خالياً من الغرض أو شوائب المادة، ثم الخلاص بالزهد الذي يسحق الإرادة مصدر الشرور في هذا العالم.
ويتساءل شوبنهاور عما إذا كان العالم يسير أصلاً على نظام معين مرسوم منذ البدايات في معزل عن تدخله هو - أي الإنسان نفسه - يجيب قائلاً : "إن هذا الإنسان يسير تبعاً لقانون هو - مبدأ العلة الكافية - ، ذلك أن كل امتثالاتنا وتصوراتنا مرتبة في ما بينها وبين بعض على نحو من شأنه أن يجعل الواحد منها مرتبطاً بالآخر، ولاشيء منها يقوم مستقلاً بنفسه أو منفصلاً عن غيره ،وهذا الإرتباط لدى شوبنهاور، إرتباط منتظم تستطيع أن تعينه قبل التجربة بصفته مركزاً في طبيعة الذات، أما بالنسبة إلى الإرادة، التي تشكل أساس القاعدة الثانية لوجود هذا العالم ، فإن شوبنهاور من أجل الوصول إلى ربطها بالامتثال يقوم بقفزة أساسية من الذات بإعتبارها عقلاً يفكر ويتصور تبعاً لمبدأ العلة الكافية إلى الموضوع بإعتباره الإرادة التي هي - في نظره، الجوهر الباطن والسر الأعظم لهذا الوجود، وما الوجود في الواقع إلا التحقق الموضوعي للإرادة .
وبالنسبة إلى شوبنهاور فإن الإرادة تختلف، من حيث إنها شيء في ذاته، عن تجلياتها في الظواهر، ومن طريق المكان والزمان تميز الإرادة نفسها في موضوعات متنوعة في أماكن مختلفة وفي لحظات مختلفة، لكنها كلها ترتبط مع ذلك وفقاً لقوانين العلية.
1
Forwarded from شوبنهاور - سيوران
وهنا يرى شوبنهاور أن الإرادة تتجلى، من حيث إنها شيء في ذاته، في الفكرة "التصور أو التمثل" قبل أن تتجلى في كثرة من أشياء مفردة ؛من هنا فإن الإرادة هي جوهر وجود الإنسان ففيها يجد الإنسان، بالتأمل الباطن المباشر، الجوهر الباطن الحقيقي للإنسان، والذي لايمكن أن يفنى، وفي هذا المعنى تكون الإرادة هي، وفق شوبنهاور الشيء في ذاته ؛وهو يؤكد أولوية الإرادة على العقل وفي هذا قلباً للوضع الذي وضعنا فيه الفلاسفة حتى شوبنهاور، الذي يقول عن نفسه إنه أول من قال بالنزعة الإرادية التي تجعل من الإرادة الجوهر الحقيقي، بينما كان كل الفلاسفة ينظرون إلى العقل على أنه هو الجوهر.
والإرادة لا هدف لها ولا غاية تقف عندها، فهي رغبة غامضة ومجهود دائب لا يعرف الكلل أو التعب؛ فإذا اعترض طريق الإرادة معترض تولد عن ذلك "الشقاء"، وإذا تم لها ما تريد في اللحظة الحاضرة كانت السعادة، وهذه السعادة لا يمكن أن تدوم؛ لأن كل رغبة تنشأ عن نقص أو عن حالة لا ترضينا ؛وترتبط الرغبة بالشقاء طالما لم تصل إلى سد هذا النقص أو إشباع تلك الحاجة .
والواقع أن كل إشباع لرغباتنا هو بداية لرغبات أخرى جديدة ،وهكذا فلا وجود لحد تقف عنده الرغبة، ومن ثم لا حد ينتهي عنده الشقاء؛ وهنا يقول "شوبنهاور": "إن الشقاء يزداد حدة وشدة تبعاً للارتفاع في سلم الكائنات حتى يصل إلى أعلى درجاته عند الفرد العبقري ،وكلما نفذ الإنسان إلى أعماق الوجود؛ أدرك أن ماهيته الأصلية هي الشقاء، ورأى أن الوجود ما هو إلا سقوط مستمر في الموت"، ويمضى "شوبنهاور" في تصوير الحياة على هذه الصورة التشاؤمية، مما يؤكد أن خوفه من الحياة هو الذي دفعه إلى نشدان الخلاص في "النرفانا" أو العدم، فالحياة عنده ليست شيئاً إيجابياً؛ وإنما هروب من الموت، ومع ذلك فماذا تكون الحياة سوى الهروب من ذلك الموت نفسه ؟ وهذا الهروب يكون بقتل الوقت كما يقول العامة !
إذن فالشقاء لامهرب منه، وكل ألم يزول ليحتل غيره مكانه، ولكل فرد نصيبه المحدد من الشقاء وفقاً لطبيعته التي تتحدد مرة وإلى الأبد، والشقاء الذي يلاقيه الفرد في حياته لا تفرضه قوة خارجية؛ وإنما فطرته نفسها هي التي تحدد كمية الآلام التي سيتعرض لها طوال حياته، ولما كانت حياة الإنسان سلسلة من الحاجات والآلام التي تنتهي لتبدأ من جديد، إذن ليست السعادة شيئاً إيجابياً بل هي سلبية في ماهيتها، فلا وجود للسعادة في ذاتها؛ وإنما تأتى السعادة من إرضاء حاجة أو لنفي ألم من الآلام، لذلك فالألم شيء أولي وشرط ضروري لوجوب السعادة .
2
والإرادة لا هدف لها ولا غاية تقف عندها، فهي رغبة غامضة ومجهود دائب لا يعرف الكلل أو التعب؛ فإذا اعترض طريق الإرادة معترض تولد عن ذلك "الشقاء"، وإذا تم لها ما تريد في اللحظة الحاضرة كانت السعادة، وهذه السعادة لا يمكن أن تدوم؛ لأن كل رغبة تنشأ عن نقص أو عن حالة لا ترضينا ؛وترتبط الرغبة بالشقاء طالما لم تصل إلى سد هذا النقص أو إشباع تلك الحاجة .
والواقع أن كل إشباع لرغباتنا هو بداية لرغبات أخرى جديدة ،وهكذا فلا وجود لحد تقف عنده الرغبة، ومن ثم لا حد ينتهي عنده الشقاء؛ وهنا يقول "شوبنهاور": "إن الشقاء يزداد حدة وشدة تبعاً للارتفاع في سلم الكائنات حتى يصل إلى أعلى درجاته عند الفرد العبقري ،وكلما نفذ الإنسان إلى أعماق الوجود؛ أدرك أن ماهيته الأصلية هي الشقاء، ورأى أن الوجود ما هو إلا سقوط مستمر في الموت"، ويمضى "شوبنهاور" في تصوير الحياة على هذه الصورة التشاؤمية، مما يؤكد أن خوفه من الحياة هو الذي دفعه إلى نشدان الخلاص في "النرفانا" أو العدم، فالحياة عنده ليست شيئاً إيجابياً؛ وإنما هروب من الموت، ومع ذلك فماذا تكون الحياة سوى الهروب من ذلك الموت نفسه ؟ وهذا الهروب يكون بقتل الوقت كما يقول العامة !
إذن فالشقاء لامهرب منه، وكل ألم يزول ليحتل غيره مكانه، ولكل فرد نصيبه المحدد من الشقاء وفقاً لطبيعته التي تتحدد مرة وإلى الأبد، والشقاء الذي يلاقيه الفرد في حياته لا تفرضه قوة خارجية؛ وإنما فطرته نفسها هي التي تحدد كمية الآلام التي سيتعرض لها طوال حياته، ولما كانت حياة الإنسان سلسلة من الحاجات والآلام التي تنتهي لتبدأ من جديد، إذن ليست السعادة شيئاً إيجابياً بل هي سلبية في ماهيتها، فلا وجود للسعادة في ذاتها؛ وإنما تأتى السعادة من إرضاء حاجة أو لنفي ألم من الآلام، لذلك فالألم شيء أولي وشرط ضروري لوجوب السعادة .
2
Forwarded from شوبنهاور - سيوران
والغريب في أمر الإنسان - كما رأى شوبنهاور - أنه حينما لا يجد الصعاب يخترعها، وعندما يحيا في يسر يحاول أن يدخل في حياته التعقيد، وهذا ما نلاحظه في الشعوب التي سارت حياتها هينة لينة بما وهبتها الطبيعة من مناخ معتدل وأرض خصبة؛ فإن هذه الشعوب تخترع عالماً خيالياً بآلهته وشياطينه وقديسيه؛ لتقدم له الضحايا والقرابين والصلوات والاعترافات...إلخ، وخدمة هذا العالم الخيالي تملأ فراغ الحياة الواقعية وخلوها من الآلام والمتاعب، فتصبح كل حادثة من حوادث العالم نتيجة لعمل من أعمال تلك الكائنات المخترعة اختراعاً، هذه الصورة المظلمة التي يرسمها "شوبنهاور" لحياة الإنسان ليس فيها سوى نتيجة واحدة، وهي - كما يقول - "من الأفضل للإنسان أن يختار العدم، وأن يؤثر الموت على الحياة" ،وهذا هو معنى عبارة "هاملت": "أكون أو لا أكون"، وعبارة "هيرودوت" الخالدة : "ليس هناك إنسان لم يتمن أكثر من مرة ألا يأتي عليه الغد" ،ولو أن الموت -انتحاراً- معناه العدم المطلق لانتحر الناس جميعاً؛ لكن الانتحار لا يصلح ما أفسده الوجود، والعزاء الوحيد عما في الحياة من شر هو قصرها، وهذا أفضل ما فيها" !
ولا معنى للتفاؤل كما رأى "شوبنهاور"، ويكفي أن يتطلع أشد الناس تفاؤلاً على أماكن البؤس والتعاسة والمرض والقتال والجريمة ليروا إلى أي حد كان هذا العالم هو أفضل عالم ممكن، والمذاهب التي تدعو إلى التفاؤل ما هي إلا مذاهب لفظية خالية من المعنى تصدر عن رؤوس خالية من الذكاء، ولا أحد يظن أن الإيمان الدينى يدعو إلى التفاؤل، وإنما - على العكس من ذلك - يجعل الحياة والشر كلمتين مترادفتين !
لكن ما مصدر هذا التعلق بالحياة ؟ يرى "شوبنهاور" أن مصدر التعلق بالحياة ليس مبعثه العقل والتفكير، فقليل من التأمل كاف لإقناعنا بأن الحياة ليست خليقة بشيء من الحب، وليس من المؤكد أن الوجود خير من اللاوجود، والحياة خير من الموت، ولو استطعت أن تسعى إلى قبور الموتى وتقرع أبوابها سائلاً إياهم :
هل تريدون العودة إلى الحياة ؟ إذن لرأيتهم ينفضون إليك رؤوسهم رافضين العودة !
إن هذا التعلق بالحياة - فيما يرى شوبنهاور- حركة عمياء غير عاقلة، ولا تفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة للحياة الخالصة، والحياة - تبعاً لذلك- يمكن أن تعد الخير الأسمى، مهما يكن من مرارتها وقصرها واضطرابها، والإرادة في ذاتها وبطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة، أما المعرفة فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة؛ لأنها تكشف لنا عما لهذه الحياة من ضآلة وهشاشة، ولهذا تحارب الخوف من الموت، ويتناول "شوبنهاور" مشكلة الموت، فيقرر أن "الموت" لا يصيب إرادة الحياة؛ وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي يحددها باستمرار؛ أما إرادة الحياة فخالدة أبد الدهر، والطبيعة قد ضمنت لها الخلود بواسطة أداة قوية تلعب الدور الأكبر في الحياة العضوية ،وهذه الإرادة هي "الغريزة الجنسية" ففيها مظهر من أوضح مظاهر تأكيد إرادة الحياة نفسها؛ لأن معناها هو أن الطبيعة مهمومة بحفظ النوع باستمرار، وأن في شدة هذه الغريزة وكونها "أقوى الغرائز" ما يدل بوضوح على أن إرادة الحياة هي سر الأسرار في الطبيعة.
3
شوبنهاور
ولا معنى للتفاؤل كما رأى "شوبنهاور"، ويكفي أن يتطلع أشد الناس تفاؤلاً على أماكن البؤس والتعاسة والمرض والقتال والجريمة ليروا إلى أي حد كان هذا العالم هو أفضل عالم ممكن، والمذاهب التي تدعو إلى التفاؤل ما هي إلا مذاهب لفظية خالية من المعنى تصدر عن رؤوس خالية من الذكاء، ولا أحد يظن أن الإيمان الدينى يدعو إلى التفاؤل، وإنما - على العكس من ذلك - يجعل الحياة والشر كلمتين مترادفتين !
لكن ما مصدر هذا التعلق بالحياة ؟ يرى "شوبنهاور" أن مصدر التعلق بالحياة ليس مبعثه العقل والتفكير، فقليل من التأمل كاف لإقناعنا بأن الحياة ليست خليقة بشيء من الحب، وليس من المؤكد أن الوجود خير من اللاوجود، والحياة خير من الموت، ولو استطعت أن تسعى إلى قبور الموتى وتقرع أبوابها سائلاً إياهم :
هل تريدون العودة إلى الحياة ؟ إذن لرأيتهم ينفضون إليك رؤوسهم رافضين العودة !
إن هذا التعلق بالحياة - فيما يرى شوبنهاور- حركة عمياء غير عاقلة، ولا تفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة للحياة الخالصة، والحياة - تبعاً لذلك- يمكن أن تعد الخير الأسمى، مهما يكن من مرارتها وقصرها واضطرابها، والإرادة في ذاتها وبطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة، أما المعرفة فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة؛ لأنها تكشف لنا عما لهذه الحياة من ضآلة وهشاشة، ولهذا تحارب الخوف من الموت، ويتناول "شوبنهاور" مشكلة الموت، فيقرر أن "الموت" لا يصيب إرادة الحياة؛ وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي يحددها باستمرار؛ أما إرادة الحياة فخالدة أبد الدهر، والطبيعة قد ضمنت لها الخلود بواسطة أداة قوية تلعب الدور الأكبر في الحياة العضوية ،وهذه الإرادة هي "الغريزة الجنسية" ففيها مظهر من أوضح مظاهر تأكيد إرادة الحياة نفسها؛ لأن معناها هو أن الطبيعة مهمومة بحفظ النوع باستمرار، وأن في شدة هذه الغريزة وكونها "أقوى الغرائز" ما يدل بوضوح على أن إرادة الحياة هي سر الأسرار في الطبيعة.
3
شوبنهاور
" جوهر الفلسفة هو البحث عن الحقيقة لا امتلاكها..ان نتفلسف هو ان نكون في الطريق..السؤال في الفلسفة أهم من الإجابة و كل اجابة يجب أن تتحول إلى سؤال جديد "
الفيلسوف كارل ياسبرز
الفيلسوف كارل ياسبرز
موضوعات الوجودية الخمسة:
هناك خمسة موضوعات أساسية ينظر الفلاسفة الوجوديون إلى كلٍّ منها بأسلوبه الخاص. وبدلًا من حصر «الوجودية» في تعريف ضيق، يمكن تبينها من خلال التشابه (تداخل الموضوعات وتلاقيها) بين هؤلاء الفلاسفة.
(١) الوجود يسبق الجوهر: ما أنت عليه (جوهرك) هو نتاج اختياراتك (وجودك) وليس العكس. الجوهر ليس المصير؛ فأنت من تختار لنفسك ما تكون عليه.
(٢) الوقت هو الجوهر: نحن أساسًا كائنات مرتبطة بالزمن. وعلى عكس زمن الساعة القابل للقياس، فإن الوقت المعاش كيفي؛ فمصطلحات زمنية مثل «ليس بعد» و«بالفعل» و«الحاضر» تختلف فيما بينها في المعنى والقيمة.
(٣) الإنسانية: الوجودية فلسفة تركز على الإنسان. وعلى الرغم من أنها لا تعارض العلم، ينصب تركيزها على بحث الذات الإنسانية عن الهوية والمعنى وسط الضغوط الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكبير الساعية لفرض السطحية والامتثال للتقاليد.
(٤) الحرية والمسئولية: الوجودية فلسفة تدور حول الحرية، وقوامها يتمحور حول حقيقة أننا نستطيع الانفصال عن حياتنا لوهلة وتأمل ما كنا نفعله فيها. بهذا المعنى فإننا دائمًا «أكثر» من أنفسنا. لكننا مسئولون مثلما نحن أحرار.
(٥) الاعتبارات الأخلاقية هي الأهم: مع أن كل فيلسوف وجودي يفهم الأخلاق — مثل الحرية — من منظوره الخاص، فالاهتمام الأساسي ينصب على تحفيزنا على تأمل جودة حياتنا الشخصية ومجتمعنا.
الفيلسوف الجديد
هناك خمسة موضوعات أساسية ينظر الفلاسفة الوجوديون إلى كلٍّ منها بأسلوبه الخاص. وبدلًا من حصر «الوجودية» في تعريف ضيق، يمكن تبينها من خلال التشابه (تداخل الموضوعات وتلاقيها) بين هؤلاء الفلاسفة.
(١) الوجود يسبق الجوهر: ما أنت عليه (جوهرك) هو نتاج اختياراتك (وجودك) وليس العكس. الجوهر ليس المصير؛ فأنت من تختار لنفسك ما تكون عليه.
(٢) الوقت هو الجوهر: نحن أساسًا كائنات مرتبطة بالزمن. وعلى عكس زمن الساعة القابل للقياس، فإن الوقت المعاش كيفي؛ فمصطلحات زمنية مثل «ليس بعد» و«بالفعل» و«الحاضر» تختلف فيما بينها في المعنى والقيمة.
(٣) الإنسانية: الوجودية فلسفة تركز على الإنسان. وعلى الرغم من أنها لا تعارض العلم، ينصب تركيزها على بحث الذات الإنسانية عن الهوية والمعنى وسط الضغوط الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكبير الساعية لفرض السطحية والامتثال للتقاليد.
(٤) الحرية والمسئولية: الوجودية فلسفة تدور حول الحرية، وقوامها يتمحور حول حقيقة أننا نستطيع الانفصال عن حياتنا لوهلة وتأمل ما كنا نفعله فيها. بهذا المعنى فإننا دائمًا «أكثر» من أنفسنا. لكننا مسئولون مثلما نحن أحرار.
(٥) الاعتبارات الأخلاقية هي الأهم: مع أن كل فيلسوف وجودي يفهم الأخلاق — مثل الحرية — من منظوره الخاص، فالاهتمام الأساسي ينصب على تحفيزنا على تأمل جودة حياتنا الشخصية ومجتمعنا.
الفيلسوف الجديد
Forwarded from باروخ سبينوزا
@spinoza_2021.pdf
343.8 KB
السَّبَبُ في وضْع الشعائر والإيمان بالقصص - الفيلسوف باروخ سبينوزا
18 ص
18 ص
بعض مصطلحات سارتر في الوجود و العَدم
▪︎الوجود في ذاته L
هو الشعور أو الوعي منظوراً إليه في ذاته، وكأنه في حالة وحدة وانعزال، وهو انعدام الوجود في ذاته، وشعور بنقص الوجود، والشوق إلى الوجود. ويُناظر ما يسميه "هايدغر" ( الموجود ) Das selende. ويقرب من معنى ( الانية ) Dasein. وهو الإنسان بما هو إنسان، أي من حيث أنه يتجاوز وجود الأشياء والوجود المادي بشكل عام.
▪︎الوجود للغير L
هو الوجود الإنساني ، أو كما يقول "هيدغر" "الموجود الذي هو نحن" ، أو "وجود الإنسان".
▪︎التناهي finitude
أي محدودية الاختيار بالنسبة إلى الإنية، فمن بين ممكناتها العديدة لا تستطيع أن تحقق إلا وجهاً أو بعض الأوجه من الممكنات، وأن تترك باقي الممكنات مما ينفذ منه العدم إلى الإنية والوجود.
▪︎الوقائعية `facticite
هي العلاقة الضرورية القائمة بين ( ماهو لذاته ) وبين ( ما في ذاته )، أي بين ( ماهو لذاته ) وبين العالم و ماضي ( ماهو لذاته ). والوقائعية هي التي تمكننا من أن نقول أن ( ماهو لذاته ) يكون أو يُوجَد. وقائعية الحرية مثلاً هي كون الحرية لا يمكن ألا تكون حرة.
____
الوجود والعدم ، جان بول سارتر ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، دار الآداب ، بيروت ، 1966.
#سارتر
▪︎الوجود في ذاته L
etre-en-sol
هو الوجود غير الواعي، وهو وجود الأشياء، ووجود العالم، ووجود الظاهرة، ويتصف بأنه ملاء.
▪︎الوجود لذاته Letre-pour-sol هو الشعور أو الوعي منظوراً إليه في ذاته، وكأنه في حالة وحدة وانعزال، وهو انعدام الوجود في ذاته، وشعور بنقص الوجود، والشوق إلى الوجود. ويُناظر ما يسميه "هايدغر" ( الموجود ) Das selende. ويقرب من معنى ( الانية ) Dasein. وهو الإنسان بما هو إنسان، أي من حيث أنه يتجاوز وجود الأشياء والوجود المادي بشكل عام.
▪︎الوجود للغير L
etre-pour-autrul
هو الشعور، ولكن منظوراً إليه من حيث علاقته بالشعورات الأخرى، أي من وجهة النظر الاجتماعية و الوجود مع الآخرين. وهو بُعد جديد للوجود، فيه يوجد الأنا أو الذات خارجاً كموضوع بالنسبة إلى الآخرين.
و كل وجود للغير يتضمن صراعاً مستمراً مع الوجود للذات، فإن كل وجود، يسعى إلى استرداد وجوده الخاص بجعل الغير - مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة - موضوعاً بالنسبة إلى الأنا أو الذات.
▪︎سوء النية mauvaise fol
هو الكذب على الذات داخل وحدة الشعور المفرد. فبواسطة سوء النية يحاول الشخص أن يفلت أو يتهرب من الحرية ذات المسؤولية التي للوجود بذاته.
▪︎العلو transcendance
هي العملية التي فيها يمضي ال ( ما هو لذاته ) أبعد مما
هو معطى، في مشروع يصممه لنفسه. وهذا المعنى الجديد أحياه هوسرل وهايدغر الذي جعل من العلو، علاقة قائمة بين الأنية ( الإنسان )، العالم.
▪︎العدم neant
في الفلسفة الوجودية لا يُنظَر إليه على أنه الافتقار إلى الوجود، بل على أنه مرتبط بالوجود بعلاقة : فعند ياسبرز أن العدم من حيث يستشعر هو ثغرة للوجود، وعند هيدغر أن الوجود ينكشف على أنه حضور وغياب معاً، وانكشاف واحتجاب معاً. وعند سارتر أن العدم تالٍ على الوجود، لكنه يلاحق الوجود.
▪︎الإنية realite-humaine هو الوجود الإنساني ، أو كما يقول "هيدغر" "الموجود الذي هو نحن" ، أو "وجود الإنسان".
▪︎التناهي finitude
أي محدودية الاختيار بالنسبة إلى الإنية، فمن بين ممكناتها العديدة لا تستطيع أن تحقق إلا وجهاً أو بعض الأوجه من الممكنات، وأن تترك باقي الممكنات مما ينفذ منه العدم إلى الإنية والوجود.
▪︎الوقائعية `facticite
هي العلاقة الضرورية القائمة بين ( ماهو لذاته ) وبين ( ما في ذاته )، أي بين ( ماهو لذاته ) وبين العالم و ماضي ( ماهو لذاته ). والوقائعية هي التي تمكننا من أن نقول أن ( ماهو لذاته ) يكون أو يُوجَد. وقائعية الحرية مثلاً هي كون الحرية لا يمكن ألا تكون حرة.
____
الوجود والعدم ، جان بول سارتر ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، دار الآداب ، بيروت ، 1966.
#سارتر