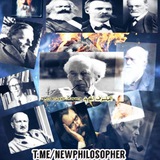إقرأوا علي الوردي بتمعن.. فقد شخَّص أمراض العرب وسبب تراجعهم وتناحرهم كلها حينما حلل شخصية الفرد العربي عامة والعراقي خاصةً..
في هذه القناة جميع مؤلفاته ومقالاته وبعضٍ من أقواله.
https://www.tg-me.com/Ali_AlWardi
في هذه القناة جميع مؤلفاته ومقالاته وبعضٍ من أقواله.
https://www.tg-me.com/Ali_AlWardi
Telegram
الدكتور علي الوردي
الدكتور علي الوردي أعظم من حلل الشخصية العراقية وفصلها تفصيلاً دقيقاً.
بُغْض البشر بروح فلسفية
النص مُحاضرة لإيان جيمس كيد من احتفالية مجلة "الفلسفة اﻵن" في لندن - يناير 2020.
إيان جيمس كيد محاضر في الفلسفة في جامعة نوتنجهام
ترجمة: محمد عثمان
كانط وشوبنهاور وشكلر، عن philosophy now
التَنديد بالجِنْسِ البَشَريِّ أصبح شائعًا هذه الأيام. بِالأخْذ في الاعتبار الأزمة البيئية العالمية، وصعود الأيدولوجيات اليَمِينية المُتَطَّرِفَة، وتقويض أُسسِ المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والعديد من الشرور الأخلاقية الأُخرى، يُنَدد الكثير من الناس بحالة البشرية. أحيانًا، لا يتجاوز التَنديد الكلام: تعبيراتُ الغضبِ عن انهيارنا الأخلاقي. ومع ذلك فأحيانًا يكتسب التَنديد روحًا عَمَليةً. في أقصى الطرف نجد هؤلاء الذين يَحضّون على نهاية جِنْسِنا، مثل مُناصري تحديد النَّسل ومن بينهم الحركة الطواعية لانقراض الجنس البشري (VHEM)[1]. العديد من المواقف المُعتَدِلة تُنادي بتَغيير جَذريِّ للبشرية، ربما باتجاه جعل طُرق الحياة أزهد وأبسط. إن انهيار نَمَط حياتنا الصِناعيّ والاِستهلاكيّ ربما يَلِيه حياة بِطِباع مختلفة ونأمل أن تكون أفضل –هذا الأمل يقدمه على سبيل المثال الفيلسوف والناشط البيئي روبرت ريد Rupert Read في كتابه الصادر عام 2019 باسم (انتهاء الحضارة، Civilization is Finished).
المُصْطَلَح المناسب لكل تلك المُمارسات المُنددة بأخلاق البشرية هو بُغْضُ البشرِ.
فإن مُبْغِضَ البشر في معناه العام واليومي هو شخصُ يَكْرَه البشر أو ينفر أو يشمئز منهم ويحاول تَجنُبَهُم. في مَسْرَحِية موليير (مُبْغِضُ البشرِ)، التي نُشِرَتْ عام 1666، يقول بطلُ العملِ «ألسيست» بأنه «يَكْرَه جميع البشرِ»، فبَعِضَهم «خَسيس» والبقية تُعاونهم على «شَرِّهم». في نهاية المسرحية، يُعلن هذا المُبْغِض عن رغبته في الهروب من مجتمعه الفاسد والمُفْسِد.
رغم هَجر المصطلح مُنذ وقتِ طويلِ إلاّ إنْه ما زال مُحتَفِظًا بمعناه: أن تكون مُبْغِضًا للبشرِ تعني أن تَكْرَه البَشَريّةَ وتُريدُ الهروبَ منها، أو ربما مُمارسة العنفِ ضِدّها. الفَيلَسُوفة جوديث شْكلَر Judith Shklar تُحذر من أن بُغْضَ البشرِ خطيرُ –لديه القُدْرةُ التي «تجعلنا تُعَساء وبدون أصدقاء»، و«يَنْكِبُنا بغَثَيَانِ في أرواحنا، ويحرمُنا من كل النِعَمِ ما عدا القَدْحِ والسّبِ»(Ordinary Vices 1984). وطِبقًا لتَحذيرها الصائبِ فالكَرَاهيةُ والعنفُ لا يَصلُحان كأساسِ لحياةِ جَيدةِ. فلو أن فَلَسفةَ بُغض البشرِ بالضرورة تَشْملُ الكراهيةَ والعنفَ فينبغي علينا أن نتجنَّبها. لحُسنِ الحظِ، فهي لا تَشملهُما.
تَعريفُ بُغْضِ البشرِ بأنه «كراهيةُ أو نَفورُ من البَشّرِ أو البَشّريةِ» مُحدودُ جدًا. فهناك العديد من أشكال البُغض، وفقط القليل منها يَحتوي على الكَراهيةِ. ففي مُوَاجَهَةِ تلك الرَذائِل نشعر بالغضَبِ -أو بالمَرَارةِ، أو بالإِحْباطِ، أو بالاِستِسلاَمِ المُحزِنِ، أو في أكثر الأحوال تفاؤُلًا؛ بأملِ مؤكدِ في قُدْرتنا على التَحْسُنِ للأفضل. وفي الواقع، بعض فَلاسِفةِ البُغْضِ يرفضون بوضوحِ أن تكون الكراهيةُ ردَ فعلِ على انهيارنا الأخلاقي.
1
النص مُحاضرة لإيان جيمس كيد من احتفالية مجلة "الفلسفة اﻵن" في لندن - يناير 2020.
إيان جيمس كيد محاضر في الفلسفة في جامعة نوتنجهام
ترجمة: محمد عثمان
كانط وشوبنهاور وشكلر، عن philosophy now
التَنديد بالجِنْسِ البَشَريِّ أصبح شائعًا هذه الأيام. بِالأخْذ في الاعتبار الأزمة البيئية العالمية، وصعود الأيدولوجيات اليَمِينية المُتَطَّرِفَة، وتقويض أُسسِ المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والعديد من الشرور الأخلاقية الأُخرى، يُنَدد الكثير من الناس بحالة البشرية. أحيانًا، لا يتجاوز التَنديد الكلام: تعبيراتُ الغضبِ عن انهيارنا الأخلاقي. ومع ذلك فأحيانًا يكتسب التَنديد روحًا عَمَليةً. في أقصى الطرف نجد هؤلاء الذين يَحضّون على نهاية جِنْسِنا، مثل مُناصري تحديد النَّسل ومن بينهم الحركة الطواعية لانقراض الجنس البشري (VHEM)[1]. العديد من المواقف المُعتَدِلة تُنادي بتَغيير جَذريِّ للبشرية، ربما باتجاه جعل طُرق الحياة أزهد وأبسط. إن انهيار نَمَط حياتنا الصِناعيّ والاِستهلاكيّ ربما يَلِيه حياة بِطِباع مختلفة ونأمل أن تكون أفضل –هذا الأمل يقدمه على سبيل المثال الفيلسوف والناشط البيئي روبرت ريد Rupert Read في كتابه الصادر عام 2019 باسم (انتهاء الحضارة، Civilization is Finished).
المُصْطَلَح المناسب لكل تلك المُمارسات المُنددة بأخلاق البشرية هو بُغْضُ البشرِ.
فإن مُبْغِضَ البشر في معناه العام واليومي هو شخصُ يَكْرَه البشر أو ينفر أو يشمئز منهم ويحاول تَجنُبَهُم. في مَسْرَحِية موليير (مُبْغِضُ البشرِ)، التي نُشِرَتْ عام 1666، يقول بطلُ العملِ «ألسيست» بأنه «يَكْرَه جميع البشرِ»، فبَعِضَهم «خَسيس» والبقية تُعاونهم على «شَرِّهم». في نهاية المسرحية، يُعلن هذا المُبْغِض عن رغبته في الهروب من مجتمعه الفاسد والمُفْسِد.
رغم هَجر المصطلح مُنذ وقتِ طويلِ إلاّ إنْه ما زال مُحتَفِظًا بمعناه: أن تكون مُبْغِضًا للبشرِ تعني أن تَكْرَه البَشَريّةَ وتُريدُ الهروبَ منها، أو ربما مُمارسة العنفِ ضِدّها. الفَيلَسُوفة جوديث شْكلَر Judith Shklar تُحذر من أن بُغْضَ البشرِ خطيرُ –لديه القُدْرةُ التي «تجعلنا تُعَساء وبدون أصدقاء»، و«يَنْكِبُنا بغَثَيَانِ في أرواحنا، ويحرمُنا من كل النِعَمِ ما عدا القَدْحِ والسّبِ»(Ordinary Vices 1984). وطِبقًا لتَحذيرها الصائبِ فالكَرَاهيةُ والعنفُ لا يَصلُحان كأساسِ لحياةِ جَيدةِ. فلو أن فَلَسفةَ بُغض البشرِ بالضرورة تَشْملُ الكراهيةَ والعنفَ فينبغي علينا أن نتجنَّبها. لحُسنِ الحظِ، فهي لا تَشملهُما.
تَعريفُ بُغْضِ البشرِ بأنه «كراهيةُ أو نَفورُ من البَشّرِ أو البَشّريةِ» مُحدودُ جدًا. فهناك العديد من أشكال البُغض، وفقط القليل منها يَحتوي على الكَراهيةِ. ففي مُوَاجَهَةِ تلك الرَذائِل نشعر بالغضَبِ -أو بالمَرَارةِ، أو بالإِحْباطِ، أو بالاِستِسلاَمِ المُحزِنِ، أو في أكثر الأحوال تفاؤُلًا؛ بأملِ مؤكدِ في قُدْرتنا على التَحْسُنِ للأفضل. وفي الواقع، بعض فَلاسِفةِ البُغْضِ يرفضون بوضوحِ أن تكون الكراهيةُ ردَ فعلِ على انهيارنا الأخلاقي.
1
ونتيجة «لتَعَدَّدِ الآراءِ حول بُغْضِ البَشّرِ» يُمكنُنا أن نَتَعرف على فَظَاعة الأخلاقِ البَشّرية دون أن ننساق للكراهيةِ، للعنفِ، أو لليَأْسِ. ولنفعل ذلك سيكون علينا أن نفهم بُغْضَ البَشّرِ بشكلِ أفضل.
تَعريفُ بُغْضِ البَشّرِ
من الغريب عدم وجود ما يكفي من الكتاباتُ الفَلْسَفيةُ عن بُغْضِ البَشّرِ. إنه مُصْطَلَح لا يُفضل الفلاسفة الأخلاقيون استخدامه.
أحياناً يُقْتَرن بُغْضَ البَشّرِ بالتَشاؤميَّةِ والعَدَميّةِ، فكلاهما يُعْرِبُ عن نظرته الكَئِيبة للوجود الإنساني. ربما يكون أرتور شوبنهاور (1788-1860) الفَيلَسوفَ الأكثر تَشاؤميَّة بلا مُنازع وأيضًا الأشد بُغْضًا للبَشّرِ. لكن التَشاؤميَّةُ والبُغْضُ ليسا نفس المُصْطَلَح: فالفَيلَسوفُ المُتَشّائمُ يَعتقدٌ بأن هُناك سِماتُ مُتَأصِّلَةُ في الكونِ بشكل عام تمنع سعادةَ الانسانِ وتجعل ازدهارَه مُستحيلًا مثل: الحَماقة، اِنعدام المعنى، المُعَاناة، بينما في المُقابلِ يَصُبُّ فَيلَسوفُ بُغْضِ البَشّرِ تَرْكِيزَه على عُيُوبِنا ورَذائِلُنا. وبفرض أن التَشاؤميَّةّ والبُغْضَ مُتْقَارِبان، لكن ذلك لا يعني أنهما مُتطابِقان. كمثالِ: يُمكنني الإيمانُ بأن الوجودَ الإنسانيَ في الكونِ بلا معنى بدون أن أقصد أنه بَغْيضُ أخلاقيًا. فقد نكون بلا معنى لكن أخلاقنا تُثير الاعجاب بشكل عام.
يُدافع ديفيد كوبر David E. Cooper عن فَلسَفةِ بُغْضِ البَشّرِ من خلال كِتابِه «الحيوانات وبغض البشر» (Animals and Misanthropy 2018). وكما يُشير العنوان، فهو يُناقش بأن التقييمَ الأمينَ لمُعاملتُنا للحيواناتِ سيُبَررُ الحُكمَ ببُغْضِ البَشَريّة. فالمِحْنَةُ التي تَعيشُها مِئات الملايين من الحيوانات غَير الإنسانية تكشفُ عن نَسَقِ كاملِ من عُيُوبِنا ورَذائِلِنا: العَجرَفة، القَسوة، الفَظَاظَة، الطَمَع، الغُرُور، الطَيْش، الجهل المُتَعْمد، الزُهُو.. والقائمة طويلة وكِئيبة.
بينما يُرَكِزُ كوبر على الحيواناتِ يُمكننا أن نفحص جوانبَ مختلفةَ من حياةِ الانسانِ. سَنَجْدُ، كما يُجَادلُ فَلاسِفةُ بُغْضِ البَشّرِ، أن الوجودَ الإنسانيَ مُشَبَّعُ بالعُيُوبِ والرَذائِلِ ومن بينها العَجرفة (في صدارة القائمة مرة أُخرى)، قَسوة القلبِ، تَصلُّب الرأي، الجَشع، النِفاق، بلادة الحِس أمام الجمال، قِصر النظر، التواني الأخلاقي، الأنانية، الاستخفاف بمعاناة الأخرين، العُنف، الإسراف، وبلا شك هناك العديد من الرَذائِلِ لم نُسمها بعد.
بالنظر إلى كل ما سبق، من السهل فِهم النقد المُبْغِضِ للبَشّرِ. ومع ذلك، فقائِمةَ بالأخطاء البَشّرية غَير كَافية لتأمينِ ما تَدعيه فلسفة البُغْضِ. تصور أحد مُنتقدي فلسفة بُغْضِ البَشّرِ وهو يَقبلُ بأن لنا رَذائِلُ ولكنه يُصّر بأنها سطحيةَ، عَرَضيةَ، ومُحدَدةَ. سيُجادلون بأن تلك الرَذائِلُ مقصورةَ على المواقف القاسية مثل الحرب والتَبَدُّلاتِ السياسية –ظروف تُجبِرُنا بأن نكون أنانيين، عنيفين، ضد طبيعتنا الخَيِّرَةِ– أو بأن هذه الرَذائِلُ مقصورةَ على المتطرفين مثل المضطربين عقليًا أو الوحوش الأخلاقية، الذين لا يمكن اعتبارهم مُمثلين أخلاقيين عن البَشّريةِ كُلها.
هذا القِناعُ الأخلاقيُ بالضبط هو ما ترفضه فَلسَفةُ بُغْضِ البَشّرِ. يَعتقدُ المُبْغِضون للبشرِ بأنه لا يوجدُ شيءُ غير مُعتاد أو عَرَضي بخصوص عُيُوبِنا –إنها مُتَجَذِرةُ فينا وتنتشرُ في كامل حياتنا. سيُشيرون إلى أن دليل ذلك أننا لا نستغرقُ وقتًا ولا جهدًا لنجد أمثلةَ على عُيُوبِ البَشّرِ ورَذائِلِهم. أحيانًا كل ما نحتاجه أن نقرأ الأخبارَ، أو ننظُر عبر النافذةِ، أو في المرآةِ. وبفرض صحة كل ما سبق، فمعظم سلوكنا الشَرِس لا يعدو كونه أفعالًا قاسية صغيرة لا تسترعي انتباهنا؛ تيارُ مُتَدّفِقُ من أكاذيبِ ضئيلةِ. يُسميها ميشيل دي مونتين (1533 – 1592) بـ«الرَذائِلُ المُعتادةُ»، لأنها تُشكل عاداتِنا اليَوْمِيَّةَ، أنْشِطَتَنا، طُرُقَ تَحْدُثِنا. في الحقيقة، لو أننا نعتقد بأن رَذائَلنا لا يُعتدَّ بها إلا في صِوَرِها المُتَطَّرِفةِ، فنحن بذلك نُقلل من قيمتها خدمةً لأنفسنا.
لذلك يُصّرُ فَيلسَوفُ بُغْضِ البَشّرِ على أن عُيُوبَنا ورَذائِلَنا لديها صفاتُ تؤكد ادعاءاتَه ضِدّ ردِ الفعلِ المُحِبّ للإنسانية. ثلاث من هذه الصفاتُ التي تُمَيزُ عُيُوبَنا وهي أنها راسخةُ، واضحةُ، موجودةُ في كل مكانِ وزمانِ: مُتَجَذِّرَةُ بعُمْقِ في أنْشِطَتِنا، مَشَارِيعِنا، طُرُقِ حياتنا التي اِعْتَدناها مُنذ القِدم؛ إن عيوبَنا في أغلب الأحيان جَليّةُ، مثل أن نتحدث عن «قَسوتِنا المُطْلَقةِ» و«جَشعِنا الصارخِ»، وعُيُوبُنا مُنتشرةُ عبر العالمِ ربما فيما عدا بعض الأماكنِ المُنعزلةِ. فعلى كل مُبغِضِ للبَشّرِ أن يُدركَ هذه الِنقاط الثلاث وإلا سيعجز عن الإدانةِ الأخلاقيةِ للبَشّريةِ.
2
تَعريفُ بُغْضِ البَشّرِ
من الغريب عدم وجود ما يكفي من الكتاباتُ الفَلْسَفيةُ عن بُغْضِ البَشّرِ. إنه مُصْطَلَح لا يُفضل الفلاسفة الأخلاقيون استخدامه.
أحياناً يُقْتَرن بُغْضَ البَشّرِ بالتَشاؤميَّةِ والعَدَميّةِ، فكلاهما يُعْرِبُ عن نظرته الكَئِيبة للوجود الإنساني. ربما يكون أرتور شوبنهاور (1788-1860) الفَيلَسوفَ الأكثر تَشاؤميَّة بلا مُنازع وأيضًا الأشد بُغْضًا للبَشّرِ. لكن التَشاؤميَّةُ والبُغْضُ ليسا نفس المُصْطَلَح: فالفَيلَسوفُ المُتَشّائمُ يَعتقدٌ بأن هُناك سِماتُ مُتَأصِّلَةُ في الكونِ بشكل عام تمنع سعادةَ الانسانِ وتجعل ازدهارَه مُستحيلًا مثل: الحَماقة، اِنعدام المعنى، المُعَاناة، بينما في المُقابلِ يَصُبُّ فَيلَسوفُ بُغْضِ البَشّرِ تَرْكِيزَه على عُيُوبِنا ورَذائِلُنا. وبفرض أن التَشاؤميَّةّ والبُغْضَ مُتْقَارِبان، لكن ذلك لا يعني أنهما مُتطابِقان. كمثالِ: يُمكنني الإيمانُ بأن الوجودَ الإنسانيَ في الكونِ بلا معنى بدون أن أقصد أنه بَغْيضُ أخلاقيًا. فقد نكون بلا معنى لكن أخلاقنا تُثير الاعجاب بشكل عام.
يُدافع ديفيد كوبر David E. Cooper عن فَلسَفةِ بُغْضِ البَشّرِ من خلال كِتابِه «الحيوانات وبغض البشر» (Animals and Misanthropy 2018). وكما يُشير العنوان، فهو يُناقش بأن التقييمَ الأمينَ لمُعاملتُنا للحيواناتِ سيُبَررُ الحُكمَ ببُغْضِ البَشَريّة. فالمِحْنَةُ التي تَعيشُها مِئات الملايين من الحيوانات غَير الإنسانية تكشفُ عن نَسَقِ كاملِ من عُيُوبِنا ورَذائِلِنا: العَجرَفة، القَسوة، الفَظَاظَة، الطَمَع، الغُرُور، الطَيْش، الجهل المُتَعْمد، الزُهُو.. والقائمة طويلة وكِئيبة.
بينما يُرَكِزُ كوبر على الحيواناتِ يُمكننا أن نفحص جوانبَ مختلفةَ من حياةِ الانسانِ. سَنَجْدُ، كما يُجَادلُ فَلاسِفةُ بُغْضِ البَشّرِ، أن الوجودَ الإنسانيَ مُشَبَّعُ بالعُيُوبِ والرَذائِلِ ومن بينها العَجرفة (في صدارة القائمة مرة أُخرى)، قَسوة القلبِ، تَصلُّب الرأي، الجَشع، النِفاق، بلادة الحِس أمام الجمال، قِصر النظر، التواني الأخلاقي، الأنانية، الاستخفاف بمعاناة الأخرين، العُنف، الإسراف، وبلا شك هناك العديد من الرَذائِلِ لم نُسمها بعد.
بالنظر إلى كل ما سبق، من السهل فِهم النقد المُبْغِضِ للبَشّرِ. ومع ذلك، فقائِمةَ بالأخطاء البَشّرية غَير كَافية لتأمينِ ما تَدعيه فلسفة البُغْضِ. تصور أحد مُنتقدي فلسفة بُغْضِ البَشّرِ وهو يَقبلُ بأن لنا رَذائِلُ ولكنه يُصّر بأنها سطحيةَ، عَرَضيةَ، ومُحدَدةَ. سيُجادلون بأن تلك الرَذائِلُ مقصورةَ على المواقف القاسية مثل الحرب والتَبَدُّلاتِ السياسية –ظروف تُجبِرُنا بأن نكون أنانيين، عنيفين، ضد طبيعتنا الخَيِّرَةِ– أو بأن هذه الرَذائِلُ مقصورةَ على المتطرفين مثل المضطربين عقليًا أو الوحوش الأخلاقية، الذين لا يمكن اعتبارهم مُمثلين أخلاقيين عن البَشّريةِ كُلها.
هذا القِناعُ الأخلاقيُ بالضبط هو ما ترفضه فَلسَفةُ بُغْضِ البَشّرِ. يَعتقدُ المُبْغِضون للبشرِ بأنه لا يوجدُ شيءُ غير مُعتاد أو عَرَضي بخصوص عُيُوبِنا –إنها مُتَجَذِرةُ فينا وتنتشرُ في كامل حياتنا. سيُشيرون إلى أن دليل ذلك أننا لا نستغرقُ وقتًا ولا جهدًا لنجد أمثلةَ على عُيُوبِ البَشّرِ ورَذائِلِهم. أحيانًا كل ما نحتاجه أن نقرأ الأخبارَ، أو ننظُر عبر النافذةِ، أو في المرآةِ. وبفرض صحة كل ما سبق، فمعظم سلوكنا الشَرِس لا يعدو كونه أفعالًا قاسية صغيرة لا تسترعي انتباهنا؛ تيارُ مُتَدّفِقُ من أكاذيبِ ضئيلةِ. يُسميها ميشيل دي مونتين (1533 – 1592) بـ«الرَذائِلُ المُعتادةُ»، لأنها تُشكل عاداتِنا اليَوْمِيَّةَ، أنْشِطَتَنا، طُرُقَ تَحْدُثِنا. في الحقيقة، لو أننا نعتقد بأن رَذائَلنا لا يُعتدَّ بها إلا في صِوَرِها المُتَطَّرِفةِ، فنحن بذلك نُقلل من قيمتها خدمةً لأنفسنا.
لذلك يُصّرُ فَيلسَوفُ بُغْضِ البَشّرِ على أن عُيُوبَنا ورَذائِلَنا لديها صفاتُ تؤكد ادعاءاتَه ضِدّ ردِ الفعلِ المُحِبّ للإنسانية. ثلاث من هذه الصفاتُ التي تُمَيزُ عُيُوبَنا وهي أنها راسخةُ، واضحةُ، موجودةُ في كل مكانِ وزمانِ: مُتَجَذِّرَةُ بعُمْقِ في أنْشِطَتِنا، مَشَارِيعِنا، طُرُقِ حياتنا التي اِعْتَدناها مُنذ القِدم؛ إن عيوبَنا في أغلب الأحيان جَليّةُ، مثل أن نتحدث عن «قَسوتِنا المُطْلَقةِ» و«جَشعِنا الصارخِ»، وعُيُوبُنا مُنتشرةُ عبر العالمِ ربما فيما عدا بعض الأماكنِ المُنعزلةِ. فعلى كل مُبغِضِ للبَشّرِ أن يُدركَ هذه الِنقاط الثلاث وإلا سيعجز عن الإدانةِ الأخلاقيةِ للبَشّريةِ.
2
إن مُناصري الحَركاتِ البِيئيةِ الحَديثةِ المُبْغِضةِ للبَشّرِ السَاعيّةِ لتغييرِ جَذريِّ مثالُ جيدُ للأشخاصِ الذين يُدركون النِقاطَ الثلاث السابقة فهم يعتبرون التدميرَ، وعدم الاكتراث بالطبيعة، والإسراف، مُتَجَذِرين في طُرقِ وأسسِ حياتِنا. مِثالُ آخر وهم مُناصرو الحركاتِ النسويّةِ الذين يُجادلون بأن تَصّلُبَ الرأيِ، والظلمَ، والاستغلاليةَ مُتَجَذِرْون بعُمْقِ في النِظام الذكوريّ حتى أن أي محاولة لإزالة هذه العُيُوب سينهار لوقعها النظامُ الذكوريّ. من الواضح كما نرى أن هناك أشكالًا مُتَعَددةُ من فلسفةِ بُغْضِ البَشّرِ. الجَوهرُ المُشتركُ هو الإدانة الأخلاقية للجنس البشري، لكن تُحَفِزَه اهتماماتِ مختلفةَ مثل المِحْنَة المُعَذِبة للحيوانات، تَدمير الطبيعةِ، اِضطهاد المرأة. قد يشعر مُبْغِضُ البَشّرِ بالغضبِ الممزوجِ بالكُرهِ، أو بالنْشَاطِ المملوء بالأملِ، أو حتى الاِستِسلَام اليَائسِ وتِبْعًا لهذه التغيُرات في وجهات النظر يختار مواقفَه المختلفةَ.
ينبغي أن يكون واضحًا أيضًا أن هذا البُغْضُ ليس مُوَجَهًا للأفرادِ. فهذا البُغْضُ حُكمُ على شيء جماعيّ وهو: البَشّرية، الحضارة الإنسانية، الطُرُق التي يعيش بها الإنسان. يمكن لمن يُبغِض البشر أن يشعر بالودِّ، وبالإعجابِ، وحتى بالحُبِ تجاه أحدهم –ومفهوم بالطبع أن هؤلاء الأفراد النادرين الذين يُحبهم خالون من أخطاء البشرية. ومن المهم القول بأن مُبْغِضَ البَشّرِ قد يرى في أحد الأفراد مثالًا لكل عُيُوبِ البَشّريةِ. إذا اتخذنا دونالد ترامب مثالًا، فمُنْتَقِدوه يعتبرونه رَمزًا لكل عيبِ في جِنْسِنا –مثالُ حي لكل الرَذائِلِ من الجَشع، الغُرُورِ، والزُهُوِ.
وبهذا تَتَبدى فلسفة بُغْضِ البَشّرِ في أشكالِ مُتَعددةِ لكن هذه التَعَدُّديّةّ تَخلِقُ مجموعةَ مُعقدةَ من المواقفِ الأخلاقيةِ والعَمَليِةِ تُفضي إلى سؤالِ صعبِ: كيف ينبغي على المرء عيش حياتَه عندما تَنْغَرِسُ في روحِه تلك الأفكار المُبْغِضةُ للبَشّرِ؟ فمن الواضح أن الأفكارَ الناقدةَ لوضع الأخلاقِ البَشّريةِ الشَنيعِ ليس مُجرد عقيدةَ نظريةَ فارغةَ بدون مُقتضياتِ على سلوكِنا وحياتِنا. قبول هذه الأفكارُ يعني أن تُغير طريقةَ حياتِك، شعورِك، تفكيرِك. وكل من يكتب عن بُغْضِ البَشّرِ يُحاول الإجابةَ على السؤالِ السابقِ. حتى كَاتبو المَسرحياتِ، فهو مَبحثُ دراميُ بعد كُل ذلك.
خِلاَل تاريخِ الفَلسَفةِ، الغَربيةِ والشَرقيةِ، أعتقد أننا نستطيع أن نتبين أربعةَ مواقف مُبْغِضة للبَشّرِ. قد يكون لدينا موقفُ تُهيمن فيه العاطفةُ أو وجهةُ نظرِ مصحوبة بأفعال مُختلفة وتَعهُداتِ. إنها طريقةُ لفهمِ العالمِ وإدارتِه –طريقةِ ليتعايش المرءُ مع بَغْضِه للبَشّرِ دون محاولةِ تغييره. وبلا شك هناك مواقفُ عديدة أخرى لكن المواقف التالية الأكثر شُهرةً.
3
ينبغي أن يكون واضحًا أيضًا أن هذا البُغْضُ ليس مُوَجَهًا للأفرادِ. فهذا البُغْضُ حُكمُ على شيء جماعيّ وهو: البَشّرية، الحضارة الإنسانية، الطُرُق التي يعيش بها الإنسان. يمكن لمن يُبغِض البشر أن يشعر بالودِّ، وبالإعجابِ، وحتى بالحُبِ تجاه أحدهم –ومفهوم بالطبع أن هؤلاء الأفراد النادرين الذين يُحبهم خالون من أخطاء البشرية. ومن المهم القول بأن مُبْغِضَ البَشّرِ قد يرى في أحد الأفراد مثالًا لكل عُيُوبِ البَشّريةِ. إذا اتخذنا دونالد ترامب مثالًا، فمُنْتَقِدوه يعتبرونه رَمزًا لكل عيبِ في جِنْسِنا –مثالُ حي لكل الرَذائِلِ من الجَشع، الغُرُورِ، والزُهُوِ.
وبهذا تَتَبدى فلسفة بُغْضِ البَشّرِ في أشكالِ مُتَعددةِ لكن هذه التَعَدُّديّةّ تَخلِقُ مجموعةَ مُعقدةَ من المواقفِ الأخلاقيةِ والعَمَليِةِ تُفضي إلى سؤالِ صعبِ: كيف ينبغي على المرء عيش حياتَه عندما تَنْغَرِسُ في روحِه تلك الأفكار المُبْغِضةُ للبَشّرِ؟ فمن الواضح أن الأفكارَ الناقدةَ لوضع الأخلاقِ البَشّريةِ الشَنيعِ ليس مُجرد عقيدةَ نظريةَ فارغةَ بدون مُقتضياتِ على سلوكِنا وحياتِنا. قبول هذه الأفكارُ يعني أن تُغير طريقةَ حياتِك، شعورِك، تفكيرِك. وكل من يكتب عن بُغْضِ البَشّرِ يُحاول الإجابةَ على السؤالِ السابقِ. حتى كَاتبو المَسرحياتِ، فهو مَبحثُ دراميُ بعد كُل ذلك.
خِلاَل تاريخِ الفَلسَفةِ، الغَربيةِ والشَرقيةِ، أعتقد أننا نستطيع أن نتبين أربعةَ مواقف مُبْغِضة للبَشّرِ. قد يكون لدينا موقفُ تُهيمن فيه العاطفةُ أو وجهةُ نظرِ مصحوبة بأفعال مُختلفة وتَعهُداتِ. إنها طريقةُ لفهمِ العالمِ وإدارتِه –طريقةِ ليتعايش المرءُ مع بَغْضِه للبَشّرِ دون محاولةِ تغييره. وبلا شك هناك مواقفُ عديدة أخرى لكن المواقف التالية الأكثر شُهرةً.
3
فلنبدأ بموقفين وصَفهما واحدُ من أكثر الفَلاسِفة الغربيين الأخلاقيين تأثيرًا، إيمانويل كانْط.
العَدُوُّ والهَارِبُ
ربما يكون إيمانويل كانْط (1724-1804) الفَيلَسوفَ الأرفع شأنًا على الأقل في التُراث الغربي، وواحد من الفَلاسِفةِ القليلين الذين كَرَسَّوا انتباهَهم بشكلِ خاصِ لبُغْضِ البَشّرِ. يُفَرِقُ كانْط بين موقفين مُعَقَدين مُبْغِضين للبَشّرِ ؛ الأول «عَدُوُّ البَشّريةِ» الذي تُهيمن عليه الكراهيةُ والاشّمِئْزَازُ من عُيُوبِ البَشّرِ وينْسَاقُ لأعمالِ العُنفِ.
أحيانًا يُمارسُ العنفَ البدنيّ حرفيًا –يكون من النوع الذي ربما يَطمح إلى تمزيق الحياةِ الاجتماعيةِ، أو يرغب ببساطة في إنزال أذاه على الآخرين. في حالات أخرى، يكون العنف رمزيًا، مثل الِنقَاشات المُتشكِكَة في المُثُل العليا المُقدَسة. يُناسب هذا الوصف بعض ناشطي البيئة المُبْغِضين للبَشّرِ: هؤلاء الذين يريدون «تفكيك الحضارة» و«هَدْمِها بالكامل»، أو من يَتطلّعون عامةً إلى انقراض البشرية برضا تام.
الموقف الثاني المُبْغِض للبَشّرِ هو ما يُسَميه كانْط «الهَارِب من البَشّريةِ». وبعكس الفارين مِنْ العَدالةِ، فالهاربين الأخلاقيين يهربون بدافع الخوفِ وليس بذنبٍ اِقْتَرَفوه. يُهيمن عليهم الخوفُ؛ مما نحن عليه، من الأذى الذي نتسبب به، من تأثيراتِ الفساد الأخلاقي عليهم وهم بيننا. وبلا شك فهؤلاء الهاربين لديهم نصيبهم من العُيُوبِ لكنهم يَتَجْنَّبون المزيدَ من الفسادِ الأخلاقيِّ بهَرَبِهم. وهذا يعني الهروب حرفيًا إلى جزيرة مُنْعَزِلةِ أو الانفصال عن العالمِ؛ في الأجيال السابقة كانوا يَنْسَحِبون إلى مُجتمعاتِ دِينيةِ مُنْعَزِلةِ أو أي مكان آخر يَعزلهم عن الرَذَائِلِ الراسِخةِ في العالم الفَسِيحِ. وعندما أعلن بوذا (وُلِدَ تقريبًا 563 قبل الميلاد – تُوفى تقريبًا 483 قبل الميلاد) عن سُمُوّ حياة الرَهبنة كان سبب ذلك أنها خاليةُ من التأثيراتِ الفاسدةِ التي تُغذي رَذَائِلَنا أو كما قال خاليةُ من الشهواتِ المَاديةِ والإغراءات الحِسّيةِ.
يرفض كانْط كلا الموقفين، لأنه يرفض الكراهيةَ، ليس لأنها تجعلنا تُعساء أو بدون أصدقاء، بل لأنه يعتقد أن علينا أن نحترم كرامةَ الأخلاقِ[2] عند رِفَاقِنا حتى لو كانوا يُخطئون باستمرار. الكراهيةُ تَتناقض مع الاحترامِ، إنها تدمره. لهذا السبب يحكم كانْط على موقف عدو البشرية بأنه «جدير بالازدراء». ويَرفُض بالمثل موقفَ الهَارِبِ من البَشّرِ. فعلى فَرضِ اِختفاء الكَراهيةِ ودَوافعِ العُنفِ في تلك الحالة [الانعزال عن البَشّرِ] فلن تكون ثَمّة أعمال اِنسانية صَادقة وصَالحة بدون مُجتمعِ إنساني. ورغم ذِيوع صَيته بوصفِه مُفكرًا مُنعزلًا، إلا أن كانْط يؤكد أننا كائناتُ أخلاقيةُ واجتماعيةُ. لا يمكن لمن يهرب من الأخرين أن تَزدهر حياتَه. ربما يستطيعون العيش مُنزوين ومَعزولين – لكن لن يعيشوا حياة طيبة.
وُجِدَ كلا الموقفين طويلًا قبل كانْط. لو أننا رَجِعنا للعصور القديمة، نستطيع أن نجد أُناسًا أعلنوا عن كَراهيةِ راسِخةِ أو خَوفِ من البَشّريةِ. يُعلن بلوتارخ (وُلدَ نحو 45 - توفي نحو 125 ميلاديًا) بأن «مَنْ يَكْرَهٌ الرَذَائِلَ، يَكْرَهُ البَشّريةَ» –ما أجمله من شعارِ لكل عَدُوِّ للبَشّريةِ. هِرَقْليطُس «الفَيلَسوف البَاكيّ» نَدَبْ حماقةَ ورَذِائِلَ رِفَاقِه وفي النهاية –كما تقول الأسطورة– هَرِبَ ليعيش في الجِبالِ. يبدو هذا مُبَالغًا فيه، ومع ذلك فهو يُبين لنا رغبة مفهومة لهَجْرِ العالمِ البَشّريِّ. لكنْ الكراهيةُ والخوفُ قد لا يمكن اِحتمالهما. فربما لو تَجَذَّر بُغْضُ البَشّرِ في مَفاهيمِ وعواطفِ أُخرى لتجعله مُحْتَمَلًا. ونستطيع أن نَجِدَ هذه المواقف الأُخرى بالتَوَجَّهِ شَرقًا.
4
العَدُوُّ والهَارِبُ
ربما يكون إيمانويل كانْط (1724-1804) الفَيلَسوفَ الأرفع شأنًا على الأقل في التُراث الغربي، وواحد من الفَلاسِفةِ القليلين الذين كَرَسَّوا انتباهَهم بشكلِ خاصِ لبُغْضِ البَشّرِ. يُفَرِقُ كانْط بين موقفين مُعَقَدين مُبْغِضين للبَشّرِ ؛ الأول «عَدُوُّ البَشّريةِ» الذي تُهيمن عليه الكراهيةُ والاشّمِئْزَازُ من عُيُوبِ البَشّرِ وينْسَاقُ لأعمالِ العُنفِ.
أحيانًا يُمارسُ العنفَ البدنيّ حرفيًا –يكون من النوع الذي ربما يَطمح إلى تمزيق الحياةِ الاجتماعيةِ، أو يرغب ببساطة في إنزال أذاه على الآخرين. في حالات أخرى، يكون العنف رمزيًا، مثل الِنقَاشات المُتشكِكَة في المُثُل العليا المُقدَسة. يُناسب هذا الوصف بعض ناشطي البيئة المُبْغِضين للبَشّرِ: هؤلاء الذين يريدون «تفكيك الحضارة» و«هَدْمِها بالكامل»، أو من يَتطلّعون عامةً إلى انقراض البشرية برضا تام.
الموقف الثاني المُبْغِض للبَشّرِ هو ما يُسَميه كانْط «الهَارِب من البَشّريةِ». وبعكس الفارين مِنْ العَدالةِ، فالهاربين الأخلاقيين يهربون بدافع الخوفِ وليس بذنبٍ اِقْتَرَفوه. يُهيمن عليهم الخوفُ؛ مما نحن عليه، من الأذى الذي نتسبب به، من تأثيراتِ الفساد الأخلاقي عليهم وهم بيننا. وبلا شك فهؤلاء الهاربين لديهم نصيبهم من العُيُوبِ لكنهم يَتَجْنَّبون المزيدَ من الفسادِ الأخلاقيِّ بهَرَبِهم. وهذا يعني الهروب حرفيًا إلى جزيرة مُنْعَزِلةِ أو الانفصال عن العالمِ؛ في الأجيال السابقة كانوا يَنْسَحِبون إلى مُجتمعاتِ دِينيةِ مُنْعَزِلةِ أو أي مكان آخر يَعزلهم عن الرَذَائِلِ الراسِخةِ في العالم الفَسِيحِ. وعندما أعلن بوذا (وُلِدَ تقريبًا 563 قبل الميلاد – تُوفى تقريبًا 483 قبل الميلاد) عن سُمُوّ حياة الرَهبنة كان سبب ذلك أنها خاليةُ من التأثيراتِ الفاسدةِ التي تُغذي رَذَائِلَنا أو كما قال خاليةُ من الشهواتِ المَاديةِ والإغراءات الحِسّيةِ.
يرفض كانْط كلا الموقفين، لأنه يرفض الكراهيةَ، ليس لأنها تجعلنا تُعساء أو بدون أصدقاء، بل لأنه يعتقد أن علينا أن نحترم كرامةَ الأخلاقِ[2] عند رِفَاقِنا حتى لو كانوا يُخطئون باستمرار. الكراهيةُ تَتناقض مع الاحترامِ، إنها تدمره. لهذا السبب يحكم كانْط على موقف عدو البشرية بأنه «جدير بالازدراء». ويَرفُض بالمثل موقفَ الهَارِبِ من البَشّرِ. فعلى فَرضِ اِختفاء الكَراهيةِ ودَوافعِ العُنفِ في تلك الحالة [الانعزال عن البَشّرِ] فلن تكون ثَمّة أعمال اِنسانية صَادقة وصَالحة بدون مُجتمعِ إنساني. ورغم ذِيوع صَيته بوصفِه مُفكرًا مُنعزلًا، إلا أن كانْط يؤكد أننا كائناتُ أخلاقيةُ واجتماعيةُ. لا يمكن لمن يهرب من الأخرين أن تَزدهر حياتَه. ربما يستطيعون العيش مُنزوين ومَعزولين – لكن لن يعيشوا حياة طيبة.
وُجِدَ كلا الموقفين طويلًا قبل كانْط. لو أننا رَجِعنا للعصور القديمة، نستطيع أن نجد أُناسًا أعلنوا عن كَراهيةِ راسِخةِ أو خَوفِ من البَشّريةِ. يُعلن بلوتارخ (وُلدَ نحو 45 - توفي نحو 125 ميلاديًا) بأن «مَنْ يَكْرَهٌ الرَذَائِلَ، يَكْرَهُ البَشّريةَ» –ما أجمله من شعارِ لكل عَدُوِّ للبَشّريةِ. هِرَقْليطُس «الفَيلَسوف البَاكيّ» نَدَبْ حماقةَ ورَذِائِلَ رِفَاقِه وفي النهاية –كما تقول الأسطورة– هَرِبَ ليعيش في الجِبالِ. يبدو هذا مُبَالغًا فيه، ومع ذلك فهو يُبين لنا رغبة مفهومة لهَجْرِ العالمِ البَشّريِّ. لكنْ الكراهيةُ والخوفُ قد لا يمكن اِحتمالهما. فربما لو تَجَذَّر بُغْضُ البَشّرِ في مَفاهيمِ وعواطفِ أُخرى لتجعله مُحْتَمَلًا. ونستطيع أن نَجِدَ هذه المواقف الأُخرى بالتَوَجَّهِ شَرقًا.
4
المُنَاضِلُ والمُسْتَكين
التقييم المَنهَجيّ لمُقَوِّماتِنا وحالتِنا الأخلاقيةِ راسخُ بقوةِ في التُراثِ الفَلسَفيّ الهِنديّ والصِينيّ مُنذ أقدم العهود التي نَعرفها. بالنظر إلى المدارس الهِندية، فالصورة كِئيبة: فالإنسان مُحتَجَزُ في دورات من الدوكخا (تعني الألم، أو انعدام التوازن، أو المَرَض) وإعادة الميلاد، مُحتَجَز ضمن «عجلة المعاناة» مدفوعة بعُيُوبِنا ورَذَائِلِنا –و«بالجِذورِ الفاسدةِ» (خاصةً عند البوذية) من الجهلِ، والضَلالِ، والجَشعِ. كُل المَدارسِ الصِينيةِ التَقليدِيةِ تتشارك تلك الصِورة الكِئيبة عن حالة البشرية. يرون أن العالم تُهيمن عليه القَسوةُ، الجَشعُ، الكَذِبُ، الأنانيةُ، التزعزُعُ، تَبْديدُ القُدراتِ، العُنفُ القَاسيّ. يَنْعِي أتباع الكونفوشية الطقوسَ الدينيةَ وتعاليمَ الملوكِ الحُكماءِ التي واراها النسيانُ. بالنسبة للطّاوية، فالبَشّرُ قد ضّلوا طريقَ السماءِ. وكُل من أتباعِ الموهية[3] والشرعوية[4] يعتقدون بأن الانضباط الذاتيَّ الصارمَ بالأخلاقِ وبأساليبِ حازمةِ للثوابِ والعقابِ قد تُغير حالتنا اللا-أخلاقية للأفضل. وبِفرضِ بأن المدارس الصِينيةِ والهِنديةِ تؤكد على العديد من الأشياء الجَيدة مثل: الفضائل، الحِكمة، الشَفقة، الفِطنة، السلوك الديني، التنوير، واتباع الطريق. لكن الحقيقة الواضحة أنه يجب عليهم تَدريس تلك الفضائل وهذه علامة على الخلل. فالوعظ الأخلاقي نفسه علامة على الانحلال، على عالم يسير بشكل خاطئ. فكما يتنبأ لاو تسي (وُلِدَ نحو 604 قبل الميلاد – تُوفي نحو 531 قبل الميلاد) فعندما يهتدي العالم إلى نسق أخلاقي صالح، فلن تكون هناك حاجة لتعاليم الملوك الحكماء، للطقوس الدينية، ولا لتدريس الفضائل.
وبشكل عام ترفض المَدارسُ الصِينيةُ والهِنديةُ الكراهيةَ كاتجاه ضِدّ البَشّريةِ. البوذيّة تعتبر الكراهيةَ رَذِيلةَ، ورغم عدم التوافق بين الكونفوشية والطّاوية إلا أنهما يتفقان على أن الكُرْهَ والعُنْفَ ليسا من تعاليمِ الملوك الحُكماء الحقيقية.
لَكنْ الصورة أقل وضوحًا عندما تَتَعلق بالهُروبِ الأخلاقي المَمْلوء بالذُعرِ. فبوذا علَّمَ أتباعه سُمُوّ حياة الرهبنة المُنْعَزِلةِ، وأتباع الطّاوية يَرتابون من فَسادِ و«خِداعِ» حَياةِ المَدينةِ. لكنْ المَدارسُ الصِينيةُ الأُخرى ترفض تلك الرُوحَ الانسحابيةَ. أتباع الكونفوشية، الموهية، والشَرْعَوية يُريدون إصلاح العالم الاجتماعي وليس هَجْره. أحياناً كان كونفوشيوس يُعلن عن غضبه وعن رَغْبتِه في الإبحار بعيدًا الى جزيرة نائية، لكن عندما يهدأ يعود لمهمته الأخلاقية. ولذا فالمَدارس الصِينية والهِندية تُقدم لنا مواقفَ مُختلفةَ من بُغْضِ البَشّرِ.
ربما نَصِفْ أولى هذه المواقف بالنِضَالِ. فهذا المُبْغِضُ للبَشّرِ يُحفِزَه الأملُ. يَرون العُيُوبَ الأخلاقيةَ الراسِخةَ في العالمِ، ويستجِيبون لها بعزمِ وَطيدِ لإصلاحها. يَتَبْدَى إحساسهم بالأملِ في جهودهم الطّموحةِ والضخمةِ لترميم حالتِنا الجماعيّةِ. وهذا ربما يشمل تعليم الأخلاق، الوعظ الديني، النِضَال السياسيّ الاجتماعيّ، أو خليط من كُل هذا.
5
التقييم المَنهَجيّ لمُقَوِّماتِنا وحالتِنا الأخلاقيةِ راسخُ بقوةِ في التُراثِ الفَلسَفيّ الهِنديّ والصِينيّ مُنذ أقدم العهود التي نَعرفها. بالنظر إلى المدارس الهِندية، فالصورة كِئيبة: فالإنسان مُحتَجَزُ في دورات من الدوكخا (تعني الألم، أو انعدام التوازن، أو المَرَض) وإعادة الميلاد، مُحتَجَز ضمن «عجلة المعاناة» مدفوعة بعُيُوبِنا ورَذَائِلِنا –و«بالجِذورِ الفاسدةِ» (خاصةً عند البوذية) من الجهلِ، والضَلالِ، والجَشعِ. كُل المَدارسِ الصِينيةِ التَقليدِيةِ تتشارك تلك الصِورة الكِئيبة عن حالة البشرية. يرون أن العالم تُهيمن عليه القَسوةُ، الجَشعُ، الكَذِبُ، الأنانيةُ، التزعزُعُ، تَبْديدُ القُدراتِ، العُنفُ القَاسيّ. يَنْعِي أتباع الكونفوشية الطقوسَ الدينيةَ وتعاليمَ الملوكِ الحُكماءِ التي واراها النسيانُ. بالنسبة للطّاوية، فالبَشّرُ قد ضّلوا طريقَ السماءِ. وكُل من أتباعِ الموهية[3] والشرعوية[4] يعتقدون بأن الانضباط الذاتيَّ الصارمَ بالأخلاقِ وبأساليبِ حازمةِ للثوابِ والعقابِ قد تُغير حالتنا اللا-أخلاقية للأفضل. وبِفرضِ بأن المدارس الصِينيةِ والهِنديةِ تؤكد على العديد من الأشياء الجَيدة مثل: الفضائل، الحِكمة، الشَفقة، الفِطنة، السلوك الديني، التنوير، واتباع الطريق. لكن الحقيقة الواضحة أنه يجب عليهم تَدريس تلك الفضائل وهذه علامة على الخلل. فالوعظ الأخلاقي نفسه علامة على الانحلال، على عالم يسير بشكل خاطئ. فكما يتنبأ لاو تسي (وُلِدَ نحو 604 قبل الميلاد – تُوفي نحو 531 قبل الميلاد) فعندما يهتدي العالم إلى نسق أخلاقي صالح، فلن تكون هناك حاجة لتعاليم الملوك الحكماء، للطقوس الدينية، ولا لتدريس الفضائل.
وبشكل عام ترفض المَدارسُ الصِينيةُ والهِنديةُ الكراهيةَ كاتجاه ضِدّ البَشّريةِ. البوذيّة تعتبر الكراهيةَ رَذِيلةَ، ورغم عدم التوافق بين الكونفوشية والطّاوية إلا أنهما يتفقان على أن الكُرْهَ والعُنْفَ ليسا من تعاليمِ الملوك الحُكماء الحقيقية.
لَكنْ الصورة أقل وضوحًا عندما تَتَعلق بالهُروبِ الأخلاقي المَمْلوء بالذُعرِ. فبوذا علَّمَ أتباعه سُمُوّ حياة الرهبنة المُنْعَزِلةِ، وأتباع الطّاوية يَرتابون من فَسادِ و«خِداعِ» حَياةِ المَدينةِ. لكنْ المَدارسُ الصِينيةُ الأُخرى ترفض تلك الرُوحَ الانسحابيةَ. أتباع الكونفوشية، الموهية، والشَرْعَوية يُريدون إصلاح العالم الاجتماعي وليس هَجْره. أحياناً كان كونفوشيوس يُعلن عن غضبه وعن رَغْبتِه في الإبحار بعيدًا الى جزيرة نائية، لكن عندما يهدأ يعود لمهمته الأخلاقية. ولذا فالمَدارس الصِينية والهِندية تُقدم لنا مواقفَ مُختلفةَ من بُغْضِ البَشّرِ.
ربما نَصِفْ أولى هذه المواقف بالنِضَالِ. فهذا المُبْغِضُ للبَشّرِ يُحفِزَه الأملُ. يَرون العُيُوبَ الأخلاقيةَ الراسِخةَ في العالمِ، ويستجِيبون لها بعزمِ وَطيدِ لإصلاحها. يَتَبْدَى إحساسهم بالأملِ في جهودهم الطّموحةِ والضخمةِ لترميم حالتِنا الجماعيّةِ. وهذا ربما يشمل تعليم الأخلاق، الوعظ الديني، النِضَال السياسيّ الاجتماعيّ، أو خليط من كُل هذا.
5
كونفوشيوس (وُلِدَ نحو 551 – تُوفي نحو 479 قبل الميلاد) مِثَالُ جَيدُ لهذا المُنَاضِل. وطوال حياته الصعبة وضع خططًا مُنَاضِلةَ ليُصْلِحَ البِنيةَ الأخلاقيةَ. كَوّن مُجتمعًا من تلامِذَتِه، نَشرهم حول العالمِ. ليؤدوا الأعمالَ الصالحةَ. ليَلْقوا على مسامعِ الحُكامِ النصيحةَ إذا رَغِبوا في الاستماع لها. ليكونوا مثالًا مُفْعَمًا بالفضيلة ليُلْهِموا اﻵخرين لها وليسْتَعِيدوا الاحترامَ للتَقْاليدَ وللطُّقوسِ الدينيةِ.
تَنْجَذِبَ المشاعرُ الحديثةُ لموقف المُنَاضِلِ المُفْعَمِ بالأملِ أكثر من انجذابها لبُغْضِ البَشّرِ الكانْطي؛ وهذا مفهوم بالنسبة لأجيالِ ألهمتها حركاتِ العَدالةِ الاجتماعيةِ، النِضَالَ البيئيّ، والجهودَ الأُخرى العازمةَ على إنقاذِ الكوكب. لكن لا ينبغي علينا الاندفاع نحو ذلك الموقف دون نقدِ. فالعديد من مُبْغِضي البَشّرِ يُحذرون من النِضَالِ المُتَحَمِس لتغيير العالم. فبوذا يَنفُر من المَشاريعِ النِضَاليةِ الطّموحةِ. لسبب واحد، أن الأسباب الجَوهرية لفظاعتِنا الأخلاقيةِ ترجع إلى رسِوخ سمات الدوكخا في الواقع وعَرَضية كُل «الحالاتِ» الإنسانيةِ. هذه الأسباب قد تُعالجها الأخلاقُ الشّخصيةُ والتَدريباتُ الرَوحيةُ. ولسبب آخر، هو أن حماسَ هذا المُناضل لا يتناسب مع فضائل البوذيّة من سكونِ، واتزانِ، وسَكِينَةِ. ولهذا السبب نحتاج موقفًا آخر.
الِاسْتِكَانةُ هي الموقف الرئيسيُّ الرابع المُبْغِض للبَشّرِ. ومثل كل المواقف الفلسفية السابقة، فهي تعكس تقييمًا ناقدًا وسلبيًا لحالة الأخلاق الإنسانية. ما يُميزها هو الروح المُسْتَسْلِمَة. يُقرر المُستكينون بأنه لا يوجد شيء يمكن فعله لجعل البشرية أفضل ولو وُجِدَ شيء فهو ضئيلُ مُقارنةً بضخامةِ عُيُوبِنا العَصِيَّةِ على الإصلاح. ربما يَتَملَّكهم الخوفُ من النتائجِ العَكْسِيةِ لمحاولاتِ الإصلاح الكُبرى التي قد توفر نِطَاقًا خِصْبًا جديدًا لاستعراض هَوَسِنا بالعَظْمَةِ، بالغُرُورِ، وبالضّلالاتِ عن أنفُسِنا. لذا يُفَضِلون الاستجابةَ بالطُرُقِ المُسْتَكِينةِ. لذا يجد المُسْتَكِينون المُبْغِضون للبَشّرِ طُرُقَهم للتَكّيُفِ مع عُيُوبِنا الجَماعيّةِ. فيتجنَّبون فخَ أكثر المجالاتِ فسادًا في الحياة البشرية حيثُ تكون إغواءاتُ الطموحِ والقوةُ في أقصى مداها، ويبحثون عن طُرُقِ أبسط للعيشِ وغير مُلْفِتَة للأنظار بعيدًا عن الاندفاع إلى الاتجاه السائد والانشغال به، يبقون مُخْتَفين وآمِنين من مُعْتَرَكِ الحياةِ حيث يُكافحون في تَنْمِيّةِ الفضائلِ مثل الانعزال والسَكِيْنَة.
تُعطينا الطّاويةُ مِثالًا جيدًا من خِلال الفَيلَسوف جوانج زي (وًلِدَ نحو 369 – تُوفي نحو 286 قبل الميلاد) صاحب قصة «حلم الفراشة» الشّهيرة. يشّتهر جوانغ زي بين الجماهير الغربية الحديثة بوصفه حِالمًا وحتى فوضويًا، يشتهر بصورة الثائر على المعتقدات، المُبْتَهِجِ، بشَعْرِه الطويل وأقدامه الحافية، الذي يَزْدَرِي تعاليمَ الملوكِ الحُكماءِ الرنّانةِ ويتجنَّب رسمياتِ الكونفوشية المُتْمَسِكة بالطّقوسِ الدينيةِ. لكن في الحقيقة، الأمور أكثر تعقيدًا. فنظرته لحياةِ البَشّرِ كِئيبة. فالعديد من الناس يشعرون بالحِيرَة وبالجَفاءِ من المُجتمعِ، قال مُتَفَكِرًا: «البشر يَهْصِرَهم الألمُ، القَلقُ ثم الحُزن»، لأن حياتهم «تنْسَاب أمامهم كجِوَادِ رَاكضِ»، لأنهم ضّلوا الطريقَ (الطّاو) (Dao).
حياة جوانغ زي المُسْتَكِينة تَكيّفت مع هذا العالم. كتاب جوانغ زي يُظْهِرَه مُتجنَّبًا للسياسةِ، وللنِقَاشاتِ مع الدارسين المُجادلين، يبقي في صُحبة مجموعة مَحدودة مَوثوقة من أصدقائه، يقضي وقتَه في تَنْمِيّة مَحبة عَفَوية لكل ما في العالم من ضوارٍ وطيورِ. هذه الأساليب المُسْتَكِينة مَكَنته من العيش في العالم البَشّري ومواجهة أو تجنُّب فساده وإغراءاته.
6
تَنْجَذِبَ المشاعرُ الحديثةُ لموقف المُنَاضِلِ المُفْعَمِ بالأملِ أكثر من انجذابها لبُغْضِ البَشّرِ الكانْطي؛ وهذا مفهوم بالنسبة لأجيالِ ألهمتها حركاتِ العَدالةِ الاجتماعيةِ، النِضَالَ البيئيّ، والجهودَ الأُخرى العازمةَ على إنقاذِ الكوكب. لكن لا ينبغي علينا الاندفاع نحو ذلك الموقف دون نقدِ. فالعديد من مُبْغِضي البَشّرِ يُحذرون من النِضَالِ المُتَحَمِس لتغيير العالم. فبوذا يَنفُر من المَشاريعِ النِضَاليةِ الطّموحةِ. لسبب واحد، أن الأسباب الجَوهرية لفظاعتِنا الأخلاقيةِ ترجع إلى رسِوخ سمات الدوكخا في الواقع وعَرَضية كُل «الحالاتِ» الإنسانيةِ. هذه الأسباب قد تُعالجها الأخلاقُ الشّخصيةُ والتَدريباتُ الرَوحيةُ. ولسبب آخر، هو أن حماسَ هذا المُناضل لا يتناسب مع فضائل البوذيّة من سكونِ، واتزانِ، وسَكِينَةِ. ولهذا السبب نحتاج موقفًا آخر.
الِاسْتِكَانةُ هي الموقف الرئيسيُّ الرابع المُبْغِض للبَشّرِ. ومثل كل المواقف الفلسفية السابقة، فهي تعكس تقييمًا ناقدًا وسلبيًا لحالة الأخلاق الإنسانية. ما يُميزها هو الروح المُسْتَسْلِمَة. يُقرر المُستكينون بأنه لا يوجد شيء يمكن فعله لجعل البشرية أفضل ولو وُجِدَ شيء فهو ضئيلُ مُقارنةً بضخامةِ عُيُوبِنا العَصِيَّةِ على الإصلاح. ربما يَتَملَّكهم الخوفُ من النتائجِ العَكْسِيةِ لمحاولاتِ الإصلاح الكُبرى التي قد توفر نِطَاقًا خِصْبًا جديدًا لاستعراض هَوَسِنا بالعَظْمَةِ، بالغُرُورِ، وبالضّلالاتِ عن أنفُسِنا. لذا يُفَضِلون الاستجابةَ بالطُرُقِ المُسْتَكِينةِ. لذا يجد المُسْتَكِينون المُبْغِضون للبَشّرِ طُرُقَهم للتَكّيُفِ مع عُيُوبِنا الجَماعيّةِ. فيتجنَّبون فخَ أكثر المجالاتِ فسادًا في الحياة البشرية حيثُ تكون إغواءاتُ الطموحِ والقوةُ في أقصى مداها، ويبحثون عن طُرُقِ أبسط للعيشِ وغير مُلْفِتَة للأنظار بعيدًا عن الاندفاع إلى الاتجاه السائد والانشغال به، يبقون مُخْتَفين وآمِنين من مُعْتَرَكِ الحياةِ حيث يُكافحون في تَنْمِيّةِ الفضائلِ مثل الانعزال والسَكِيْنَة.
تُعطينا الطّاويةُ مِثالًا جيدًا من خِلال الفَيلَسوف جوانج زي (وًلِدَ نحو 369 – تُوفي نحو 286 قبل الميلاد) صاحب قصة «حلم الفراشة» الشّهيرة. يشّتهر جوانغ زي بين الجماهير الغربية الحديثة بوصفه حِالمًا وحتى فوضويًا، يشتهر بصورة الثائر على المعتقدات، المُبْتَهِجِ، بشَعْرِه الطويل وأقدامه الحافية، الذي يَزْدَرِي تعاليمَ الملوكِ الحُكماءِ الرنّانةِ ويتجنَّب رسمياتِ الكونفوشية المُتْمَسِكة بالطّقوسِ الدينيةِ. لكن في الحقيقة، الأمور أكثر تعقيدًا. فنظرته لحياةِ البَشّرِ كِئيبة. فالعديد من الناس يشعرون بالحِيرَة وبالجَفاءِ من المُجتمعِ، قال مُتَفَكِرًا: «البشر يَهْصِرَهم الألمُ، القَلقُ ثم الحُزن»، لأن حياتهم «تنْسَاب أمامهم كجِوَادِ رَاكضِ»، لأنهم ضّلوا الطريقَ (الطّاو) (Dao).
حياة جوانغ زي المُسْتَكِينة تَكيّفت مع هذا العالم. كتاب جوانغ زي يُظْهِرَه مُتجنَّبًا للسياسةِ، وللنِقَاشاتِ مع الدارسين المُجادلين، يبقي في صُحبة مجموعة مَحدودة مَوثوقة من أصدقائه، يقضي وقتَه في تَنْمِيّة مَحبة عَفَوية لكل ما في العالم من ضوارٍ وطيورِ. هذه الأساليب المُسْتَكِينة مَكَنته من العيش في العالم البَشّري ومواجهة أو تجنُّب فساده وإغراءاته.
6
👍1
مَأزَقُ فَلسَفةِ البُغْضِ
من السهل اِعداد قائمة طويلة من الأعداء، الهاربين، المُنَاضِلين، والمُسْتَكِينين. وخلال تُراثِ الفَلسَفةِ عَبر العالمِ تتكرر هذه المواقف الأربعة مرة بعد أخرى. كل منها يبين لنا طريقته الخاصة للعيش بنظرة مُبْغِضة للبَشّرِ. ورغم ذلك، فنحن نحتاج إلى اِختبار دقائقِ هذه المواقف في ضوء أسئلة مثيرة للاهتمام لم أناقشها: ما علاقة بُغْض البَشّرِ بالدِّينِ؟ وهل من المقبول أو من العدل إدانة الَبشّريةِ، بدلًا من مجموعات مُحَددة من البَشّرِ؟ ماذا لو كان قرار هذه الفلسفة [ببُغض البشر] مُبَالغًا فيه؟ ولو كان صحيحًا، هل ينبغي علينا نشر هذه الأنباء السيئة عن البشرية؟
كل ما سبق أسئلة مُهمة، لكننا لن نتمكن من تَقَصّيها إلا إذا اقتنعنا بجدية فلسفة بُغْضِ البَشّرِ. وهذا يعني نبذ التعريف القاموسي بوصفها «كراهية البشر». فهناك العديد من الطُرُقِ لتكون مُبْغِضًا للبشر، فقط واحدة منها تتصف بالكراهية. في الحقيقة، لا يُلزم مبغضو البشر أنفسهم بالتمسك بموقف واحد.
بالنظر إلى العديد من الكتابات المُبْغِضة للبشر، أجد كثيرًا تأرجُحًا مُؤلمًا بين المواقف المختلفة –لحظات من الغضب والكُره يَعْقِبها هدوء مُسْتَسْلِم ما يَلْبَث أن يُصبح أملًا مُتفائلًا ثم يتكرر الأمر مرة أخرى. أراد كونفوشيوس دائمًا الاستسلام لكنه دائمًا ما كان يقبض على الأمل من أجل البشرية. في سنواته الأخيرة استحال نِضَاله اِسْتِسْلَامًا. وهذا يُبين لنا أن المُهمة الفلسفية الحقيقية ليس في تجربة إحدى المواقف المُبْغِضة للبَشّرِ، لكنها في التعامل العاطفي والأخلاقي مع هذا التَأرجُحِ بين المواقف. التعامل مع هذا هو جَوهر المَأزَقِ الذي تُواجهه تلك الفلسفة.
[1] VHEM الحركة الطوعية لانقراض العنصر البشري والتي تختصر إلى (VHEMT) هي حركة اجتماعية تؤيد فكرة انقراض الجنس البشري عن طريق الحد من عملية التكاثر. وتدعم تلك الحركة فكرة الانقراض في حد ذاتها وفي المقام الأول، الأمر الذي من شأنه أن يمنع الانحلال البيئي.
[2] كرامة الأخلاق: يذكر كانْط في أكثر من خمسة عشر موقعًا كلمة «الكرامة» في كتابه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق وقد رأيت أن أقتبس من كانْط نفسه تعريف «الكرامة» عنده لكي نفهم كيف نحترم كرامة أخلاق رفاقنا فإليك الاقتباس: «لكل شيء في مملكة الغايات (ثمن أو كرامة)؛ فما له ثمن فمن الممكن أن يستبدل بشيء آخر (مكافئ له)، أما ما يعلو على كل ثمن، وما لا يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له كرامة».
7
الفيلسوف الجديد
من السهل اِعداد قائمة طويلة من الأعداء، الهاربين، المُنَاضِلين، والمُسْتَكِينين. وخلال تُراثِ الفَلسَفةِ عَبر العالمِ تتكرر هذه المواقف الأربعة مرة بعد أخرى. كل منها يبين لنا طريقته الخاصة للعيش بنظرة مُبْغِضة للبَشّرِ. ورغم ذلك، فنحن نحتاج إلى اِختبار دقائقِ هذه المواقف في ضوء أسئلة مثيرة للاهتمام لم أناقشها: ما علاقة بُغْض البَشّرِ بالدِّينِ؟ وهل من المقبول أو من العدل إدانة الَبشّريةِ، بدلًا من مجموعات مُحَددة من البَشّرِ؟ ماذا لو كان قرار هذه الفلسفة [ببُغض البشر] مُبَالغًا فيه؟ ولو كان صحيحًا، هل ينبغي علينا نشر هذه الأنباء السيئة عن البشرية؟
كل ما سبق أسئلة مُهمة، لكننا لن نتمكن من تَقَصّيها إلا إذا اقتنعنا بجدية فلسفة بُغْضِ البَشّرِ. وهذا يعني نبذ التعريف القاموسي بوصفها «كراهية البشر». فهناك العديد من الطُرُقِ لتكون مُبْغِضًا للبشر، فقط واحدة منها تتصف بالكراهية. في الحقيقة، لا يُلزم مبغضو البشر أنفسهم بالتمسك بموقف واحد.
بالنظر إلى العديد من الكتابات المُبْغِضة للبشر، أجد كثيرًا تأرجُحًا مُؤلمًا بين المواقف المختلفة –لحظات من الغضب والكُره يَعْقِبها هدوء مُسْتَسْلِم ما يَلْبَث أن يُصبح أملًا مُتفائلًا ثم يتكرر الأمر مرة أخرى. أراد كونفوشيوس دائمًا الاستسلام لكنه دائمًا ما كان يقبض على الأمل من أجل البشرية. في سنواته الأخيرة استحال نِضَاله اِسْتِسْلَامًا. وهذا يُبين لنا أن المُهمة الفلسفية الحقيقية ليس في تجربة إحدى المواقف المُبْغِضة للبَشّرِ، لكنها في التعامل العاطفي والأخلاقي مع هذا التَأرجُحِ بين المواقف. التعامل مع هذا هو جَوهر المَأزَقِ الذي تُواجهه تلك الفلسفة.
[1] VHEM الحركة الطوعية لانقراض العنصر البشري والتي تختصر إلى (VHEMT) هي حركة اجتماعية تؤيد فكرة انقراض الجنس البشري عن طريق الحد من عملية التكاثر. وتدعم تلك الحركة فكرة الانقراض في حد ذاتها وفي المقام الأول، الأمر الذي من شأنه أن يمنع الانحلال البيئي.
[2] كرامة الأخلاق: يذكر كانْط في أكثر من خمسة عشر موقعًا كلمة «الكرامة» في كتابه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق وقد رأيت أن أقتبس من كانْط نفسه تعريف «الكرامة» عنده لكي نفهم كيف نحترم كرامة أخلاق رفاقنا فإليك الاقتباس: «لكل شيء في مملكة الغايات (ثمن أو كرامة)؛ فما له ثمن فمن الممكن أن يستبدل بشيء آخر (مكافئ له)، أما ما يعلو على كل ثمن، وما لا يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له كرامة».
7
الفيلسوف الجديد
"علينا أن نتذكر أن نصرخ أعلى قليلاً "
آلان دي بوتون
أحياناً، يمكن أن يبدو لنا -بوضوحٍ مخيف- أنّ لا أحد يهتمّ لأمرنا حقّاً. فهم بالكاد يلاحظون وجودنا أو يبقون معنا ليستمعوا لما لدينا أن نقول، ولا يلتقطون أيّاً من تلميحاتنا. إنهم مشغولون جدّاً بمشاريعهم الخاصّة واهتماماتهم اليومية.
على ضوء دليل كهذا، من السهل لنا أن نسقط في هاوية استنتاجات مهوّلة وخطيرة بشأن حالنا: نحن وحيدون – لدرجة أبعد من أي إمكانية للتواصل والتعاطف.
لكن يمكن أن تكون الحقيقة أكثر اعتياديّة\إثارةً للملل، وتحمِلُ مقداراً أكبر من الأمل. نحن البشر -بغالبيّتنا- حريصون جدّاً على تقديم المساعدة عندما نلاحظ حاجة ملحّةً لذلك، لكننا أيضاً مشتّتون دائماً ومأخوذون\مهمومون بشدّة بحيواتنا الخاصّة، وغير مرّجح أن نلاحظ أن هنالك أي خطب لدى الناس حولنا ما لم يتمّ تصريح المشكلة لنا بأوضح العبارات. عندها، لكن فقط عندها، سنقدم على فعل شيء ما حيال ذلك، ونستحضر كلّ ذكائنا وإرادتنا لنرعى آلام شخص آخر. بكلمات أخرى، نحن نستجيب بشكل جيّد للصرخات، لكن بشكل مريع للتّلمحيات.
تتجلى القضية بشكل خاصّ عندما يُقْدِم شخصٌ نعرفه على الانتحار. نحن على يقين بأننا كنّا لقدّمنا كلّ ما في وسعنا لمساعدته لو عرفنا حجم اليأس الذي كان يمرّ به. بنفس الوقت، نحن نعلم أيضاً أنّنا لم نستعلم ونستفسر كثيراً، ولم نسعَ لقراءة التلميحات، ومن المؤكد أننا أعطينا الانطباع بأننا مشغولون دائماً. وهكذا –بشكل سهل التفّهم- نشعر بأننا كلّنا بأس وقسوة قلب.
من الحكمة أن نسترجع هذه الحقائق دون غلِّ أو تفاجؤٍ عندما يحين دورنا في زيارة مشاعر الضعف واليأس. عدم الاكتراث الظاهر على الآخرين هو حقّاً في الظاهر فقط. علينا أن نتعلّم كيف نصرخ. مع الأسف، عادةً ما نفتقر للثقة اللازمة لفعل ذلك تحديداً عندما يكون ضروريّاً للغاية، إذ أنّ شعوراً بدائياً بالحرج يسيطر علينا وقت الحاجة\الضيق، وكأنّ بمقدور أيّ إنسان أن يستمرّ في هذه الحياة باستخدام ذكائه الفردي فقط.
جزء من مأساة كوننا يائسين، هو كم يبدو عذابنا غير مبرّرٍ لنا.
ومع ذلك، ينبغي ألا نسمح لأنفسنا أبدا أن ننسى أنّنا -وكيفما بدت لامبالاة الآخرين على السطح- محاطون بأشخاص، عندما يرون حالة طوارئ أمامهم، سيقفزون إلى الأنهار الجليدية لإنقاذ حياة أشخاص غرباء تماماً. ولو علمنا بشكلٍ لا لبس فيه أنّ شخصاً (حتى لو كان معرفةً عرضيّةً لا صديقاً حميماً) يحتاجنا بشدّة الآن، في الغالب سنترك كل شيء ونجري لمساعدته. لكننا، وبنفس الوقت، في وضعٍ ميئوس منه عندما يأتي الأمر لقراءة العقول وفهم التلميحات.
عندما نمرّ في محنتنا القادمة، علينا أن نتذكّر ألّا نَكرَه أنفسنا جرّاء تطلّبنا للمساعدة وأن ننادي بعلو الصوت، متفائلين بدرايتنا أنّ معظم الناس حولنا سيستجيبون لآلمنا عندما يصل الصوت لآذانهم. علينا أن نتذكر أن نصرخ أعلى قليلاً – وأن نكره أنفسنا أقل قليلاً
آلان دي بوتون
آلان دي بوتون
أحياناً، يمكن أن يبدو لنا -بوضوحٍ مخيف- أنّ لا أحد يهتمّ لأمرنا حقّاً. فهم بالكاد يلاحظون وجودنا أو يبقون معنا ليستمعوا لما لدينا أن نقول، ولا يلتقطون أيّاً من تلميحاتنا. إنهم مشغولون جدّاً بمشاريعهم الخاصّة واهتماماتهم اليومية.
على ضوء دليل كهذا، من السهل لنا أن نسقط في هاوية استنتاجات مهوّلة وخطيرة بشأن حالنا: نحن وحيدون – لدرجة أبعد من أي إمكانية للتواصل والتعاطف.
لكن يمكن أن تكون الحقيقة أكثر اعتياديّة\إثارةً للملل، وتحمِلُ مقداراً أكبر من الأمل. نحن البشر -بغالبيّتنا- حريصون جدّاً على تقديم المساعدة عندما نلاحظ حاجة ملحّةً لذلك، لكننا أيضاً مشتّتون دائماً ومأخوذون\مهمومون بشدّة بحيواتنا الخاصّة، وغير مرّجح أن نلاحظ أن هنالك أي خطب لدى الناس حولنا ما لم يتمّ تصريح المشكلة لنا بأوضح العبارات. عندها، لكن فقط عندها، سنقدم على فعل شيء ما حيال ذلك، ونستحضر كلّ ذكائنا وإرادتنا لنرعى آلام شخص آخر. بكلمات أخرى، نحن نستجيب بشكل جيّد للصرخات، لكن بشكل مريع للتّلمحيات.
تتجلى القضية بشكل خاصّ عندما يُقْدِم شخصٌ نعرفه على الانتحار. نحن على يقين بأننا كنّا لقدّمنا كلّ ما في وسعنا لمساعدته لو عرفنا حجم اليأس الذي كان يمرّ به. بنفس الوقت، نحن نعلم أيضاً أنّنا لم نستعلم ونستفسر كثيراً، ولم نسعَ لقراءة التلميحات، ومن المؤكد أننا أعطينا الانطباع بأننا مشغولون دائماً. وهكذا –بشكل سهل التفّهم- نشعر بأننا كلّنا بأس وقسوة قلب.
من الحكمة أن نسترجع هذه الحقائق دون غلِّ أو تفاجؤٍ عندما يحين دورنا في زيارة مشاعر الضعف واليأس. عدم الاكتراث الظاهر على الآخرين هو حقّاً في الظاهر فقط. علينا أن نتعلّم كيف نصرخ. مع الأسف، عادةً ما نفتقر للثقة اللازمة لفعل ذلك تحديداً عندما يكون ضروريّاً للغاية، إذ أنّ شعوراً بدائياً بالحرج يسيطر علينا وقت الحاجة\الضيق، وكأنّ بمقدور أيّ إنسان أن يستمرّ في هذه الحياة باستخدام ذكائه الفردي فقط.
جزء من مأساة كوننا يائسين، هو كم يبدو عذابنا غير مبرّرٍ لنا.
ومع ذلك، ينبغي ألا نسمح لأنفسنا أبدا أن ننسى أنّنا -وكيفما بدت لامبالاة الآخرين على السطح- محاطون بأشخاص، عندما يرون حالة طوارئ أمامهم، سيقفزون إلى الأنهار الجليدية لإنقاذ حياة أشخاص غرباء تماماً. ولو علمنا بشكلٍ لا لبس فيه أنّ شخصاً (حتى لو كان معرفةً عرضيّةً لا صديقاً حميماً) يحتاجنا بشدّة الآن، في الغالب سنترك كل شيء ونجري لمساعدته. لكننا، وبنفس الوقت، في وضعٍ ميئوس منه عندما يأتي الأمر لقراءة العقول وفهم التلميحات.
عندما نمرّ في محنتنا القادمة، علينا أن نتذكّر ألّا نَكرَه أنفسنا جرّاء تطلّبنا للمساعدة وأن ننادي بعلو الصوت، متفائلين بدرايتنا أنّ معظم الناس حولنا سيستجيبون لآلمنا عندما يصل الصوت لآذانهم. علينا أن نتذكر أن نصرخ أعلى قليلاً – وأن نكره أنفسنا أقل قليلاً
آلان دي بوتون
الفارابي، أبو النصر محمد.
عبد الغفار مكاوي
لسنا نعرف كثيرًا عن حياة الفارابي، فقد كان رجلًا يخلد إلى السكينة والهدوء. وقف حياته على التأمل الفلسفي، يستظل به الملوك، ثم تزيَّا آخر الأمر بزي المتصوفة. يقال إن والد الفارابي كان قائدًا عسكريًّا ومن أصل فارسي، وأن الفارابي قد وُلد حوالي سنة ٨٧٠م في وسيج، وهي قرية صغيرة تقع في ولاية فاراب من بلاد الترك (التركستان الحالية). حصل الفارابي علومه في بغداد، ودرس بعضها على معلم مسيحي هو يوحنا بن شيلان. ألم في دراسته بالأدب والرياضيات، ومؤلفاته في الموسيقى (ومن أهمها كتاب الموسيقى الكبير) شاهد على سعة دراسية للرياضيات. ارتحل الفارابي من بغداد إلى حلب، ولعل ذلك راجع إلى الاضطرابات السياسية التي وقعت ببغداد. وفي حلب استقر في مجلس سيف الدولة، إلا في أخريات حياته حيث ترك القصر وخلا إلى نفسه بين البساتين ومظاهر الطبيعة، فما كان يرى — فيما يقول ابن خلكان — إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك نهر، حالمًا بمدينة فاضلة تتحقق فيها للبشر على الأرض السعادة القصوى، ومات في دمشق في شهر ديسمبر عام ٩٥٠م عن ثماني عامًا. سُمي الفارابي بالمعلم الثاني، والمعلم الأول هو أرسطو، وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: إن أرسطو سُمي بالمعلم الأول لأنه هذب وجمع ما تفرَّق من مباحث المنطق ومسائله، فأقام بناءه متماسكًا وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها، وسُمي الفارابي بالمعلم الثاني لما قام به من تأليف كتاب يجمع ويهذب ما تُرجم قبله من مؤلفات أرسطو خاصة (ولعله كان يقصد كتاب فلسفة أرسطوطاليس الذي حققه ونشره — بجانب عدد آخر من كتب الفارابي — الدكتور محسن مهدي) فمنذ أيام الفارابي أُحصيت كتب أرسطو ورُتبت على صورة لم تتغير في جملتها، وصارت تفسر وتشرح على طريقة الفارابي (راجع إحصاء العلوم بتحقيق المرحوم الدكتور عثمان أمين).
حاول الفارابي أن يقيم البرهان على أن أفلاطون وأرسطو متفقان، وإذا كان يختلفان في المنهج والأسلوب وسيرة الحياة فإن مذهبهما الفلسفي واحد (الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطو). وقد تأثَّر في ذلك تأثرًا مباشرًا بالأفلاطونية الجديدة، كما تأثر بها في كون العالم يجئ صدورًا عن الله في صورة فيض، فمرتبة تفيض عن المرتبة الأعلى منها وهكذا حتى نصل إلى أدنى المراتب.
كان الفارابي ذا نظرة شاملة تعمم أكثر مما تجرئ، فلم يكن يرضيه الوقوف عند الجزئيات، ولم يكن يحفل بالعلوم الجزئية، بل حصر جهده كله في المنطق وفيما بعد الطبيعة وفي علم الطبيعة. والفلسفة عنده — كما هي عند أرسطو — العلم بالموجودات بما هي موجودة، وهي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمام العقل صورة شاملة للعالم. ويذهب الفارابي إلى أن كل موجود فهو إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا ثالث لهذين الضربين من الوجود، ولما كان الممكن لا بد أن تتقدم عليه علة تُخرجه إلى الوجود، ولما كانت العلل لا يمكن أن تتسلسل إلى غير نهاية، وكان لا بد من الانتهاء إلى موجود واجب الوجود لا علة لوجوده، وهو أزلي، وهو موجود بالفعل من جميع جهاته ولا يعتريه التغيُّر، وهو عقل محض، وخير محض، ومعقول محض، وعاقل محض، وهو البرهان على جميع الأشياء، وهو العلة الأولى لسائر الموجودات، ويحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن يكون واحدًا لا شريك له. ومعرفتنا بالله عن طريق الاستدلال من الموجودات التي صدرت عنه أوثق من معرفتنا به معرفة مباشرة، فمن الواحد يصدر العالم، وذاك حين يتعقل الله ذاته، وعن الله يفيض منذ الأزل وجود ثانٍ هو ما يُسمى بالعقل الأول، وهو العقل الذي يحرك الفلك الأكبر، وبعده تأتي عقول ثمانية يختلف بعضها عن بعض، برغم أن كلًّا منها كامل في ذاته، وهذه العقول الثمانية التي نيطت بها الأجرام السماوية تُضاف إلى العقل الأول فتصبح العقول تسعة، وهي كلها تؤلف المرتبة الثانية من مراتب الوجود. وفي المرتبة الثالثة يجئ العقل الفعال الذي يكون حلقة الاتصال بين العالم العلوي والعالم السفلي. وفي المرتبة الرابعة تأتي النفس، وهذا العقل الفعال وهذه النفس من شأنهما أن يتكثرا في أفراد البشر فيكون منهما بمقدار ما هنالك من بني الإنسان. وفي المرتبة الخامسة من مراتب الوجود توجد الصورة. وفي السادسة توجد المادة، ومن هاتين تتكون الأشياء؛ إذ إن كل شيء قوامه صورة ومادة. وبهذه المراتب الست تنتهي سلسلة الموجودات التي ليست ذواتها أجسامًا، مع ملاحظة أن الثلاث المراتب الأولى كائنات ليست أجسامًا. ولا هي تحل في أجسام، وأن الثلاث مراتب الأخيرة تلابس الأجسام وإن لم تكن في ذاتها أجسامًا. أما الأجسام فهي ستة أجناس: الأجسام السماوية، والحيوان الناطق، والحيوان غير الناطق، وأجسام النبات، والمعادن، والعناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار).
1
عبد الغفار مكاوي
لسنا نعرف كثيرًا عن حياة الفارابي، فقد كان رجلًا يخلد إلى السكينة والهدوء. وقف حياته على التأمل الفلسفي، يستظل به الملوك، ثم تزيَّا آخر الأمر بزي المتصوفة. يقال إن والد الفارابي كان قائدًا عسكريًّا ومن أصل فارسي، وأن الفارابي قد وُلد حوالي سنة ٨٧٠م في وسيج، وهي قرية صغيرة تقع في ولاية فاراب من بلاد الترك (التركستان الحالية). حصل الفارابي علومه في بغداد، ودرس بعضها على معلم مسيحي هو يوحنا بن شيلان. ألم في دراسته بالأدب والرياضيات، ومؤلفاته في الموسيقى (ومن أهمها كتاب الموسيقى الكبير) شاهد على سعة دراسية للرياضيات. ارتحل الفارابي من بغداد إلى حلب، ولعل ذلك راجع إلى الاضطرابات السياسية التي وقعت ببغداد. وفي حلب استقر في مجلس سيف الدولة، إلا في أخريات حياته حيث ترك القصر وخلا إلى نفسه بين البساتين ومظاهر الطبيعة، فما كان يرى — فيما يقول ابن خلكان — إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك نهر، حالمًا بمدينة فاضلة تتحقق فيها للبشر على الأرض السعادة القصوى، ومات في دمشق في شهر ديسمبر عام ٩٥٠م عن ثماني عامًا. سُمي الفارابي بالمعلم الثاني، والمعلم الأول هو أرسطو، وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: إن أرسطو سُمي بالمعلم الأول لأنه هذب وجمع ما تفرَّق من مباحث المنطق ومسائله، فأقام بناءه متماسكًا وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها، وسُمي الفارابي بالمعلم الثاني لما قام به من تأليف كتاب يجمع ويهذب ما تُرجم قبله من مؤلفات أرسطو خاصة (ولعله كان يقصد كتاب فلسفة أرسطوطاليس الذي حققه ونشره — بجانب عدد آخر من كتب الفارابي — الدكتور محسن مهدي) فمنذ أيام الفارابي أُحصيت كتب أرسطو ورُتبت على صورة لم تتغير في جملتها، وصارت تفسر وتشرح على طريقة الفارابي (راجع إحصاء العلوم بتحقيق المرحوم الدكتور عثمان أمين).
حاول الفارابي أن يقيم البرهان على أن أفلاطون وأرسطو متفقان، وإذا كان يختلفان في المنهج والأسلوب وسيرة الحياة فإن مذهبهما الفلسفي واحد (الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطو). وقد تأثَّر في ذلك تأثرًا مباشرًا بالأفلاطونية الجديدة، كما تأثر بها في كون العالم يجئ صدورًا عن الله في صورة فيض، فمرتبة تفيض عن المرتبة الأعلى منها وهكذا حتى نصل إلى أدنى المراتب.
كان الفارابي ذا نظرة شاملة تعمم أكثر مما تجرئ، فلم يكن يرضيه الوقوف عند الجزئيات، ولم يكن يحفل بالعلوم الجزئية، بل حصر جهده كله في المنطق وفيما بعد الطبيعة وفي علم الطبيعة. والفلسفة عنده — كما هي عند أرسطو — العلم بالموجودات بما هي موجودة، وهي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمام العقل صورة شاملة للعالم. ويذهب الفارابي إلى أن كل موجود فهو إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا ثالث لهذين الضربين من الوجود، ولما كان الممكن لا بد أن تتقدم عليه علة تُخرجه إلى الوجود، ولما كانت العلل لا يمكن أن تتسلسل إلى غير نهاية، وكان لا بد من الانتهاء إلى موجود واجب الوجود لا علة لوجوده، وهو أزلي، وهو موجود بالفعل من جميع جهاته ولا يعتريه التغيُّر، وهو عقل محض، وخير محض، ومعقول محض، وعاقل محض، وهو البرهان على جميع الأشياء، وهو العلة الأولى لسائر الموجودات، ويحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن يكون واحدًا لا شريك له. ومعرفتنا بالله عن طريق الاستدلال من الموجودات التي صدرت عنه أوثق من معرفتنا به معرفة مباشرة، فمن الواحد يصدر العالم، وذاك حين يتعقل الله ذاته، وعن الله يفيض منذ الأزل وجود ثانٍ هو ما يُسمى بالعقل الأول، وهو العقل الذي يحرك الفلك الأكبر، وبعده تأتي عقول ثمانية يختلف بعضها عن بعض، برغم أن كلًّا منها كامل في ذاته، وهذه العقول الثمانية التي نيطت بها الأجرام السماوية تُضاف إلى العقل الأول فتصبح العقول تسعة، وهي كلها تؤلف المرتبة الثانية من مراتب الوجود. وفي المرتبة الثالثة يجئ العقل الفعال الذي يكون حلقة الاتصال بين العالم العلوي والعالم السفلي. وفي المرتبة الرابعة تأتي النفس، وهذا العقل الفعال وهذه النفس من شأنهما أن يتكثرا في أفراد البشر فيكون منهما بمقدار ما هنالك من بني الإنسان. وفي المرتبة الخامسة من مراتب الوجود توجد الصورة. وفي السادسة توجد المادة، ومن هاتين تتكون الأشياء؛ إذ إن كل شيء قوامه صورة ومادة. وبهذه المراتب الست تنتهي سلسلة الموجودات التي ليست ذواتها أجسامًا، مع ملاحظة أن الثلاث المراتب الأولى كائنات ليست أجسامًا. ولا هي تحل في أجسام، وأن الثلاث مراتب الأخيرة تلابس الأجسام وإن لم تكن في ذاتها أجسامًا. أما الأجسام فهي ستة أجناس: الأجسام السماوية، والحيوان الناطق، والحيوان غير الناطق، وأجسام النبات، والمعادن، والعناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار).
1
تأثر الفارابي في آرائه السياسية بجمهورية أفلاطون (آراء أهل المدينة الفاضلة، فلسفة أفلاطون بتحقيق روزنتال وفالزر، والسياسات المدنية، وكتاب تحصيل السعادة والتنبيه على سبيل السعادة وكلها طبعه حيدر آباد) وقال بفكرة أن يملك زمام الدولة حاكم فاضل وعادل يجمع صفات النبي والملك الفيلسوف والإمام الشيعي المعصوم، ويحقق حلمه بالمدينة الفاضلة فالأمة الفاضلة «التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة» لكي يتجاوزها إلى إطار الإنسانية أو «المعمورة الفاضلة» عندما تتعاون الأمم فيما بينها على بلوغ السعادة. ويختار المفكر والحكيم طريق التضحية «فلا يبالي أن يموت أو يؤثر الموت على الحياة كما فعل سقراط» لتغيير واقع المدن الظالمة والضالة الجاهلة. وتحقيق حلم العدل يجعل للفارابي مكانة ممتازة في تاريخ الفكر الطوباوي (انظر مقال الدكتور جابر عصفور عن نظرية الفن عند الفارابي بمناسبة الاحتفال بذكراه المائة بعد الألف، مجلة الكاتب، ديسمبر ١٩٧٥م، العدد ١٧٧، ص١٠–٣٥، وكذلك فيلسوف العرب والمعلم الثاني للشيخ مصطفى عبد الرازق، ومنزلة الفارابي من المدرسة الفلسفية الإسلامية (بالفرنسية) باريس ١٩٣٤م وفي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ومنطق أرسطو في العالم للعربي (بالفرنسية) الطبعة الثانية، المكتبة الفلسفية، فران، باريس ١٩٦٩م، والكتب الثلاثة الأخيرة للدكتور إبراهيم بيومي مدكور، ومجلة المورد، المجلد الرابع، العدد السادس، ١٩٧٥م، بغداد (عدد خاص عن الفارابي)).
2
2
الثقافة.pdf
514.2 KB
مدخل فلسفي شامل حول تعريف الثقافة، وحقوق الأقليات الثقافية؛ منشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة)
الكاتب: باتي تامارا لينارد
ترجمة: ديمة حمد الحارثي
مراجعة: سيرين الحاج حسين
@Newphilosopher
الكاتب: باتي تامارا لينارد
ترجمة: ديمة حمد الحارثي
مراجعة: سيرين الحاج حسين
@Newphilosopher
هربرت سبنسر
نقولا فياض - #نقولا_فياض
من أعظم مفكري الإنكليز في القرن الماضي، وقد بقي اسمه حتى صدر هذه المائة على لسان كل أديب وعالم، ولكن الشهرة كالأزياء لها عهد وينقضي؛ فقلما تجد اليوم من يستشهد به مع أنه لم يطرق موضوعًا إلا ترك فيه أثرًا عميقًا من تفكيره، ولا سِيَّما في الحرب التي شهرها على الاشتراكية والنظام البرلماني.
كان سبنسر أعدى عدو للاشتراكية، ومع ذلك فالاشتراكيون يستندون إليه في دعم مذهبهم، ويتخذونه على الرغم منه حليفًا لهم؛ لأنه أظهر منذ الساعة الأولى ميله إلى جعل الأرض ملكًا للأمة. ولكن الذين يستشهدون به ينسون أنه طالب بتعويض عادل للمُلاك؛ فهو يعترف بحق الأمة في ملكية العقار، ولكنه لا يعترف لها بحق الاستيلاء على كل ما أضافه الإنسان إلى الأرض من عمله الخاص، أو ماله المُكتَسَب بعرق جبينه، وجُل ما يحق لها السيطرة عليه هي الأرض الصخرية والمستنقعات والغابات.
يقول سبنسر: إن ملكية الأرض بادئ ذي بدء كانت عملًا استبداديًّا، لا يخلو من السرقة والتزوير، فكان فيه اللص يتلو اللص. ويُقدِّم مثلًا على ذلك النورمانديين؛ فقد اغتصبوا الأرض اغتصابًا من الدانماركيين والسكسون، كما اغتصبها السكسون من السلت، والسلت من أبناء بريطانيا العظمى الأصليين. فإذا أراد المجتمع اليوم أن يستولي على عمل ألفي سنة فقد أتى أمرًا إدًّا، وارتكب من اللصوصية أعظم مما ارتكب أولئك. ثم إن دخول العقار في حَوْزة الأمة لا يأتي بالفائدة المطلوبة؛ لأن إدارة المجتمع لا تضاهي إدارة الفرد في تصريف الأمور وتسييرها سيرًا مُوفَّقًا.
1
نقولا فياض - #نقولا_فياض
من أعظم مفكري الإنكليز في القرن الماضي، وقد بقي اسمه حتى صدر هذه المائة على لسان كل أديب وعالم، ولكن الشهرة كالأزياء لها عهد وينقضي؛ فقلما تجد اليوم من يستشهد به مع أنه لم يطرق موضوعًا إلا ترك فيه أثرًا عميقًا من تفكيره، ولا سِيَّما في الحرب التي شهرها على الاشتراكية والنظام البرلماني.
كان سبنسر أعدى عدو للاشتراكية، ومع ذلك فالاشتراكيون يستندون إليه في دعم مذهبهم، ويتخذونه على الرغم منه حليفًا لهم؛ لأنه أظهر منذ الساعة الأولى ميله إلى جعل الأرض ملكًا للأمة. ولكن الذين يستشهدون به ينسون أنه طالب بتعويض عادل للمُلاك؛ فهو يعترف بحق الأمة في ملكية العقار، ولكنه لا يعترف لها بحق الاستيلاء على كل ما أضافه الإنسان إلى الأرض من عمله الخاص، أو ماله المُكتَسَب بعرق جبينه، وجُل ما يحق لها السيطرة عليه هي الأرض الصخرية والمستنقعات والغابات.
يقول سبنسر: إن ملكية الأرض بادئ ذي بدء كانت عملًا استبداديًّا، لا يخلو من السرقة والتزوير، فكان فيه اللص يتلو اللص. ويُقدِّم مثلًا على ذلك النورمانديين؛ فقد اغتصبوا الأرض اغتصابًا من الدانماركيين والسكسون، كما اغتصبها السكسون من السلت، والسلت من أبناء بريطانيا العظمى الأصليين. فإذا أراد المجتمع اليوم أن يستولي على عمل ألفي سنة فقد أتى أمرًا إدًّا، وارتكب من اللصوصية أعظم مما ارتكب أولئك. ثم إن دخول العقار في حَوْزة الأمة لا يأتي بالفائدة المطلوبة؛ لأن إدارة المجتمع لا تضاهي إدارة الفرد في تصريف الأمور وتسييرها سيرًا مُوفَّقًا.
1
وفي برنامج الاشتراكيين مادة أخرى لم يقف سبنسر فيها عند رأيه الأول: تلك حرية المرأة. فقد رأى بالاختبار أنه من الخطر إشراك المرأة في السياسة، وأبى عليها ما للرجال من الحقوق السياسية؛ لأنها لا تقوم بما يقومون به من الواجبات، ولا تُساهم في الخدمة العسكرية كثيرًا أو قليلًا.
ولا بد هنا من القول: إن رجوع سبنسر عن رأيه الأول في هاتين المسألتين: ملكية الأمة للأرض وحرية المرأة، كان نتيجة العلم والاختبار، وإذا أخذنا على رجال السياسة تقلُّبهم في أقوالهم وأعمالهم فلا يسعنا الطعن في المفكرين أمثال سبنسر، عندما يُعيدون النظر في آرائهم القديمة ويُمحِّصونها على ضوء الحقيقة والواقع.
على أن هناك أمرًا ثبت فيه منذ البداية ولم يحد عنه قيد شعرة، وهو اهتمامه بالطبقة العاملة؛ فقد دافع عنها دفاعًا مستطيلًا، وظل حتى النهاية يُردِّد ويُعدِّد ما يكتنف مستقبل الأكثرية من ظلام وشقاء، فالبطالة والازدحام في المساكن الضيِّقة المُظلمة الفاسدة الهواء، والمِهَن المُضنية، والشيخوخة المُحزنة، والانقسام البليغ بين الطبقات، وتفاوت الأرباح الهائل، وحصة الأسد المُعدَّة منها للمخدوم على حساب الخادم … كل هذه الأدواء يشكو سبنسر ويتألم منها، إلا أنه لا يظنها غير قابلة للشفاء.
كان سبنسر من المتفائلين المؤمنين بالرقي، على شرط أن لا يبقى الإنسان مكتوف اليدين، بل يتدخل تدخلًا فعليًّا في مقدرات نفسه، ولكنه لا يعتقد بدواء سحري يشفي من الأمراض كافة؛ فهو يبني فلسفته على ناموس النشوء والارتقاء، ويُشبِّه جسم المجتمع بجسم الفرد؛ أي أنه قابل مثله للتأثر بعوامل خارجية كالتربة والمناخ، وداخلية كالمِزاج والأهواء. وكما يبدأ نماء الجسم بالجرثومة يبدأ نماء المجتمع بالأسرة، ثم القبيلة، إلى أن تتألف الأمم والشعوب، فتنقسم حينئذٍ إلى فئتين أو جيلين أو مثالين: مثال ينتحل الجندية، ومثال ينتحل الصناعة.
والفرق بين المثالين أن المرء يفقد حريته في الأول على أن تُكفَل له حاجاته من مطعم ومسكن وكساء، بينما يظل في الثاني حرًّا يعتمد على نفسه في هذه الحاجات. على أن المثال الخالص عسكريًّا كان أو صناعيًّا غير موجود. ويُمكن القول: إن دول أوروبا مزيج من الاثنين؛ فهي نصف عسكرية ونصف صناعية. ويرى سبنسر أن المثال العسكري غالب في ألمانيا، والصناعي في إنكلترا وأميركا، وفيهما دليل ناصع على ما يمكن للشعب أن يصل إليه من البَسْطة والغِنَى بدون الحرب.
ويقول سبنسر: من العجيب أن الطبقات العاملة تشعر بضرورة السِّلم وتكره الفكرة العسكرية، ومع ذلك نراها تحاول من حيث لا تدري تطبيق نظامها الاستبدادي على الصناعة، بإخضاع الفرد للدولة، فيصير الصُّناع جنودًا يتحكَّم بهم النُّظار والمُفتِّشون، بدلًا من الضباط والقُواد.
ويرد زعماء الاشتراكية على هذا بقولهم: إن الفرق عظيم بين الحالين؛ لأن النظار والمفتشين هم مندوبون خاضعون لرقابة الشعب، مُعرَّضون للانتقاد والعزل، فلا يمكن للعامل أن يكون مُقيَّد الحرية كالجندي.
وعلى الجملة فالاشتراكية في نظر سبنسر رجوع إلى الوراء لا يتفق مع سير الحضارة.
أما عداؤه للنظام البرلماني فراجع إلى فكرته الأساسية التي تجعل من المجتمع جسمًا حيًّا، ينمو ويكبر حسب شرائع طبيعية لا قِبَل للإنسان أن يُبدِّل فيها كما يشاء. والحياة الاجتماعية لا تنتظم اتِّباعًا لخطة يرسمها العقل والمنطق، بل اتباعًا للحاجات الماسة، ولن تجد مجتمعًا راقيًا قام طبقًا لبرنامج أو خطة موضوعة من قبل بالمناقشة الرسمية، ففي أي حال كان لا سبيل للإنسان أن يُغيِّر الأشياء الطبيعية إلا بخضوعه للشرائع الطبيعية.
وهذا ناموس عام ينطبق على الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الاجتماع. وبما أن نمو المجتمع تابع لأسباب عمومية، لا سلطة للإرادة البشرية عليها، فسيادة الشعب مربوطة بالجهل، لا يمكنها أن تهتدي الطريق أو تعرف الوسائل التي ينمو بها المجتمع، وجل ما تستطيع هو أن تُقر وتُثبت هذه الوسائل، وعليه فليسن المندوبون عن الشعب ما شاءوا من الأحكام والشرائع والقوانين؛ فالعِبرة في جعلها ذات فعل نافذ. وقد عمل سبنسر إحصاءً للقوانين التي صدرت في إنكلترا ولم تُنفَّذ، فإذا بها فوق ما يتصوره العقل.
2
ولا بد هنا من القول: إن رجوع سبنسر عن رأيه الأول في هاتين المسألتين: ملكية الأمة للأرض وحرية المرأة، كان نتيجة العلم والاختبار، وإذا أخذنا على رجال السياسة تقلُّبهم في أقوالهم وأعمالهم فلا يسعنا الطعن في المفكرين أمثال سبنسر، عندما يُعيدون النظر في آرائهم القديمة ويُمحِّصونها على ضوء الحقيقة والواقع.
على أن هناك أمرًا ثبت فيه منذ البداية ولم يحد عنه قيد شعرة، وهو اهتمامه بالطبقة العاملة؛ فقد دافع عنها دفاعًا مستطيلًا، وظل حتى النهاية يُردِّد ويُعدِّد ما يكتنف مستقبل الأكثرية من ظلام وشقاء، فالبطالة والازدحام في المساكن الضيِّقة المُظلمة الفاسدة الهواء، والمِهَن المُضنية، والشيخوخة المُحزنة، والانقسام البليغ بين الطبقات، وتفاوت الأرباح الهائل، وحصة الأسد المُعدَّة منها للمخدوم على حساب الخادم … كل هذه الأدواء يشكو سبنسر ويتألم منها، إلا أنه لا يظنها غير قابلة للشفاء.
كان سبنسر من المتفائلين المؤمنين بالرقي، على شرط أن لا يبقى الإنسان مكتوف اليدين، بل يتدخل تدخلًا فعليًّا في مقدرات نفسه، ولكنه لا يعتقد بدواء سحري يشفي من الأمراض كافة؛ فهو يبني فلسفته على ناموس النشوء والارتقاء، ويُشبِّه جسم المجتمع بجسم الفرد؛ أي أنه قابل مثله للتأثر بعوامل خارجية كالتربة والمناخ، وداخلية كالمِزاج والأهواء. وكما يبدأ نماء الجسم بالجرثومة يبدأ نماء المجتمع بالأسرة، ثم القبيلة، إلى أن تتألف الأمم والشعوب، فتنقسم حينئذٍ إلى فئتين أو جيلين أو مثالين: مثال ينتحل الجندية، ومثال ينتحل الصناعة.
والفرق بين المثالين أن المرء يفقد حريته في الأول على أن تُكفَل له حاجاته من مطعم ومسكن وكساء، بينما يظل في الثاني حرًّا يعتمد على نفسه في هذه الحاجات. على أن المثال الخالص عسكريًّا كان أو صناعيًّا غير موجود. ويُمكن القول: إن دول أوروبا مزيج من الاثنين؛ فهي نصف عسكرية ونصف صناعية. ويرى سبنسر أن المثال العسكري غالب في ألمانيا، والصناعي في إنكلترا وأميركا، وفيهما دليل ناصع على ما يمكن للشعب أن يصل إليه من البَسْطة والغِنَى بدون الحرب.
ويقول سبنسر: من العجيب أن الطبقات العاملة تشعر بضرورة السِّلم وتكره الفكرة العسكرية، ومع ذلك نراها تحاول من حيث لا تدري تطبيق نظامها الاستبدادي على الصناعة، بإخضاع الفرد للدولة، فيصير الصُّناع جنودًا يتحكَّم بهم النُّظار والمُفتِّشون، بدلًا من الضباط والقُواد.
ويرد زعماء الاشتراكية على هذا بقولهم: إن الفرق عظيم بين الحالين؛ لأن النظار والمفتشين هم مندوبون خاضعون لرقابة الشعب، مُعرَّضون للانتقاد والعزل، فلا يمكن للعامل أن يكون مُقيَّد الحرية كالجندي.
وعلى الجملة فالاشتراكية في نظر سبنسر رجوع إلى الوراء لا يتفق مع سير الحضارة.
أما عداؤه للنظام البرلماني فراجع إلى فكرته الأساسية التي تجعل من المجتمع جسمًا حيًّا، ينمو ويكبر حسب شرائع طبيعية لا قِبَل للإنسان أن يُبدِّل فيها كما يشاء. والحياة الاجتماعية لا تنتظم اتِّباعًا لخطة يرسمها العقل والمنطق، بل اتباعًا للحاجات الماسة، ولن تجد مجتمعًا راقيًا قام طبقًا لبرنامج أو خطة موضوعة من قبل بالمناقشة الرسمية، ففي أي حال كان لا سبيل للإنسان أن يُغيِّر الأشياء الطبيعية إلا بخضوعه للشرائع الطبيعية.
وهذا ناموس عام ينطبق على الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الاجتماع. وبما أن نمو المجتمع تابع لأسباب عمومية، لا سلطة للإرادة البشرية عليها، فسيادة الشعب مربوطة بالجهل، لا يمكنها أن تهتدي الطريق أو تعرف الوسائل التي ينمو بها المجتمع، وجل ما تستطيع هو أن تُقر وتُثبت هذه الوسائل، وعليه فليسن المندوبون عن الشعب ما شاءوا من الأحكام والشرائع والقوانين؛ فالعِبرة في جعلها ذات فعل نافذ. وقد عمل سبنسر إحصاءً للقوانين التي صدرت في إنكلترا ولم تُنفَّذ، فإذا بها فوق ما يتصوره العقل.
2
من أين إذن هذه الثقة العمياء بما يمكن للبرلمان أن يُجريه من إصلاح؟ وعلامَ هذا الإيمان بالحكومة الذي يُشبه ايمان المتوحش بالصنم؟ يعزو سبنسر ذلك إلى انتشار التعليم. ومن العقائد الراسخة في الأذهان أن التعليم يُهذِّب الشعب ويُنيره، وهذا وهْم؛ لأنه لا يوجد صلة بين قضية هندسية وأدب النفس. ولا يكفي تعليم الأولاد ما هو الخير ولماذا يُسمَّى خيرًا ليصنعوا الخير عندما يكبرون؛ فانتشار التعليم غير كافٍ ليجعل الشعب قابلًا للحكم الحر، ولا بد من الأخلاق، بل قد يساعد التعليم الناقص على نشر أخطاء كثيرة.
وإذا كان المثقفون لا يقبلون بمُطالعة ما يُخالف طريقة تفكيرهم وشعورهم، فما قولك بالشعب إذا كان لا يتذوق إلا ما يُوافق هوًى في نفسه! وأبلغ دليل على نتائج هذا التعليم هو هذه النشرات التي تُغذي الأوهام؛ لأن الجريدة تسعى قبل كل شيء إلى إرضاء مشتركيها، فتُقوِّي فيهم بهذه الطريقة أميالًا شتَّى يصعب تحقيقها، وتجعلهم يظنون أن الحكومة قادرة على معالجة كل الشئون، ومن واجبها التدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتُردِّد على مسامعهم في كل سانحة إمكان تبديل النظام الحالي. وبما أنهم هم الذين سينتخبون، فمن مصلحتها تقوية هذه العقيدة في رءوسهم، وهكذا يُصبح الشعب الذي هو صاحب السيادة أُلعوبة في يد رجال السياسة.
ثم يحمل سبنسر على النواب حملة شعواء، مُتهمًا إياهم بالجهل والوعود الكاذبة والأثرة وتضحية مصالح البلاد في سبيل مصلحتهم الخاصة.
لقد كان لِما كتبه «سبنسر»، وخصوصًا في كتابه «الفرد ضد الدولة»، صدًى بعيد حتى قيل عنه: إنه فوضوي. وما لا ريب فيه أن هذا الكتاب الصغير قد ساعد كثيرًا في بث الدعوة إلى الفوضوية، ولا سِيما في الولايات المتحدة، بتشويههم كلامه وتفسيره تفسيرًا يوافق مصلحتهم. وسبنسر نفسه يقول: بين وَيْلَينِ هُما: استبداد الاشتراكية وحرية الفوضى أُفضِّل الفوضى مع كل ما فيها من شقاء. ولكنه ليس فوضويًّا بكل معنى الكلمة؛ لأن الفوضويين يُطالبون بإبطال كل وظائف الدولة، بينما هو يريد إبطال البعض ودعم البعض الآخر؛ فيطلب من الحكومة عدم التدخل في شئون الدين والتربية والأعمال الخيرية؛ لتكتفي بالمحافظة على النظام.
هناك في نظره مبدأ عام يُسيطر على عِلم السياسة، وهو التعارض بين أدب الأسرة وأدب الدولة. أدب الأسرة يقضي بالعناية الفائقة للولد الضعيف الهزيل، المحروم من نعم الحياة، والاشتراكية تريد إدخال هذا الأدب في الحكومة؛ لتساعد أصحاب العاهات والعيوب وضروب النقص. وهذا ما جعلهم يتَّهمون سبنسر بقساوة القلب، مع أنه يطلب أن تقوم جمعيات خاصة بعمل الخير، لا أن تتلهى به الحكومات فتصل إلى تقهقر النسل بدلًا من تحسينه. هو يريد أن يتحمل كل إنسان مسئوليته، فلا يتكِّل على غيره في ضعفه وكسله وجهله، فلا يبقى في ميدان الجهاد وتنازع البقاء إلا الأنسب، وليس الأنسب هو القوي، بل الأكثر أهليَّة واستعدادًا.
الفيلسوف الجديد
#سبنسر
وإذا كان المثقفون لا يقبلون بمُطالعة ما يُخالف طريقة تفكيرهم وشعورهم، فما قولك بالشعب إذا كان لا يتذوق إلا ما يُوافق هوًى في نفسه! وأبلغ دليل على نتائج هذا التعليم هو هذه النشرات التي تُغذي الأوهام؛ لأن الجريدة تسعى قبل كل شيء إلى إرضاء مشتركيها، فتُقوِّي فيهم بهذه الطريقة أميالًا شتَّى يصعب تحقيقها، وتجعلهم يظنون أن الحكومة قادرة على معالجة كل الشئون، ومن واجبها التدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتُردِّد على مسامعهم في كل سانحة إمكان تبديل النظام الحالي. وبما أنهم هم الذين سينتخبون، فمن مصلحتها تقوية هذه العقيدة في رءوسهم، وهكذا يُصبح الشعب الذي هو صاحب السيادة أُلعوبة في يد رجال السياسة.
ثم يحمل سبنسر على النواب حملة شعواء، مُتهمًا إياهم بالجهل والوعود الكاذبة والأثرة وتضحية مصالح البلاد في سبيل مصلحتهم الخاصة.
لقد كان لِما كتبه «سبنسر»، وخصوصًا في كتابه «الفرد ضد الدولة»، صدًى بعيد حتى قيل عنه: إنه فوضوي. وما لا ريب فيه أن هذا الكتاب الصغير قد ساعد كثيرًا في بث الدعوة إلى الفوضوية، ولا سِيما في الولايات المتحدة، بتشويههم كلامه وتفسيره تفسيرًا يوافق مصلحتهم. وسبنسر نفسه يقول: بين وَيْلَينِ هُما: استبداد الاشتراكية وحرية الفوضى أُفضِّل الفوضى مع كل ما فيها من شقاء. ولكنه ليس فوضويًّا بكل معنى الكلمة؛ لأن الفوضويين يُطالبون بإبطال كل وظائف الدولة، بينما هو يريد إبطال البعض ودعم البعض الآخر؛ فيطلب من الحكومة عدم التدخل في شئون الدين والتربية والأعمال الخيرية؛ لتكتفي بالمحافظة على النظام.
هناك في نظره مبدأ عام يُسيطر على عِلم السياسة، وهو التعارض بين أدب الأسرة وأدب الدولة. أدب الأسرة يقضي بالعناية الفائقة للولد الضعيف الهزيل، المحروم من نعم الحياة، والاشتراكية تريد إدخال هذا الأدب في الحكومة؛ لتساعد أصحاب العاهات والعيوب وضروب النقص. وهذا ما جعلهم يتَّهمون سبنسر بقساوة القلب، مع أنه يطلب أن تقوم جمعيات خاصة بعمل الخير، لا أن تتلهى به الحكومات فتصل إلى تقهقر النسل بدلًا من تحسينه. هو يريد أن يتحمل كل إنسان مسئوليته، فلا يتكِّل على غيره في ضعفه وكسله وجهله، فلا يبقى في ميدان الجهاد وتنازع البقاء إلا الأنسب، وليس الأنسب هو القوي، بل الأكثر أهليَّة واستعدادًا.
الفيلسوف الجديد
#سبنسر
لأسباب قد يتعذر حصرها أصبحنا كلنا ورثة لهيجل ونظرته إلى تاريخ الأفكار. لم يعد في وسعنا أن ننظر للفكر إلا في كليته وهو يعمل متجها نحو غاية بعينها. صحيح أننا تمردنا ضده مع الوضعيين فمع الماركسيين ثم مع الوجوديين بل حتى مع الهايدغريين، إلا أننا لم نكف حتى مع هؤلاء عن البحث عن نقط النهايات وسبل التملك و طرق التجاوز. فربما لا يتعلق الأمر في تاريخ الفكر باكتمال فكر أوتملك تراث، وربما لا يتعلق بتحقيق الفكر في الواقع، ولا حتى بتجاوز تراث أو تبشير بالنهايات. ربما كان الأهم السماح لصيرورات مبعثرة أن تبرز في عملها فيما وراء ما يقدم نفسه تراثا فكريا.
آنئذ لن نشغل بالنا بنقط نهاية ولحظات اكتمال، ولن يهمنا في شيء ما إذا كان الانعراج يحمل اسم هيجل أو اسم كونت أو غيرهما من الأسماء، ولن نثير الصخب مع من أثاره حول ما إذا كان نيتشه ينتمي، أولا ينتمي، لتاريخ الميتافيزيقا. إذ أن نقاط النهاية ستغدو لا متناهية. وسيصبح بالإمكان رصدها عند كثير من الأسماء، بل سيغدو من واجب الفكر البحث عن نقاط الخروج التي قد ينفلت فيها الفكر عن الرقابة التي يفرضها على نفسه، والمنطق الصارم الذي يخضع إليه نفسه.
لن يعود ميدان الفكر، كما شاء له الهيجليون ومن دار في فلكهم نفيا وإيجابا، قائما على أساس مشترك. ولن يطرح المفكرون الأسئلة ذاتها، ولن يستعملوا التصورات عينها. لن يكون هناك ما من شأنه أن يجمع المفكرين ويضمهم داخل تاريخ موحّد، لا المذهب ولا التيار ولا “النظرة إلى العالم”. كل ما هناك حركات متفردة وخطوط متقاطعة. وربما غدا عمل الفكر أساسا ليس بناء المذاهب ولا رصد التيارات ولا تكوين “النظرات إلى العالم” ، وإنما فك الوحدات الموهومة بحثا عما هو متفرد. يتعلق الأمر ببعث الحدث في وحدته وتفرده داخل ما يقدم نفسه حركة كلية. فلسنا هنا، كما أثبت فوكو، لا أمام وحدات، ولا إزاء كليات، وإنما أمام تفرّدات. إبراز هذه التفردات هو وقوف عند الحدث داخل الفكر، بل هو إبراز الفكر كحدث.
نحو رؤية لاهيجلية لتاريخ الفكر
عبد السلام بنعبد العالي
#هيغل
آنئذ لن نشغل بالنا بنقط نهاية ولحظات اكتمال، ولن يهمنا في شيء ما إذا كان الانعراج يحمل اسم هيجل أو اسم كونت أو غيرهما من الأسماء، ولن نثير الصخب مع من أثاره حول ما إذا كان نيتشه ينتمي، أولا ينتمي، لتاريخ الميتافيزيقا. إذ أن نقاط النهاية ستغدو لا متناهية. وسيصبح بالإمكان رصدها عند كثير من الأسماء، بل سيغدو من واجب الفكر البحث عن نقاط الخروج التي قد ينفلت فيها الفكر عن الرقابة التي يفرضها على نفسه، والمنطق الصارم الذي يخضع إليه نفسه.
لن يعود ميدان الفكر، كما شاء له الهيجليون ومن دار في فلكهم نفيا وإيجابا، قائما على أساس مشترك. ولن يطرح المفكرون الأسئلة ذاتها، ولن يستعملوا التصورات عينها. لن يكون هناك ما من شأنه أن يجمع المفكرين ويضمهم داخل تاريخ موحّد، لا المذهب ولا التيار ولا “النظرة إلى العالم”. كل ما هناك حركات متفردة وخطوط متقاطعة. وربما غدا عمل الفكر أساسا ليس بناء المذاهب ولا رصد التيارات ولا تكوين “النظرات إلى العالم” ، وإنما فك الوحدات الموهومة بحثا عما هو متفرد. يتعلق الأمر ببعث الحدث في وحدته وتفرده داخل ما يقدم نفسه حركة كلية. فلسنا هنا، كما أثبت فوكو، لا أمام وحدات، ولا إزاء كليات، وإنما أمام تفرّدات. إبراز هذه التفردات هو وقوف عند الحدث داخل الفكر، بل هو إبراز الفكر كحدث.
نحو رؤية لاهيجلية لتاريخ الفكر
عبد السلام بنعبد العالي
#هيغل
Audio
▪العنوان: فتغنشتاين حدود التفكير واللغة
▪النوع: #فلسفة #فكر #فتغنشتاين
▪الوقت: 23 دقيقة
@Newphilosopher
▪النوع: #فلسفة #فكر #فتغنشتاين
▪الوقت: 23 دقيقة
@Newphilosopher
👍1
السببية_عند_أرسطو_الفيلسوف_الجديد_.pdf
307.7 KB
السببية عند أرسطو - الفيلسوف الجديد، 28 ص
موسوعة ستانفورد للفلسفة
موسوعة ستانفورد للفلسفة